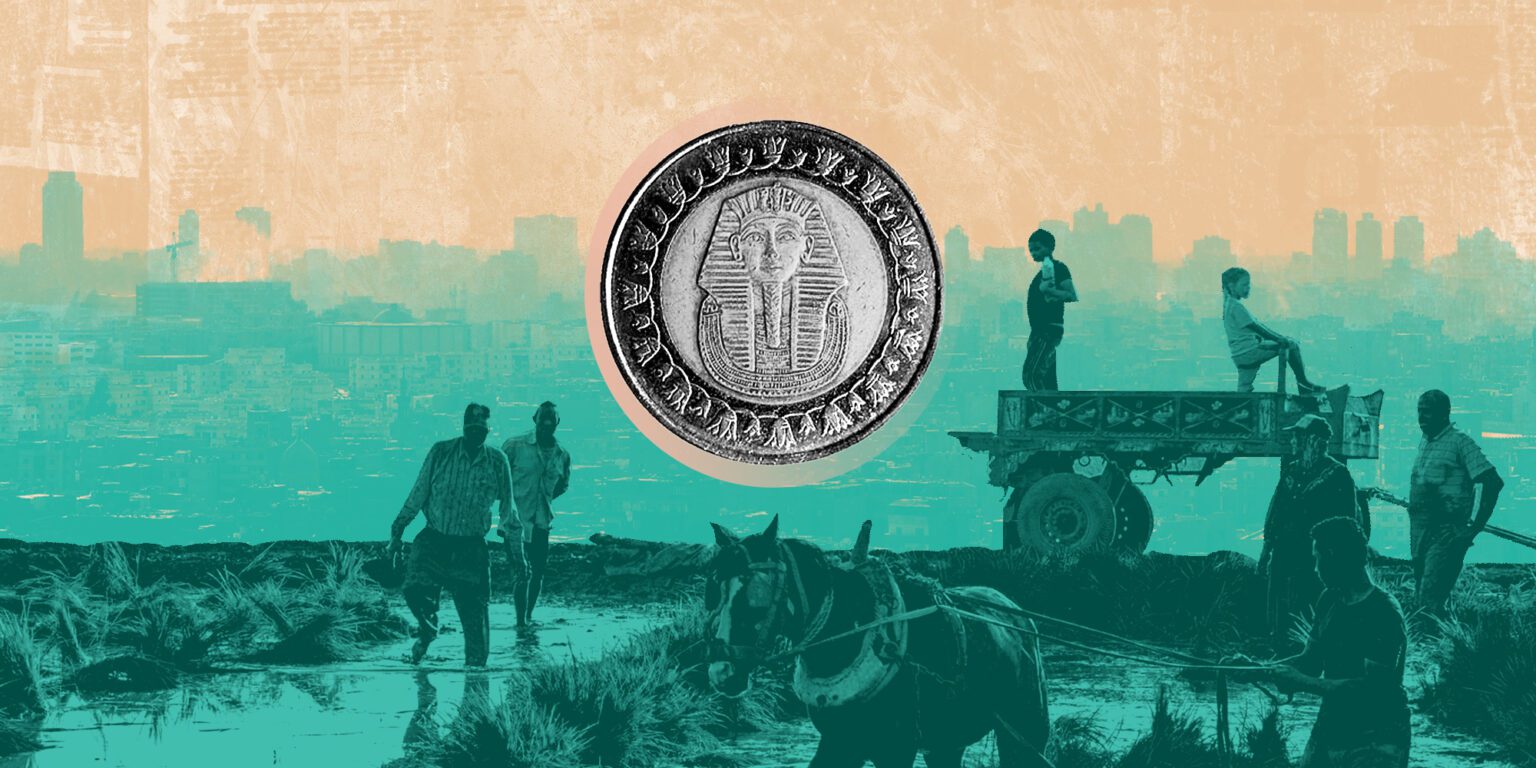ينتظر المصريون تخفيضاً جديداً للجنيه ورفعاً لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في 30 آذار/ مارس الحالي، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي قفز، خلال شباط/ فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 في المئة، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
يُرْجع صناع السياسة الاقتصادية في البلاد السبب في التضخم إلى توافر السيولة المالية في يد السكان، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، أي أنهم يحصرون مشكلة التضخم في الإطار النقدي (نسبةَ إلى النقود)، ما يجعل البنك المركزي المصري يتبنى رد فعل وحيداً حيال ذلك، وهو رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق وتخفيض الطلب، لكن هل يحدث التضخم بفعل زيادة السيولة المالية وحدها؟ وهل هذا هو ما يحصل في مصر؟
عجز عن تخفيض التضخم
وفق خبراء اقتصاديين، يحدث التضخم لسبب من اثنين، الأول ارتفاع طلب المستهلكين بما يفوق السلع المعروضة. والثاني ارتفاع تكاليف الإنتاج، والذي يتم تضخيمه إعلامياً عبر إسناده إلى الحرب الروسية – الأوكرانية، واستبعاده إدارياً بالتوقف عن معالجته تماماً، بينما توجَّه مجمل السياسات الاقتصادية في البلاد لمواجهة السبب الوهمي للتضخم، وهو السيولة النقدية.
على مدار عام كامل من الإجراءات النقدية المضادة للتضخم المتمثّلة في رفع سعر الفائدة، منذ طرح شهادات الـ 18 في المئة في آذار 2022، عجز البنك المركزي عن تخفيف حدة التضخم، بل ساهم بسياساته النقدية في تعميق التضخم وتحويله من مشكلة عرضية إلى مشكلة شبه دائمة، بسبب ما نتج من رفع سعر الفائدة من ركود ضرب النشاط الاقتصادي في البلاد. فمن المعروف اقتصادياً، أن التضخم الطبيعي يدور في حدود 9 إلى 12 في المئة، بحسب مستهدفات البنك المركزي، لذا فإن المعدلات الحالية في مصر تعني انكماشاً اقتصادياً واتساعاً لرقعتي البطالة والفقر.
ينشر موقع “درج” على حلقات كتاباً صدر هذا العام (2050) في نيويورك لكاتبه مارك دبوسي، وهو صحفي أميركي من أصل لبناني عاش في بيروت قرابة عشر سنوات.
حرب في الجهة الخاطئة
ككل البنوك المركزية في العالم، لا يستطيع البنك المركزي المصري أن يحارب ارتفاع التضخم (وهي مهمته الدستورية الأولى) إلا بأدوات نقدية، عبر رفع سعر الفائدة، وهي سياسة تصلح فقط حين يكون التضخم ناتجاً من ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض، وبالتالي يحاول البنك تقليل الطلب والاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية، فتنخفض الأسعار.
لكن الواقع خلاف ذلك تماماً، فالتضخم في مصر يرتبط بالعرض، وتحديداً بارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بشحّ الدولار، لأن الإنتاج المصري يقوم ببساطة على مستلزمات سلعية مستوردة، ويرتبط بارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة والحقلية.
وبالتالي، فإن مشكلة التضخم ترتبط بالهشاشة الاقتصادية وضعف صمود البنية الاقتصادية أمام أي مؤثرات خارجية، خصوصاً أن النظام المصري يكاد يفقد السيطرة كلياً على سعر العملة، ولم يعد في مقدور المسؤولين مقاومة ضغوط صندوق النقد والبنك الدولي والدول الخليجية لتحرير سعر الصرف.
يُرجع الباحث الاقتصادي المصري محمد رمضان، ارتفاع التضخم الهائل الى انخفاض قيمة العملة الوطنية بنحو 50 في المئة خلال أقل من عام، ما انعكس بشكل كبير على أسعار السلع، بخاصة تلك المستوردة.
البلاد باتت مكشوفة اقتصادياً على الأزمات التضخمية الناتجة من ارتفاع تكاليف الإنتاج لجهة السلع المصنعة (أو المجمعة محلياً بالأحرى) واستيراد الغذاء بسبب انخفاض قيمة الجنيه وزيادة الأسعار عالمياً (أو ما يعرف بالتضخم المستورد). ووفق رمضان، فإن ضعف كفاءة التصنيع، بخاصة السلع الوسيطة التي تشكل نحو نصف الواردات المصرية، يعد من أبرز الأسباب الهيكلية للتضخم، فأي تغير في سعر الصرف يؤثر بشكل كبير في تكلفة إنتاج كل السلع تقريباً.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالسوق المصرية في حالة فوضى عارمة، والأسعار متروكة كلياً للتجار الذين يرفعونها انتهازاً لفرصة جني أرباح سهلة أو توقعاً لتعويم ممكن يليه ارتفاع لسعر المنتجات.
العنصر الأساسي لتلك الهشاشة هو فجوة التمويل التي عانت منها البلاد على مدار العقود الأربعة الأخيرة ولا تزال، إذ كانت الأنظمة السابقة تعالج هذه المعضلة بتخفيض النفقات الاجتماعية وتحجيم الاستهلاك من خلال دعم القطاعين الزراعي التصديري، والصناعي التجميعي الذي يساهم في تقليل الاستيراد، بينما كان الحل يكمن في خطوة من اثنتين: الأولى جذب الاسثتمار المباشر، الذي فشل حكم عبد الفتاح السيسي في تحقيقه كما حكم مبارك والسادات من قبله، لأسباب أصبحت معروفة، على رأسها الفساد المتغلغل في البيروقراطية المصرية، وضعف مهارة اليد العاملة، ومكافحة الفساد الحقيقية التي تستدعي تغييراً سياسياً يعيد هيكلة الدولة، وأيضاً تغييراً في الأولويات.
الاستدانة من أجل التصنيع كانت الخيار الثاني الأكثر جذباً، إذ طالب الخبراء الرئيس السيسي، منذ لحظة وصوله الى السلطة، بتطوير القطاع الصناعي عبر الاستدانة ورد الديون لاحقاً من عوائد التصدير، وفي ظل الانخفاض الكبير لنسبة الديون المصرية، ربما أثار ذلك شهية الرئيس للاستدانة، لكن بدلاً من إعادة تطوير القطاع الصناعي وتأسيس بنية صناعية (بتكلفة أولية متوقعة 60 مليار دولار)، جلب الرئيس 120 مليار من الخارج وضخّ معظمها في قطاعي البنية التحتية والعقارات.
لم يكن السيسي يراهن على الإنفاق على القطاع العقاري في البداية، لكنه حين كان رئيساً للمخابرات العسكرية كان يتابع باهتمام مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي كان نظام الإخوان المسلمين يحاول إنشاءه باستثمار قطري. وبعدما أطيح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، أبدى السيسي اهتماماً بتكملة المشروع على أنه مشروعه الخاص، فبدأ بحفر قناة السويس الجديدة متوقعاً أن تضيف إلى خزينة البلاد 100 مليار دولار، لكنها لم تحقق رقماً مهماً.
المفارقة أن حفر القناة تحقّق باكتتابٍ شعبي لم تشهده مصر منذ تأسيس “بنك مصر”، بقيادة الاقتصادي المصري طلعت حرب في عشرينات القرن الماضي، أي أن القناة، على رغم أنها بددت جزءاً معتبراً من مدخرات المصريين، كانت ثمرة عفوية لـ”الاعتماد على الذات” كاستراتيجية بديلة للتنمية بدلاً من الاعتماد على الاستثمار المباشر أو الديون، لكن الرئيس السيسي لم يفطن إلى ذلك، بل دفع المصريين الى إخراج أموالهم وصرفها عبر الضرائب والجباية وكل ما طاولت يداه.
إقرأوا أيضاً:
قناة السويس وجذب المستثمرين
بعدما فشلت قناة السويس الجديدة فشلاً مؤسفاً، أراد السيسي جذب الشركات التي تستخدم قناة السويس في نقل بضائعها، مشجعاً إياها على نقل مصانعها الى ضفاف القناة، واختصار المسافة إلى البلاد التي تصدّر البضائع إليها، لكنها رفضت بحجة ضعف البنية التحتية ومشكلات الإرهاب وضعف شبكة الاتصالات وبُعْد أكبر مدينة كبيرة من القناة، وهي القاهرة، بمسافة 160 كيلومتراً.
عمد السيسي الى إنشاء عاصمة جديدة في الصحراء الشرقية (جهة السويس) ومدينة الجلالة بالقرب من السويس، وأنشأ شبكة طرق جديدة تربط كلاً من السويس والجلالة والعاصمة الإدارية والقاهرة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح، بالإضافة إلى المونوريل والقطار السريع لنقل البضائع، معلناً “الجمهورية الجديدة” من دون أي مقدمات.
هذه الاستثمارات التي كلفت البلاد أكثر من 120 مليار دولار، لم تجذب المستثمرين حتى الآن، ولا يبدو أنهم سيأتون في المستقبل القريب، وهذه الديون التي أُنفقت في مشروعات غير إنتاجية والتي تتطلب خدمتها تفريغ خزينة البلاد تدريجياً، ضاعفت هشاشة اقتصاد البلاد أكثر فأكثر.
التنمية عبر الدين
تعود مشكلة الديون وضعف ما تضيفه الضرائب إلى خزينة الدولة إلى سياسات طبقية في المقام الأول، إذ تخفض الدولة الضرائب على الأرباح بشكل كبير على الأغنياء ورجال الأعمال، خوفاً من هروب أموالهم إلى الخارج (على رغم أنها تهرب في نهاية الأمر)، وترفع في المقابل الضرائب غير المباشرة (ضريبة الاستهلاك، ثم ضريبة المبيعات، وأخيراً ضريبة القيمة المضافة)، وهو ما جعل موارد البلاد غير كافية لسد فجوة العجز التجاري.
كما تعود المشكلة إلى ضعف مدخرات المصريين، وبالتالي ضعف الموارد الموجّهة للاستثمار، فلتمويل الإنفاق الاستثماري يجب ألا يقل معدل ادخار المصريين عن 25 في المئة على الأقل، فيما لم يتجاوز الـ6 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الأجور، وهي مشكلة مرتبطة دائرياً بضعف الإنتاجية، فالأجور ضعيفة بسبب ضعف الإنتاجية والإنتاجية ضعيفة بسبب ضعف الأجور، والحكومة لا تملك شيئاً إزاء ذلك. وبدلاً من الضغط على أصحاب الأعمال لحماية العمال ورفع رواتبهم والتأمين عليهم، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم، وقفت الدولة موقف المتفرج، خوفاً من هروب المستثمرين، إزاء ممارسات الظلم الساحق في بيئات العمل المصرية، الذي يسفر عن مستوى متدنِّ من الإنتاجية، فضلاً عن عزوفها عن القيام بدورها في التعليم والتدريب والتأهيل الفني، وهو ما يؤثر بدوره على مقدرات البلاد، إذ يحرمها من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتطلب عمالة رخيصة ومؤهلة، بينما تكتفي الحكومة بتوفير العمالة الرخيصة فقط.
وبالتالي، لا ترتبط مشكلة ضعف المدخرات بإسراف المصريين أو استهلاكهم كما يعتقد صانعو السياسة الاقتصادية، وعليه يحاولون نزع النقود من يد الشعب، بل بضعف الأجور بشكل أساسي، وهي مشكلة طبقية أخرى تتسبب بها الحكومة بمحاباتها أصحاب الأعمال على حساب المنتجين الذين لا يجدون ما يدخرونه.
الدين طريقاً للتضخّم
هذا الواقع قائم منذ أربعة عقود على الأقل، فلماذا تفاقم الآن؟ حدث ذلك بشكل أساسي بسبب جرأة الرئيس السيسي على الاقتراض في ظل غياب الكوابح السياسية، فيما كان الرئيس الراحل أنور السادات محاطاً ببحر من التيارات السياسية المعارضة للنفوذ الأجنبي ودمج الاقتصاد المصري بالاقتصادات العالمية. أما خلال حكم الرئيس مبارك في الثمانينات، حين وصلت البلاد الى الإفلاس في عام 1989، وأُسقطت الديون أميركياً بفضل مشاركة الجيش المصري في حرب الخليج، كان مبارك أكثر حذراً في الاقتراض الخارجي، حتى لو جاء ذلك على حساب التنمية.
أما الرئيس السيسي فقد جاء في عصر الأموال الرخيصة الناتجة من سياسة التسيير الكمي في البلاد الأجنبية بعد أزمة 2008، وهي سياسة قائمة على طبع النقود من دون غطاء من الذهب أو ما يقابله من السلع، ومنح القروض بفائدة تقارب الصفر، وهو أمر يثير شهية حاكم يحلم بالعظمة والإبهار والإنجازات السهلة.
لكن حين بدأ البنك الفيدرالي الأميركي في رفع سعر الفائدة في أواخر عام 2021، جاذباً تلالاً من الدولارات حول العالم إلى النظام المصرفي الأميركي باعتباره الملاذ الآمن للإدخار العالمي والاستثمار، سقطت مصر في هوة عميقة من الشح الدولاري.
ومن هذه الزاوية بالذات، تلعب الديون دوراً معتبراً في التضخم، كما يقول الباحث الاقتصادي مجدي عبد الهادي لـ”درج”، من خلال قنوات عدة، أولها رفعها تكلفة الاقتراض من الخارج نتيجة ضعف الثقة الائتمانية في بلد مرتفع المديونية، ما يرفع تكاليف تمويل سداد تلك القروض أياً كانت الطريقة، وثانيها من خلال القروض الخارجية نفسها، كوسيلة تمويل، تطبع الحكومة على أساسها نقوداً جديدة تدخل الاقتصاد دونما تصديرٍ موازٍ، والأدهى توظيف تلك القروض في مشاريع لا تنعكس في زيادة الإنتاج والعرض المحلي بشكل يوازي زيادة القاعدة النقدية.
أما ثالثها وأكثرها وضوحاً هو انعكاسها التراكمي على تدهور سعر صرف العملة الوطنية، بما ترتبه من صدمات تضخم على كامل مستوى الاقتصاد، تزيد معه حمولة التضخم المستورد، بحسب عبد الهادي.
ذلك كله يوضح أن مشكلة التضخم في البلاد تتطلب تغييرات سياسية وإجرائية أكثر عدالة وشمولاً من مجرد رفع سعر الفائدة، الذي قد يطيح بالنشاط الاقتصادي في البلاد إذا ما استمر على هذه الوتيرة التي يعمل بها البنك المركزي.
فلم يعد أمام النظام هامش أكبر للمناورة أمام القوى الاقتصادية الدولية، وليس هناك مسؤول مصري واحد على استعداد للوقوف في وجه تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي والخبراء النقديين الذين يعيدون تأكيد موقفهم بحياد: تخفيض قيمة العملة المصرية ورفع الفائدة وتبني سياسات انكماشية، مع كل ما تحمله من ثقل على كاهل المصريين.
وعلى رغم أن البلاد في أول طريق الركود، الذي يتطلب إجراءات توسعية ولو جزئية، فإن هذه النسب العالية من التضخم، وفق الباحث الاقتصادي محمد جاد، في حديثه لـ”درج”، تؤثر في الاقتصاد بسبب إجبارها البنك المركزي على رفع سعر الفائدة، وبالتالي تخفيض الطلب الاستهلاكي، ما يحدّ من النمو الاقتصادي للبلاد، ويؤدي إلى زيادة تكلفة القروض على المنتجين، فيرفع الأسعار ويزيد نسبة التضخم في النهاية.