يَتحرّك الرعب في الأنظمة القمعيّة كالهواء، تختلف ثخانته وتدفقه، بحسب الفرد والمكان، هو تلك القشعريرة التي يستعيد عبرها قاطنو مدينة كدمشق، عنفاً ماضياً من دون القدرة على الإشارة إليه، فالرعب يُهدد “الاستقرار” و”الحس بالأمان”، لا في المدينة وحدها، إنما أيضاً في المنازل والأجساد التي قد تتحول جثثاً هامدة بسبب كلمة على البطاقة الشخصيّة.
العلاقات المحكومة بالرعب في المدينة أساسها النجاة، فالرعب يستنزفُ طاقة أجساد القاطنين، بوصفها موضع عنف النظام القائم، ما يقضي على البعد السياسي الذي يمكن أن يمتلكه المواطنون، إذ لا قرار لهم في ما يحدث.
ويظهر “الصحافيون المرحون” مصطادو “الشكل الجديد” من الحياة، يقتبسون من الأحداث اليوميّة ليكتبوا نسخة “بيضاء” و”نظيفة” و”مُنمّقة” عن حياة الكتلة البشرية القاطنة في المدينة، في تجاهل وتناس مقصودين لسطوة العنف، الذي أنتج ضحايا، ومهجّرين، ومعتقلين سابقين، ومناضلين لأجل لقمة العيش.
سنناقش ثلاثة نماذج لا تظهر بوضوح ضمن مُنتجات “الصحافيين المرحين”، لاكتشاف تجربة “العدو المهزوم” أو المعتقل السابق الذي يحاول متابعة حياته، و”المواطن المطيع” الذي يحاول الحفاظ على حياته، و”الصحافي المتخفيّ” الذي يحاول أن يكتب ويمارس مهنته خارج سياق البروباغاندا الرسميّة أو الحكايات المرضية.
“الصحافة الإنسانيّة” أو “الصحافة السرديّة” التي نحاول انتقادها تُنتشر على المنصات التي تأخذ موقفاً معارضاً أو ناقداً للنظام السوريّ، ومشكلة هذه “الحكايات” أنها متحذلقة وتوارب حول المشكلة الرئيسية في سوريا ودمشق، وتتبنّى أسلوباً وديّاً، متواضعاً، حميمياً، يتفادى الكلمات والتسميات التي تشير إلى مصدر الرعب. كما يتم ترتيب الحجج و”المعلومات” ضمنها بطريقة تحث على التعاطف السطحيّ مع الناجين الذين فقدوا كل شيء.
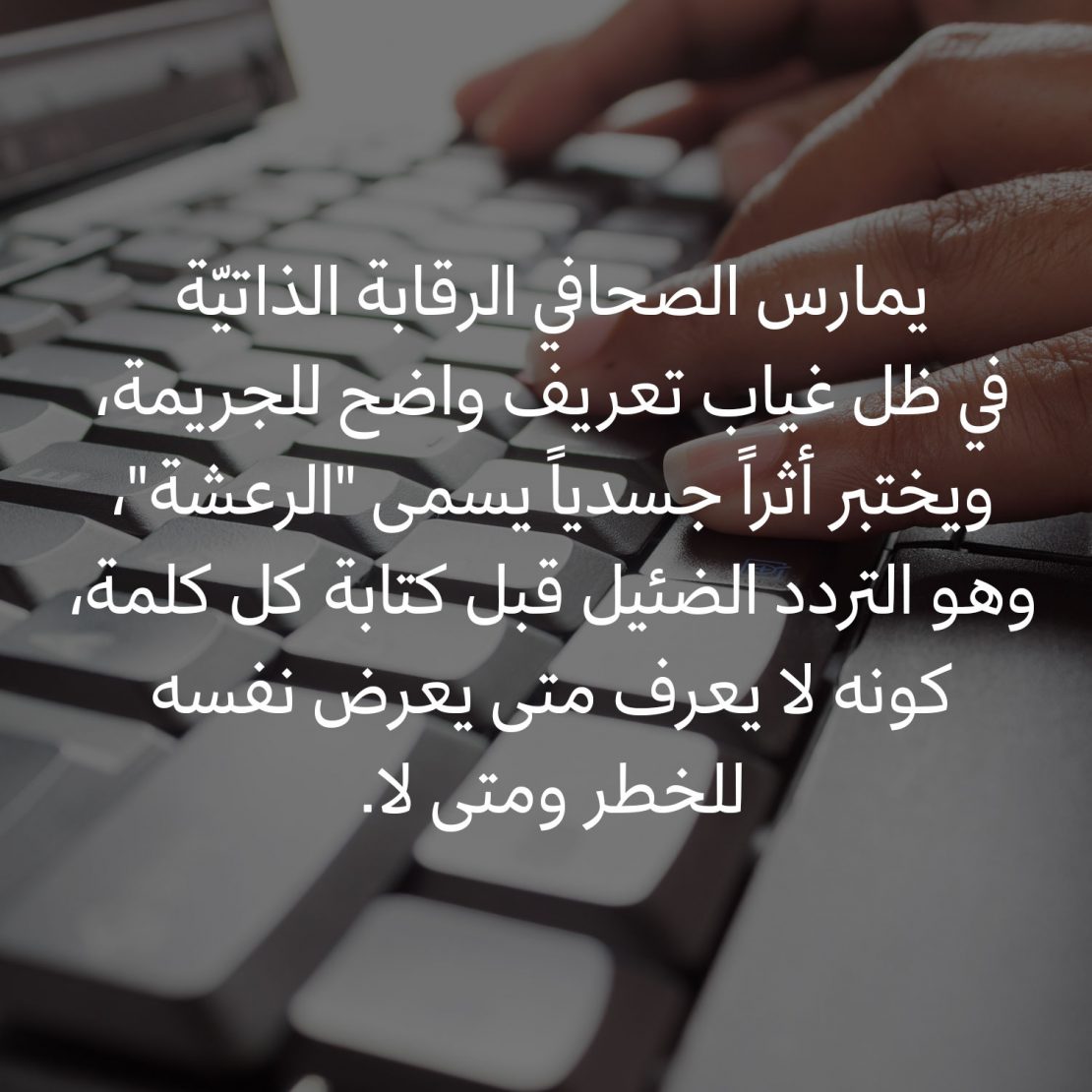
تخلق الحذلقة تلك، مفارقة لدى القارئ، كونها تخفي طبقات من العنف، إذ تجزئ التجربة الإنسانيّة في المكان لإعادة رسم ملامحها، بعيداً من أي دلالات سياسيّة. هي تدّعي كشف هموم الناس ومعاناتهم وتستخدم أسماءهم الحقيقيّة، لننغمس في تجربة الفرد المقيم في المدينة وكلماته الشعريّة، من دون أي صدى للخوف أو الرعب، الذي نراه على وجوه آخرين، لا نستطيع ذكر أسمائهم خوفاً على حياتهم، التي يدارونها ويخافون أي إشارة إلى موقفهم مما شهدته المدينة.
العدو المهزوم
ترك الاعتقال ندبة على ساق أ.ح، (28 سنة)، الذي خرج من المعتقل في أحد الأفرع الأمنيّة في دمشق بعد عامين ونصف العام، بتهمة “إرهاب مدينة”. الندبة مصدرها جرح لم يُعالَج، وكان محظوظاً لأن الأمر لم يتطور إلى التهاب عميق في اللحم، ولم يمت بسببه كما حصل لكثيرين. لكنه، وبعد خروجه، بقي محروماً من حقوقه المدنيّة، ممنوعاً من السفر، ومحجوزاً على أمواله. في حديث معه، وبعد سلسلة من أساليب “الوقاية” من الرقابة والتشفير المقصود للكلمات والعبارات، وصف لـ”درج” مرحلة ما “بعد الاعتقال” قائلاً: “بقيت لفترة طويلة بعد خروجي من السجن في المنزل، لا أغادر كثيراً، وحين أغادر أتجنب كل ما هو عسكري، وأتجنب الاختلاط بأناس جدد، أحاول أن أعيش (ضمن القانون)، وأتحاشى أي دائرة حكوميّة، إلا للضرورة القصوى، والآن أصبح لدي بعد عناء جواز سفر. وكنت أتجنب السؤال لفترة طويلة عن وضعي القانونيّ بسبب الخوف، حتى بعد صدور العفو الرئاسيّ الذي شملني”.
أ.ح واحد من “الأعداء” الذين نجوا، في حين فقد آخرون حياتهم، وأُعلن موتهم في السجون بجلطات قلبيّة. هو واحد من كتلة بشريّة، تمارس حياتها اليوميّة بعد “تأديبها”، يعيشون في ظل التهديد الدائم، والخوف من الاعتقال مرة أخرى، هم الذين شهدوا الرعب بأجسادهم، وما زالوا يتحركون في مساحات السيادة و”الأمن والأمان”.
الرعب الذي يعتري “الأعداء السابقين” يمتد إلى المكان وتكوينه الرمزي، والأشخاص الفاعلين ضمنه، ضباط النظام العام. فالصور والأشخاص يبثون الرعب ذاته، كوننا لا نعلم من يمكن أن يشكّل بينهم تهديداً، وهذا ما يقوله أ.ح: “بعد خروجي من السجن، عدت إلى المكان الذي اعتقلت منه بحكم أنه مكان دراستي، والشخص المسؤول عن اعتقالي كان هناك، أراه دوماً، والرعب يرافقني كيفما تحركت، لم أتحدث عن تجربة الاعتقال، بقيت في داخلي، وحتى حين أتحرك في أرجاء المكان الذي اعتقلت منه، تعود إليّ ومضات ما حدث، وكيف حدث، وأخشى أن يتكرر”.
ترك الاعتقال ندبة على ساق أ.ح، (28 سنة)، الذي خرج من المعتقل في أحد الأفرع الأمنيّة في دمشق بعد عامين ونصف العام، بتهمة “إرهاب مدينة”.
هذه العلاقة الخطرة مع الذاكرة، والخوف من استعادة العنف الشخصيّ، تخفيانه معاناة الحياة اليوميّة، خصوصاً أن “العنف” لا ينتهي بمجرد الخروج من السجن، بل له أعراض قانونية وقضائيّة، وأخرى جسدية تظهر مع الزمن. وهنا يخبرنا أ.ح عن تجربته وعن “إحساسه” بأنه نجا إذ يقول: “في المرحلة الأولى خارج السجن كان الأمر أشبه بالحلم، كان لدي يقين بأنني مت داخل المعتقل، وحياتي الآن هي حلم، وأنا متوهم بأنني حيّ، بقيت مضطرباً لفترة طويلة، وكأنني أعيش حياة بديلة، ستنتهي في أي لحظة، لكن، بعد فترة، صدّقتُ أنّني نجوت، لكن ما زالت تراودني أفكار عن رداءة المكان الذي كنت فيه، ورداءة المكان الآن خارج السجن، وأحياناً تظهر الزنزانة فجأة أمامي، من دون أي مؤثر أو محرض، فقط ومضة أشبه بصفعة”.
المثير للاهتمام حين الحديث مع أ.ح هو أنه يتابع البرامج التي يتحدث فيها المعتقلون السابقون عن ذكرياتهم، ويؤكد أن ما فيها “حقيقي”، وكأن من في الخارج، الذين يمتلكون القدرة على الحديث عما مر معهم، محظوظون نوعاً ما، وكأن في الاستذكار والسرد نوعاً من العلاج. وهنا لا بد من الإحالة إلى أسلوب التشفير الذي يستخدمه أ.ح، وترتيب الكلمات واختياره إياها، وما يسكت عنه وما يقوله، و”الرعشة” التي يثيرها فيه الحديث خوفاً من رقيب ما.
المواطن المطيع
هناك اتفاق ضمني من نوع ما، بين م.م ذو الـ47 سنة وزوار بيته، عليهم أن يطرقوا الباب بصورة “موسيقيّة”، ذات نغم، بدل الضرب المباشر من دون إيقاع، لأن ذلك يزلزل البيت وقد يخرب الزيارة المتوقعة، والسبب أن الطرق من دون إيقاع كان من اختصاص دوريات التفتيش والمداهمات التي كانت تجوب دمشق.
ينتمي م.م إلى كتلة بشريّة تمارس الطاعة، لم يتعرض لأي عنف جسديّ مباشر، لكن أولاده اضطروا إلى ترك البلاد، هو محاط بهالة من الرعب تهدد حتى وجوده في منزله (الآمن)، إذ يقول: “يزورنا كل فترة عناصر من الجيش، يسألون عن الأولاد، وأين رحلوا، كونهم متخلفين عن الجيش، فيكون جوابي أنهم في الخارج، يكملون دراستهم، أشعر بالخوف كلما أتو، علماً أنهم ألطف ممن كانوا سابقاً بسلاحهم لتفتيش المنزل”. ويضيف: “أحمد الله دوماً حين يغادرون، فأولادي بخير، لكن أحياناً نكون في الشارع مع زوجتي، فتجهش بالبكاء، إذ ترى شاباً يشبه واحداً من أبنائها، فتركض نحوه، تضمه، وتدعو له بالخير، أعلم أنهم لن يرجعوا إلى سوريا، ولا أريدهم أن يرجعوا، أخاف أن يعتقلوا أو ينتهي بهم الأمر في الجيش”.
يردف م.م: “كنا نسمع في نشرات الأخبار عن تظاهرات في الحي الذي نقطنه، نتسلل خفية أمام الباب، نشاهد ما يحصل، ثم نعود ونقفل الباب، حتى يصل الأمن لتفريق الناس، كان هذا منذ زمن بعيد، الآن. لا يوجد أي مظاهر لذلك، لكننا نعلم من كان في الحي على تواصل مع رجال الأمن، وأحاول دوماً حين يسألونني عن أولادي أن أخبرهم بأنهم ذهبوا ليكملوا دراستهم، وأطلب منهم الدعاء بالتوفيق وأمل اللقاء”.
المطيعون
تتجلى الطاعة السابقة كأداء جسديّ، سواء كان جديّاً أو ساخراً، عبر سلسلة من “الحركات” و”التصرفات” المرئية، للابتعاد من الشبهات. هؤلاء المطيعون كحالة م.م، هم الكتلة التي يراهن النظام السوري عليها، بوصفهم مولّدي النظام العام ومنتجيه، هم الذين يظهرون في خلفيات التقارير الرسميّة، يرقص أمامهم ناشطو المجتمع المدني، ويوزعون عليهم المياه والحلويات كمبادرة #هانت، التي وزعت فيها الزهور على المنتظرين في طوابير محطات البنزين.
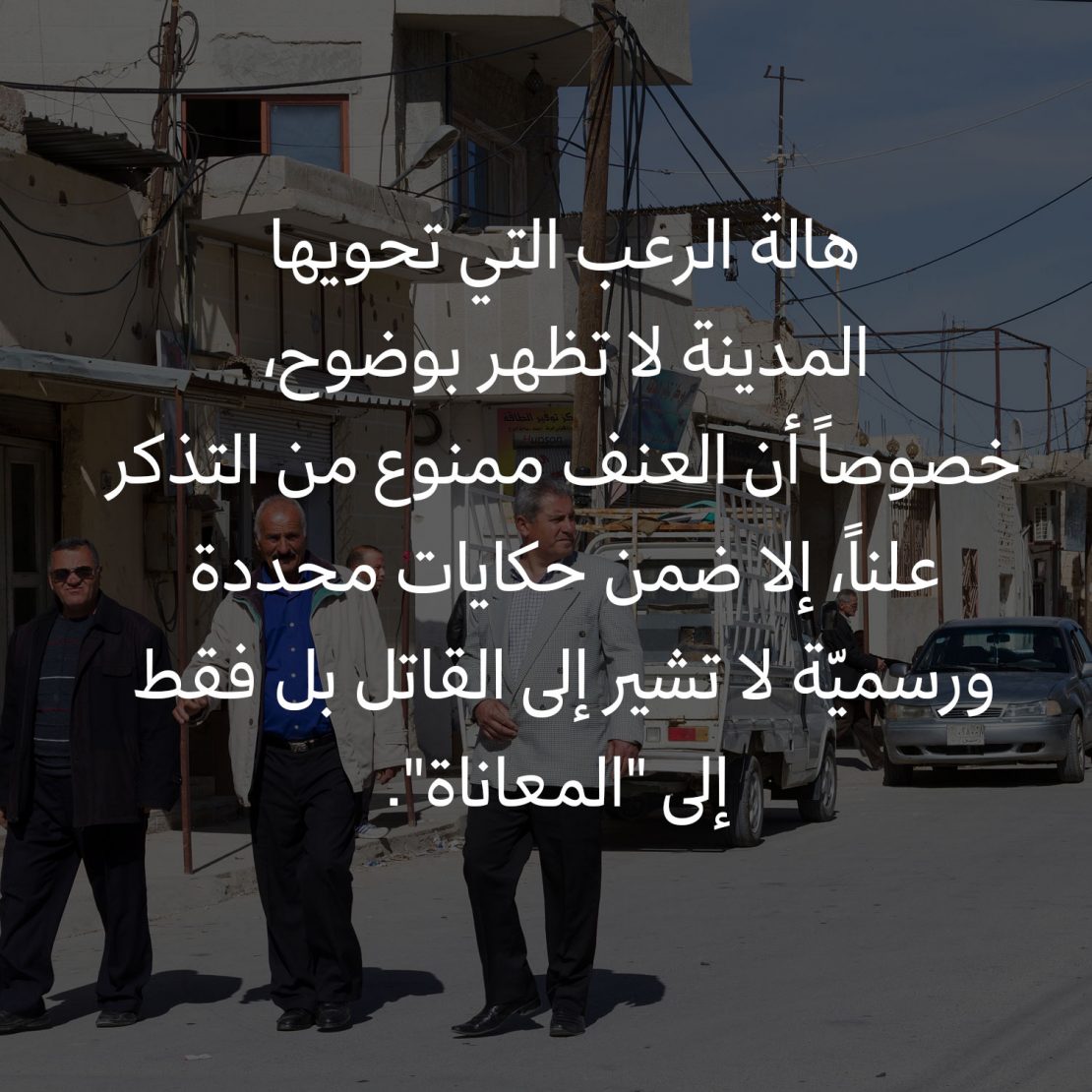
هالة الرعب التي تحويها المدينة لا تظهر بوضوح، خصوصاً أن العنف ممنوع من التذكر علناً، إلا ضمن حكايات محددة ورسميّة لا تشير إلى القاتل بل فقط إلى “المعاناة”. وهنا يظهر أثر الرعب، هو تلك الرعشة الجسدية المحيطة بالحياة اليوميّة، التردد الطفيف أثناء الكلام أو الابتسامة الساخرة أمام العدسة، هو الالتزام الهش بسيناريو السلطة الرسميّ، الذي يرى بدقة بحسب كلمات بشار الأسد، أن هناك “شعباً وهمياً” و”مخترعاً” في عقول من يرفضون سلطة النظام السوري.
ضمن أنظمة الحرب الأهلية تتحول المدينة إلى مساحة للقضاء على احتمالات الإنتاج لدى الأفراد، الكتلة المطيعة والخاضعة لسطوة السلطة تتحول إلى ما يشبه “الحياة الصرفة” تحاول فقط النجاة وضمان استمرارها الجسديّ. ويتحول الحصول على الطعام والشراب ومتطلبات الحياة إلى معاناة يومية، وتحدياً ضد “أفخاخ” لا يمكن التنبؤ بها، فتهديد مقومات الحياة أشبه باستراتجيّة سياسيّة لترسيخ مفهوم النجاة والصبر في سبيل تجاوز “الأزمة” وإعادة بناء الوطن بعد التخلص من الإرهابيين، ونتلمس هذه السياسات ضمن تفاصيل الحياة اليوميّة. يقول م.م الذي لا يتجاوز راتبه الـ100 دولار شهرياً: “النقود فقدت قيمتها، حتى ما يصلنا من الخارج يختلف سعر صرفه الرسمي عن السوق السوداء، لذلك أطلب من أولادي تحويل النقود إلى بيروت، ليقوم شخص بإدخالها إلى دمشق ورقياً، لأصرفها في السوق السوداء، لأكسب أكثر”.
التقنيات السابقة مرتبطة باقتصاد ظلّ من نوع ما، وتاريخ من الفساد الذي هيمنت أشكاله على مفاصل الحياة، ليكون الجميع “نظرياً” مذنبين، وليلجأوا إلى طرائق “لا قانونيّة” للحصول على مقومات الحياة، لنعود لنظام الحرب الأهليّة، الذي يجرّم الجميع، ويحولهم إلى ساعين لنجاتهم، وكأن المدينة مصممة ضدهم. شوارع دمشق شهدت موتاً عشوائياً ومراقبة من أفرع أمن خفيّة، وكتلة بشريّة تتحكم بمقدرات الحياة، ليظهر “الصمود اليومي” كواجب وطني على الجميع المشاركة فيه.
يترك الرعب أثراً في الذاكرة التي تخزن صوراً عن انفجارات واحتمالات موت شهدتها المدينة، وعنف ما زال مستمرّاً حتى بعد توقف المعارك المباشرة حول المدينة، كمحاولات إثبات “غياب” الزوج، أو إثبات موت أحدهم، ليتحول العنف السياسي المباشر إلى عراك بيروقراطي حول تعريف الحياة والموت، ومحاولة لتفادي الذاكرة السابقة عن “الموت”. يقول م.م: “شهدت انفجارات عدة كانت قريبة مني، نجوت منها بأعجوبة، وإلى الآن أذكر كلما مررت من جانب الأماكن التي وقعت فيها، ما كان يمكن أن يحصل، كنت اختفيت أو احترقت”.
شوارع دمشق شهدت موتاً عشوائياً ومراقبة من أفرع أمن خفيّة، وكتلة بشريّة تتحكم بمقدرات الحياة، ليظهر “الصمود اليومي” كواجب وطني على الجميع المشاركة فيه.
ويضيف: “شاهدت أشلاء نتيجة انفجارات وقذائف هاون عشوائية، وجدت نفسي مصادفة بجانبها، ما زلت أرتعد كلما مررت من المكان، أشير إلى زوجتي أحياناً إليها، ونحمد الله أنا وزوجتي لأن أولادنا غادراو البلاد، لأنني أعلم، أنه لو حصل شيء لأي واحد منهم، لكنت مشيت في الشارع مجنوناً”.
الصحافي المتخفّي
كيف يكتب أحدهم من دمشق؟ سذاجة هذا السؤال لم تكن مفاجئة لبيسان السعيد ذات الـ27 سنة، التي لم تتعرض للاعتقال، وتعمل صحافيّة باسم وهمي من داخل المدينة، وتصف لـ”درج” بداية تجربة الكتابة لمنصات “مشبوهة” وأجنبيّة، بقولها:” أعي أنظمة المراقبة التي يملكها النظام السوريّ، وهذا خطر لا بدّ من التسليم به. المحررون فقط يعرفون هويتي الحقيقيّة، كما أنني أتجنب التعريف عن نفسي كصحافية حين ألتقي بعض من أريد أخذ آرائهم، وأفضل اللقاءات الشخصية على المراسلات الإلكترونيّة”.
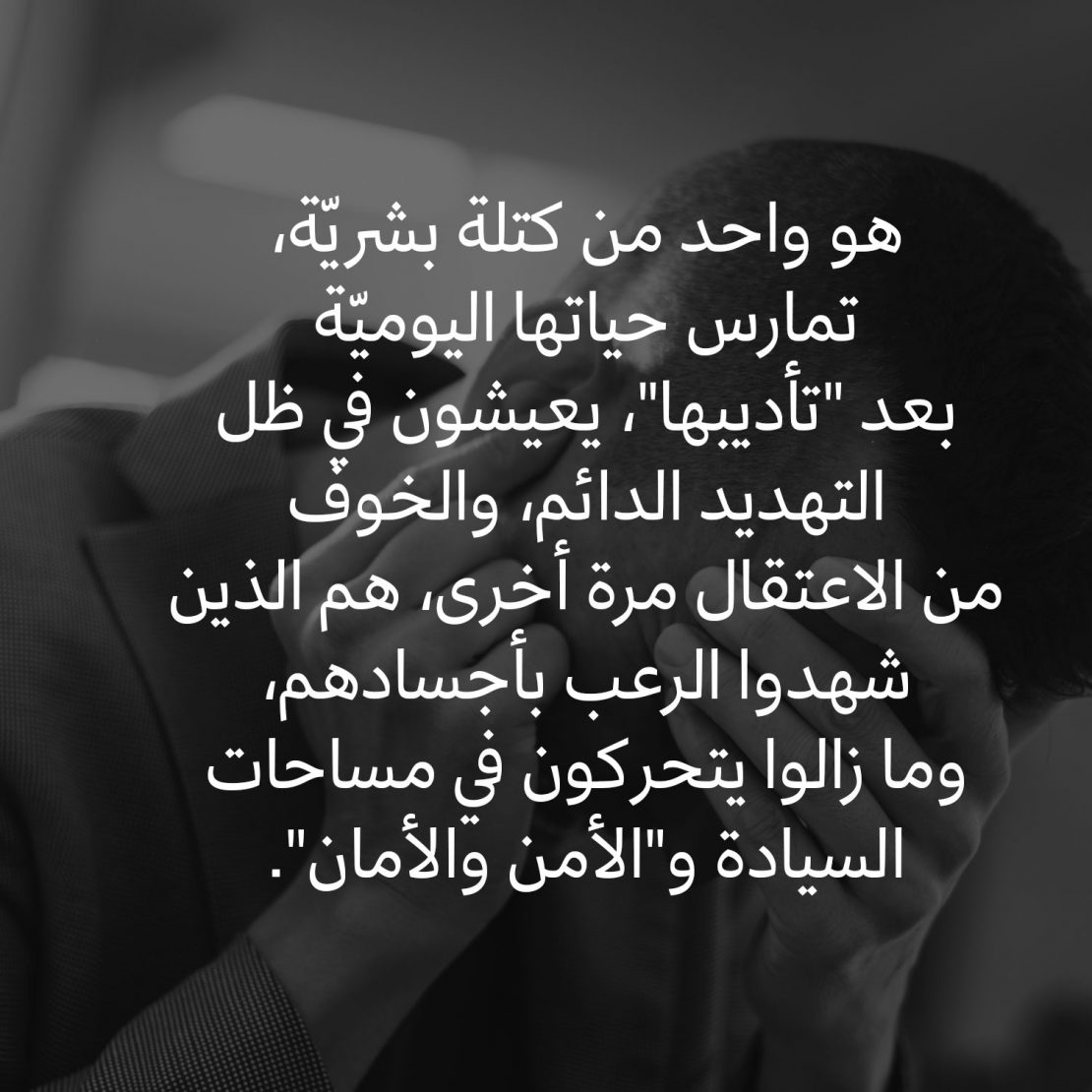
تنتمي السعيد إلى فئة من المتخفّين، أصحاب الأسماء الوهميّة، الذين لا يثيرون الجدل، لا يمتلكون صلاحيات “الصحافي المرح”، الذي يتنقل في أنحاء المدينة. هي واحدة من الذين مع كل لمسة على لوحة المفاتيح يخافون أن ينكشف أمرهم. تتابع: “أتحرك في المدينة كسائحة في بعض الأحيان، أراقب باهتمام وبحذر، فالناس في سوريا كالزومبي، ويستفزني ما أقرأه عن الحياة الطبيعية والمستمرة، ولكنني أخاف أن اكتب عن الموضوع لا بسبب “الجريمة” المرتبطة بذلك وحسب، بل أيضاً لأن الأمر مخيف عاطفياً، إذ لا يمكن لوم الناس كلياً على متابعتهم حياتهم، ولا يمكن لوم النظام فقط، كذلك هناك تقسيمات كثيرة في المناطق المختلفة، وهذا ما يجعل الحذر والخوف لا يرتبطان بسطوة النظام وحدها، بل أيضاً بالقارئ ورأيه في ما أكتبه”.
الفئة الثانيّة من الصحافيين المستقلين هم أولئك المرحون، الذين يتحركون في فضاءات المدينة، ويغطون حكاياتها، وتطغى على حكايتهم القصص الإنسانيّة أو الـ”فيتشر”، هم نشيطون، يكتبون بأسمائهم الصريحة، يحبّون البيئة ويحاولون إنقاذها، ينشطون لحقوق المرأة، هناك “جديّة” لا يمكن إنكارها في طبيعة هذا العمل الصحافي، لكنه مسموح، مباح، منمّق، يتعامل مع المدينة كمساحة للمغامرة.
الرقابة الذاتية
يمارس الصحافي الرقابة الذاتيّة في ظل غياب تعريف واضح للجريمة، ويختبر أثراً جسدياً يسمى “الرعشة”، وهو التردد الضئيل قبل كتابة كل كلمة، كونه لا يعرف متى يعرض نفسه للخطر ومتى لا. هذه الرعشة قد تتسلل إلى النص من دون أن تكون واضحة، هي تهدد أسلوب الصحافي المتخفّي وكيفية وصفه المكان أو ترتيبه حججه المنطقية. وتخبرنا السعيد: “كنت مرة أكتب وأصف أحد الحواجز العسكريّة، وآلية إيقافه للناس وتعامله معهم، لأكتشف بعدما انتهيت أن النص يوضح أنني من سكان المنطقة، وأعرف تفاصيلها بدقة، ما اضطرني إلى تغيير الوصف والتخفيف من إدراكي لما يحصل خوفاً من انكشاف هويتي”.
القصص التي نقرأها ونتداولها تمر على محررين ومدققين وأشخاص ذوي مواقف سياسية متنوعة، والأهم هناك سياسات المنصة نفسها، وهنا تتحدث السعيد عن هذه الإشكاليّة: “أواجه مشكلات مع المحررين الذين بسبب تغييرهم الكلمات والجمل، تتلاشى بعض العبارات وتستبدل بأخرى غير صحيحة، لكن المشكلة أنني لا أستطيع الحديث عن ذلك علناً أو الإشارة إليه كوني أكتب باسم وهمي، ولا أستطيع أن افضح ذلك، بالتالي، تترك المقالات أحياناً أسيرة بعض آراء المحررين في الصحف والمواقع المختلفة، لكن ما أحاول دوماً أن أفعله هو الإشارة إلى العطب، لا أتعامل مع الأعراض فقط، بل أشير إلى السبب والسياق، ولا أتجاهل حقيقة تاريخ المكان وما شهده”.
عادة ما يتم استخدام قوالب وأساليب صحافيّة لهذا النوع من الحكايات تحت تسميّة “قالب وول ستريت جورنال” أو تقنية “المربعات الخمسة”، الذي يركز على السرد القصصي والعاطفيّ، وظهر شكله النظري الواضح في الثمانينات. كما صدر كتاب يشرح هذه التقنيّة وعلاقة السرد القصصي مع القصة الإخبارية، لكن ما يهمنا هو أن هذا القالب يراهن لجذب القارئ إلى الحميمي، وتجربة الشخص الذي يتم اقتباس كلمات منه في بداية المقال، للانتقال إلى العمومي والرسمي و”الإخباري”.
هنا لا بدّ من الإحالة إلى أهميّة “الماضي” في هذه القصص و”الفيتشرات” التي تتبنى هذا القالب، ففي الكتاب الذي ينظّر لهThe Art and Craft of Feature Writing: Based on The Wall Street Journal Guide”، يُذكر أن الماضي لا بد أن يكون ظاهراً كونه على علاقة وطيدة مع ما يحصل الآن، والأهم أن “الحكاية الحميميّة” تكتسب أهميتها، بأنها أسلوب لجذب القارئ وإضفاء العاطفة على الحكاية، ولا تشكل جوهرها، بل هي وسيلة لكشف الاختلاف بين “الرسميّ” و”الشخصي”، لكن حينما يكون الرسمي مُضللاً، والشخصيّ محكوماً بالخوف، من دون أي إشارة إلى “الماضي” وكيف شكّل الآن، نرى أنفسنا كحالة بيسان، صحافيين خائفين، قصصهم قائمة على المراقبة، أو علنيين ومرحين، قصصهم قائمة على “الميلودراما” والمعلومات المشبوهة.







