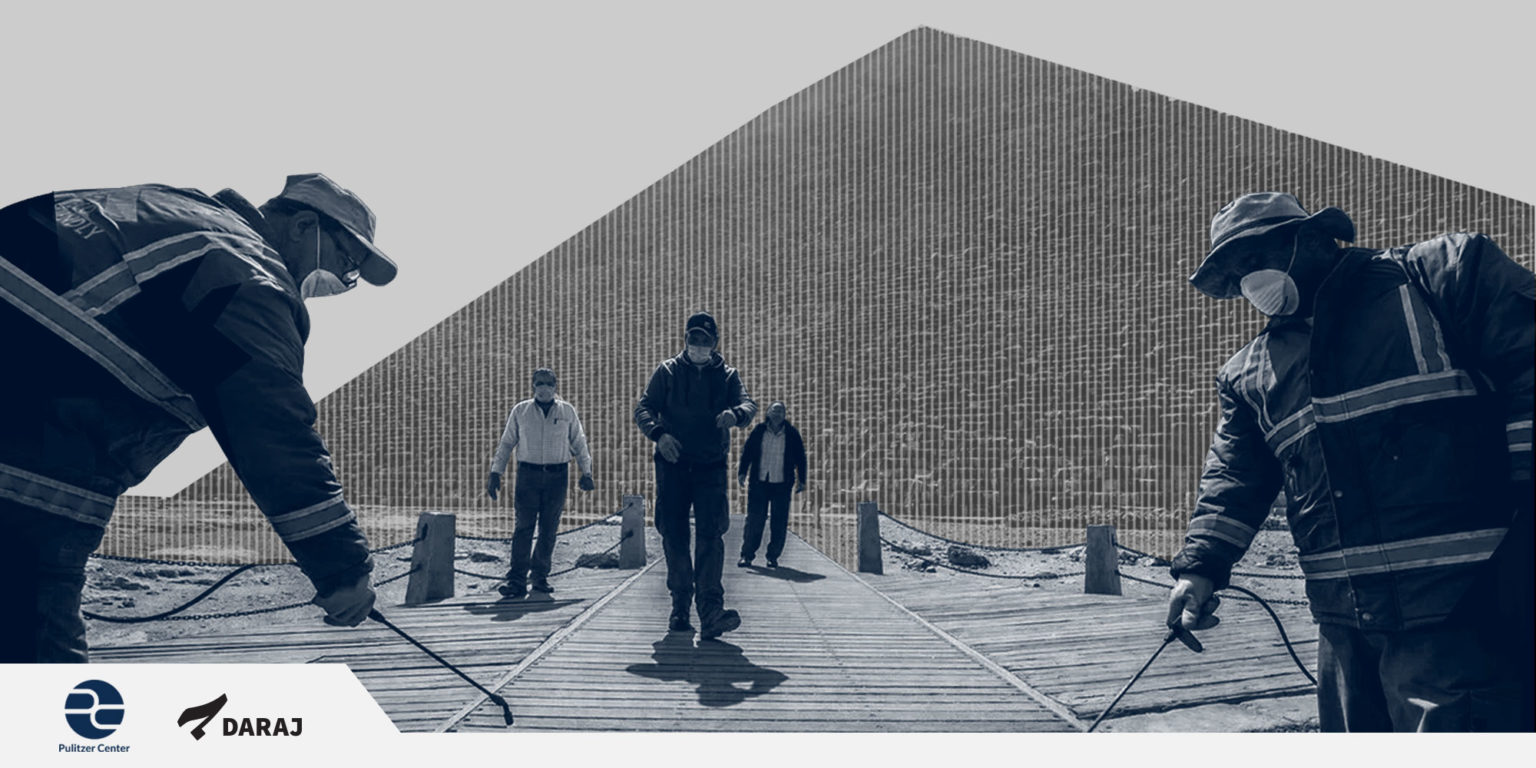هذا الموضوع تمّ إعداده بالتعاون مع Pulitzer Center.
تفيد إحصاءات دولية بأنه حتى مطلع تموز/ يوليو 2020، ناهز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض “كوفيد-19” حوالى 3500 مصري، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات في مصر إلى أكثر من 75 ألف شخص. من الواضح أن المنحنى الوبائي لانتشار الفايروس لم يصل إلى مرحلة التسطيح بعد. فضلاً عن أن العدد الإجمالي للحالات المُعلنة يتضاعف كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع منذ أواخر نيسان/ أبريل الماضي، عندما أعلنت وزارة الصحة أن أقل من 6 آلاف شخص أصيبوا بهذا الفايروس القاتل. ونظراً إلى قلة عدد الاختبارات التي أُجريت للكشف عن الإصابات، إذ تأتي مصر في المرتبة 176 بين دول العالم من حيث عدد الاختبارات ولا تتأخر عنها في المنطقة سوى السودان واليمن (بمعدل 1.3 اختبار لكل 100 ألف شخص وفقا لأحد أهم مواقع القياس الدولية)، فمن المستحيل أن نتحقق من مدى تضرر مصر جراء جائحة “كوفيد-19” بصورة أكثر واقعية. وقد صرح أحد الوزراء في الحكومة أن الأرقام الحقيقية ربما تكون خمسة أضعاف الأرقام الرسمية المُعلنة، ما سيضع مصر في المرتبة 28 من بين أشد البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات بدلاً من المرتبة 103 الحالية. وفي أواخر حزيران/ يونيو، وجد استطلاع للرأي كان من الضروري أن توافق الحكومة على إجرائه بموجب القانون، أن عدد من أصيبوا بفايروس “كورونا”، من المصريين في عمر 18 سنة فأكثر يزيد عن 600 ألف شخص (أي نحو 1 في المئة من سكان مصر).
تنعكس الأعداد المتضاربة القائمة على النماذج الافتراضية أو الأعداد المتدنية بصورة سافرة التي تعلنها الحكومة والقائمة على معدلات اختبارات منخفضة نسبياً للغاية، على أي مناقشة عامة صريحة، وهو نشاط يصعب بدء ممارسته في مصر في ظل الغياب المتزايد للإعلام المستقل والقيود المفروضة على حرية التعبير منذ عام 2014. ولذا ليس مُستغرباً أن يلجأ المصريون إلى التجربة المباشرة والقصص المتداولة والشائعات لمعرفة ما يحصل وكيفية التعامل مع هذا الواقع.

وأدت الطريقة التي أصيبت بها مصر بفايروس “كورونا”، والطريقة التي تعاملت بها معه، وكيفية تفاعل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع هذه الجائحة، إلى تفاقم ضائقة أعمق بكثير تواجهها مصر، وهي ضائقة يعاني منها هذا البلد منذ فترة طويلة، وربما تكون أكثر ضرراً في الأمد البعيد من هذا الفايروس الخطير. إذ يسمم مزيج مرعب من الاستبداد الفظ والبيروقراطية الهشّة والفقر المدقع وممارسات السوق الجشعة، المناخ العام ويجعل مصر سريعة التأثر بالصدمات، ومن دون وسيلة متفق عليها لقياس هذا الأثر طالما كان مضراً بالأفقر والأضعف.
وهكذا بحلول منتصف عام 2020، تركت الجائحة أغلب المصريين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين على الأرجح، يعولون بشكل أكبر على تصاريف القدر والعناية الألهية، لا السياسات الحكومية واستجابات السوق. صحيح أن التضامن الاجتماعي والمبادرات التي اتخذتها المنظمات الصغيرة، والشبكات الاجتماعية الواسعة، والمجتمعات المحلية في الأحياء والقرى ساعدت كثيراً، إلا أن الوصم الاجتماعي والأنانية والخوف والجهل كلها شوهت هذه الحملات الإيثارية، فقد تعرض مصابون إلى النبذ حتى بعد موتهم وتحولهم إلى جثث تبحث عن مكان تُدفن فيه، بسبب مخاوف من الإصابة بالفايروس نابعة غالباً عن الجهل وتضارب المعلومات الصادرة عن الحكومة أو عدم نشرها بصورة صحيحة وكافية.

السياسات الحكومية: مثال صريح على الاضطراب
تخلت الحكومة المصرية تماماً في أواخر يونيو/حزيران، عن المحاولات المترددة لفرض حظر تجول جزئي ووضع قواعد للتباعد الاجتماعي وتقييد التنقل. بيد أن ذلك لا يعني أن كل ما أقرته الحكومة من إجراءات حول هذا الشأن بصورة متقطعة وغير منتظمة منذ أواخر آذار/ آذار، تم فرضه أو مراعاته بصورة جدية باستثناء تعليق الرحلات الجوية.
على رغم إحجام الحكومة في بادئ الأمر عن فرض إجراءات صارمة ربما من منطلق الرغبة في عدم إفساد نهاية الموسم السياحي، غيرت القاهرة موقفها في الأسبوع الثاني من آذار، وبدأت تتخذ تدابير جادة تتعلق بالصحة العامة. وفي الأسبوع التالي، فرضت قيوداً صارمة على التجمعات العامة، وأغلقت المدارس والمساجد والكنائس والمقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية، ضمن إجراءات أخرى. في حين رأت مصادر أن وفاة ضباط في الجيش بسبب الإصابة بالفايروس، والعبء المتزايد جراء ارتفاع حالات الإصابات، فضلاً عن التحذيرات القاسية التي وجهتها منظمة الصحة العالمية، كانت وراء هذا التحول.
أدت الطريقة التي أصيبت بها مصر بفايروس “كورونا”، والطريقة التي تعاملت بها معه، إلى تفاقم ضائقة أعمق .بكثير تواجهها مصر
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار أميركي) لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن جائحة “كوفيد-19″، وتقديم مساعدات إضافية للصحة العامة. وفي أواخر آذار فرضت الحكومة حظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.
وتوالت الإجراءات والمؤتمرات الصحافية، حتى أن منتقدي الحكومة أعربوا عن إعجابهم بهذا الأداء غير المعتاد، فعلى رغم التأخير النسبي، كانت الإجراءات شاملة والخطط بدت وافية. ثم في الأسابيع التالية بات من الواضح أن الأوامر كانت تصدر من دون إجراء المشاورات اللازمة، وأن المسؤولين التكنوقراط كانوا يضعون الخطط المتعلقة بالصحة العامة من دون التأكد من توفر الموارد اللازمة، فضلاً عن رفض القطاع الخاص تحمل قدر من التكاليف الباهظة -أو عدم قدرته على ذلك- الناجمة عن الوباء سواء في تدابير الصحة العامة أو تباطؤ الإنتاجية.
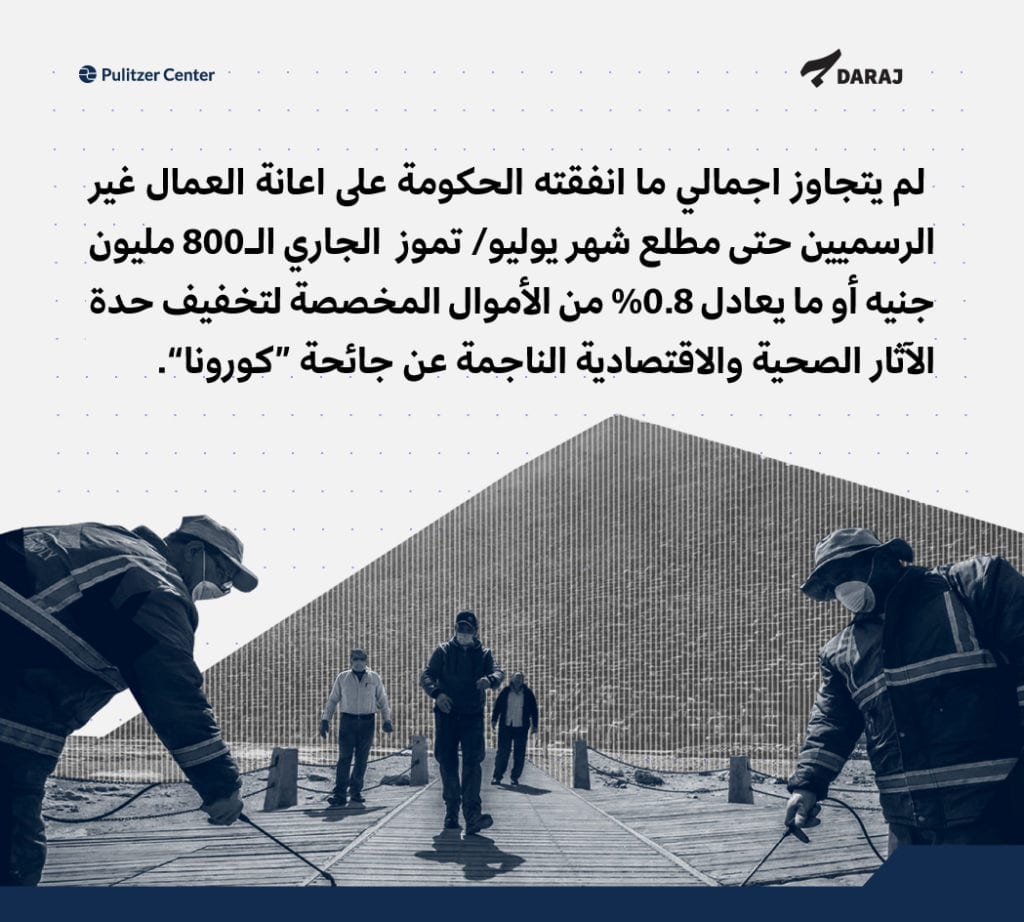
لكن ما الذي يحدث حقاً؟
بدأ الذين لا يثقون عادةً في الحكومة أو في وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة، يجمعون معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي أو من أقرانهم، بينما سعى أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التباعد الجسماني أو الذين لم يأخذوا المسألة برمتها بجدية، إلى مواصلة حياتهم، لا سيما الذين يحتاجون إلى العمل ويعتمدون على الأجور اليومية.
تفاقم الأمر عندما بدأت الحكومة في أواخر نيسان، في التقاعس عن تنفيذ الإجراءات وتضاربت رسائلها، إذ تحولت من مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم وارتداء الأقنعة الواقية، إلى إصدار الأوامر لشركات البناء باستئناف العمل؛ ومن الإعلان عن فرض حظر تجول صارم إلى التراخي في التنفيذ ثم تقليل ساعات الحظر والسماح بالمزيد من التجمعات الاجتماعية خلال شهر رمضان. وفوق ذلك كله، استمرت عربات مترو القاهرة المكتظة بالركاب في نقل ما يزيد على 3.5 مليون شخص يومياً.
حتى حزمة الحوافز التي بلغت قيمتها 100 مليار جنيه، استهدفت إلى حد كبير قطاعات الأعمال الكبرى مثل قطاع السياحة، والقطاع المصرفي، وقطاع البناء والتشييد، وشملت إجراءات لإعادة جدولة القروض، أو تخفيضات على أسعار استهلاك الطاقة للمصانع، أو حتى تقديم الإعانات المباشرة كما في حالة المُصدرين. وفي بلد يعمل فيه ما يصل إلى 40 في المئة من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، الذي يُشغّل العاملين بلا عقود عمل أو ضمان اجتماعي، قررت الحكومة أن تمنح العمال غير الرسميين، الذين يتعين عليهم تسجيل بياناتهم عبر الإنترنت، 500 جنيه مصري أو ما يعادل 34 دولاراً فقط ولمرة واحدة. وبعد شهرين، سجل حوالى 4.4 مليون شخص للحصول على هذه المنحة، لكن الحكومة اعتبرت أن 1.6 مليون شخص منهم فقط مؤهلين للاستفادة من هذا “السخاء”. ولم يتجاوز إجمالي ما انفقته الحكومة في ما يتعلق بهذا الأمر بالتحديد حتى مطلع يوليو، 800 مليون جنيه أو ما يعادل 0.8 في المئة من الأموال المخصصة لتخفيف حدة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن “كورونا”.
وتوصلت دراسة أجرتها مؤسسة “مركز قضايا المرأة المصرية” إلى أن 8 في المئة فقط من النساء اللاتي تقدمن بطلب للحصول على هذه المنحة الصغيرة، حصلن عليها بالفعل، على رغم أن ما يقرب من 58 في المئة من اللاتي شملهن الاستطلاع في أحياء عشوائية فقيرة في القاهرة، فقدن وظائفهن، مع خفض رواتب أغلب من بقين في وظائفهن.
وقالت سيدة من أحد الأحياء العشوائية في القاهرة في مقابلة مع المؤسسة في حزيران، إن تصريحات الحكومة جعلت المواطنين في حيرة من أمرهم، “مش عارفين عايزين الناس تقعد في البيوت ولّا تخرج، لازم يرسوا على برّ، وكل قرار من دول يقولوا لنا ح يتنفذ إزاي، وإيه الاجراءات اللي ح ياخدوها عشان الناس الغلابة ما تنضرّش”. عانى الفقراء من أوقات عصيبة للغاية منذ آذار واضطروا إلى الاستعانة بآليات يائسة لمواجهة الأوضاع. وقالت امرأة اخرى للمؤسسة إنها باتت تذهب إلى عملها وتعود منه مشياً على الأقدام لتوفير مصاريف المواصلات التي تصل إلى 50 سنتاً أميركياً يومياً.
وحتى عندما تعلن الحكومة عن قرارٍ، فإن ذلك لا يعني أنها ستشرع في تنفيذه. ففي نيسان، تعهدت الحكومة بصرف مكافآت إضافية للأطباء الذين يوافقون على العمل في مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لمرضى “كوفيد-19″، علماً أن أولئك الأطباء يشكون بالفعل من تدني أجورهم المعتادة. وبعد بضعة أسابيع، تراجعت الحكومة عن وعدها بدفع 1250 دولاراً لكل طبيب يقيم أسبوعين في تلك المستشفيات. وبعد شد وجذب دفعت لهم مبالغ أقل من ذلك بكثير. وفي النهاية، وصل الأمر إلى حد انتقاد الحكومة الأطقم الطبية، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن غيابهم عن العمل وعدم انتظامهم يتسبب في زيادة الإصابات والوفيات. أثار ذلك غضب نقابة الأطباء مع وفاة حوالى 200 شخص من العاملين في القطاع الطبي وإصابة أكثر من 3 آلاف. لطالما شكا الأطباء والممرضون من نقص معدات الوقاية الشخصية ووحدات العناية المركزة وساعات العمل الطويلة والرواتب المتدنية التي تأثرت كثيراً بسبب التضخم. احتجزت السلطات أيضاً 8 أشخاص على الأقل من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بسبب انتقادهم الحكومة علانيةً على منصات التواصل الاجتماعي، واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ظل مثل هذا الخطر الداهم على من يتحدثون علناً عن الجائحة بخاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد السياسات والإنفاق الحكومي، لا بد أن كثيرين لزموا الصمت وبات الناس جاهلين بما يدور حولهم في دولة تسيطر فيها الحكومة أو مؤيديها على معظم وسائل الإعلام، وبات المسؤولون يعملون من دون أي تعليقات جادة أو رد فعل من المواطنين على سياساتهم وأدائهم. وهكذا تمر الأخطاء، حتى المريع منها، من دون أيّ اعتراض أو يتم التستر عليها.
هذا الأمر ليس غريباً على حكومة تجاهلت التزاماً دستورياً بتخصيص 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية الصحة. فمنذ إقرار الدستور الجديد عام 2014 بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، لم تتجاوز مخصصات الصحة نسبة 1.81 في المئة سنوياً، ومن المقرر أن تبلغ نسبتها 1.37 في المئة في السنة المالية 2020/2021. في الوقت نفسه، واصلت الحكومة رفع الدعم عن الطاقة، ما أدى إلى فرض مزيد من الضغوط على الشرائح الفقيرة. وفي تموز، زادت الحكومة أسعار الكهرباء أكثر من 30 في المئة وقررت خصم 1 في المئة من رواتب الموظفين الحكوميين الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين موظف وخصم 0.5 في المئة من أصحاب المعاشات الحكومية. جاءت هذه القرارات فيما اتفقت الحكومة على طلب قروض جديدة بلغت قيمتها 13 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك سوق الدين الدولية، ليتجاوز إجمالي الدين الخارجي 120 مليار دولار. بينما تتفاوض الحكومة ذاتها لشراء فرقاطتين من طراز “فريم” (FREMM) من إيطاليا تبلغ قيمتهما 1.35 مليار دولار.

الإجراءات التي فرضتها الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض النفقات بدت ملتوية للغاية وكشفت عن تحيزات صريحة تخدم مصالح محددة بدقة تتعلق بأولويات للأمن القومي لا تخضع لنقاش علني وفي الوقت نفسه ضمان وضع طيب في أعين منظمات التمويل الدولية وسوق الدين العالمي.
وفي هذه الأثناء، لجأ كثر من المصريين إلى تدابير يائسة. وأقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر، في أواخر حزيران بمدى تأثير “كورونا” في الكثير من المصريين، إذ انخفض دخل 73 في المئة منهم في حين فقد 26 في المئة وظائفهم، وتقوم حوالى نصف الأسر التي شملتها الدراسة بالاقتراض من غيرها، بينما تعتمد 17 في المئة منها على مساعدات أهل الخير، في حين لم تحصل سوى 4.5 في المئة من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.
ولسد هذا العجز الكبير في الخدمات الصحية المتاحة أو ميسورة التكلفة، سارعت المؤسسات الخيرية المصرية، وهي مؤسسات وجمعيات أهلية، إلى مساعدة آلاف الفقراء من مرضى “كوفيد-19” الذين يحتاجون إلى تلقي الرعاية في المستشفيات. فقد وفرت مؤسسات مثل “مرسال” ومستشفى “25 يناير” خدمات التشخيص والعلاج والدواء والإقامة في المستشفيات لكثيرين لم يتمكنوا من الحصول على الخدمات الحكومية أو لا يستطيعون تحمل نفقات القطاع الخاص.
القضاء والقدر ونظريات المؤامرة
في ظل السياسات الفوضوية التي تنتهجها الدولة، في ما يتعلق بالرقابة أو الإعلام، ومرافق الرعاية الصحية غير الكافية في أحسن الأحوال، لم يبق لكثيرين سوى آلية واحدة لمواجهة الأزمات، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر والتعامل بلا مبالاة وإرجاع هذا التدهور إلى مؤامرة أجنبية غامضة تحاك ضد الوطن.
مثل أميركيين كثيرين أدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع علنية في بالم بيتش في ولاية فلوريدا وقالوا إن أزمة “كوفيد-19” برمتها، ما هي إلا مؤامرة حاكتها قوى لا تقل شراً عن الشيطان نفسه من أجل السيطرة على الشعب، تصور مصريون أن الجائحة كانت مؤامرة عالمية تنطوي على أسلحة كيماوية مُطورة معملياً أو حرب سرية بين الولايات المتحدة والصين أو مؤامرات دبرتها كبرى شركات الأدوية، إلى آخره. مثل السيدة المصرية الأميركية التي حصدت ملايين المشاهدات على مقطع فيديو نشرته على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وصرخت في وجه متابعيها، “Shame on you”، “عيب عليكم يا مصريين” بينما القت بجواز سفرها الأميركي جانبا مشيرة إلى أن لديها معلومات وأن وسائل الإعلام الأميركية تلقت أوامر بتخويف الناس لأن “ترامب عايز يلعب لعبة مش لطيفة مع الصين، وطمعه وجشعه استفز الصين… والصين متفوقة علينا جميعاً لأنها تعمل في صمت… وهم أصلاً عندهم الدواء”. وقالت إن الصين تمتلك لقاحاً لـ”كوفيد-19″، لكن هذا لم يُنشر في الإعلام لأن الأوامر هي أن يظل الجميع مرعوبين بينما يجني التجار الجشعون أرباحاً، وأن أميركا تستغل الفرصة وتريد أن تتربح من المصريين. واختتمت قائلة: “نضفوا التراب من على القرآن الكريم واقرأوه… عودوا إلى القرآن يا مصريين وصلوا”. وربما لا يثير الدهشة أن هذه السيدة المضطربة الأقوال كانت تمتلك مطعماً في ولاية فلوريدا نفسها حيث أجريت جلسة الاستماع، لكنها أفلست وأغلقته قبل سنوات.
لا يمكن أن يُفسِر انخفاض الإيرادات والانكماش الاقتصادي هذه التناقضات والفوضى الحاصلة حالياً، لكن ما يمكن أن يفسرها هو عملية صنع القرار الغامضة التي تتولاها مجموعة صغيرة من السياسيين وصناع القرار الذين يحاولون إرضاء قوى متصادمة في الدولة والسوق من دون الخضوع لأيّ مساءلة مجدية أمام الشعب. إذ لا تُطرح هذه القرارات والممارسات للنقاش الجاد في البرلمان الحالي الضعيف، ولا في وسائل الإعلام المترنحة الخاضعة لرقابة صارمين وتوجيههم، ولا حتى في منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن يتسبب منشور انتقادي معارض مكتوب عليها في حبس صاحبه.
في نهاية المطاف، لم تشهد البلاد تطبيقاً حقيقياً للتدابير التي يقرّها نظام سلطوي وتنفذها أجهزة تكنوقراطية حكومية من دون مشاورات حقيقية ورقابة شعبية وإعلامية.
في مثل هذا المناخ العام، يبدو أن ممارسة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مع الإيمان بالقضاء والقدر هي الطريقة العقلانية المثلى التي يتبعها مصريون كثيرون. عندما سأل موقع “مدى مصر” محمد عمران، وهو بائع متجول يبيع حقائب وأحذية في سوق مزدحم وسط القاهرة، عما إذا كان يلتزم التوصيات الصحية الرسمية الخاصة بالتباعد الجسماني، لخص محمد الأمر بلهجة تحمل قدراً من الحدة قائلاً، “الحكومة قالت عيشوا مع الكورونا واللي ليه نصيب في حاجة هيشوفها”.