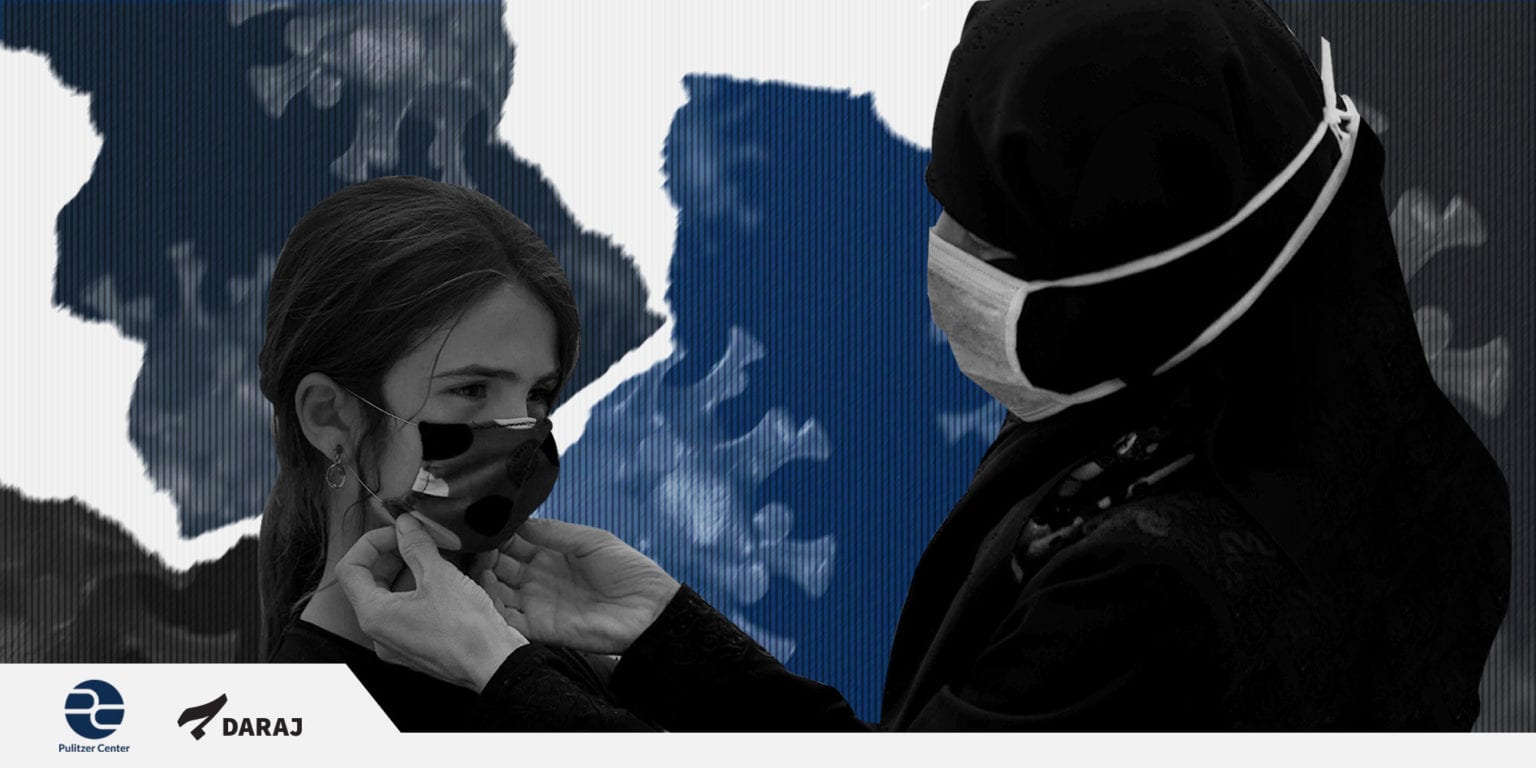- هذا الموضوع تم اعداده بالتعاون مع Pulitzer Center
لا شيء يُوقِف انتشار “فايروس” كورونا. فلا الطقس الحارّ -كما ظنّ البعضُ سابقاً- ولا شعور تحدّي الفايروس لدى القادة الشعبويّين استطاعا منع ظهور موجة جديدة من الوباء. فقد بلغ عدد حالات الإصابة بفايروس “كورونا” المُسجلة حتّى نهاية تمّوز/ يوليو 2020 نحو 18 مليوناً، منها 700 ألف حالة وفاة تقريباً.
ومع أنّ الفايروس لا يُفرِّق بين غنيّ وفقير، ولا بين وزير وخفير، ولا بين مواطِن ومهاجِر، فإنّ تداعيات الوباء كانت ظاهرة وأثرها واضح على الفئات الأضعف والجماعات التي تعاني التمييز في المجتمع؛ فقد شعرت النساء وكبار السنّ والمهاجِرين واللاجئين بتلك التداعيات السلبيّة أكثر من غيرهم. وهذا هو الحال تحديداً في دول ذات أنظمة رعاية صحيّة متداعية واقتصادات هشّة أو في تلك الدول التي تأثّرت بالحروب والصراعات. فقد تأثر اللاجئون والنازحون داخليّاً، خصوصاً، بشكلٍ متفاوِت بتداعيات وباء “كوفيد-19” والإجراءات التي اتّخذتها الحكومات للحدِّ من انتشاره.
بما أنّ وباء “كوفيد-19” يشبه في تداعياته الحروبَ والصراعات، فقد أصبحت أزمة اللاجئين -نتيجةً لذلك- مشكلةً عالميّة تستدعي استجابات عالميّة.
في هذا المقال أحاجِج أنّ هناك أربع جبهات ستزيد من تفاقُم الموقف بالنسبة إلى اللاجئين والنازحين، نتيجة انتشار الوباء وتداعياته. وقد سبقَت تلك القضايا الأربع ظهور فايروس “كورونا”، وكانت موجودة هيكليّاً منذ سنوات، لكنّها تفاقمَت نتيجة ظهوره وانتشاره، ونتيجة الطريقة التي تمّ بها التعامُل مع الفايروس. هذه الأمور الأربعة هي:
1) العجز عن الوصول إلى خدمات رعاية صحيّة لائقة.
2) التداعيات الاقتصاديّة.
3) الوصم الاجتماعيّ والتمييز.
4) صعود التوجّهات القوميّة والحمائيّة الاقتصاديّة.
ستتأثّر بشكلٍ كبير المنطقة العربيّة التي تستضيف ملايين النازِحين قسراً، كما هو الحال في العراق وفلسطين وسوريا واليمن، إضافةً إلى الدول التي تستضيف لاجئين مثل لبنان والأردن. تقدِّر الأمم المتّحدة أنّ حوالى 55.7 مليون في المنطقة العربيّة هم بحاجة إلى مساعدات إنسانيّة، ومنهم 26 مليوناً من النازِحين. وهو الأمر الذي يمثّل معضلةً واسعة النطاق.

نظم رعاية صحّيّة منقوصة
قبل انتشار وباء “كوفيد-19″، كان اللاجئون والنازِحون يُعانون من محدوديّة الحصول على رعاية صحّيّة لائقة. في الدول المتأثّرة بالصراعات، تتراجع أنظمة الرعاية الصحّيّة، وتُعاني نقصاً هائلاً في الموارد البشريّة والإمدادات. ففي سوريا، غادَرَت غالبيّة العاملين في مجال الرعاية الصحّيّة البلادَ، ودمّرت البنية التحتيّة للقطاع الصحّيّ أو لحقتها الأضرار. وفي اليمن – حيث انهار نظام الرعاية الصحّيّة نتيجة الحروب والعقوبات التي سبقت ظهور الوباء – تعمل المستشفيات تحت ضغط شديد لمواجهة انتشار الفايروس. بالمثل، في الدول التي تستضيف لاجئين، غالباً ما يجد أولئك اللاجئون صعوباتٍ في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحّيّة، ويعتمدون على مُقدِّمي الرعاية أي جهات العمل الإنسانيّ وغير الحكوميّ. إضافةً إلى هذا، غالباً ما يجد اللاجئون أنفسَهم في ضيقات ماليّة لتغطية فواتير الخدمات الصحّيّة، ويضطرّون إلى بيع بعض ممتلكاتِهم لتغطيتها أو لاقتراض المال في معظم الأوقات حين تسوء ظروفهم الصحّيّة. بالنسبة إلى معظم اللاجئين والنازِحين يمثّل “كورونا” ضغطاً إضافيّاً ينضمّ إلى تلك الصعوبات المستمرّة التي يواجهونها.
ركود اقتصاديّ أسوأ من أزمة 2008
ربّما كانت تداعيات الوباء الاقتصادية، أكثر نتائج الوباء إيلاماً. يتوقّع صندوق النقد الدوليّ آفاقاً سلبيّة للاقتصاد العالميّ، المتوقّع أن ينكمش بنحو 5 في المئة عام 2020. في حين ستتأثّر اقتصادات المنطقة العربيّة تقريباً، باستثناء مصر، بذلك الركود عام 2020. وترى منظّمة الأمم المتّحدة أنّ من المتوقّع أن ينخفضَ النموّ المحلّيّ الإجماليّ للمنطقة بمقدار 152 مليار دولار، نتيجةَ الانكماش المتوقّع بنسبة 5.7 في المئة في النموّ الاقتصاديّ بين عامَي 2019 و2020، ومن المتوقّع أن يكون الاقتصاد اللبنانيّ الأسوأ أداءً، إذ ينكمش بنسبة 12 في المئة. يعني هذا التراجع بوضوح، إلى جانب تأثيرات أخرى، ارتفاع معدّلات البطالة وازدياد نسبة الفقر. تقدّر لجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (إسكوا) أنّ التباطؤ الاقتصاديّ المقبل سيتسبّب في إضافة حوالى 8.3 مليون نسمة إلى عِداد الفقراء.

من المتوقّع أيضاً أن تشهد الدول المتأثّرة بالصراعات والدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، تباطؤاً في النموّ الاقتصاديّ أكثر من غيرها. فضلاً عن أن اللاجئين الذين يعملون غالباً في قطاع الاقتصاد غير الرسميّ، من دون أيّ شكل من أشكال الحماية الاجتماعيّة أو التأمين الاجتماعيّ، يعتمدون على مكاسبهم اليوميّة ويضطرّون إلى العمل خارج منازلهم طلباً للرزق ولتصريف شؤون حياتهم اليوميّة. ففي لبنان، على سبيل المثال، يعمل 55 في المئة من القوى العاملة في القطاع غير الرسميّ (91 في المئة من العمال غير اللبنانيّين و27.8 في المئة من العمال اللبنانيّين). وبالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ إجراءات الإغلاق -الرامية إلى احتواء تفشّي الوباء- تُعدّ ترفاً تتمتّع به الطبقة العليا (الغنيّة) والطبقة المتوسّطة، ولكنّهم لا قِبَلَ لهم به. إذ إنّ الإغلاق يعني فقْدَ مصدر قُوتِهم اليوميّ. وفي دراسة أجريت في إحدى المناطق الحضريّة في بيروت يعيش فيها اللاجئون جنباً إلى جنب مع مُضيفيهم اللبنانيّين المعدومين، فَقَدَ 80 في المئة من المشاركين في الدراسة من جميع الجنسيات و85 في المئة من المشاركين السوريّين والفلسطينيّين أنشطَتَهم التي توفّر لهم دخلاً أثناء إجراءات الإغلاق المفروضة. ولذا، فلا شكّ في أنّ مخاوف وقوع اللاجئين في براثن الفقر المُدقِع -بل الجوع حتّى- صارت أمراً واقعاً يحدث الآن.

الوصم الاجتماعيّ والقيود على اللاجئين
تحظى حالات الطوارئ بمكانة خاصّة لدى الدول الاستبداديّة. فقد قدَّم الوباء لبعض الحكومات ذريعةً لتشديد الإجراءات الأمنيّة ولفضِّ أيّ شكل من أشكال التجمهر ولقمع حرّيّة التعبير. في الواقع كانت هذه القيود أكثر تمييزاً ضدّ اللاجئين. فقَد وجَد كثر منهم أنفسَهم مُستهدَفين بتدابير الإغلاق بسبب تفشّي كراهية الأجانب، وارتفاع خطاب الكراهية، وتداوُل المعلومات الخاطئة، والانطباع بأنّ اللاجئين قد ينشرون الفايروس. فبحسب منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، فرضت بلديّات لبنانيّة قيوداً تمييزيّة خاصّة على اللاجئين السوريّين لم تُطبَّق على المواطنين اللبنانيّين في بلداتهم وقراهم.
الدول المنغلقة على الداخل
لعلّ مَشاهد إغلاق الحدود، والجيوش الوطنيّة التي جابت الشوارع، وسنّ تدابير الصحّة العامّة على الصعيد المحلّيّ في ظلّ تعاوُن محدود متعدِّد الأطراف، كلَّها علاماتٌ تُشير إلى تصاعُد نزعة الدولة القوميّة أثناء وباء “كوفيد-19”. ومع أنّه من المفهوم أن تحتلّ الدول القوميّة والمؤسّسات الوطنيّة مركزَ الصدارة في جهود مكافحة الوباء، فقد شهدنا بزوغَ عصرٍ جديد من النزعة الحمائيّة المُتصاعِدة خلال الوباء، بل من المتوقّع أن تدوم لبعض الوقت. إنّ الخوف من النزعة القوميّة المتصاعدة والقلق بشأن الخطاب القويّ القائل بأنّه يتعيَّن على الدول أن تتقوقع على نفسها، قد لا يقتصر على العودة إلى نموذج “وستفاليا” فحسب، بل على الأرجح سيتجاوز ذلك إلى الحدّ من التعاوُن المتعدِّد الأطراف، والتضامُن الدوليّ، والمساعدات الإنسانيّة والإنمائيّة. فالحكومات في الشمال العالميّ، التي تُمثّل من الناحية التاريخيّة الدولَ المانحة للمساعدات، تتّجه -بشكلٍ متزايد- نحو الانكفاء على نفسها، وتميل إلى التفكير في أساليب لإعادة إنعاش اقتصاداتها وخدمات الرعاية الاجتماعيّة، بدلاً من المساهمة في مخطّطات إغاثة اللاجئين. وبما أنّ اللاجئين الذين يعيشون في الدول النامية الضعيفة إلى حدٍّ كبير يعتمدون على المساعدات الإنسانيّة، فسوف يتأثّرون بشدّة إذا تضاءَلَت تلك المساعدات.
قد يبدو مستقبل اللاجئين والنازحين داخليّاً ومجتمعاتهم المُضيفة الفقيرة قاتماً ومُخيفاً، عند الأخذ في الاعتبار هذه العناصر الأربعة مجتمِعةً. إذ يختلف هذا المشهد- بشكلٍ صارخ- اختلافاً جذريّاً عن تلك الصور التي شاركها أبناءُ الطبقة العليا على وسائل التواصل الاجتماعيّ خلال فترة الإغلاق وهم يعزفون الموسيقى على الشرفات ويرقصون على أسطح المنازل. فالمسألةُ بالنسبة إلى اللاجئين والنازحين داخليّاً، مسألةُ حياةٍ أو موت، ومناورة بين خطر المجاعة وخطر الإصابة بالفايروس.
ثمّة ضرورة مُلحَّة للدعوة إلى التضامُن الحقيقيّ، ولكنّ الأهمّ من ذلك أنّه لا مفرَّ من تحطيم المبدأ الراسخ الذي يوجِّه دفة العالم في الوقت الراهن، وهو مواجهة الأزمات العالميّة من خلال الاستجابات المحلّيّة. وبما أنّ وباء “كوفيد-19” يشبه في تداعياته الحروبَ والصراعات، فقد أصبحت أزمة اللاجئين -نتيجةً لذلك- مشكلةً عالميّة تستدعي استجابات عالميّة.