تتشكل الذاكرة الجمعية حول حدث ما، من خلال مجموعة الشهادات الفردية التي تروي هذا الحدث. فمع التظاهرات الشعبية وما تلاها في سوريا منذ عام 2011، برزت ظاهرة الشهادات بكثرة، شهادات التظاهر، شهادات الاعتقال، شهادات الهجرة والنزوح. لم يكن المجتمع مدركاً هذه العلاقة الوثيقة مع الشهادات، لكن حاجته إلى توثيق ما يحدث انفجرت فجأة، فتكاثرت الأعمال الفنية الروائية والأدبية والسينمائية في محاولات توثيق الحدث. ساهمت الشهادات الفردية والفنية في سرد الحدث التاريخي.
انفجار مرفأ بيروت شهد ظاهرة مماثلة، فقد سبق الانفجار حريق استمر أمام الأعين نحو 15 دقيقة قبل انطلاق شرارة التفجير، هذه الـ15 دقيقة كانت كافية لتُرفع كاميرات عشرات الموبايلات من المدينة لتصوير الحريق. رغبة هؤلاء المصورين والمصورات بالإخبار عن حدث الحريق شكلت الشهادات التي ستوثق للحدث- الانفجار.
تروي مروة الحدث بالانفعال ذاته الذي عايشته، لكن هذه التجربة هي تجربة حواس وذهن ونفس وجسد، فكيف يمكن أن تروى بكمالها؟
تلك الفيديوات التي صورها مواطنون شكلت الشهادات الفردية التي تُمكننا من روي حدث جمعي تاريخي هو انفجار مرفأ بيروت وأرشفته. تنتهي بعض هذه الفيديوات بلحظة الانفجار وتمدد الضغط فوق المدينة ليدمرها، وفي أغلبيتها يصاب فيها حاملو الكاميرا بأضرار، وفي بعض الأحيان فارقوا الحياة. يمكن اعتبار هؤلاء المواطنين المصورين بمثابة شهداء الشهادة. ومن هنا ربما التقارب بين لفظي شهادة وشهيد أو شهيدة.
كذلك في الحدث السوري، تكاثرت الأفلام والفيديوات التي يخاطر فيها المصورون بحياتهم لتوثيق ما يحصل.
أصحاب الشهادات الفردية لا يقدمونها لتوثيق الحدث الجمعي فقط، بل هم ينطلقون في الأساس من حاجة ذاتية للروي. وعلم التحليل النفسي هو أكثر العلوم إدراكاً لحاجة الإنسان إلى الروي، بينما يطلق الروائي غابريل غارسيا ماركيز على سيرته الذاتية عنوان: “نعيشها لنرويها”. إننا نعيش الحياة والأحداث لنرويها.
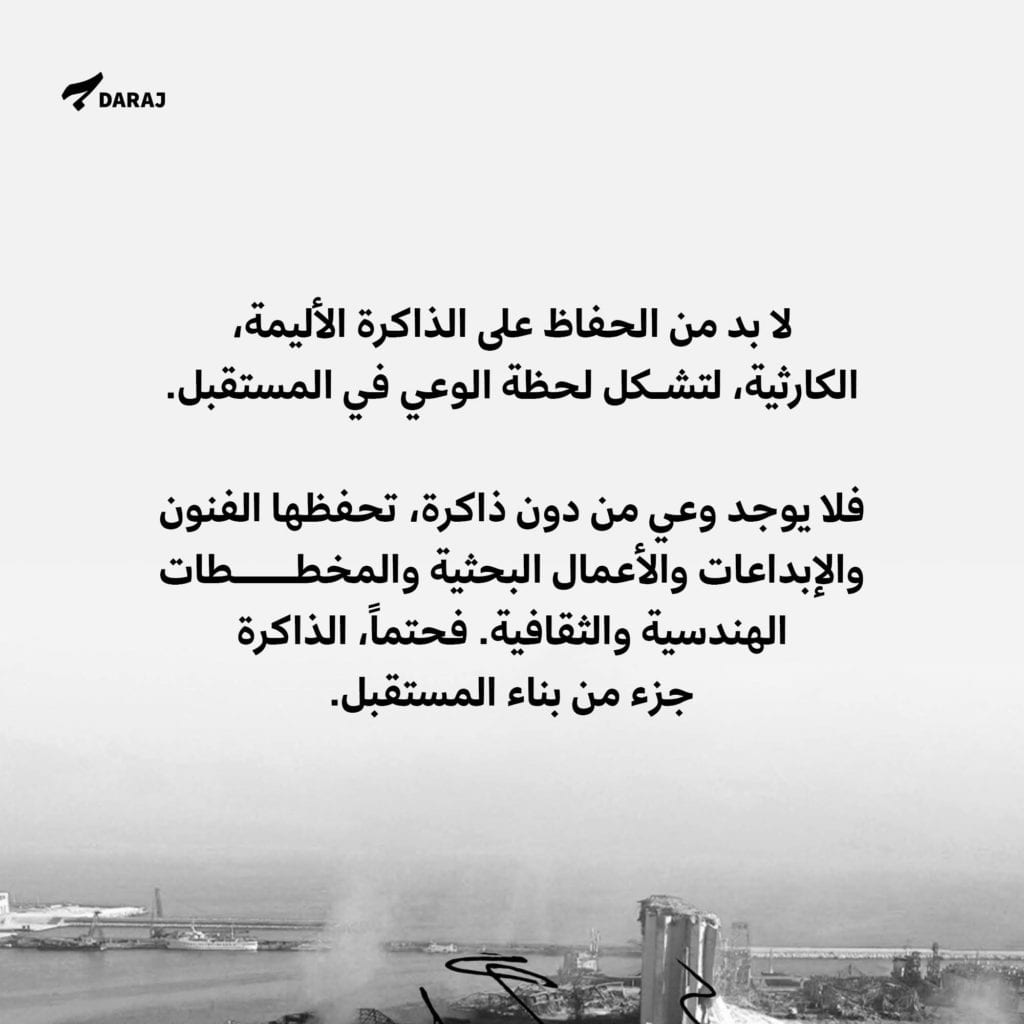
الحاجة إلى الروي
رغم مرور أسابيع على انفجار المرفأ، ما زالت مروة تروي لكل زائر لحظة دخوله منزلها، حكايتها مع لحظات الانفجار لحظة بلحظة، كيف حاولت الهروب من الانفجار وهي تفتح باب البيت، كيف ارتفعت عن الأرض لتسقط على بعد أمتار وتتأذى. تروي مروة الحدث بالانفعال ذاته الذي عايشته، لكن هذه التجربة هي تجربة حواس وذهن ونفس وجسد، فكيف يمكن أن تروى بكمالها؟
لا تستطيع أية تجربة حسية ذهنية أن تروى بكاملها، لذلك نحتاج إلى روي الحدث نفسه من زوايا مختلفة، من شهادات مختلفة، وبشكل لا نهائي.
اعتمدت جمعيات للدعم النفسي الخط الساخن للمتضررين نفسياً من انفجار المرفأ، فخصصت رقماً ثلاثياً للاتصال والحديث مع مختصين، وبالتالي الروي، وسيكون لدى هذه الجمعيات أرشيفاً حكائياً كبيراً من شهادات شخصية عن هذا الحدث التاريخي الذي نبحث عن مفاعيله وتشكله في الذاكرة الجمعية.
الاختلاف في المصطلحات في رواية حدث جمعي يخلق انشقاقات واختلافات في رؤية تاريخ البلاد بين الفئات المتعددة في المجتمع الواحد، كما هو الحال في الحدث السوري
الكارثة تخلق جماعة
في كتابه “الذاكرة الجمعية”، يبين موريس هالبواش أن الحدث الجمعي يوّحد أفراداً منفصلين ليجعلهم جماعة. الجماعة التي عاشت الحدث وتأثرت به. في سهرة بيروتية بعد 3 أسابيع من الانفجار قال أيمن: “بالسلامة جميعاً، وخصوصاً من عاشوا الانفجار”.
3 من أصل 8 من الحضور عاشوا ضغط الانفجار الهائل، وكانوا وكنّ في مناطق تضررت من تأثيره، لقد جمع بينهم رابط جديد، ليس الرابط السياسي ولا الرابط الطائفي أو المهني ولا الرابط المناطقي، بل هو رابط جديد، هو ذاكرة الحدث التي جمعتهم، وجعلتهم جماعة. فالمعروف أن المتضررين من انفجار مرفأ بيروت ينتمون إلى مناطق مختلفة، طبقات اقتصادية وثقافية متعددة، إلى رؤى سياسية عدة، وإلى طوائف وأديان متنوعة، ما يوحدهم هو الحدث- الانفجار. يعبر عن ذلك في الأمثال الشعبية بالقول: “الكارثة بتجمع، أو المأساة بتجمع”.
يكتب موريس هالبواش: “إن الذكرى يمكن أن تصمد فينا مقابل الزمن، بدءاً فقط من اللحظة التي كنا نشكل فيها مع الشهود الآخرين جماعة، وكنا نفكر تفكيراً مشتركاً وفق علاقات معينة، فإننا نبقى على صلة مع هذه الجماعة ونبقى قادرين على التماهي معها وقادرين على دمج تاريخنا بتاريخها”. إذاً، كيف بإمكان جماعات متفرقة أن تتشارك الحدث فيجمع بينها في الذاكرة.
مع ثورة 17 تشرين في لبنان، كان حارسان سوريان أول الضحايا لمبنى في وسط البلد التجاري. توفيا اختناقاً على أثر اشتعال حريق في المبنى ليلاً من جراء أحداث التظاهرات. كذلك في انفجار مرفأ بيروت، سالت دماء 46 ضحية سورية إلى جانب الدماء اللبنانية والأوروبية وغيرها، لقد وحدت الكارثة جماعات مقسمة دولياً وقانونياً.

الاختلاف على الذاكرة
لكن، في المقابل، فإن الاختلاف في المجتمع على توصيف الحدث الجمعي قد يؤدي إلى انقسامات بين فئات من الجماعة، أو بين الأفراد والجماعة. فمثلاً، تختلف التعابير التي يستعملها السوريون في توصيف الحدث السوري المستمر منذ 2011، منها: الانتفاضة، الثورة، الأزمة، الحرب الكونية، المؤامرة وغيره… يبين البحث المعنون “سورية في مضمون وسائل الإعلام العربية، ماهر سمعان، نالين ملا، لؤي حمادة” الاختلافات في المصطلحات المستعملة في وسائل الإعلام لتوصيف الحدث السوري، كل واحدة بحسب ميولها السياسية وانتماءاتها الإيديولوجية. هذا الاختلاف في المصطلحات في رواية حدث جمعي يخلق انشقاقات واختلافات في رؤية تاريخ البلاد بين الفئات المتعددة في المجتمع الواحد، كما هو الحال في الحدث السوري بين المعارضة والموالاة. ومن هنا تأتي أهمية متابعة مجريات التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الانفجار وتحديد توصيفه وطريقة رويه في التاريخ.
تكرر الأمر نفسه مع انفجار مرفأ بيروت، يصر البعض على الغارة الإسرائيلية، غيرهم على الصاروخ، آخرون يستعملون مفردة “انفجار” للتوضيح بأنه حدث بلا فاعل، حدث ناتج عن خطأ، بينما يستعمل آخرون عبارة “تفجير” للإصرار على أنه مدبر ومن تخطيط فاعل. وتتعدد الصفات المعطاة للحدث: كارثة، جريمة، مجزرة…ألخ. هكذا ينقسم الرواة في رؤية الحدث ذاته تبعاً لقناعاتهم السياسية أو ميولهم الفكرية، وبالأدق تبعاً لرؤاهم عن سؤال: كيف يجب أن يروى الحدث الجمعي؟ وبالتالي كيف يجب أن يُروى تاريخ البلاد؟ ومن هنا يكتب موريس هولبرانش: “لا يكفي أن نعيد بناء صورة الحدث الماضي قطعة قطعة لنحصل على الذكرى. تنبغي إعادة البناء تلك انطلاقاً من معطيات ومفاهيم مشتركة موجودة في ذهننا كما في أذهان الآخرين، لأنها تعبر من دون توقف بين الجهتين”.
يعاني السوريون واللبنانيون القاطنون خارج بلادهم، كمنفيين أو مغتربين أو لاجئين من انفصال بين ذاكرتهم الفردية وبين ذاكرة الجماعة الجديدة التي استقبلتهم
الانفصال عن ذاكرة الجماعة
يعاني السوريون واللبنانيون القاطنون خارج بلادهم، كمنفيين أو مغتربين أو لاجئين من انفصال بين ذاكرتهم الفردية وبين ذاكرة الجماعة الجديدة التي استقبلتهم، أي المجتمعات التي لجأوا إليها كفرنسا، ألمانيا، السويد وغيرها. هؤلاء يتابعون الأحداث التي تهمهم في بلادهم عبر وسائل التواصل والإعلام، وحالما يخرجون إلى شوارع باريس، برلين، ستوكهولم، أو نيويورك فإنهم يشعرون بانفصال عن الجماعة التي حولهم، فلا أثر للحدث الحاصل في بلادهم أو مفاعيل له في شوارع مدن الهجرة واللجوء، ومن هنا فإنهم والجماعة المستقبلة الجديدة بحالة انفصال، ذلك أنهم لا يتشاركون الذاكرة نفسها، أو على الأقل انتقائية الذاكرة نفسها.

في مقالة بعنوان “لقد دمروا مدينتنا وأجبرونا على لملمة الركام”، كتبت المقيمة الإيطالية في بيروت ليفيا كاروسو شهادتها عن تجربة تفجير بيروت. كانت في مقهى “رواق”، وقد تأذت جسدياً مع عشرين آخرين من جرحى المكان، وبسبب نقص المستشفيات اضطرت للانتظار 6 ساعات بعد التفجير لتتمكن من تلقي العلاج اللازم لجراحها. بعد التجربة، كتبت ليفيا كاروسو شهادتها، وبعد شهر غادرت بيروت إلى إيطاليا للاستراحة. لكنها ما أن خرجت من إطار الحدث، حتى بدأت تشعر بالذنب تجاهه. لقد كتبت من إيطاليا مطولاً عن شعورها بالابتعاد من تجربة الجماعة التي عاشت الكارثة- الانفجار، وعن رغبتها في متابعة أخبار آثار الحدث وما تلاه أي ما يحصل في بيروت في المناطق المتضررة. إن الرغبة في متابعة الحدث قوية، مثلاً الرغبة بمتابعة إعادة الإعمار للمدينة بيروت تمنح شعوراً بالراحة لمن عايشوا الحدث. لذلك، كان للتعاضد الاجتماعي المتجلي في مجموعات الشباب والشابات في لبنان، التي توجهت إلى مناطق الضرر للمساعدة، أثر في نفوس كثيرين، إنهم جزء من إمكان تحمل الكارثة، هذه المبادرات والمساعدات جزء من قدرة الذهن على احتمال الحدث الجلل. لقد شارك هؤلاء المتطوعون في كتابة ذاكرة الحدث-الكارثة التاريخي.
النضال الفردي للتأثير في الذاكرة الجمعية
في المستوى الأول للذاكرة الجماعية، تبقى ذكريات الأحداث والتجارب التي تخص العدد الأكبر من أفراده. أما الذكريات التي تخص عدداً محدوداً من أفرادها، وأحياناً فرداً واحداً من أفرادها، وعلى رغم من أنها جزء من ذاكرة الجماعة، إلا أنها تتراجع إلى مستوى خلفي في ذاكرة الجماعة. لذلك على الأفراد أن يسعوا إلى التعبير عن ذاكرتهم وتجاربهم، ويعملوا على سردها، وعلى توضيح وجهة نظرهم حيالها، وكذلك على محاولة الإبقاء على استمراريتها في تاريخ الجماعة.

في انفجار مرفأ بيروت، تطاير الزجاج في مرسم الفنان السوري محمد خياطة في مرسمه في منطقة الأشرفية ليمزق لوحاته المنتشرة في المرسم، فقرر الفنان إبقاء أقسام اللوحات الممزقة والتعامل معها كأعمال فنية تحتفظ بذاكرة الإنفجار. أما الفنان البريطاني آبي يوسل الذي يعيش في بيروت منذ 9 سنوات، فكان يرسم لوحة لمدينة بيروت لحظة انفجار المرفأ، تطاير الزجاج ليدخل في قماش لوحته، فقرر أن يتركه كجزء من اللوحة، قال: “دخول الزجاج في اللوحة يعبر أفضل تعبير عن رؤيتي وتجربتي في المدينة، بعد الأضرار التي لحقت باللوحة أصبحت اللوحة كاملة في التعبير عن موضوعتها”. الفنانان أدخلا تجربتيهما الفرديتين عبر الفن إلى الذاكرة الجمعية.
تعدد القراءات للحدث الجمعي
إن كانت الذاكرة الجمعية تستمد قوتها واستمراريتها مما تعتمد عليه كدعامة من الأشخاص، فهؤلاء الأشخاص هم أفراد في نهاية المطاف، يتذكرون كأفراد في جماعة. من كتلة الذكريات المشتركة تلك، التي ترتكز واحدتها على الأخرى، لا تظهر الذكريات نفسها بقوة وكثافة لكل واحد في الجماعة. لقد رأينا كيف أن كل ذاكرة فردية هي وجهة نظر تطل على الذاكرة الجمعية، وأن وجهة النظر هذه تتغير وفقاً للرؤية التي تتبناها، وأن هذه الرؤية للحدث التاريخي تتغير بناءً على المستوى الاجتماعي والثقافي والمرجعيات السياسية أو الدينية لكل فرد. فليس من المفاجئ عندئذ ألا يستقي الجميع الجزء نفسه من الحدث المشترك. لأن ذلك يتعلق بمرجعيات ذات طبيعة سياسية، اجتماعية، ثقافية مختلفة لكل من الرواة المحتملين للحدث، الذين يشكلون الذاكرة الجمعية، التي ستكون بلا شك متعددة القراءات والتأويلات.
الذاكرة الجمعية والذاكرة التاريخية
الذاكرة الجمعية تغلف الذاكرات الفردية من دون أن تختلط بها. هي تتطور وفق قوانينها الخاصة، وإن ولجت أحياناً بعض الذكريات الفردية إليها، فإن تلك الذكريات تغير من هيئتها. وهذا يعني أن على الأفراد أن يناضلوا لكي تكون ذاكرتهم الفردية جزءاً من الذاكرة الجمعية ومؤثرة فيها. في فيلم “طرس رحلة إلى الصعود إلى المرئي”، غسان حلواني، رؤية ذاتية سينمائية للمخرج عن تجربته مع اختفاء والده، لكنه لم يتوقف عند ذلك، إذ قدّم أيضاً على المستوى السينمائي الفني ما هو جديد في مجال تعامل السينما مع مفهوم الاختفاء القسري. لقد انطلق صانع الفيلم من تجربته الذاتية لكنه أضاف أيضاً إلى تاريخ السينما تقنيات فيلمية جديدة في كيفية التعامل مع موضوعة المختفين قسراً، مع كيفية التعامل مع ذاكرة الحرب البصرية أيضاً.
وكما يؤثر الأفراد في الذاكرة الجمعية، فإن الحدث الجمعي أيضاً يؤثر في حياة الأفراد، وبالطبع، تفرض الذاكرة الجمعية ثقلها على ذاكرات الأفراد، الأحداث الجمعية الكبرى للكوارث، الحروب، الثورات تفرض نفسها على الذاكرات الفردية وعلى طريقة رواية كل منا تاريخه. ومن هنا لا توجد سيرة ذاتية لإنسان لا تتداخل مع الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية الكبرى المحيطة به.

إشكالية التعامل مع ذاكرة الكارثة
السؤال الإشكالي في التعامل مع الكارثة، هل علينا جبر الضرر والاستمرار وإعادة البناء بحيث تتجاوز الذاكرة ما حدث؟ أم علينا أن نحتفظ بالذكريات التي تؤشر إلى الكارثة؟ في تسعينات القرن الماضي، انتهت الحرب الأهلية اللبنانية بناءً على اتفاق جمعي يتبنى مقولة “لا غالب ولا مغلوب”. هذا المنطق أثّر في التعامل مع ذاكرة الحرب الأهلية، أصبح الحديث عن الحرب الأهلية أقرب إلى الجريمة التي تسعى إلى تزكية النعرات الحزبية والدينية، بدلاً من أنها تسعى إلى نقاش ما حصل.
تم التعامل مع الذاكرة بطريقة إخفاء ما حدث أو التغاضي عنه لأجل بناء المستقبل. فمُنعت أفلام تتناول أحداثاً من الحرب الفنية، وحُجبت أعمال فنية تناولت ذاكرة الحرب، بينما يعلمنا علم النفس أن تجاوز الكارثة أو المأساة يتطلب الحديث عنها.
كتبت ليفيا كاروسو شهادتها، وبعد شهر غادرت بيروت إلى إيطاليا للاستراحة. لكنها ما أن خرجت من إطار الحدث، حتى بدأت تشعر بالذنب تجاهه.
اليوم مع إعادة إعمار مرفأ والمناطق المتضررة من المدينة بيروت، تم اقتراح إبقاء اهراءات القمح على حالها كجزء من ذاكرة الحدث، آخرون يرغبون برؤية بيروت الجديدة النابضة بالحياة بلا ذاكرتها الأليمة، وبمرفأ حديث وعالمي لا يحمل شيئاً من بصريات الكارثة. من هذين الرأيين المتعارضين تنشأ إشكالية التعامل مع الذاكرة المأساوية الكارثية. في السلسلة الوثائقية من إنتاج قناة “بي بي سي” (دليل إلى محبي الفنون في المدن)، تخصص حلقة للمدينة بيروت، من أبرز المعالم الفنية التي يتوجه صانعو الفيلم للتصوير فيها والحديث عنها، هو “بيت بيروت” البناء الطابقي الواقع على حدود تماس الحرب الأهلية، والذي حوّل في السنوات الأخيرة إلى فضاء ثقافي فني، وراعى تصميمه وهندسته الإبقاء على ذاكرة المكان التي كان يحملها في الحرب الأهلية. لقد كان البناء موقعاً عسكرياً مناسباً لتمركز المقاتلين المسلحين في حرب الشوارع المتقابلة. لقد جذب “بيت بيروت الثقافي” صانعي الفيلم بوصفه مشروعاً جمع بين الذاكرة وإعادة الإعمار فامتلك خصوصية فنية. لكن هذه الخصوصية هي ذائقة نسبية بين الأفراد، كما أن المكان هو فضاء فني ثقافي، فهل يمكن تعميم تجربته على كامل المدينة. ليعود السؤال مجدداً: هل نبقي في تصميم المناطق المدمرة المستقبلي آثاراً على الكارثة الجمعية في بيروت المدينة؟
مهما اختلف جواب كل منا على السؤال المطروح، فإن موريس هولبراش يصر في أي حال على ضرورة مشاركة الأفراد، أي كل منا، في روي الذاكرة الجمعية والتأثير فيها، كي يكون المستقبل قريباً من الطموحات. المستقبل لن يشبه تماماً أي رؤية فردية نمتلكها، بل هو مزيج من الرؤى المتنوعة الفعالة في رؤية المستقبل والمؤثرة به. فبالتالي، بإمكان الأفراد المشاركة في كتابة المستقبل عبر قدرتهم في التأثير على الذاكرة الجمعية والمشاركة فيها. يعتبر هولبراش أن مشاركة الفرد في الذاكرة الجمعية ينقل الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج فالرشد: “على رغم أن حياتنا وحياة أهلنا وحياة أصدقائنا منضمة ضمن إطار جماعة الأمة مثلاً، لكن الأمة لن تهتم بالمصائر الفردية لكل واحد من أعضائها”. ما يعني أن نضال الأفراد يجب أن يتركز على نشر تجرتبهم الذاتية ووجهة نظرهم وذلك عبر الكتابة، الشهادات، الفنون، الأعمال الفنية، الأغاني والموسيقى.

رؤى التاريخ المختلفة: تحطيم التماثيل
حين نخرج من كنف نظام سياسي وثقافي إلى نظام آخر، نكتشف أننا كنا نقرأ التاريخ بالطريقة التي أملاها علينا هذا النظام، التاريخ مكتوب ومفروض تبعاً لقيمه ومعتقداته. كأن يقال الجاهلية على الحضارات ما قبل الإسلامية، وكأن يقرأ الشيوعيون التاريخ بطريقة مختلفة عن الأنظمة الليبرالية، وغيرها من الاختلافات الإيديولوجية التي تؤثر في قراءة التاريخ. بالتالي، التاريخ هو ليس حالة مكتملة، بل هو صيرورة خاضعة لإعادة القراءة بإستمرار حسب وعينا السياسي والثقافي. لقد تزامنت الإحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا ضد العنصرية مع ظاهرة تحطيم التماثيل التاريخية التي تعود إلى حقبة الممارسات العبودية والحكم الاستعماري. واجتاحت الولايات المتحدة وبعض المدن الأوروبية ظاهرة تحطيم تماثيل شخصيات تاريخية في الساحات العامة. إنها قراءة جديدة للتاريخ. حصل الخلاف مثلاً، على الملك البلجيكي (ليوبولد الثاني) إن كان عنصرياً سفاحاً أو فاتحاً بطلاً. التماثيل هي الذاكرة المفروضة من التاريخ على الذاكرة الجمعية، لتقوم على إعادة قراءة الرموز التاريخية بحسب وجهة نظره ورؤيته ومنطلقاته الفكرية والسياسية. وهذا ما حدث مع ذاكرة الأفارقة الأميركيين والأوروبيين في علاقتهم بالتماثيل النصبية.
صحيح أن التغير المجتمعي والتغير الجمعي يحتاج إلى أن تتخفف الذاكرة من طفح فيض الوقائع التي عليها أن تحتفظ بها، وأن الدول المرتبطة كثيراً بماضيها التراثي والتاريخي أقل قدرة على التغير والتحول بسبب ثقل هذا الماضي. إلا أنه لا بد من الحفاظ على الذاكرة الأليمة، الكارثية، لتشكل لحظة الوعي في المستقبل. فلا يوجد وعي من دون ذاكرة، تحفظها الفنون والإبداعات والأعمال البحثية والمخططات الهندسية والثقافية. فحتماً، الذاكرة جزء من بناء المستقبل.
إقرأوا أيضاً:








