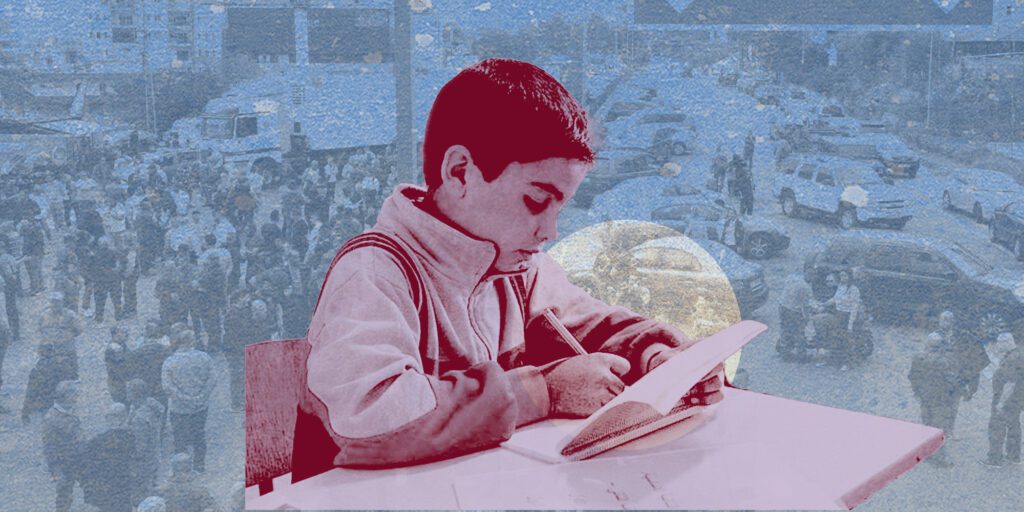كان هذا قبل أكثر من 25 عاماً. نخرج من المبنى اليوناني، فهذا الجزء من مباني الجامعة الأميركية في وسط القاهرة كان مدرسة الجالية اليونانية في مصر يوماً، عبر بوابة الجامعة إلى شارع يوسف الجندي، وهذا، لمن لا يعرف، كان أحد رموز ثورة 1919، ندلف يميناً باتجاه شارع التحرير، ثم يساراً باتجاه ميدان التحرير وصولاً إلى مبتغانا: محل كشري التحرير الشهير.
الكشري لمن لا يعرفه أكلة شعبية مصرية تجمع ما لا علاقة له ببعضه بعضاً، فتخلق من التنافر تناغماً. أرز، عدس داكن (بني اللون، أو “عدس بجبة” كما يسمى في مصر)، بصل محمر، شعرية، مكرونة (باستا، صنفان منها عادة)، يضاف الحمص (حبات منه)، وصلصة طماطم، و”دَقَة” من الخل والثوم وبهارات أخرى، وشطة في صورة سائل ناري حارق لمن رغب. أصل الأكلة ليس معروفاً على وجه الدقة. الأرز والعدس قديمان في مصر، لا شك في هذا. الأول (أي الأرز)، مثلاً لا حصراً، يذكره كأحد محاصيل مصر الرئيسية ابن حوقل الذي عاش في القرن العاشر الميلادي، في كتابه الشهير “صورة الأرض”، أما العدس فمعروف في هذا الجزء من العالم قبل الأرز، فالثابت أن قدماء المصريين عرفوا هذا المحصول قبل الميلاد بآلاف السنين. أما القرآن ففي معرض حديثه عن بطر بني إسرائيل على نعمة “المن والسلوى” في رحلة التيه بعد خروجهم من مصر، يذكر العدس كمثلٍ على طلبهم استبدال ما “هو أدنى بما هو خير”: “وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍۢ وَٰحِدٍۢ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ…” (إلى آخر الآية، سورة البقرة، 61). كان العدس طعام الفقراء “الأدنى” وهكذا بقي. أما الذي أتى بالمكرونة الإيطالية لتخالط العدس والأرز المصريين، فالسؤال لا إجابة معروفة عليه.

أفتاني أصدقاء من أصولٍ هندية، أن الكشري المصري سليل وجبة من بلاد أسلافهم ذات اسم مشابه يتغير قليلاً من مكان إلى آخر عبر شبه القارة الهندية: “كيسوري، كيتشدي، كيشوري”، ويجمع في كل صوره الأرز والعدس. في بعض وصفات هذا الابتكار الهندي يطبخ العدس والأرز حتى يصبحا معاً أقرب إلى الحساء، من ثم هو طعام أساس على مائدة شهر رمضان عند بعض مسلمي شبه القارة الهندية (كما أنواع مختلفة من الحساء على موائد رمضان). في صيغٍ أخرى منه يقارب الكشري المصري كخليط من الأرز والعدس ويضاف إليه البصل المحمر واللبن الزبادي، عدا ذلك السمن عنصر أساس مشترك في هذه الأكلة في كل صورها. ربما أتى الاسم، أو وصفة من هذا الطبق، عبر جنديٍ أو موظف متنقل عبر الإمبراطورية البريطانية في أوائل القرن الماضي (التي كانت الهند مستعمرتها الأهم، ومصر منطقة نفوذ أساسية لها). لكن على العكس من الأصل الهندي (إن ثبت ذلك)، الكشري المصري أكلةٌ نباتية صارمة، توافق، كما جل الأكلات الشعبية المصرية الرخيصة، شروط الصوم المسيحي- القبطي الذي يحرم فيه أكل أي طعام تخالطه “روح”، أي أي منتج حيواني أياً كان. الأقرب ربما إلى الكشري المصري: المجدرَة. هذه موجودة، ببعض التباين، في ما عرف قديماً بـ”بلاد الشام”: فلسطين، الأردن، لبنان وسوريا اليوم. بحسب كتاب “الطبيخ” العائد للقرن الثالث عشر لمؤلفه محمد ابن حسن البغدادي، الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، كانت المجَدرَة تجمع العدس والبرغل، لكن الأشهر منها اليوم يعتمد على الأرز، وفي صيغةٍ مختلفةٍ عن الكُشري يطبخ العدس مع الأرز، وقد تتشابه المحصلة النهائية مع الكشري بإضافة البصل المحمر. لكن المجدرة مشرقية خالصة في ما يبدو، فلا مكرونة إيطالية هنا.
يوجد “كشري” مصري آخر أقرب إلى المجدرة، الكشري الأسكندراني (نسبة إلى المدينة الشهيرة)، إذ يطبخ الأرز مع العدس الأصفر (المقشور) ثم يضاف إلى الخليط صلصة الطماطم (البندورة)، المطبوخة مع الثوم، لكن في الكشري المصري الشهير (و الألذ بما لا يقاس) يطبخ كل مكونٍ على حدة ثم تُخلطُ النقائض لتصنع طبقنا الشهير. فهل تمصرت المجدرة واتخذت اسماً هندياً؟ ربما.
إقرأوا أيضاً:
لكن عدا الوجبة وما فيها، محل (أي الدكان، محل المطعم) الكشري الذي عرفناه كان مؤسسةً تامة، لها طقوسها ولغتها ونظامها. كان (ولا يزال) محل كشري التحرير (الذي أصبح اليوم سلسة ناجحة من الفروع تغطي مصر كلها)، في الجهة اليسار من شارع التحرير وأنت متجه إلى الميدان الذي يحمل الاسم نفسه. على يسار الباب، حاجز زجاجي وراءه كميات هائلة من عناصر الكشري التي ذكرنا، وإلى جوارها علب بلاستيكية لتعبئة الوجبات لمن يرغب في الأكل خارج المكان، إلى اليمين موائد مغطاة بطبقة معدنية، وأمامنا سلم للطبقة العليا، حيث كنا نصعد بعد أن يؤشر لنا أحد العاملين. في الطبقة العليا (وكان المكان من طبقتين فقط)، كان ينتظرنا عم مصباح، صاحبنا الأصلع الممتلئ البشوش. كنا نجود عليه بالقليل الذي نستطيع في كل زيارة، لكن استقباله الودود كان أكرم منا. لا طعام هنا سوى الكشري والأرز باللبن (“الحلو” كما يطلق عليه، فلا “حلو” آخر هنا)، لكن في التخصص تميز. نخبر عم مصباح طلبنا، فنحن من فرط ترددنا على المكان كنا قد حفظنا قائمة الطلبات (المحدودة)، فالفرق بين الطلبات الكمية، وهذه يعرّفها السعر، ثم الإضافات من أي من المكونات، وهناك طلب صغير زائد، “كمالة” لمن لم يشبع الطبق الأساس جوعه (أسماء الطلبات اليوم قد تغيرت). عدا “الكمالة”، من التعبيرات التي أذكرها “المثلث”، وهذا كان زيادات من العدس والبصل المحمر والصلصة، ومن “لغة” المكان تسمية البصل المحمر “ورد”، والصلصة “مونة”، ويطلق أيضاً على العدس “كهرمان”، والأرز “بندق” والمكرونة “لوز”. لا أذكر أن أياً من الأطباق كان سعره يزيد على أربعة جنيهات، وكان الكبير منه نكافح نحن الشباب لننهيه (أكبر الأطباق اليوم سعره 25 جنيهاً).
الكشري المصري أكلةٌ نباتية صارمة، توافق، كما جل الأكلات الشعبية المصرية الرخيصة، شروط الصوم المسيحي- القبطي الذي يحرم فيه أكل أي طعام تخالطه “روح”، أي أي منتج حيواني أياً كان.
ما أن يتلقى صديقنا عم مصباح طلبنا حتى يردده بصوت عالٍ لمتلقٍ في الطبقة السفلى، وبعد دقائق، تتعافى فيها أذناك، يأتي الطلب كما رغبت بالضبط. هناك من يتلقى فيبلغ، ثم من يتلقى ثم يبلغ مرةً أخرى، ثم من ينفذ، ومن دون ورقة أو قلم، يعمل النظام بكفاءة وانضباط. الأرض كانت تُفرش بنشارة الخشب، تُكنس بين الحين والآخر، فهذه تمتص ما قد يسقط من الموائد إن كان رطباً ويضيع فيها ما قد يكون جافاً. عدا دورق معدني للماء، وأكواب معدنية أيضاً، على كل واحدة من الموائد المغطاة بطبقة معدنية فضية اللون، زجاجتان في واحدة منهما “الدَقة”، سائل فاتح اللون، خليط من الثوم والخل والملح وعصير الليمون، مُخفف ببعض الماء، يضيف إلى الكشري طعماً ممتازاً، وفي زجاجة أخرى، أجاركم الله، “الشطة”، السائل الناري الأحمر. كان عم مصباح يدور بين الموائد صائحاً بصوت لا يقل جهوراً عن هذا الذي يأتي به بالطلبات: “الشطة حامية ناااار”، خشية أن يضع أحدهم أكثر من بضع قطراتٍ في طبقه فيشتعل فوه حريقاً لا ينطفئ. كان أيضاً يردد: “ماترغش الشطة”، أي لا تهزها، لماذا؟ لا أعرف. لكنني أذكر أن الزجاجات كانت دافئة دوماً، أو هكذا خيل لي، هل كان يخشى من انفجارها؟ هل هز الزجاجة يزيدها لهيباً؟
لكن الشطة السائلة هذه التي كنا نعاملها كمادةٍ شديدة الانفجار، كان لواحدٍ منا سبيلٌ آخر معها. صديقنا “ياسر”، (وهذا ليس اسمه الحقيقي، فعلاقة أي منا مع أي حارق أمر شخصي)، كان يحفر في طبقه مساحة واسعة ثم يملأها تماماً ببركة من السائل الأحمر القاني، ثم يشرع في تقليب كل ما في طبقه ليضمن اختلاط كل ما فيه بالشطة. ثم يشرع بالأكل. بحسب ما أخبرني: أول ما يبدأ من أثر هو وقوف شعر رأسه، أما نحن الناظرين فنلاحظ أولاً إصابته بالفواق (الزغطة)، ثم تصببه عرقاً غزيراً. لسبب مجهول يستمتع باصطلائه النار ويواصل الأكل. بعد الانتهاء نخرج، ثلاثتنا أو الأربعة أو الخمسة منا كما كنا نذهب عادة، إلى الشارع وواحد منا كأنه قد استحم للتو، لكن بكامل ملابسه.
بعد التهامنا طبقاً أتى اسمه من الهند، ربما كان أصله من بلاد الشام، يوافق الصيام القبطي، نسير عائدين في شارع التحرير، ثم عبر الشارع المسمى على اسم أحد زعماء ثورة 1919، الذي أعلن مدينته: زفتى، جمهوريةً مستقلة كتمردٍ على مصر خاضعة للاحتلال البريطاني، ثم دخولاً من بوابة الجامعة الأميركية نعود إلى مقاعد الدرس، وإن كنا مخدرين بعض الشيء من ثقل ما أكلنا، وأحاول، أنا على الأقل، الاحتفاظ بمسافة بيني وبين غيري بعد ما سكبت من “دَقَة” مملوءة بالثوم بغزارة على طبقي. الكشري ذو التاريخ الغامض: يملأ بطنك، يغذيك، لكنه يخدر عقلك، ولو قليلاً.
إقرأوا أيضاً: