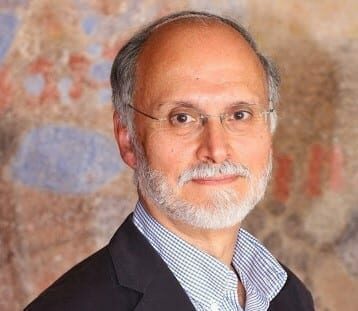شهدت السنوات القليلة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً وخطيراً في استخدام “معاداة السامية” (أي كره اليهود) سلاحاً لدَرء النقد عن الصهيونية، بل لتحريم هذا النقد وتجريمه بوصمه بالعنصرية. وقد وصل الأمر إلى سخرية اتهام كل من يشير إلى الطبيعة العنصرية للدولة الصهيونية بأنه “لا سامي”، أي عنصري هو نفسه! ذلك أن وصف دولة إسرائيل بالعنصرية هو أحد “الأمثلة” التي أوردها تعريف معاداة السامية الذي يروّجه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” في نص رديء للغاية، تمت صياغته قبل 15 عاماً وتبنّاه التحالف المذكور قبل أربع سنوات، حين أطلق مساعي محمومة لجعل الحكومات والمؤسسات الثقافية الغربية تعتمده. وقد نجح التحالف في جعل البرلمان الأوروبي يتبنّى، يوم أول حزيران/ يونيو 2017، قراراً يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ووكالاته إلى اعتماد التعريف المذكور “بغية دعم السلطات القضائية وأجهزة فرض القانون في مساعيها من أجل استكشاف الاعتداءات المعادية للسامية ومقاضاتها بفعالية أكبر”.
شكّلت معاداة السامية حجة الحركة الصهيونية الرئيسية منذ تأسيسها، وقد لازم تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين استخدام هذه الحجة في تبريره وتبرير ممارسات منفّذيه.
ثم تبنّت التعريف الملغوم بضعة برلمانات منها الألماني والفرنسي، لكنّه اصطدم في الكونغرس الأميركي بالمناعة القوية التي يمنحها لحرية التعبير “التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة”، والحال أن العمل بالتعريف لتجريم نقد إسرائيل يتناقض تناقضاً صارخاً مع الحرية المذكورة. لكنّ ذلك لم يمنع مؤسسات حكومية أميركية، لا سيما وزارة الخارجية، بل حتى الرئاسة في عهد دونالد ترامب، من تبنّي التعريف والعمل به. والحكومة البريطانية برئاسة المحافِظة تيريزا ماي، التي تميزت بالمغالاة في دعمها الصهيونية إلى حد افتخارها بإصدار حكومة بلادها وعد بلفور المشؤوم، كان لها دورٌ رائدٌ في دفع معظم الحكومات الأوروبية إلى تبنّي التعريف. ولا تزال بريطانيا تتقدّم الجميع في المزايدة في شأن التعريف الرديء، إذ يسعى الآن وزير التربية في حكومة بوريس جونسون وراء فرضه على الجامعات، على رغم معارضة نقابة الأساتذة الجامعيين.
طبعاً، ليس استخدام “معاداة السامية” سلاحاً لدَرء النقد عن الصهيونية بالجديد، بل شكّلت معاداة السامية حجة الحركة الصهيونية الرئيسية منذ تأسيسها، وقد لازم تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين استخدام هذه الحجة في تبريره وتبرير ممارسات منفّذيه، مذ وصل النازيون إلى الحكم في ألمانيا، خصوصاً بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية. وقد رأت الحركة الصهيونية في معادي السامية خير حلفائها، نظراً إلى تضافر مسعاهم لتقليص عدد اليهود في بلدانهم، سواء أكان ذلك من خلال الحدّ من هجرة اليهود إليها أم من خلال دفع سكانها اليهود إلى الهجرة، مع مسعى الحركة الصهيونية لاجتذاب اليهود إلى فلسطين تحقيقاً لمشروعها. لذا كان من المنطقي أن ترى الحركة الصهيونية في وصول النازية إلى الحكم فرصة ذهبية، ومن المعروف أنها أبرمت مع حكومة أدولف هتلر بعد أشهر قليلة من استيلائه على السلطة اتفاقاً قضى بإلزام اليهود الألمان بالذهاب إلى فلسطين لو أرادوا الاستفادة من أموالهم عند رحيلهم من ألمانيا الذي فرضه عليهم النازيون (بدأ هؤلاء ممارسة “التطهير العرقي” إزاء اليهود قبل أن ينتقلوا إلى إبادتهم أثناء الحرب العالمية الثانية).
إقرأوا أيضاً:
أما بعد هزيمة النازية في الحرب، فقد أخذ الصهاينة يصوّرون مشروع دولتهم في فلسطين كأنه تعويضٌ عن تعرضّ اليهود الأوروبيين للإبادة، ويسعون وراء جلب اليهود الذين تم تخليصهم من معسكرات الاعتقال النازية إلى فلسطين، الأمر الذي تكثّف بالطبع بعد تأسيس دولتهم عام 1948. ومنذ ذلك الحين والصهاينة يستخدمون “الهولوكوست” (المحرقة) أساساً لإضفاء الشرعية على دولتهم، بل ولمطالبة الحكومات الغربية بتوفير شتى أشكال الدعم لها، بدءاً بحكومة ألمانيا الغربية التي قدّمت المساهمة الأهم في تمويل دولة إسرائيل وتسليحها في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم. وقد كانت عقدة ذنب الأوروبيين إزاء مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة في الإبادة النازية، من خلال المشاركة في تنفيذها أو عدم السعي لمنع ارتكابها مثلما كان يتوجب، مصدراً أساسياً للتعاطف الذي حظيت به الدولة الصهيونية في أوروبا في عقديها الأولين.
بيد أن الحالة أخذت تتبدّل إثر حرب عام 1967 وذلك لسببين، أولهما أن الجيل الأوروبي الجديد لم يشعر بالذنب مثل الجيل الذي عايش الحرب العالمية الثانية، وثانيهما أن صورة إسرائيل تحوّلت من أسطورة الدولة الصغيرة المهدّدة بالفناء في إبادة جديدة يقترفها العرب (هكذا كانت الدعاية الصهيونية تصوّر الأمور، مع تشبيهها جمال عبد الناصر بهتلر) إلى صورة إسبرطة شرق أوسطية، تحوز على قوة عسكرية تفوق ما يتناسب مع حجمها بأضعاف. وقد تعزّزت هذه الصورة الأخيرة لمّا أدرك العالم في تلك المرحلة بالذات أن الدولة الصهيونية قد تزوّدت بالسلاح النووي. هذا وقد أخذت صورة إسرائيل الأخلاقية تزداد سوءاً باطراد منذ تلك الحقبة، وخصوصاً بعد اجتياحها الأراضي اللبنانية عام 1982، وهو احتلال ما كان بوسعها تبريره بالدفاع عن النفس، لا سيما أنه ترافق بفظاعات شكّلت مجزرة صبرا وشاتيلا ذروتها.
كانت الانتفاضة الفلسطينية التي بلغت أوجها عام 1988 المحطة اللاحقة في تدهور صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي عموماً والغربي خصوصاً. وقد سرّعت انتقال الحكم الصهيوني إلى تنفيذ “خطة آلون” التي رُسمت بعيد حرب 1967 والتي قضت بالتخلّي عن إدارة المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية في الأراضي التي احتُلّت في تلك الحرب، وفرض طوق عليها من خلال الاحتفاظ ببقية الأراضي المحتلة وتكثيف المستوطنات فيها. فكانت اتفاقات أوسلو عام 1993 التي تبعتها بضع سنوات من توهّم التوصل إلى حلّ سلمي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع حلول نهاية القرن ومعه نهاية “عملية السلام” وعودة العلاقات بين الدولة الصهيونية والشعب الفلسطيني إلى طبيعتها الاضطهادية السافرة، دخلنا القرن الحادي عشر، وقد تتالت محطات جديدة في انحطاط صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي، متمثلة بالعدوان الجديد على لبنان عام 2006 والاعتداءات المتكررة على غزة.
آخر طرائف الحملة الخبيثة على “معاداة السامية” فهي نظر شركة “فايسبوك” في احتمال رصدها استخدامات تعبير “الصهيونية” التي يتستّر وراءها العداء العنصري لليهود.
هكذا بلغت إسرائيل عهد بنيامين نتانياهو، وهو لا يزال يترأس حكومتها منذ 12 سنة (!)، معزّزاً تطابق الحكم الإسرائيلي مع أقصى اليمين الذي تنزع إليه الصهيونية بطبيعتها، بصفتها أيديولوجية عرقية. ومع نتانياهو، بلغ استخدام “معاداة السامية” سلاحاً لدَرء النقد عن دولته وحكومته وشرعنة عدائه العنصري السافر للعرب ذروةً قصوى، وقد وصل به الأمر يوماً إلى إعفاء هتلر من مسؤولية إبادة اليهود ليلقيها على أمين الحسيني، الأمر الذي أثار استنكاراً واسعاً بين يهود العالم. وقد صعّدت حكومة نتانياهو ضغطها على الحكومات الغربية كي تحرّم نقد دولته بتبنّيها تعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” سابق الذكر، الأمر الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي الذي يسّره انحطاط صورة الحركة الفلسطينية الواقعة بين مطرقة “السلطة الوطنية” الغارقة في الفساد وسندان “حماس”.
أما آخر طرائف الحملة الخبيثة على “معاداة السامية” فهي نظر شركة “فايسبوك” في احتمال رصدها استخدامات تعبير “الصهيونية” التي يتستّر وراءها العداء العنصري لليهود. فلو أفلحت الشركة في إيجاد برنامج قادر على رصد مثل هذه الاستخدامات، سوف نتمنى عليها أن تجيّره إلى رصد استخدامات تعبير “الإسلاموية” Islamism وسواه من التعابير التي يتستّر وراءها العداء للمسلمين وهو في عالمنا الراهن أكثر انتشاراً وأكثر خطورة من العداء لليهود بما لا يُقاس! وقد صدق شاعر المارتينيك إيمي سيزير في خطابه الشهير عن الاستعمار عندما قال إن ما لا يغفره الغربيون لهتلر “ليس الجريمة بذاتها، الجريمة ضد الإنسان، وليس إهانة الإنسان بوصفه إنساناً، بل هو الجريمة في حق الرجل الأبيض، إهانة الرجل الأبيض، وكون هتلر طبّق على أوروبا ممارسات استعمارية كانت حتى ذلك الوقت مخصّصة حصرياً لعرب الجزائر و”حمّالي” coolies الهند و”عبيد” nègres أفريقيا”.
إقرأوا أيضاً: