في الأسبوع الأول من آذار/ مارس، لم تلقَ أخبار ترحيل 94 لاجئاً سورياً من الدنمارك سوى القليل من الزخم. فقد كانت صحيفتا “ذي إندبندنت” و”ذي تلغراف” البريطانيتان، على رأس وسائل الإعلام الكبرى العالمية القليلة- إلى جانب مصادر الأخبار المتمركزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطرقت إلى خبر عودتهم المتوقعة، وتأكيدات الحكومة الدنماركية أنّ دمشق تعتبر مكاناً آمناً. إذ أشار ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي وعضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي الدنماركي، مطلع عام 2021 إلى أن الحكومة الدنماركية أوضحت جلياً للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم “موقّتة”، ومن الوارد أن تُسحب منهم إذا ما استقرت الأوضاع في بلدهم الأم. بناءً عليه، أوصى تسفاي “بالعودة إلى ديارهم وبدء حياة جديدة هناك”.
منذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011، التي أتمت عامها العاشر في 15 آذار من العام الجاري، تابع العالم عن قرب تفكك نظام بشار الأسد والتدمير الوحشي الذي تعرضت له البلاد، وكانت لقوات داخلية وخارجية وعارضة يد فيه. في أعين كثيرين، كانت أزمة اللاجئين السوريين التي سببتها الحرب، بمثابة صحوة سياسية وتذكيراً بالواجب الأخلاقي. ومن عجيب المفارقات اعتبارها وسيلة لغاية أسمى من قبل الإمبرياليين الجدد والمناهضين للإمبريالية على حد سواء.

إذ طافت صورة جثمان الطفل الصغير آلان الكردي، وهو ملقى على إحدى ضفاف البحر المتوسط، وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حين طالب نشطاء ومشاهير وقادة العالم، بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والاهتمام العالمي. وقد دأبت المنظمات غير الحكومية، من الأمم المتحدة إلى “منظمة أطباء بلا حدود”، على تنظيم الحملات بلا هوادة من أجل الحصول على تمويلات خاصة وعامة، من طريق استعراض الدمار الذي وصلت إليه الشام أمام أعين الجميع. فقد انتشرت عمليات قطع الرؤوس على نطاق واسع على الإنترنت، كذلك هدم معبد وأبراج مدينة تدمر الأثرية، فقد صارت الآثار التي صمدت لمئات السنين حطاماً وغباراً. وأعادت المشاهدات الهائلة والتداول الكبير لهذه المقاطع والصور، وقصص الضحايا، تقديم أزمة بلاد الشام للعالم، باعتبارها مأساةً ومعاناةً أزليةً تعيشها المنطقة.
لكن، بدلاً من أن تشعر الدول الأوروبية بالخوف، مهدت الطريق أمام صعود الفاشية بلا مجهود في منطقة لطالما أُشِيدَ بالتزامها تجاه احترام حياة الإنسان والسهر على رفاهيته. لنأخذ مثلاً النموذج الاسكندنافي الدانماركي الذي يحظى باحترام الليبيراليين واليساريين المعتدلين بفضل تنوعه المتناغم حين يتعلق الأمر بالمفاوضات الجماعية، والضمان الاجتماعي ونظام السوق الرأسمالية المختلطة. تُقدم الدنمارك نفسها باعتبارها مدينة فاضلة تتسم بالديموقراطية الاجتماعية [الممكنة/ المعقولة]، ومفعمة بالحيوية والعقل. إذ إنها تمنح الأبوين الحق في إجازة ما بعد الولادة، مع توفير الكثير من الحضانات المدعومة، فضلاً عن نظام الرعاية الصحية الذي يغطي، أو يسدد بعض التكاليف الباهظة للأطباء المتخصصين والعلاجات، وتقديم المساعدات المدرسية والحوافز وأجور الموظفين المغرية، فما تعتبره الدنمارك من أساسيات الحياة، يعتبر في مناطق أخرى من العالم المتقدم حلماً بعيد المنال.
فقد كان سوء الحكم وسوء الإدارة وبعض الخصائص الثقافية، سبباً في عدم توفير هذه الإمكانات التي تبدو ممكنة في معظم الدول المتقدمة ذات الاقتصادات المتقدمة والصناعات عالية الجودة والصفقات التجارية المشبوهة. ولكن كما هو الحال في جميع المدن الفاضلة، تلوح الخديعة في الأفق. يناقش اليساريون، بخاصة أصحاب القناعات التي ظهرت في الحقبة ما بعد الاستعمارية، أسئلةً حول أسباب وكيفية نجاح وكفاءة وإنصاف النموذج الاسكندنافي، ويحاولون البحث ملياً في الأسباب التي تبقيه متماسكاً. ثمة اعتقاد واسع منتشر بين أرجاء الشمال العالمي والجنوب العالمي على نحو تقليدي، وهو أن الشمال العالمي يستمد احتياجاته المفرطة من العمالة الرخيصة من الجنوب العالمي. ما أدى إلى تسريع وتيرة التدهور البيئي الذي لحق بدول الجنوب. فالإمبريالية في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُعرف بكونها سيطرةً صريحةً واستعباداً، بل أعادت تقديم نفسها في صورة سوق حرة قائمة على العولمة باعتبارها قوة ربحية استغلالية، حيث يحظى الفائز بكل شيء. فبينما مهّدت النقابات العمالية الدنماركية الطريق أمام الطبقة العاملة في الديموقراطيات المتقدمة، دهست صناعتها (سواء التجارية أو النفطية) الجهود التي يبذلها العمال المأجورين في أماكن أخرى من العالم، مخلفةً وراءها ناراً ودخاناً (آثاراً من الدمار).

لكن كيف تتبدى منهجية الشركات العابرة للحدود في الاستهانة بحياة الإنسان في مكان آخر من العالم، تحت ظل حكومة ديموقراطية اشتراكية؟ في المملكة المتحدة، أدت البيئة العدائية التي صنعتها تيريزا ماي، إلى إبعاد المهاجرين، وتهميش أولئك الذين تمكنوا من البقاء. كشفت فضيحة “ويندراش” التي أدت إلى استقالة وزيرة الداخلية آنذاك آمبر رود، عن الاعتقالات غير القانونية وترحيل المقيمين لعقود الذين جاءوا من دول الكاريبي. وفي وقت كتابة هذا المقال، ذكرت شارلوت روبن من شبكة شؤون الهجرة أن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، قد أعلنت أن طالبي اللجوء، الذين يتوجب عليهم منذ هذه اللحظة الدخول بشكل “قانوني” إلى البلاد تجنّباً للاعتقال، ستُسوى أوضاعهم بشكل موقت يتم تقييمه بانتظام، مع احتمال التراجع عنها، إلا في حال ثبت وجود سبب “حقيقي” يستوجب الحماية. ومن هذا المنطلق، ظهر مفهوم “الآخر”، حتى يُضفي معنى على “المواطن” الذي يدعمه التقسيم الاقتصادي، ومن ثم الاجتماعي، على مستوى العالم. من ينتمي إلى هذه البلد؟ وكيف يبدو الأشخاص المنتمون إليها؟ وماذا عن طريقة كلامهم؟ هل يساهمون أو يعرقلون تشكيل ذاكرة وهوية جماعية؟ هذا النوع من المواقف ينتقل من المستوى المؤسسي إلى النقاشات الاعتيادية اليومية، التي تضفي عليه تعليقات تضر في الغالب أولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون بالفعل -وحتى المدينة الفاضلة الاشتراكية الدنماركية ليست مستثناةً من هذه الكراهية للأجانب واحتقارهم.
عام 2018، فرضت الدنمارك حظراً على تغطية الوجه في الأماكن العامة، الذي يشار إليه إعلامياً بـ”حظر البرقع”. وبالطبع، استهدف هذا الحظر النساء المسلمات وجرَّمهن، بعدما اعتبرت وزارة العدل ممارساتهن التقليدية منافية لقيم المجتمع الدنماركي. بعد ذلك بعام، صدر قانون يستهدف المناطق المعزولة التي تقطنها الأقليات العرقية في البلاد- وهي المناطق السكنية التي تتسم بمعدلات بطالة وجريمة مرتفعين، وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم ودخل أسري منخفض- وينص على إجبار جمعيات الإسكان على بيع أو إعادة هيكلة المساكن العامة.
يتمثل الغرض من هذه الخطة في “تغيير التركيبة الاجتماعية والإثنية لمشاريع الإسكان المنخفضة الدخل”، التي تعتبر أيضاً مناطق معزولة تقطنها الأقليات العرقية، وعلى رغم أن الحكومة عرضت توفير مساكن جديدة لأولئك الأشخاص المعرضين لخسارة منازلهم بموجب القانون الجديد، فقد أوضحت أيضاً أن أولئك الذين يرفضون المغادرة سيطردون. يُثري وجود “أحياء الأقليات المعزولة” وما ينطوي عليه من إيحاءات سلبية تجاهها كمرتع للفوضى والجريمة، الوصف المستمر بأن “الآخر” لا يُمكن أبداً أن يندمج في المجتمع المضيف ما لم تتدخل سلطة أكبر في هذه المجتمعات المحلية وتفككها بدلاً من تحدي العوائق المؤسسية التي تؤدي إلى عزلها. ولتوضيح عمق هذه القضية، يكفي أن ننظر إلى صورة وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة إنغر ستويبرغ، وهي تحمل كعكة احتفالاً بإقرار القانون الخمسين الذي شددت من خلاله الحكومة الائتلافية اليمينية التي تنتمي إليها القيود المفروضة على الهجرة. وكما هو الحال في جميع المدن الفاضلة، البريق يخفي الحقيقة.
إقرأوا أيضاً:
بيد أن هذه ليست معلومات جديدة. إذ إن تشدد الدنمارك مع اللاجئين والمهاجرين معروف على نطاق واسع بالنسبة إلى أولئك الذين تابعوا عن كثب استجابة أوروبا لأزمة اللاجئين السوريين وصعود اليمين المتطرف وتنامي النزعات القومية الحادة. فقد تسببت الخطابات المناهضة للهجرة في تعطيل المؤسسات الديموقراطية وإرغام المنطقة على التصالح مع إرث ماضيها الاستعماري والإمبريالي، كاشفة بذلك عن أوجه التضارب التي تعاني منها الحضارة الغربية أمام جميع المؤمنين بها، لتصبح محل سخرية من منتقديها. وعلى رغم أن دول الخليج تنصلت من كل المسؤولية تجاه التخفيف من حدة الأزمة، وتحايل لبنان على سياسات الحدود المفتوحة التي لطالما اتبعها من خلال استحالة حصول اللاجئين السوريين على فرص عمل ومأوى، فإنهم لا يروجون لأنفسهم على أنهم حصون المساواة والحرية. وهنا تكمن جسامة الصدمة التي سببها قرار إعادة 94 شخصاً من الدنمارك إلى وطنهم، والمحتجزين حالياً في مرافق الترحيل التي سيظلون فيها إلى أن يوافقوا على العودة طوعاً.
الواقع أن قرار الدنمارك اعتبار دمشق منطقة آمنة للعودة يعد قراراً هزلياً حين يواجه بحقيقة وجود آلاف الأشخاص المفقودين أو المحتجزين أو المختطفين على أيدي القوات النظامية. والأدهى من ذلك أن نظام الأسد هدم المنازل المهجورة، وأعاد تطوير “التجمعات السكنية العشوائية”، وأجبر السكان الباقين على النزوح قسراً في محاولة وقحة لهيكلة المدينة اجتماعياً وتخطيطها، وحصر العاصمة بمجتمع يتألف من أنصار الأسد والنخبة الغنية وحسب. لذا فإن اللاجئين العائدين إلى سوريا سواء طوعاً أو كرهاً، ليسوا في مأمن من الاضطهاد أو التجنيد في الجيش. وبدلاً من مناقشة الموارد الضئيلة المتبقية للسوريين عند العودة إلى ديارهم والتي قد لا تكفي “لإعادة بناء” حياتهم، تعتقد وزارة الهجرة الدنماركية أن عودة 100 ألف لاجئ إلى وطنهم عام 2019، من أصل 6.1 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، هو دليل على أن سوريا أصبحت آمنة.
عادت مروة، وهي الآن امرأة تبلغ من العمر 22 سنة، هربت إلى لبنان مع عائلتها عندما بلغت الـ12 من عمرها، مرة أخرى إلى دمشق، لتعود أدراجها إلى لبنان مجدداً بعد عام واحد. فبعدما نشأت وتزوجت في لبنان، قررت العودة عام 2019 إلى مسقط رأسها في حي التضامن، وهي بلدة قريبة من مركز العاصمة دمشق، للمساعدة في إعادة بناء منزل عائلتها. وفور وصولها، وجدت مروة أن تأمين المستلزمات الأساسية، مثل الخبز والماء والكهرباء والغاز، كان أكثر صعوبة من لبنان، الذي كان أيضاً يمر بأزمة سياسية وقت رحيلها.
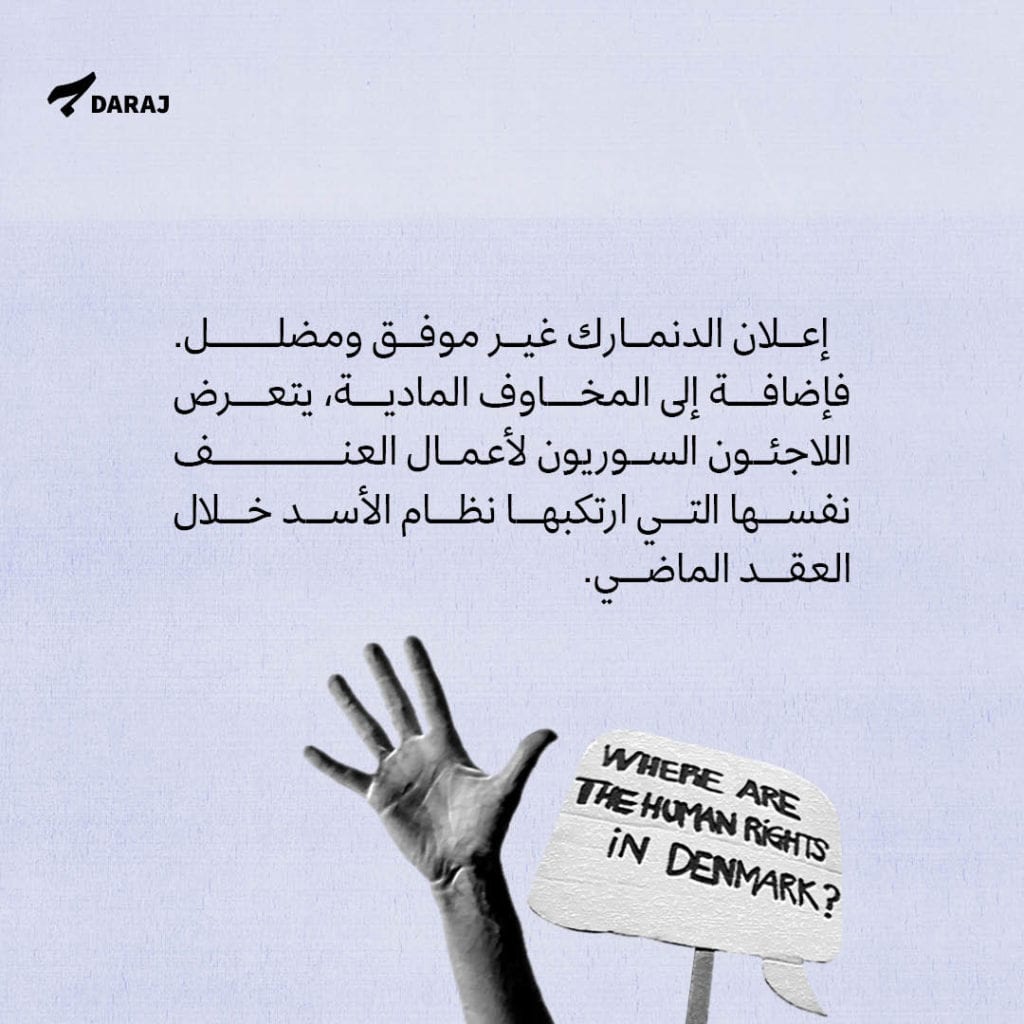
كل ما يهمني هو تدبير إيجار المكان الذي أقيم فيه وتوفير الأموال اللازمة لتربية طفلي، وهو ما لم أستطع فعله في سوريا. فالأسعار مرتفعة في كل مكان، ولكن بالنسبة إلى شخص لا يملك الكثير، فإن حياته مقيدة بشكل كبير بسبب الموارد المحدودة في البلاد. ولهذا السبب يغادر الشعب السوري: فنحن في حاجة إلى تأمين حياة أفضل لأنفسنا وعائلاتنا وأطفالنا.
اختارت مروة العيش في حي الأوزاعي مع زوجها وابنها، بينما تقيم بقية أفراد عائلتها في بيت طفولتها الذي أعيد بناؤه لحسن الحظ. ومع ذلك، فهي لا تزال مورد الرزق للأسرة، وتعمل أخصائية تهذيب أظافر متنقلة في بيروت وتخوض غمار الحياة في ظل القيود المفروضة على البلاد جراء جائحة “كورونا”، وآثار التضخم الشديد، وتوقف القطاع المصرفي عن كافة التحويلات الدولية.
لا شك في أن إعلان الدنمارك غير موفق ومضلل. فإضافة إلى المخاوف المادية، يتعرض اللاجئون السوريون لأعمال العنف نفسها التي ارتكبها نظام الأسد خلال العقد الماضي، والتي أدانتها الدول الشمالية والغربية مراراً وتكراراً. بل إن الحد وصل بالبعض إلى تبرير شن المزيد من الهجمات على البلاد ومواطنيها بوصفها عملاً من أعمال التحرير والإنقاذ. وكما تقول الكاتبة الروائية ليلى العلمي في كتابها “مواطنون لكن بشروط”، لا يسيطر الشعب السوري على مصائره السياسية، ولكن مواطني البلدان المضيفة لهم يمكنهم ذلك، على أقل تقدير، يمكنهم أن يحاسبوا حكوماتهم على وضع السوريين المنهكين بالفعل تحت وطأة الضغوط والشكوك التي لا مبرر لها. وإذا كان الخطاب المناهض للهجرة يُبرر إلغاء تصريح إقامة 94 شخصاً، لأنهم لم يعودوا يحتاجون إلى “حماية حقيقية”، ولم يعد بوسع الدولة أن تتحمل أعباء الغرباء، فقد مُني التعايش والتعددية الثقافية بوصفهما مشروع اجتماعي وثقافي بالفشل الذريع. ربما تكون الدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُقدم على إعادة اللاجئين، ولكن كن على يقين أن الدول الأخرى ستحذو حذوها إذا سنحت الفرصة للقيام بذلك بهدوء وسرية.
أياً كانت المعايير التي اتصف بها هؤلاء الأشخاص لكي يتأهلوا للعودة إلى بلد في وضع خطير، فهي توضح كيف أن الحدود والدول القومية الحديثة، لا توجد إلا لتحدد “الآخر”، وهي أرض بعيدة بإمكان المرء أن ينقطع عنها، ليستعيد السلام ويجلب الراحة لـ”النفس”. بيد أنه مثلما أظهر لنا التاريخ مراراً وتكراراً، فإن البشر من الأنواع المهاجرة كثيرة الترحال، ولا سيما في ظل نظام رأسمالي عالمي قائم على عولمة السوق الحرة، يفرض أين يمكن إيجاد الفرص وأين ينبغي جني المكاسب. وسيظل اللاجئون يواجهون مخاطر ترحالهم، ويلاحقون مستقبلاً مسلوباً منهم في أوطانهم. وإلى أن تعترف بلدان مثل المملكة المتحدة والدنمارك والولايات المتحدة بهذا الواقع، فإنها سوف تمزق نفسها إلى أن يصبح كل ما تبقى، مثل شخصية “دوريان غراي” التي أبدعها أوسكار وايلد في روايته، مجرّد انعكاس للمسخ.
إقرأوا أيضاً:









