بينما يستعد الأردن للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن التي تحولت لاحقاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لا تزال قضية الأمير حمزة تطغى على حديث المواطنين الأردنيين. حدث الزلزال السياسي قبل أسابيع، عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 20 شخصية بارزة بتهمة التخطيط لانقلاب. من بينهم ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، الذي طُلِب منه التوقف عن الاجتماع مع شيوخ العشائر ذات التوجهات المعارضة. فقد بدأت عشائر كثيرة في التطلع إليه باعتباره أولى بالمُلك من أخيه عبد الله، مدفوعة بغضب من الأزمات والصعوبات الاقتصادية والفساد المستشري في مؤسسات البلاد.
جلب البريطانيون الهاشميين من شبه الجزيرة العربية ونصبوهم ملوكاً على المملكة التي رسموا حدودها عام 1921. وعلى رغم افتقارها للثروة والمكانة، استطاعت المملكة الحفاظ على استقرارها الداخلي بفضل رعاية عشائرها، بخاصة بعدما استضاف الأردن ملايين النازحين الفلسطينيين بعد حربي عامي 1948 و1967 بين العرب وإسرائيل. كانت المقايضة بسيطة للغاية لكنها نجحت: الخبز مقابل الولاء. لكن منذ تتويج الملك عبد الله عام 1999، شهدت الوظائف الحكومية والخدمات الاجتماعية المخصصة لأبناء العشائر الأردنية تراجعاً كبيراً للغاية. وعليه فقد كان تدخل الأمير حمزة في تلك العلاقة المتوترة بين الأسرة المالكة وقاعدتها العشائرية هو أساس تلك القضية.
في حين يرى البعض إن ثمة مؤامرة حقيقية تتعلق بتدخل سعودي، يعتقد معظم المحللين أن القضية برمتها كانت أزمة مفتعلة بهدف إلهاء الشعب الساخط من سوء إدارة النظام الملكي الحاكم طيلة العقد الماضي. فاقمت الجائحة من الأزمة الاقتصادية في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني البلاد منه بالفعل، وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة من 15 إلى 25 في المئة، وزيادة معدلات الفقر زيادة هائلةً، لتصل إلى 37 في المئة بعدما كانت 16 في المئة. ولم تثمر وعود الملك عبد الله العقيمة بإجراء إصلاح ديموقراطي عن أيّ شيء ملموس. وكان رد فعل المملكة على الانتقادات المستمرة التي يوجهها نشطاء العشائر للملك- الفعل الذي يعد من أقصى أشكال التجاوز- هو مضاعفة وتيرة القمع، وليس تبني سياسات أفضل والتعامل بمزيدٍ من الشفافية.

لكن القصة الحقيقية لا علاقة لها بقمع المعارضة أو مؤامرات القصر. فمثل الأنظمة الديكتاتورية كافة، لا يتعامل الأردن بتساهل مع المعارضة الشعبية. أضف إلى ذلك أن معظم الأنظمة الملكية العربية تعاني من تناحر داخلي بين أفراد الأسر المالكة. فخلال العقد الماضي، شهدت السعودية والمغرب والبحرين حملات قمع وتكميم أفواه قوية- بل ومتطرفة- بحق بعض الأمراء المنشقين. وعصفت مؤامرات انقلابية وصراعات على الخلافة بعائلة الصباح الحاكمة في الكويت.
ما تكشف عنه هذه الأزمة فعلياً هو النهاية المؤلمة لـ”مَحمِيّة أميركية” في قلب الشرق الأوسط. إذ تتداعى الشرعية الشعبية للأردن بعدما تحول إلى “مملكة موز” تعتمد بشكل أساسي على الكميات الضخمة من المساعدات والأسلحة التي تتلقاها من واشنطن لتبقى صامدة. فقد تنازل الأردن عن كثير من سيادته عندما وقع على اتفاقية دفاع جديدة في كانون الثاني/ يناير من دون إطلاع الشعب الأردني عليها، مُنح الجيش الأميركي بموجبها امتيازات وإعفاءات غير مقيدة تسمح له بإدارة عملياته داخل الأراضي الأردنية بِحُرية وهو ما يحول المملكة بأكملها إلى قاعدة عسكرية أميركية ضخمة. كل هذا يجعل النظام غير مستعد أصلاً للتفكير في إجراء أيّ إصلاحات داخلية من دون ضغط أميركي صريح.
في الوقت ذاته، تبقى الولايات المتحدة شريكاً متواطئاً في التخبط الاقتصادي والانتهاكات السياسية التي تساهم في تفكك البلاد. يعد الملك عبد الله حالياً الزعيم الوطني صاحب أطول فترة حكم في العالم العربي، وعادة ما يشيد الرؤساء الأميركيون بولاء مملكته للغرب، ويصفونها بأنها نموذج عربي للإصلاح والاعتدال. وخلال الأزمة الأخيرة، تواصلت إدارة بايدن مع الملك عبدالله لإبداء دعمها لحملة الاعتقالات والاطمئنان على سلامته. وأوصاه الرئيس الأميركي جو بايدن بأن “يظل قوياً”، في حين أكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، على “الشراكة الاستراتيجية” بين الولايات المتحدة والأردن.
هذه قصة حزينة إنما مألوفة. لنأخذ مثلاً إيران في ظل حكم الشاه، أو بعض الحالات الأخرى التي ليست من الشرق الأوسط مثل فيتنام الجنوبية أو هندوراس في عهد سوموزا. يُظهر التاريخ أنه عندما يتحول دعم دكتاتورية أحد الحكام التابعين إلى ركيزة مقدسة في السياسات الخارجية الأميركية، فإن هذا الحاكم التابع يصبح معتمداً بشدة على الدعم الأميركي، لدرجة إعطائه الأولوية لعلاقته مع واشنطن على حساب مصلحة شعبه. في حالة الأردن، حافظت المملكة على الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط ووفرت الحماية لإسرائيل، مع تجاهل المشكلات الخاصة بالأردنيين. يرتكب مثل أولئك الحكام أسوأ التجاوزات الاستبدادية، ويسعون إلى إثراء أنفسهم، ما يؤدي إلى تنفير شعوبهم منهم. ويتجاهلون الدلائل المنذرة بقرب اندلاع ثورة، مؤمنين بأن واشنطن سوف تنقذهم. لكنها لا تقدم على ذلك مطلقاً.
تلك الرغبة في الهيمنة التي تجعل واشنطن تساند أنظمة الموز بينما تدمر نفسها ليست مجرد إعادة قولبة لمبدأ كيركباتريك، الذي يرى أن حتى أكثر الديكتاتوريات الموالية للغرب فساداً، تعد أفضل من الديموقراطيات المناهضة له. بل تنبع هذه الرغبة من حقيقة اعتيادية أكثر بساطة. فبمجرد أن تصبح الولايات المتحدة ملزمة ليس بالدفاع عن نظام ما وحسب، بل إدارة الدولة نفسها أيضاً، لا يمكنها التراجع.
إقرأوا أيضاً:
إشكالية الاستقرار
تواجه الولايات المتحدة إشكالية مستعصية. إذ يخشى صناع السياسات من أن يؤدي التراجع عن أي جزء من دعمهم إلى زعزعة استقرار البلد التابع لهم، الذي لا يمكنه الصمود دون هذا الدعم. ويصبح الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو إطالة أمد هذا النظام الحالي، حتى وإن كان واضحاً أن السياسات التي يتبناها هذا النظام تزعزع استقراره. ولهذا السبب تستطيع إدارة بايدن أن تعيد صياغة وتقويم علاقاتها مع دولة كبيرة وغنية مثل السعودية بسبب تجاوزاتها الاستبدادية، لكن لا يسعها فعل شيء في حالة دولة صغيرة وفقيرة مثل الأردن.
بدأ تحول الأردن إلى الاعتماد على الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة. فقد حلت واشنطن محل البريطانيين الذين انحصر دورهم في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وأصبحت هي التي تُقدم لها الحماية، وكان ذلك تحركاً منطقياً نظراً إلى ضرورة دعم الأنظمة المناهضة للاتحاد السوفياتي في كل مكان. وعلى رغم أن الأردن لا يحتوي على نفط، فإن أهمية وجودة تكمن في أنه يُمثل حاجزاً جيوسياسياً يعزل إسرائيل وشبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط عن القوى المتطرفة المتمثلة في الشيوعية والقومية العربية.
بعد انتهاء الحرب الباردة، أصبح الأردن جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الأميركية من خلال المساعدة في استهلال مساعي “السلام الأميركي” (باكس أميركانا-Pax Americana) في الشرق الأوسط. فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية التي عقدت معاهدة سلام مع إسرائيل، وسهل تنظيم حملات مكافحة الإرهاب، وسرع من عملية غزو العراق. فضلاً عن أنه استضاف التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية وساعد في إمداد الأسلحة للمتمردين السوريين- وعلى رغم ما قام به ضباط المخابرات الأردنية من سرقة الأسلحة التي أرسلتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى مقاتلي المعارضة السورية من طريق الأردن، وبيعها لتجار سلاح في السوق السوداء. بيد أن اتفاقية التعاون الدفاعي الأردنية الأميركية الأخيرة تتجاوز ذلك بكثير، إذ إنها تُلزم المملكة بالمساعدة في خوض حروب الولايات المتحدة المستقبلية في المنطقة.
طوال هذه المراحل، ساهمت واشنطن في بناء الدولة الأردنية. وقد كانت المعونات الخارجية إحدى الآليات. فعلى مدار سنوات، تجاوزت المساعدات الاقتصادية الأميركية جميع العائدات الضريبية المحلية، بل كان ذلك هو الشيء الوحيد الذي يمنع “الأردن الحصين” من الانهيار نحو الإفلاس. وعلى رغم أن الأردن يتلقى اليوم الدعم من جهات مانحة مختلفة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، يظل الدعم الاقتصادي الأميركي هو أكثرها مرونةً على نحو فريد: إذ إنه يُقدم في الغالب في صورة أموال نقدية، فضلاً عن أنه مضمون، وتتجاوز قيمته الآن مليار دولار سنوياً.
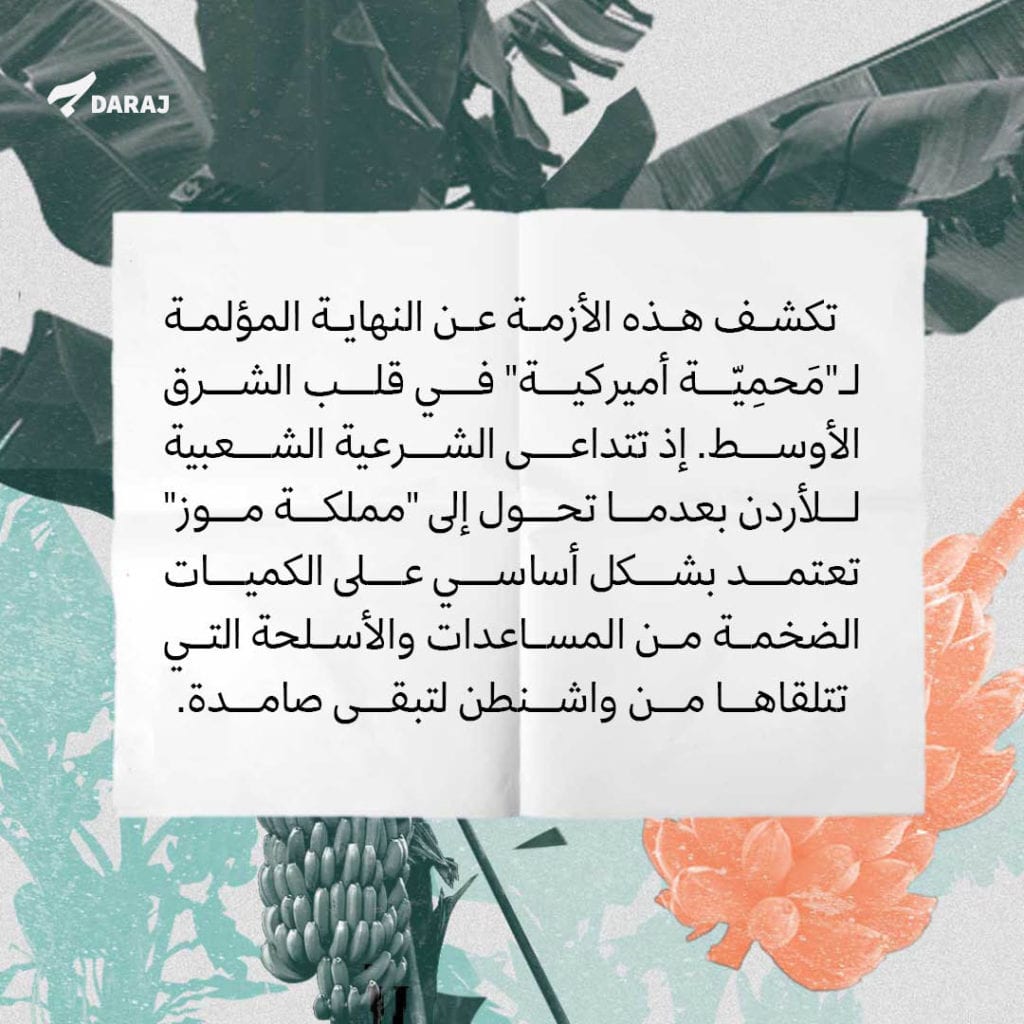
وعلى المنوال ذاته، بدأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تصميم وتشغيل جزء كبير من البنية التحتية المادية في الأردن في ستينات القرن الماضي، وتحملت أعباء القيام بالمهمات الأساسية للحكم -إمداد المجتمع بالسلع والخدمات العامة- نيابة عن الأسرة المالكة. فعندما يحصل الأردنيون على المياه من الصنبور، وهو إنجاز ليس بهينٍ في بلد يعاني من الجفاف الشديد، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وحتى “منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”، وهي مشروع ضخم يهدف إلى تحويل مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر إلى مركز تجاري إقليمي، قام بتمويله وتصميمه مجموعة من التكنوقراط الأميركيين.
علاوة على ذلك، أصبحت المؤسسات القمعية الأردنية التي تدعم أركان النظام مرتبطة على نحو تكافلي بالولايات المتحدة. إذ تكرس دائرة المخابرات العامة، التي يُشيد بها الصحافيون الغربيون باعتبارها النسخة العربية من الموساد، القدر ذاته من الوقت للتضييق على المعارضين الأردنيين، مثلما تفعل لمكافحة الإرهاب. ويُعزى الفضل في الكثير من مهاراتها ومواردها لوكالة الاستخبارات المركزية. وتواصل القوات المسلحة عملها جاهدة بفضل التدريبات والمساعدات العسكرية الأميركية. فضلاً عن أن معظم أسلحة الجيش -الدبابات والطائرات النفاثة والمدفعية والمدافع- مصنوعة في الولايات المتحدة.
من هذا المنطلق، يحظى الأردن بمكانة استثنائية، حتى بين صفوف حلفاء واشنطن. إذ يُعتبر من الدول التابعة للولايات المتحدة التي تديرها أسرة مالكة تدرك أن أهم مبنى في عمّان باستثناء الديوان الملكي هو السفارة الأميركية. بالطبع، أن تكون مَحمِيّة أميركية؛ فهذا أمر له أعباء من حين إلى آخر. فعلى سبيل المثال، الاعتماد على نيات واشنطن الحسنة، منح عبد الله حيزاً ضئيلاً لوقف “صفقة القرن” التي قدمتها إدارة ترامب. فقد كانت تلك الخطة الاستفزازية الرامية إلى حل المعضلة الإسرائيلية- الفلسطينية سبباً في إثارة غضب عبد الله، لأنها انحازت إلى مطالبات إسرائيل المتعلقة بالأراضي، في حين تجاهلت الدور القيادي التقليدي للأردن بوصفه وسيطاً في الصراع. بيد أنه حتى في خضم هذه الأزمة، لم تُشكك إدارة ترامب في الحكمة من إبقاء عبد الله في الحكم.
ما وراء سياسة الدعم الكامل
كل هذا يفسر لماذا لا تزال الولايات المتحدة تنحو إلى تقديم الدعم الكامل للأردن، على رغم ما تعانيه مملكة الموز من تدهور متزايد في الأوضاع، بدايةً من اعتقال الأمراء، ووصولاً إلى قمع المعارضين من العشائر. لا تستطيع واشنطن أن تتخيل وجود أي شكل آخر للأردن، لأنها ليست مضطرة أبداً إلى ذلك. ربما ستتعلم الولايات المتحدة بالطريقة الصعبة. إذ إن التاريخ لا يكشف حصراُ أن الدعم الأميركي فشل في إنقاذ الأنظمة الاستبدادية التابعة له من الاضطرابات الاجتماعية، بل إن الحكومات التي تحل محل تلك الأنظمة غالباً ما تكون أيضاً معادية بشدة للولايات المتحدة. تُعد حالة جمهورية إيران الإسلامية أفضل مثال على ذلك، فقد ظلت تلك القضية تلاحق قادة الولايات المتحدة لمدة 40 عاماً. وعلى مقربةً من الولايات المتحدة، هناك النظام الكوبي الذي يُعتبر النتيجة التاريخية للثورة التي أطاحت بإحدى جمهوريات الموز الفريدة، التي شهدت الحكم الدكتاتوري للرئيس فولغينسيو باتيستا.
في ضوء استبعاد إقدام الولايات المتحدة على فرض أي ضغوط من أجل إصلاح جاد من بعد، فإن عبء التغيير يقع على عاتق الأردن. إذ تدرك الأسرة المالكة بالفعل ما ترغب في تحقيقه العشائر الأردنية، بل وكل المواطنين الأردنيين، لأنهم كانوا يطالبون به بشدة منذ بزوغ فجر الربيع العربي. إنهم يريدون حملات شفافة تتسم بالصدق للقضاء على الفساد المستشري. ويتمنون التوقف عن إهدار النفقات العامة، ووضع بدلاً من ذلك برامج مُجدية تسهم في خلق مزيد من فرص العمل. ويرغبون في تقليل حدة القمع وإفساح المجال لمزيد من الديموقراطية، وهو تعهد قطعه عبدالله على نفسه عام 2011.
بيد أن الوقت على وشك النفاد. لا يزال الشرق الأوسط تربة خصبة لاندلاع الثورات، فقد أطاحت الانتفاضات الشعبية بستة من حكامه المستبدين خلال العقد الماضي. وما إذا كان دور الأردن قد حان ليشهد تغييراً ثورياً مماثلاً؛ فإن هذا يتوقف على قدرة الأسرة المالكة على إعادة التفكير في النهج الذي تتبعه بصورة جذرية، بدلاً من اللجوء إلى الولايات المتحدة طمعاً في تأييدها. وإذا ما حدث ذلك، فقد تصبح المملكة الهاشمية بالفعل نموذج الإصلاح والاعتدال كما تصفها واشنطن الآن.
هذا المقال مترجم عن foreignpolicy.com ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي.
إقرأوا أيضاً:










