في آذار/ مارس 2021، استيقظ المصريون على خبر مقتل طبيبة شابة في منطقة السلام شرق القاهرة على يد صاحب العقار الذي تقيم فيه وحارس العقار واثنين من الجيران، بعدما اقتحموا منزلها بحجة وجود “صديق” في شقتها، وبعدما اعتدوا عليها بالضرب ألقوها من الطبقة السادسة لتلقى حتفها على الرصيف.
أثار الخبر صدمة في الأوساط المثقفة والنسوية، إلا أنه مر مروراً صامتاً على الأغلبية التي لم ترَ في خبر قتل سيدة تعيش بمفردها لأنها استضافت شخصاً ما في بيتها، شيئاً ينبغي الكلام عنه، فهو يدخل ضمن تلك المساحة المظلمة التي يجب التعامل مع الضحايا فيها بأقصى درجات القسوة ومن دون ضجيج، هذا الصمت أساء النشطاء فهمه فرأوا في الغضب العارم على وسائل التواصل دليلاً على تغيّر المجتمع ورفضه انتهاك الخصوصية.
في الشهر ذاته انتشر فيديو مسجل بكاميرا مراقبة منزلية مثبتة في مدخل عقار في حي المعادي الراقي، يظهر تحرش رجل يدعى محمد جودت بطفلة تبيع المناديل، وقد حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ما نال رضا المتابعين.
في زحام الاحتفاء بالانتصار الكبير على متحرشٍ بالصوت والصورة، تم التعامل مع كاميرا المراقبة باعتبارها نصيرة المرأة التي يتم انتهاك جسدها من دون أن تتمكن من إثبات الانتهاك، كما هو دارج في معظم وقائع التحرش، بل طالب البعض بزرع كاميرات في كل مداخل الأبنية السكنية، وزوايا الحدائق العامة، على اعتبار أنها أماكن مفضلة للمتحرشين.
ما الذي يربط بين الواقعتين غير أن الضحية في كليهما أنثى؟ يتحدث الخبر الأول عن اعتداءٍ على سيدة بحجة حماية “الشرف”، إذ عرَّف صاحب العقار نفسه بأنه “رجل صعيدي… لا يقبل بالمسخرة“، والصعيد هو موطن الشرف ومنبعه! ومع أن الضحية ليست ضمن ساحة “شرفه”/”حريمه”، إلا أن مجرد وجودها في عقارٍ يملكه جعلها تدخل ضمن نطاق نفوذه الأخلاقي، بحكم تملكه العقار وسلطته الأخلاقية عليه. فيما يتحدث الخبر الثاني عن انتهاك جنسي لطفلة في مدخل عمارة تم توثيقه عبر كاميرا مراقبة منزلية.
تكمن الصلة الرفيعة بين الواقعتين في تطور الرقابة على مداخل العمارات، والتي يتم تبريرها أمنياً، فـ”البواب” (الحارس الأخلاقي للعقار) الذي هرع لإبلاغ صاحب العقار بدخول رجل إلى سكن السيدة الوحيدة، تحوّلت مهمته كما يظهر في الواقعة الثانية، إلى كاميرا مراقبة منزلية تبسط سلطة مباشرة لصاحب العقار من دون وسيط بشري معرض للسهو والغفلة والانشغال، بحكم عمل معظم البوابين في مهنة أو اثنتين وربما ثلاث، وهو ما أفقد ملاك العقارات الثقة في إمكان السيطرة الكاملة على ما يدور في أملاكهم.
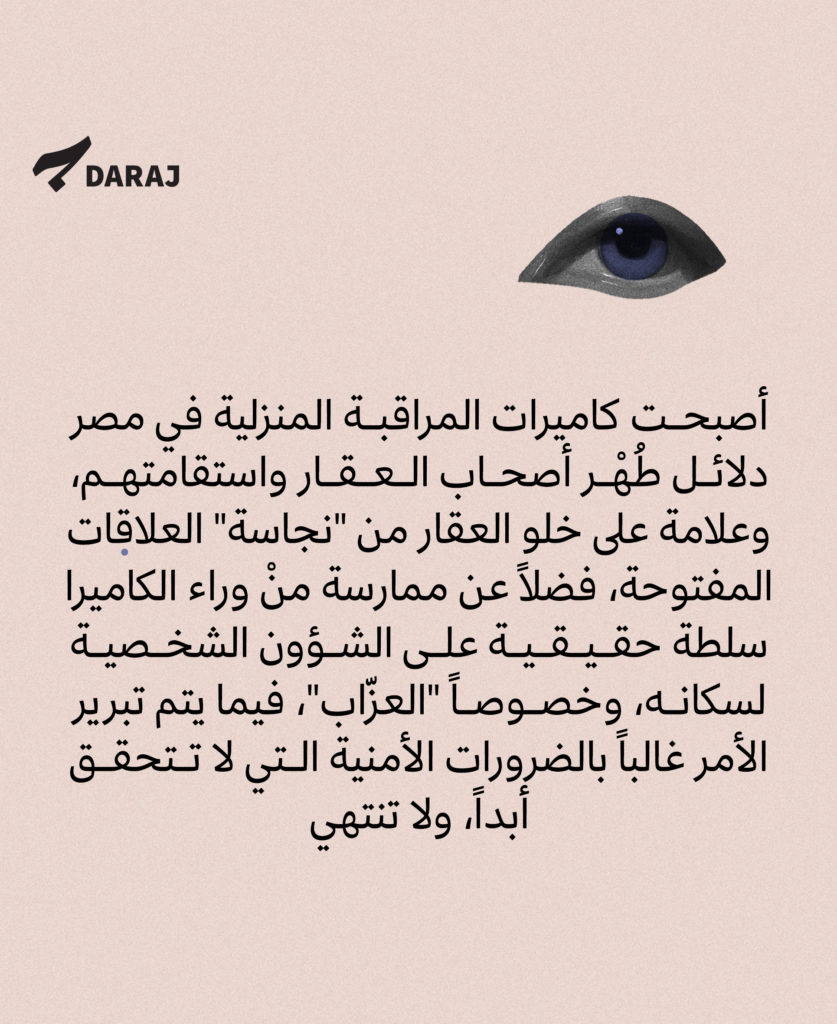
لم يعد يمر يوم من دون أن تضيق فيه مساحة الحرية الشخصية في مصر، بعدما صودرت الحرية العامة كاملةً، هذا التضييق لا يأتي بقرار، بل على شكل انتشار مرضي لـ”كاميرات المراقبة المنزلية” بعدما أصبحت زهيدة التكلفة، سهلة التركيب، كاستجابة عملية لنزوع محافظ لدى شريحة “ملاك العقارات” وهم أكثر شرائح المجتمع محافظةً على المستوى الاجتماعي والأشد ميلاً إلى الاستقرار على المستوى السياسي، وقد هالتهم حريات ما بعد الثورة في ما يخص العلاقات بين الجنسين تحديداً.
تعمل المراقبة في مصر في الاتجاه المعاكس لموجة تراجع الاحتفاء بالأسرة وتبجيلها، كأداة مثالية للانضباط العائلي تستعيد على شكل حديث، وبنوستالجيا صامتة، أخلاقيات المجتمع القروي المأهول بالمواطنين الصالحين الذين يراقبون بعضهم بعضاً.
أصبحت هذه الكاميرات دلائل طُهْر أصحاب العقار واستقامتهم، وعلامة على خلو العقار من “نجاسة” العلاقات المفتوحة، وبالتالي الانسجام مع خيال الطبقة الوسطى، فضلاً عن ممارسة منْ وراء الكاميرا سلطة حقيقية على الشؤون الشخصية لسكانه، وخصوصاً “العزّاب” ومحو كل تطلعاتهم في الاستقلال والسيطرة على حقائق واقعهم الشخصي جداً، فيما يتم تبرير الأمر غالباً بالضرورات الأمنية التي لا تتحقق أبداً، ولا تنتهي.
ما يثير الدهشة أن المراقبة لم تعد تثير اعتراضاً، حتى لدى أنصار الاستقلال الشخصي، على رغم أنها تشمل جانباً ظاهراً للغاية للتعدي على النطاق الخاص، أو النطاق الذي اختصره صامويل وارين ولويس برانديز بـ”الحق في أن تُترك وشأنك”، في مقالهما الشهير عن “الخصوصية“.
بالعودة الى حادثة منطقة الهرم يقول محمد رأفت اليماني، رئيس اتحاد ملاك عمارة سكنية بمنطقة الهرم بالجيزة لـ”درج”: “أنا وضعت ٦ كاميرات مراقبة في مداخل العمارة، وفي الحقيقة لم يعترض أحد من السكان، بل بالعكس دفعوا ثمنها، وأودعوا وحدة التخزين عندي، وبيلجأوا للتسجيلات لو حصل أي شيء”.
شادي محسن طالب في كلية الآداب يقول لـ”درج”: “كل ما أدخل عمارة أحس بالاختناق من الكاميرا اللي في مدخلها، أو الرغبة في تكسيرها بالأصح، حتى كاميرات الشارع بتضايقني، هما بيحطوا كاميرات في بير السلم وعلى بسطات السلالم. دايماً بفكر إنه غرضهم منع البوس في العمارة، أكتر منه غرض أمني، لأنه فيه بوابين وأحياناً أفراد أمن، وبفكر قد إيه البلد دا تعيس بحداثته”.
لحظة من التفكير ستكشف بعضاً من مفارقات المراقبة، فلها من دون شك جوانب إيجابية مثل تضييق نطاق الجريمة، وتوثيق وقائع التحرش، لكن هل المكاسب التي نجنيها من تكنولوجيا المراقبة توازي الثمن الذي ندفعه من فقدان الخصوصية والاستقلال ومن الخضوع لأبوية أصحاب العقار وتطفلهم غير المرغوب فيه؟
إقرأوا أيضاً:
حارس عقار متيقظ للأمن وعين مراقبة إلكترونية للأخلاق
المراقبة الإلكترونية إذاً قضية تتداخل فيها أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية تفرض جميعها تحديات جمّة على الخصوصية الشخصية، وأضرارها من هذه الناحية أكثر فداحة من وجود حارس العقار المتيقظ، على رغم الإحساس بالانزعاج في الحالتين، إذ على المرء تعديل سلوكه بناءً على أنه مرئي، وهو ما يفرض عليه التحلي بالحذر والتكيّف، إلا أنه في حالة الكاميرا هناك أخطار تتعلق بالمواد التي يتم تسجيلها وإعادة نسخها وإمكانية نشرها على الإنترنت أو المساومة بشأنها.
وبالتالي يؤدي الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا، الرخيصة وغير المنضبطة، إلى تغيير طبيعة بيئة السكن نفسها، وطبيعة ما نفعله وكيف نفعله، وهو ما يُضعِّف استقلالنا النفسي، فـ”مجرد معرفة المرء بأن أفعاله مراقبة وأن هناك جهازاً يظهر للعيان يراقب ويسجل سلوكه، يتعرض اتزانه للاضطراب، ويضعه في حالة من عدم الراحة”، كما يقول ريموند واكس في كتابه “الخصوصية“.
“القانون في العسل”
المراقبة الإلكترونية أفادت الطفلة التي تم التحرش بها في مدخل عمارة المعادي، إلا أن مستقبل عمليات المراقبة اليومية يبدو مخيفاً، إذ يعد الانزلاق غير المنضبط نحو تكثيف تكنولوجيا المراقبة، خارج الأماكن العامة في ما يشمل المطارات ومراكز التسوق، وخارج نطاق القانون، بمزيد من قلقلة حياتنا الخاصة التي توضع تحت رحمة ذلك المتطفل الجالس خلف الشاشة الموصلة بالكاميرا، فتتآكل حريتنا فيما يقنعنا بأنه يحاول حمايتنا.
تبدو عملية الإشراف السلطوي على الحياة اليومية للمصريين نشِطة، فإضافة إلى تباهي أصحاب العقارات بالكاميرات المثبتة في المداخل تشجع الدولة نفسها على التوسع في ذلك النشاط العزيز على قلبها، يشهد على ذلك توسع “بيزنس” تكنولوجيا المراقبة ،ومحلات الكاميرات التي انتشرت فجأة وخصوصاً hikvision الصينية، وتشير أسعارها المخفضة إلى تسهيلات كبرى قُدّمت لها لتغزو الأسواق.
في هذا الصدد يقول رأفت اليماني، رئيس اتحاد ملاك عقار بالهرم: “الكاميرات دي مش مرخصة قانونياً،يعني أنت مش محتاج رخصة ليها حتى لو بتسجل صوت وصورة، ومرة جاء لي أمين شرطة وطلب مني أوجه أصحاب المحلات أسفل العقار لتركيب كاميرات وشكرني على الكاميرات اللي مركبها “.
في الدنمارك يمُنع استخدام كاميرات المراقبة بدون إبلاغ الذين يتعرضون لها بأنهم مراقبون عبر لافتات واضحة، وفي السويد يتعين على الشرطة نفسها الحصول على إذن قضائي من أجل استخدام كاميرات المراقبة، فيما تتبنى فرنسا وهولندا نظاماً صارماً لترخيص كاميرات المراقبة ويشترط أيضاً وضع علامة تحذير في المحيط الخارجي للمنطقة التي تراقب، ويشتمل القانون الألماني على شرط مماثل، لكن في مصر تبقى المسألة برمتها خارج نطاق القانون.
ولا ضمانة بأن التكاليف الاجتماعية لكاميرات المراقبة مساوية على الأقل للمهمات الأمنية المتوقعة من تركيبها، فالمجرمون يفعلون واحداً من اثنين حين يتعلق الأمر بكاميرا في عقار سكني: التخفي عبر قناع أو توجيه الوجه للأسفل مع ارتداء “كاب” وبالتالي تصبح الكاميرا بلا قيمة، أو الذهاب إلى عقار آخر بلا كاميرا، وبالتالي زحزحة الجريمة. وقد يفيد ذلك ملاك العقار، إلا أنه لا يقلل من معدلات الجريمة أو الخسائر على المستوى المجتمعي ككل.
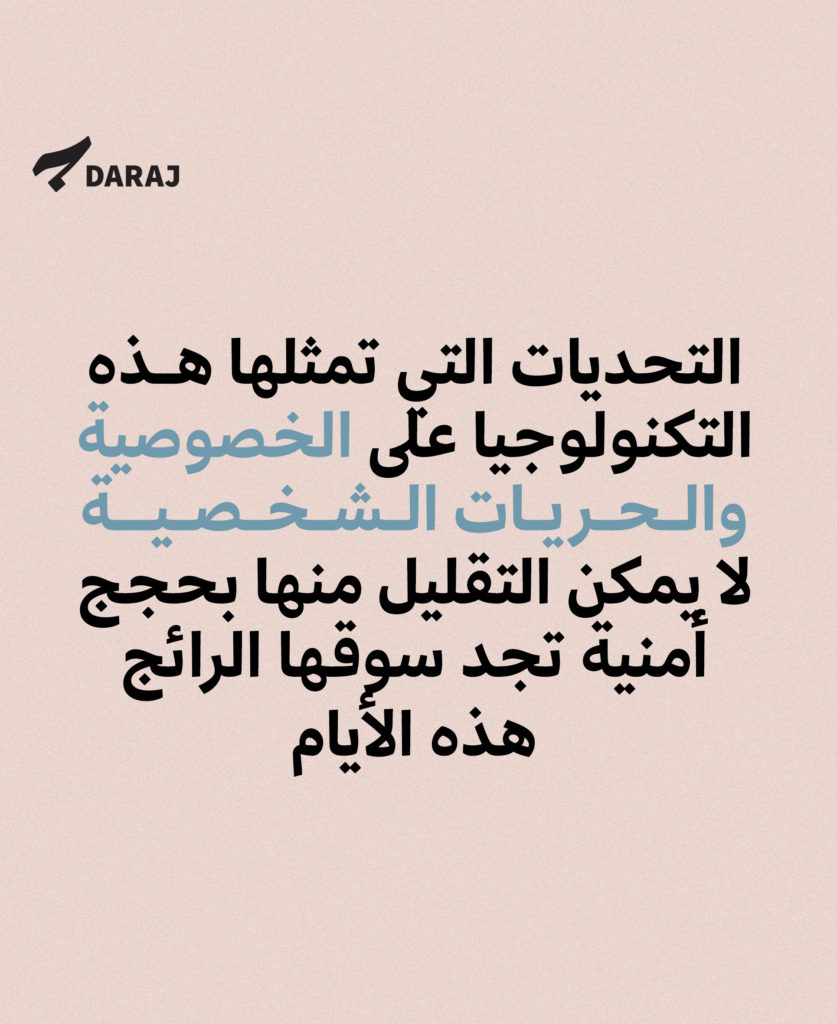
أمين حمزاوي مترجم وكاتب مهتم بالآثار الاجتماعية للتكنولوجيا يقول لـ”درج”: “الرأسمالية المعاصرة تشهد طفرة في وظائف الأمن والمراقبة، ولهذا علاقة بتوزيع الثروة التي تحتكرها شريحة صغيرة جداً محصنة في مدن، وكأن البرجوازية رجعت تتحصن في المدن التي تجاوزتها بداية من عصر النهضة”.
الآثار الاجتماعية لانتشار كاميرات المراقبة المنزلية، تتزايد بحيث تحاصر الحريات الشخصية كأداة ضبط اجتماعي. وكأن كاميرات المراقبة تطبق قاعدة: “أنت لن تُترك وشأنك” العزيزة على قلب مصريين كثر، بحيث باتت تتعدى الذين تتم مراقبتهم إلى المراقبين أنفسهم.
فبحسب حمزاوي: “جزء كبير من الوظائف الخالية في مصر هي لأفراد أمن، يشغلها خريجو جامعات برواتب منخفضة، هذا يؤدي إلى الإفقار النفسي. تخيل أن يكون نشاطك اليومي هو أن تفتح البوابة وتغلقها في مدخل كمباوند وتتفحص بطاقات الهوية. هذا إفقار مادي ومعنوي شامل. والأسوأ أن تجلس أمام شاشة مراقبة لترى الداخل والخارج، وأنت محروم من أي تواصل إنساني معهم على مدار اليوم،حتى البوابون تربطهم صلات إنسانية ما جيدة أو سيئة برواد المكان أبسطها إلقاء السلام”.
التحديات التي تمثلها هذه التكنولوجيا على الخصوصية والحريات الشخصية لا يمكن التقليل منها بحجج أمنية تجد سوقها الرائج هذه الأيام، خصوصاً مع إجراءات التقشف القاسية التي فرضتها السلطة، وباتت آثارها ظاهرة للعيان في ما يتمثل في معدلات قياسية للجريمة، فالآثار المترتبة عليها أكبر من مجرد أثر جانبي عارض، بقدر ما يشير إلى تحولات لا إنسانية في حياتنا نفسها.
الاهتمام بالخصوصية ليس رفاهية، فمن طريقه تتشكل العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبالتالي بين الخاص والعام، وهي مساحة ما زالت غائمة في بلد يشق طريقه لأن يصبح مجتمعاً، ويتجاوز كونه جماعة ذات تقاليد راسخة من الرقابة الحميمية من الجميع على الجميع، ولا يظهر فيه تقسيم واضح بين العام والخاص إلا على سبيل هوامش حضرية محدودة في المدن، لا تزال تكافح مُجهدةً الهجمة الفيكتورية عليها.
هذا الطابع الضبابي بين الخاص الذي تجب حمايته والعام الذي يجب تأمينه، لا ينبغي حسمه بمصلحة إلغاء الخصوصية، بل تعزيزها بترسانة قانونية، ورأي عام قادر على أن يوازن بين المصالح والحريات، كي نحمي المساحة التي نحتاجها كي نحافظ على استقلالنا الشخصي، وكي نبدو على راحتنا من دون أقنعة أخلاق زائفة، لا تنفع سوى في إقلاق راحتنا وتكبيلنا… أكثر بعد.
إقرأوا أيضاً:










