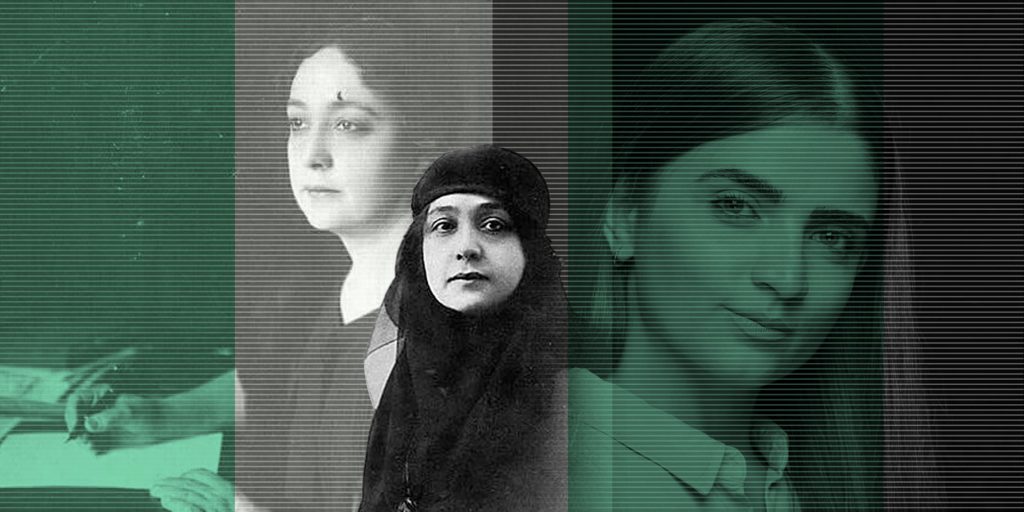أشاد محافظون بقدرة سيدة محجبة على الوصول إلى القمة، وتوصلوا لاستنتاج سريع مفاده أن الحجاب لا يعيق المرأة في شيء، وبالتالي لا ضرورة لتقليد المسلمات المرأة الغربية بحجة الانطلاق وتحقيق الذات.
في المقابل تلخصت الردود الليبرالية بأن الفضل في حضور البنات في المجال العام ووصولهن إلى أعلى المراتب في مجالهن يعد نقيضاً كاملاً لإيديولوجيا التحجُّب، وأن الفضل كله يرجع إلى الحركات النسوية ذات الطابع العلماني التي طالما ناصبها المحافظون العداء.
تعالي معي إلى “الكوافير”
يشير الجدل المتصاعد والذي شمل معظم المهتمين بالألعاب الأولمبية وبالنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية عموماً، إلى أن مسألة الحجاب ما زالت تمثل ساحة كبرى للصراع بين قوى المجتمع الحية، وتثير انفعالات قوية لدى جميع الأطراف، كجزء لا يتجزأ من إشكاليات الحياة الاجتماعية المصرية.
الأمر الغريب الذي يتم التطبيع معه في كل ذلك، هو أن المؤيدين والمعارضين رجال، فيما يغيب صوت النساء تقريباً في أمرٍ يخصهن، ما عدا أصوات نسوية نادت بأن ليس لأحد أن يفرض تصوراته عن الصواب والخطأ على جسد المرأة، وأن للنساء الحق في ارتداء الحجاب أو خلعه، ويعد هذا الاتزان جديداً على الحركة النسوية المصرية وتطوراً لافتاً في مسيرتها.
كان رد الفعل النسوي تاريخياً، وهي نسوية نخبوية، على الانتشار الكثيف للحجاب، اختزالياً ومؤدلجاً بالكامل وذات صبغة علمانية سلطوية، بل ويكشف عن مشاعر حيرة وقلة تفهّم إزاء هذا المظهر الغريب وغير المألوف لديهن، بل وكان هناك بعض الاستعلاء الطبقي في تفسير لجوء النساء للحجاب
وتضمن الخطاب النسوي أحياناً تعبيرات استشراقية تماماً ضد المحجبات، إذ تمت الإشارة إلى حجابهن كغطاء لممارسة “الأمور المخزية” وهي إعادة تدوير محلي لاتهام استعماري سابق للنسوة المسلمات بأنهن يختلفن عن الأوروبيات بأنهن يفعلن كل “المخازي” من خلف قناع.
وتوحي ردود الفعل المتطرفة هذه بغضب نسوي من اللاتي خذلنهن في معركة التحرّر وسارعن إلى الخضوع للمعايير الذكورية بأنفسهن، ولطالما وُصف الحجاب كرمز لخضوع المرأة وتبعيتها، عبر العودة إلى صورة للإسلام تنتمي إلى العصور الوسطى، لكن هذه الردود توحي أيضاً بانعدام عميق للرأفة بالنساء اللاتي لم تتوفر لهن مستويات معيشية مرتفعة تحميهن من كمّاشة انتهاكات الشارع، حيث معدلات التحرش العالية، وإكراهات المنزل.
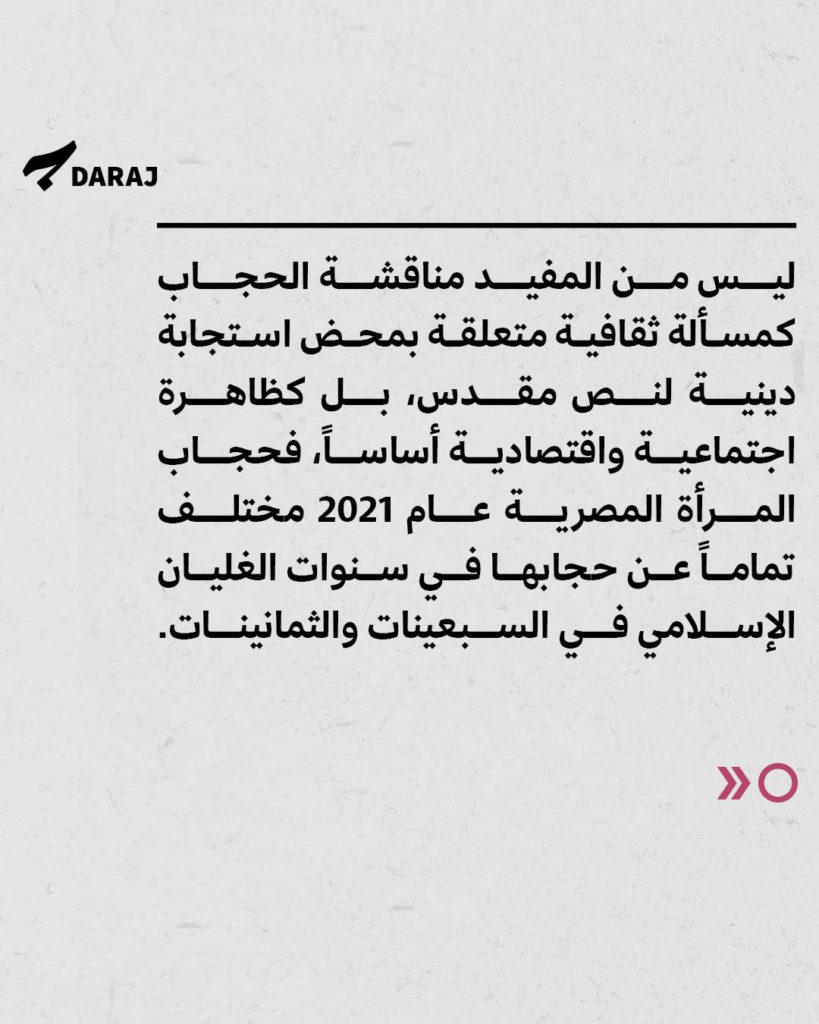
شَرَك الخيارات الصعبة
حين يعيش الناس في بيئات مثل المدن يكون عليهم الامتثال النسبي لمعايير النوع الاجتماعي، وطرائق الاتصال مع الجنس الآخر، وسُبل التعامل مع الإيماءات الرمزية، وهي معايير تفرضها الأسرة والمدرسة والشارع وأماكن العمل والطبقة، وأخيراً الدولة، وتقع نساء الطبقة الوسطى في قلب هذه الديناميكية الاجتماعية.
الأخذ بظاهر هذه العملية الاجتماعية يفضي إلى استنتاجات متسرعة بأن نساء تلك الطبقة ضحايا لبيئة ثقافية قهرية تفرض عليهن قيوداً مشددة في ما يتعلق باعتبارات الحشمة والسلوك القويم وبقية الأفكار المثالية الدينية.
لكن التعامل مع النساء كرهائن عالقات في تشابكات علاقات القوة هذه ليس دقيقاً دائماً، ويؤدي في الغالب إلى تعميمات خطابية لا تستند إلى حقائق الواقع الاجتماعي، فهن وإن كنّ يساهمن في إعادة إنتاج تلك المعايير بمسايرتها فإنهن يعملن على تغييرها وتحطيمها وتفريغها من مضمونها، من دون ضجيجٍ في الغالب.
النظر إلى المرأة باعتبارها فاعلاً ليس استبصاراً جديداً، لكنه ضروري في ظل مصادرة فاعليتها في التحليلات التي تؤطرها في إطار المستجيب السلبي، فهي تحجّبت بفعل الحركة الإسلامية، وخلعت الحجاب بعد الانكشاف السياسي والفكري للإسلاميين عقب ثورة 25 يناير، هذه تحليلات تركّز على العوامل الخارجية وتتجاهل فعالية النساء على اعتبار أنهن خارج علاقات القوة في الهياكل الاجتماعية وهو أمر خاطئ كلياً.
في المقابل، تشير التجربة الفعلية المُلَاحظة لنساء الطبقة الوسطى إلى قدرتهن على التحايل والتفاوض وتوسيع مجال خياراتهن وزيادة فرصهن عبر امتلاك أدوات قوة: التعليم، العمل، العلاقات، الخطاب والتعبير عن أنفسهن، حتى داخل القيود الخانقة التي تفرضها الثقافة المهيمنة، وفي القلب من هذه الاستجابة تقع استراتيجية التكيُّف.
ويمكن تأطير الحجاب ضمن هذه الاستراتيجية التي لجأت إليها نساء الطبقة الوسطى في ظل ضغط الخطاب الأخلاقي (الأسري تحديداً)، بعدما تحولت خطابات الصحوة الإسلامية، قبل تفكّكها، إلى بُعدٍ أساسي للحياة اليومية، وفي ظل الانتهاكات التي تتعرض لها نساء تلك الطبقة، والتي تتمثل في استباحة جسد غير المحجبات من جهة، وبين متطلبات الحياة العصرية.
إقرأوا أيضاً:
والعلاقة بالأسرة بالنسبة إلى المرأة في مصر تعد أساساً تبني عليه العلاقات كافة، فالأسرة توفر للمرأة المكانة ومقومات تشكيل الشخصية وتمثل ملاذاً لها في نهاية المطاف، وقد اختبرت الفتيات المستقلات ذلك مع بداية جائحة “كورونا” حين فقدن مصادر دخلهن وعدن إلى الأسرة، والنساء المتزوجات أيضاً يختبرن ذلك الموقف مع أول بادرة خلاف مع أزواجهن، فمهما بلغت النزعات الفردية لدى الجيل الأحدث سناً، فإن الواقع يفرض شروطه على أي اعتبارات أيديولوجية، فمع العيش في “مجتمع المخاطر” حيث العلاقات عابرة وسريعة وهشة، والعمل غير مستقر ولا ثابت، تصبح الأسرة شبكة موارد ثابتة ومسألة لا يمكن الاستغناء عنها.
لذا فالجانب الاجتماعي للحجاب، أكثر أهمية من الجانب الفردي بما لا يقارن، وهو مرتبط بالأسرة بالذات، حيث المعايير الأخلاقية تتجاوز التدين إلى السمعة والأخلاق والمظهر العام، وفي مجتمع يعتبر جسد المرأة “مكمن الأخلاق” يتضح مدى محورية هذا الزي في بنية الحياة الأسرية.
ولاعبات مصر في الأولمبياد (فريال أشرف، جيانا فاروق، هداية ملاك) كثيراً ما عانت أسرهن من أجل تمكينهن في مجالهن الذي يحتاج استثماراً طويل المدى وغير مضمون النتائج، وحشدت مواردها لإيمانها ببناتها اللاتي تشبثن بآمالٍ تتطلب تضحية وعملاً شاقاً، وبالتالي ليس من الصعب على هؤلاء الفتيات إرضاء أسرهن بـ”إيشارب” بسيط فوق الشعر، وهي متطلبات أولية لأغلب أسر الطبقة الوسطى المصرية.
في دراستها “الاحتجاج الهادئ… المرأة العاملة والتحجب الجديد والتغير في القاهرة“- 1988، عن العاملات في الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى القاهرية، توصلت الباحثة أرلين علوي ماكليود، إلى أن حاجة النساء إلى العمل (لأسباب اقتصادية تحديداً) ألقت بالمرأة المصرية في معضلة، إذ سمح الحجاب للمرأة باكتساب شرعية الخروج إلى الشارع والعمل، وسمح لها بالمطالبة بالاحترام التقليدي.
أعدت ماكليود دراستها في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 1983 وتموز/ يوليو 1988، وبحثت بنهج أنثربولوجي حالة 58 امرأة عاملة، وكانت حجتها أن نساء تلك الشريحة بحاجة للعمل لأسباب اقتصادية لكن إيديولوجيا النوع (رجل- امرأة) تعارض عمل النساء، وهذا يضع المرأة في معضلة تتجلى في التحجُّب لكن الحجاب في الوقت نفسه حل للمعضلة.
وبالنسبة إلى طرح ماكليود، فقد فرض كلٌ من العمل والزواج على المرأة دورين مختلفين، وهي تحاول الموازنة بينهما من دون أمل يُذكر في النجاح، حيث تواجه المرأة أزمة الهوية الثقافية (كامرأة مسلمة) وكذلك الشخصية الناجمة عن الخبرة الجديدة بالعمل خارج المنزل التي أدت إلى تآكل هويتها التقليدية من دون أن تمدها ببديل معقول، وقد خفف الحجاب من التوترات الناجمة عن هذا التعارض.
في معرض ردها على طرح ماكيلود، تشير الباحثة المصرية فدوى الجندي في كتابها “الحجاب بين الحشمة والخصوصية والمقاومة” إلى أن الضغوط الآتية من عمل النساء في وظيفتين (البيت والعمل العام) ليست أمراً فريداً تختص به نساء الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى في القاهرة، بل كان مركزاً للنقاش في الولايات المتحدة الأميركية، فلم تلجأ النساء العاملات إلى التحجب لحل الصراع، بل بدأن فرض المساواة في العمل المنزلي على الرجال.
وربما يُفهم من طرح فدوى الجندي أن هناك ضعفاً في الحركة النسوية المصرية التي لم تتمكن من خوض معركة مع الرجال لإجبارهم على المشاركة في العمل المنزلي، لكن الأمر لا يتعلق بممارسات إيديولوجية مُنظمة وحسب، بل بالاقتصاد السياسي في بلدين مختلفين، بلد رأسمالي مركزي وآخر تابع ونامٍ.
فالفروق بين القدرات الاقتصادية حاسمة هنا، فقد حُلّْت مسألة العمل المنزلي بالنسبة إلى الأميركيات عبر العمالة الرخيصة من العالم الثالث، وهو أمر غير متوفر على الإطلاق بالنسبة إلى مصر، لذا لم يكن هناك عوار منهجي في دراسة ماكليود كما تزعم الجندي، خصوصاً في حدود دراستها.
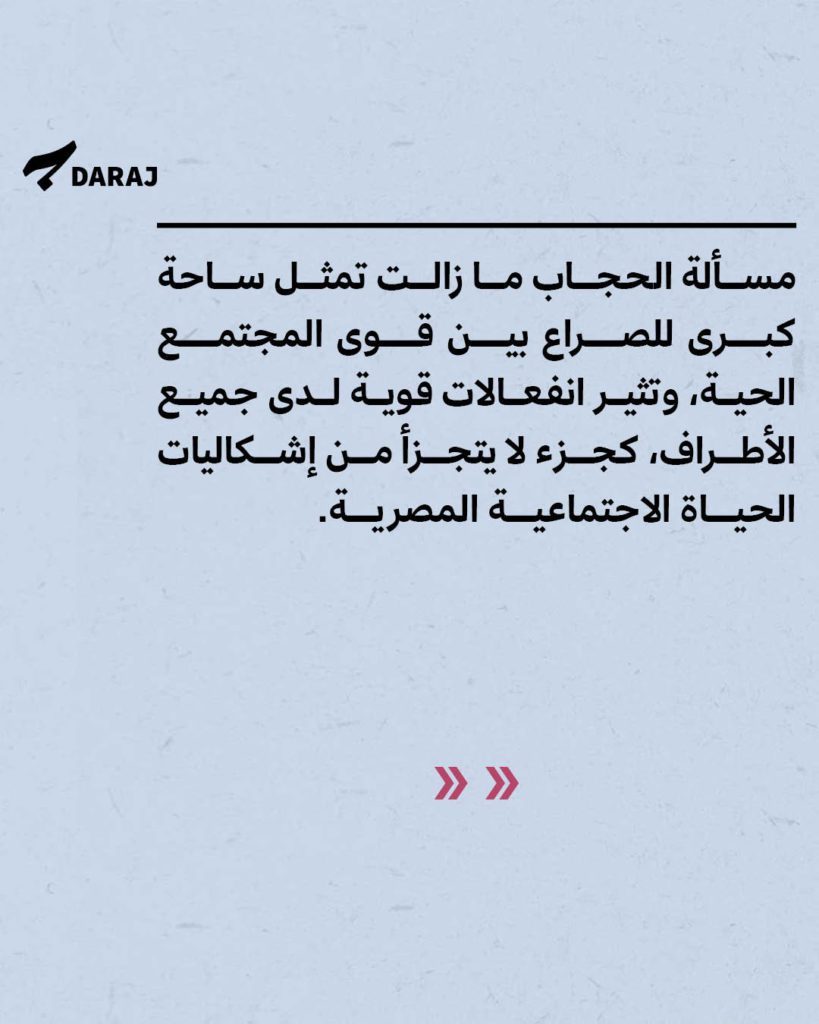
“الضحك على الذقون”
بالوصول إلى هنا سنتأكد أنه ليس من المفيد مناقشة الحجاب كمسألة ثقافية متعلقة بمحض استجابة دينية لنص مقدس، بل كظاهرة اجتماعية واقتصادية أساساً، فحجاب المرأة المصرية عام 2021 مختلف تماماً عن حجابها في سنوات الغليان الإسلامي في السبعينات والثمانينات.
فحين كان الحجاب رمزاً للصحوة الإسلامية وعلامة على الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية والتوجه السياسي، كان جزءاً من مصفوفة أيديولوجية كاملة شملت تحريم الاختلاط والدعوة إلى العفة وبقاء المرأة في المنزل، وكان حجاباً صارماً يغطي المرأة من رأسها حتى قدميها، ويتميز بألوان بعينها متقشفة وقاتمة ومنزوعة الجمال، كل ذلك كان يدور في فلك الطبقة الوسطى فما أسفل.
آنذاك كانت سيدات الطبقة العليا يرتدين زيّاً غربياً بالكامل (إيطاليا وفرنسا كانتا منتهى ذائقة المصريات حينئذٍ)، والطبقة الوسطى تأرجحت، كعادتها، بين المتطلبات الأخلاقية لحساسيتها الدينية الطارئة والمتعففة وبين الولع بتقليد الطبقة الأعلى في الملابس تحديداً، والملابس مؤشر مركزي على الوضع الطبقي ورأس المال الثقافي، فكان لا بد من حل تفاوضي.
من هنا بدأت مسيرة التعديل التي لم تنتهِ، هناك وضع معيشي يرتفع بالتدريج، بفضل سفر الرجال إلى الخليج، وقدرات شرائية تتكدس، ونزوع استهلاكي ينمو بفعل تغلغل وسائل الإعلام في البيوت، وخطاب عفة يخفت تحت ضغط المشكلات المجتمعية،فبدأت النساء التخفّف من سُمْك القماش وحجمه.
وتدريجاً وبشكل غير معلن، تقلص الحجاب الطويل الذي يغطي النصف الأعلى من المرأة كاملاً إلى “إيشارب” مُثبّت بـ”دبابيس” على الرأس يغطي الشعر بالكاد، والألوان: البيج الكئيب والأسود الوقور والرمادي الغامق تراجعت لمصلحة ألوان زاهية كالبنفسجي والزهري، فيما بقية قطع الملابس عصرية تماماً.
وبعد مظهر التنسُّك الفريد الذي أطلت به المحجبات بملابسهن الفضفاضة المتقشفة في الثمانينات الراكدة، أصبحت ملابس المحجبات أكثر أناقة، وأكثر تحرراً من المعايير الأخلاقية لمصلحةالمعايير الجمالية، صارت ضيقة وملتصقة بالقوام، وبدلاً من أن يكون الحجاب شارةً لصحوةٍ إسلاميةٍ منصورة ومُجلْجِلة صار إطاراً جمالياً لوجه مُخضّب بالمكياج وعيون مكحّلة يؤطرها “الآيلاينر”.
أحس الإسلاميون بالخداع، فبعد عقود من الدعاية المكثفة والتحريضية التي حاصرت النساء في المترو والميكروباصات والشارع والمدرسة صارخة بـ”الحجاب قبل الحساب” وبـ”بوسترات” تدعو إلى الذعر من مشاهد النيران المطبوعة على حوافها، أسفر كل ذلك عن غطاء هزيل للرأس.
ولم يعد من المجدي شن حملات مماثلة، فنظرياً النساء محجبات وبالتالي فقدت الدعوة إلى تحجيبهن شرعيتها، وموضوعها أيضاً. وجد الأخلاقيون العتاة أنفسهم في حالة مضنية من التفاوض والمساومة العبثية مع النساء حول مشروعية “الإيشارب” كبديل عن “الخمار”. لقد راوغت النساء تيار الحشمة مراوغة ملحمية.
إقرأوا أيضاً: