في نقاش مع أصدقاء من جنسيات أفريقية وعربية حول الديموقراطية، أجمع أغلبهم على تفضيل الدكتاتورية المقرونة بالتنمية على الخطاب الديموقراطي الذي يأخذ بلدانهم إلى المزيد من التخلف والحروب الأهلية والعرقية.
سماعي هذا الكلام من شباب أنهكتهم الأزمات السياسية والفساد والفقر، جعلني ألمس كيف نجح من يروجون فكرة الاستقرار في ظل الاستبداد في زرعها في عقول الملايين من الشباب العربي والأفريقي، وتخويفهم من الديموقراطية، لدرجة أنهم أصبحوا يفضلون الاستبداد والقمع على أن يعيشوا بحرية وكرامة، لأن الديموقراطية في نظرهم “لا تطعم خبزاً” ولا تخلق لهم فرص عمل ولا بنية تحتية تسهل حياتهم.
حاولت أن أدافع عن وجهة نظري، لأن التنمية من دون حقوق إنسان وعدالة وحرية وكرامة لن تكون سوى سلّم يتسلقه المستبدون نحو مزيد من الاستبداد والفساد، وستؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة، وقلت إن أسمى ما يتوق إليه الإنسان هو أن يعيش بكرامة وحرية.
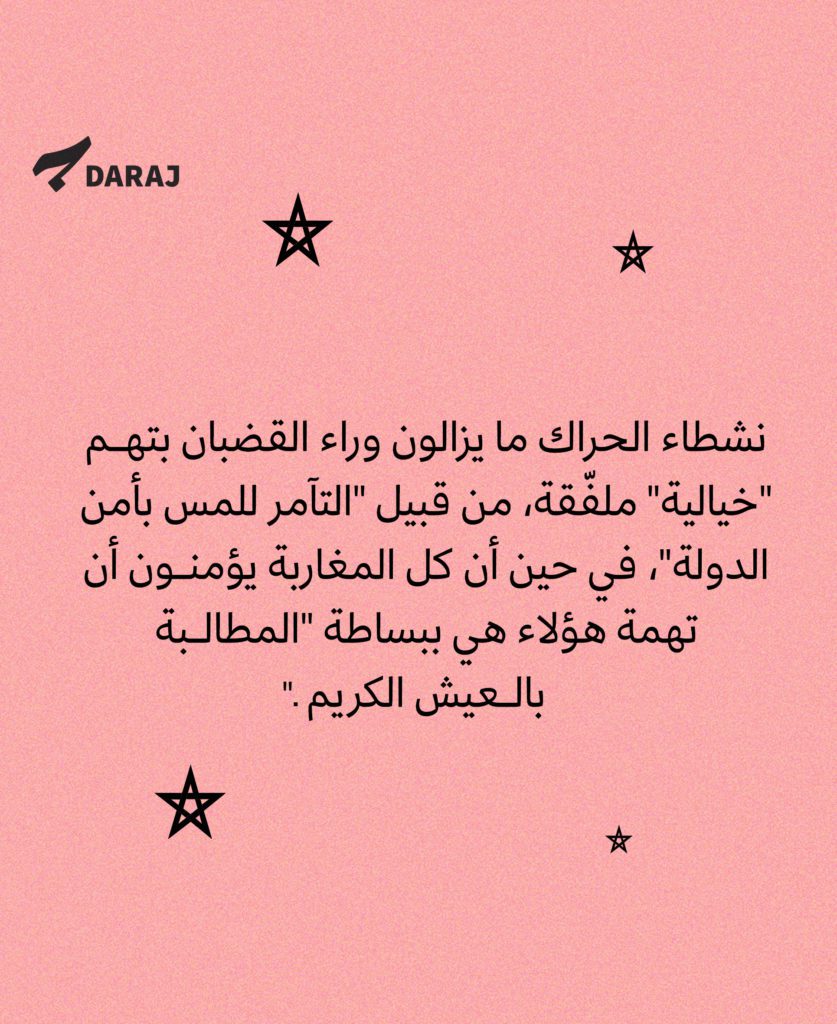
وفي خضم نقاشنا ضرب أحدهم المغرب مثلاً، وقال إنه متقدم على رغم من أنه بلد غير ديموقراطي، فأجبت أنه إذا قارناه ببعض الدول الأفريقية والعربية الغارقة في الحروب الاهلية والازمات السياسية والطائفية يمكن القول إنه متقدم نسبيا في عدد من المجالات، ويمكننا أن نتقدم أكثر لو أن لدى حكّامنا الإرادة السياسية ويغلّبون المصلحة العامة ومحاربة الفساد على مصالحهم الخاصة، ويسعون إلى أن نصبح دولة ديموقراطية تحترم حقوق الأفراد وحرياتهم وكرامتهم.
رويت لهم كيف أن سكان منطقة الريف في شمال المغرب خرجوا للمطالبة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبيل التعليم والشغل والصحة في احتجاجات سلمية، فقابلت الدولة هذه المطالب باعتقال الشباب والحكم على بعضهم بالسجن لعشرين سنة، وضربت القوى الأمنية شيوخ المنطقة ونساءها وشرّدوا الكثير من أسرها، ودفعوا بخيرة أبنائها إلى المقامرة بحياتهم في قوارب الموت طلباً للهجرة.
وعلى رغم أن الملك اعترف بفشل النموذج التنموي في تلك المنطقة وغيرها من بقاع المملكة وأقال عدداً من الوزراء والمسؤولين بسبب تأخر تنفيذ المشاريع التي كانت موجهة لمنطقة الريف، إلا أن نشطاء الحراك ما يزالون وراء القضبان بتهم “خيالية” ملفّقة، من قبيل “التآمر للمس بأمن الدولة”، في حين أن المغاربة كلهم يؤمنون بأن تهمة هؤلاء هي ببساطة “المطالبة بالعيش الكريم”.
ليس هذا فقط فحتى الصحافيون الذين نقلوا الحقيقة بمهنية واستقلالية وكشفوا الانتهاكات الحقوقية التي عاشتها المنطقة خلال فض المسيرات واعتقال المحتجين والعنف الممارس ضدهم، وبينوا للعالم بشاعة النظام البوليسي الذي يحكمنا والذي يضيق صدره بالأصوات المعارضة المستقلة، وجدوا أنفسهم في السجن بتهم جنسية، لتشويه سمعتهم لدى الرأي العام والقضاء على مستقبلهم، فضلاً عن حصار الصحافة المستقلة وتخويف الصحافيين والفاعلين الحقوقيين من خلال التشهير والتجسس عليهم.
وبينما كان الفضاء الإلكتروني قبل سنوات عصياً على الترويض ومن خلاله انطلقت شرارة الربيع العربي، نجح النظام في بسط سيطرته عليه من خلال اعتقال النشطاء والمدونين وإطلاق أحكام شديدة جداً بحقهم.
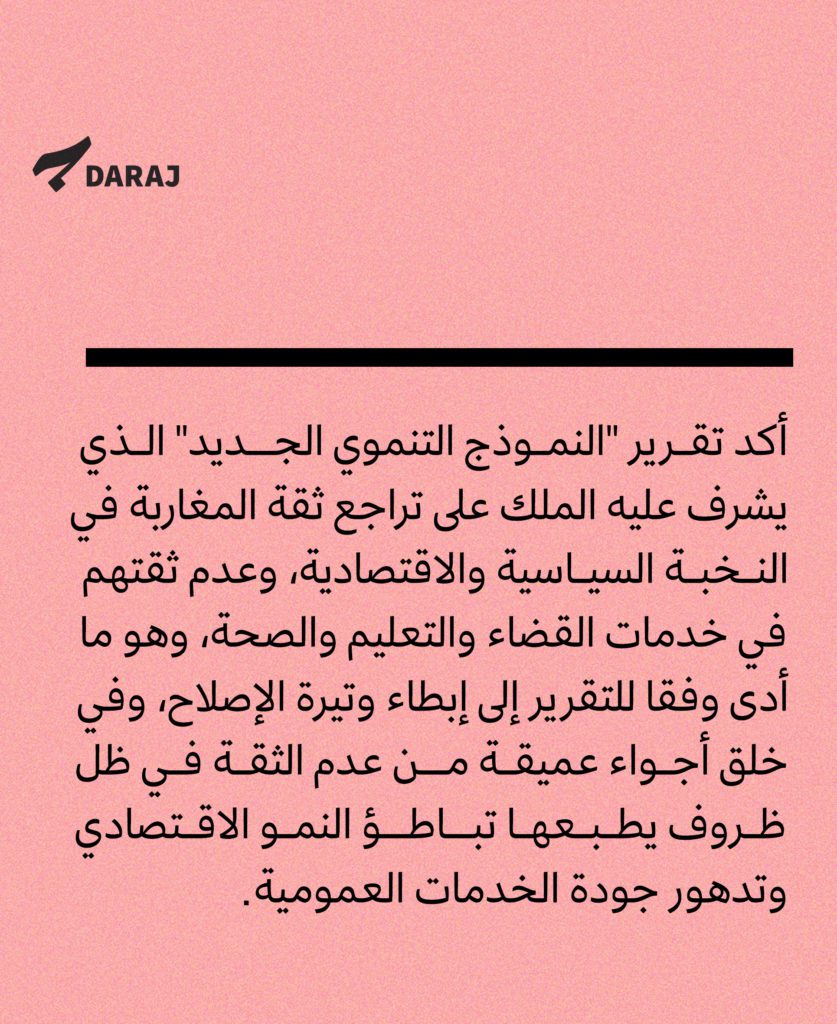
أدى هذا الاحتقان، ومعه التضييق على الفضاء العام وقتل الصحافة المستقلة فضلاً عن تراجع النخب السياسية والثقافية والنقابية وتراجع مؤسسات الوساطة وتقوية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى تراجع ثقة المغاربة في المؤسسات الرسمية والعمل السياسي وتنامي الاحتقان الاجتماعي، وهذا يظهر بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الوقفات الاحتجاجية التي تقابل غالباً بالقمع والعنف.
هذا الواقع لا ترصده المنظمات الحقوقية داخل المغرب أو خارجه وحسب، بل رصده تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يشرف عليه الملك بنفسه، إذ أكد التقرير تراجع ثقة المغاربة في النخبة السياسية والاقتصادية، وعدم ثقتهم في خدمات القضاء والتعليم والصحة، وهو ما أدى وفقاً للتقرير إلى إبطاء وتيرة الإصلاح، وخلق أجواء عميقة من عدم الثقة في ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية.
استغرب أصدقائي من كل هذا، وأخبروني أن ما يصلهم عن المغرب هي تلك الصورة الوردية، عن دولة استطاعت أن تكون استثناءً في منطقة موبوءة واستجابت لمطالب الشارع وسمحت للإسلاميين بأن يشاركوا في الحكم ويقودوا الحكومة لقرابة 10 سنوات.
أخبرتهم أن هذا صحيح لكنكم تنظرون من الزاوية التي يسوقها المغرب عن نفسه للخارج، وحسب، لكن الحقيقة أن الإسلاميين قادوا الحكومة لكن لا يحكمون، وأن الملك استجاب بشكل سريع لنبض الشارع سنة 2011 لكن سرعان ما تم الانقلاب على هذه المكتسبات(على قلّتها)، وعاد “المخزن “(النخبة الحاكمة المتصلة بالملك) للحكم بمساحة أكبر مما كانت عليه قبل الربيع العربي مستغلاً الوضع الإقليمي المضطرب، حيث استطاع التحكم في المؤسسات الانتخابية وشراء الذمم وإضعاف مؤسسات الوساطة واستمالة المثقفين إلى صفه من خلال الامتيازات والمناصب، وتقوية الأجهزة الأمنية والمخابرات واعتقال كل الأصوات المزعجة ومحاصرة العمل الحقوقي ومنع التجمعات والتظاهر.
ما الحل إذاً؟ يسألني أحدهم.
نظرياً، الحل هو في الديموقراطية والإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، ونظام يقوم على عقد اجتماعي يدعم العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية ويحارب الفساد والريع، ويحترم الحقوق والحريات ويحميها، فضلاً عن إعلاء قيم الشفافية والعدل والمساواة وسيادة القانون. وإلا، الاستبداد في المقابل.
لو كنتم مكاني، ماذا تختارون؟
إقرأوا أيضاً:








