“المجاهدون الحقيقيون همه اللي في أفغانستان أما الفلسطينيين واللبنانيين اللي بيموتوا عشان الأرض فمش رح يخشوا الجنة. أنا بقولكوا أهو”.
الجملة عالقة في ذهني وكأنني أسمعها الآن.
قالتها بحدة معلمة الدين في مرحلة الإعدادية في أوائل الثمانينات. تنظر إليّ من خلف نظارتها السميكة وتخاطبني بنبرة حاسمة أنا وزميلاتي في الصف، حين أثرت قضية عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عام 1982.
وقتها كنت أعيش مع عائلتي في جدة في السعودية، مراهقة متحمسة لحكايات تصلنا من جنوب لبنان فأذيعها لزميلاتي في مدرسة البنات الخاصة التي كنت أدرسُ فيها. أخبرتُهنّ يومها عن شابات يافعات أقدمن على عمليات عسكرية ضدّ مواقع إسرائيلية، لكن المعلمة التي سمعتني حرصت على إخراج النقاش من دائرة “تحرير الأرض” إلى خانة “الجهاد”، وقالت إن الجهاد الحق هو ذاك الحاصل في أفغانستان أما المتحمسون والمتحمسات من لبنانيين وفلسطينيين (لم يكونوا إسلاميين في تلك المرحلة) ويقاتلون من أجل تحرير الأرض المحتلة فهذا ليس كافياً ليرضى عنهم الله بحسبها. شعرتُ بالخيبة لأن من تحمستُ لهم لن يتقبل الله تضحيتهم.
جملتُها تلك كانت بداية ذاكرتي عن أفغانستان.
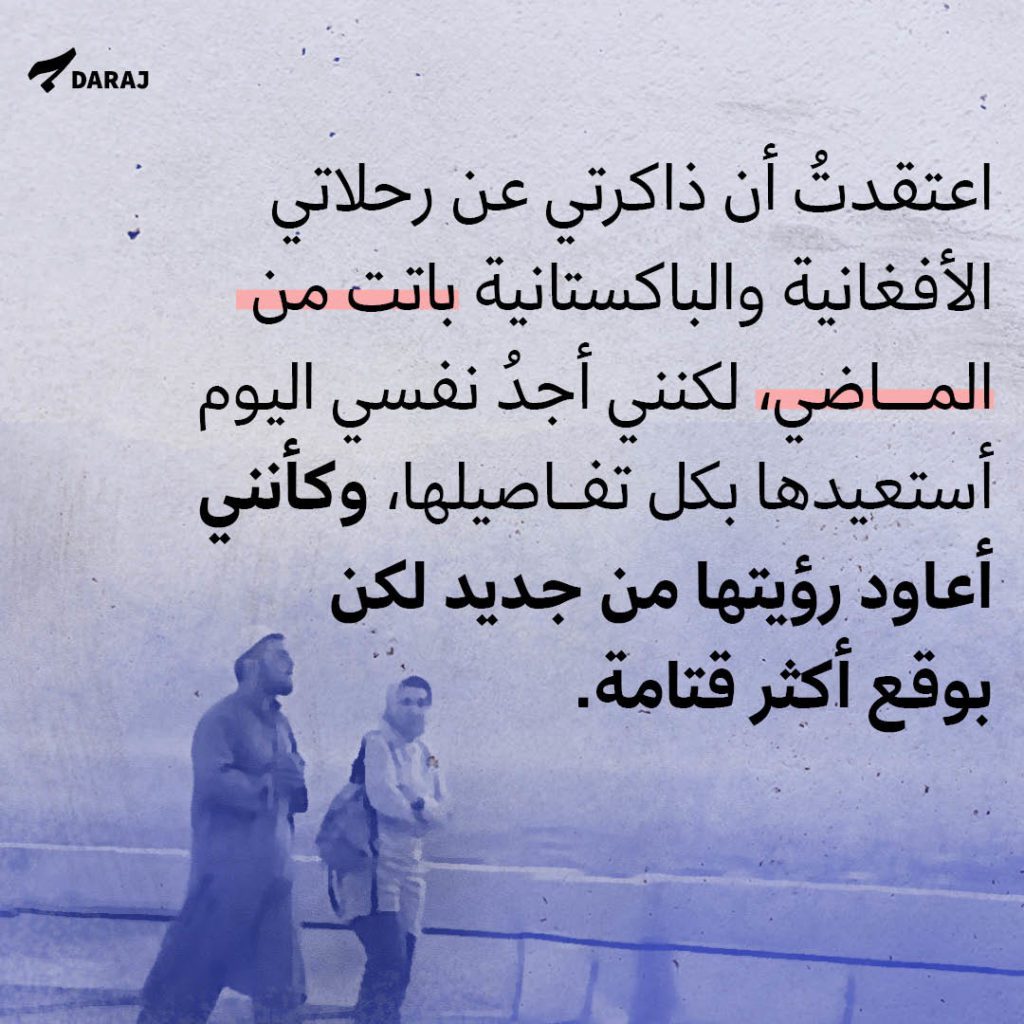
أخبار “المجاهدين” ضد الاحتلال السوفياتي كانت تملأ نشرات الأخبار السعودية. هو زمن الإعلام المقفل بالكامل، ولم تبد لي أفغانستان أكثر من بلد بعيد غامض.
في الحقبة ذاتها، زارنا وفد نسائي أميركي ليطلع على مدرسة البنات المعزولات عن الذكور والمحتشمات بالكامل. حرصت المديرة حينها على أن يزرن فصلنا ويستمعن الى زميلة لنا وهي تجوّد القرآن، كان صوتها عذباً بلا شك. طبعاً لم تفهم الزائرات الأميركيات شيئاً، لكنهن اكتفين بابتسامات عابرة ورحلن.
في مرحلتي الطفولة والمراهقة، من المألوف أن نطرح أسئلة وجودية وفلسفية وبالنسبة إلي كانت أسئلتي “الساذجة” ذات طابع نسوي فطري، فهي حساسة تجاه وعيي بذاتي كأنثى، وتجاه التمييز ضدّي وضدّ بنات جنسي لجهة اللباس والدور وعلاقات القوة داخل الأسرة والمجتمع. لم تقنعني الأجوبة التي برّرتْ تفضيل الرجل على المرأة بوصفها حكمة إلهية لن أفهم كنهها، أو تلك التبريرات التي تحاول تجميل الأقفاص والأقفال التي تُحبس النساء داخلها.
حقوق النساء لم تكن شعاراً رائجاً كما اليوم، والوافدات الأميركيات اللواتي زرن فصلنا كنّ كما لو يتجولن في حديقة عامة، فهن يشبهن السياسة الأميركية حينها، ابتسامات زائفة تغطي صفقات النفط والمصالح الاقتصادية وتتغاضى عما هو غير ذلك.
كررت معلمات الدين المتعاقبات علينا تعليقات تعلي من شأن “المجاهدين”، وكانت بعضهن يمررن آراء أثارت حنقي خصوصاً حين جزمت إحداهن بأن الحرب اللبنانية المندلعة في تلك الفترة كانت “عقاباً” من الله على “مجون” يمتهنه أهل بلدي.
كان من الصعب مناقشة معلمة الدين، فهي تملك ناصية الحقيقة المطلقة.
بدأت انتبه حينها للأخبار الواردة من أفغانستان. لم أكن رأيت أفغانيات حينها ولا حتى عبر الشاشات، بدت النساء وكأنهن خارج الصورة تماماً التي كان يستحوذ عليها رجال ملتحون يرتدون زياً محلياً قاتماً ويحملون الكثير من الأسلحة، يستقبلهم زعماء وتشيد بهم قيادات بوصفهم “مجاهدين” و”مقاتلين من أجل الحرية”.
إنها الحقبة التي نمت فيها تنظيمات جهادية دعمتها الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. لكن لاحقاً تطور مسار تلك التنظيمات وتشعبت ولاءاتها ومصادر رفدها بالمال والسلاح لتخرج علينا “القاعدة” وحركة “طالبان” وتسيطر على كابول، وتتسيد ممارساتها على الأقليات والمعارضين لها من الأفغان وتدفع النساء الثمن الفادح لتلك السيطرة.
تزامن هذا الصعود مع انتقالي وعائلتي إلى لبنان حيث درست الصحافة في سنوات الحرب الأخيرة وبدأت عملي في السنة التي انتهت فيها الحرب. الحرب اللبنانية كانت انتهت عام 1991، على تسوية إقليمية سياسية أعفت عن أمراء الحرب وفرضتهم مجدداً قيادات للبنان كما باتت إيران وسوريا تسيطران بشكل أساسي في مسار الحدث اللبناني.
كان العمل الصحافي في لبنان محكوماً بسقوف سياسة ما بعد الحرب.
وبين تعقيدات العمل الصحافي تحت سقوف الوصاية السورية، وطموحاتي الصحافية والنسوية، بدأت رحلات متنقلة بين أكثر من دولة.

في منتصف التسعينات نمت سيطرة “طالبان” بدعم من المخابرات الباكستانية مستفيدة من امتداداتها القبلية وتقاطعات السياسات الخليجية آنذاك.
سريعاً ما طافت مشاهد عنيفة للقتل والإعدامات ورجم النساء وإقصائهن من الحياة العامة وحصرهن بالمنازل للزواج والإنجاب.
ضاعف من خطورة المشهد هناك احتضان “طالبان” للمطلوب الأول آنذاك زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن وأتباعه ومريديه الذين نفذوا لاحقاً هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.
قبل تلك الهجمات بنحو عام وتحديداً، عام 2000 ذهبتُ إلى باكستان، وكانت بداية محاولاتي عبر السفارة الأفغانية هناك للدخول إلى كابول. أتتني ردود مضحكة لكنها تنسجم مع الثقافة الدينية التي تتربى عليها كثيرات في مجتمعات عربية وإسلامية عدة. الموظف طلب مني أن أجلب معي “محرماً” ذكراً، سواء أكان أبي أو أخي أو زوجي ليرافقني ويسمحوا لي بالدخول.
سخرت منه في سرّي، لكنني لم أستسلم للردود هذه، فذهبتُ بعدها إلى “المدرسة الحقانية” في بيشاور شمال باكستان. هناك تخرج قادة “طالبان” وهناك تلقّى آلاف الشبان الصغار من باكستانيين وأفغان ومن دول إسلامية مختلفة تعاليم دينية صارمة خصوصاً في ما خص النساء والحياة العامة.
التقيتُ حينها المولى سميع الحق وهو رجل دين باكستاني معروف، وكان رئيساً للمدرسة الحقانية التي تأسست عام 1947، وهي المدرسة التي درس فيها كثر من أعضاء “طالبان”، وبينهم مؤسس الجماعة الملا عمر، حتى إن سميع الحق لقّب بأبي “طالبان”. وصلت شهرته إلى ذروتها خلال فترة الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفياتي، فقد كان معظم أعضاء مجلس شورى “طالبان” من طلبة مدرسته السابقين. كانت المدرسة تتلقى تمويلاً من دول خليجية وإسلامية وكان حضورها قوياً ومدعوماً من المخابرات الباكستانية.
سميع الحق كان يتحدث العربية بطلاقة وسمح لي بتسجيل لقاء مصور معه، علماً أن “طالبان” حينها كانت تمنع الكاميرات والتصوير وتعتبرها من المحرمات. في المقابلة، شرح لي سميع الحق “أهمية” طالبان و”أخلاق” عناصرها وقوتهم في دحر “الاحتلال” السوفياتي ومواجهة أميركا.
لكن ما يقال على الشاشات والمنابر وفي المقابلات يختلف عن حقيقة ما يحصل. بعد المقابلة سمح سميع الحق لزملائي بتصوير المدرسة التي يتعلم فيها الفتية أن المرأة يجب أن “تصان” في المنزل وألا تخرج منه، ويتعلمون أن الموسيقى حرام والتلفزيون ممنوع والصور رجس من الشيطان.
خلال تصوير زملائي المدرسة، استضافني سميع الحق في منزله المجاور لأتعرف إلى زوجته وأولاده. حين دخلتُ منزله فوجئت بجهاز تلفزيون يتربع وسط المنزل وإذا به يخبرني بابتسامة أنه يتابع الفضائيات اللبنانية. عرّفني إلى زوجته الثانية (لأن الأولى كبرت في السن كما قال وهو يحتاج زوجة شابة)، وحين انزلق غطاء الرأس الذي طلب مني ارتداءه خلال المقابلة سارع للقول أن لا داعي لأن أعدل المنديل طالما أنني مع عائلته في منزله، على رغم أنه كان حاضراً، ويفترض ألا يقبل بذلك باعتباره رجل دين ملتزماً.
كان سميع الحق ببساطة نموذجاً شائعاً لرجال دين وسياسة يضمرون ويعيشون بخلاف ما يروجون. لم يكن يرى غضاضة في ترسيخ تعاليم صارمة بحق النساء والحريات لكنه كان يعيش حياة مزدوجة في منزله ورأيت ذلك بنفسي. بقي سميع الحق يدير أشهر مدرسة طالبانية في باكستان حتى اغتياله طعناً عام 2018.
تلك الزيارة كانت مفتاح دخولي إلى أفغانستان.
سميع الحق وشيوخ آخرون في باكستان كانت لهم الحظوة، ويإيعاز منه إلى السفارة سُمح لي بالحصول على تأشيرة أفغانية ودخول أفغانستان، التي لم تكن أقل من رحلة نحو المجهول.
الدخول كان عبر بيشاور الباكستانية، فالحدود الجبلية طويلة وبدائية وغير معبدة بشكل جيد. رحلة مرهقة وسط طرق وعرة يرافقنا فيها مترجمنا الأفغاني اللطيف الذي يجيد العربية، فيما السائق يستمع إلى مغنية محلية شهيرة، لكن ما أن كنا نقترب من حواجز “طالبان” حتى يستبدل شريط الغناء بشريط قرآن. على الحواجز كانت تتدلى أشرطة الكاسيت التي كان “يعدمها” عناصر طالبان.
لم يكن زمن الـBluetooth قد لاح حينها.
هل حقاً ستعود تلك المشاهد إلى أفغانستان مجدداً؟
من الصعب جداً عدم استحضار المقارنة وسط هذا السيل من الصور الواردة من هناك اليوم، بعد انسحاب الأميركيين واستعادة “طالبان” لقوتها وسيطرتها وفرض ممارسات تحاكي ما فعلته قبل 21 عاماً.
سنوات غياب “طالبان”، كانت أرست مشهداً مختلفاً للعلاقات بين الدول، فـ”الحرب على الإرهاب” سببت انتكاسة كبرى لمبدأ حقوق الإنسان مع تكريس انتهاكات برعاية منظومات “ديموقراطية” غربية، أعادت أفغانستان والمنطقة عقوداً إلى الوراء.
بعدما سقطت “طالبان” في الحرب عام 2001 واستعاد الأفغان بعضاً من أنفاسهم، انتقل اهتمام واشنطن إلى العراق لتنغمس في حرب دموية غيرت وجه المنطقة والعالم حتى اليوم. سقوط “طالبان” حينها لم يكن مكتملاً، فقد اعتمدت واشنطن سياسة ترتكز عسكرياً على الطائرات المسيرة التي قتلت آلاف الأفغان المدنيين، وإدارياً تقوم على تشكيل حكومة وإدارة أفغانية فاسدة غير مؤهلة ساهمت في إبقاء الكثير من الأفغان تحت مظلة “طالبان”.
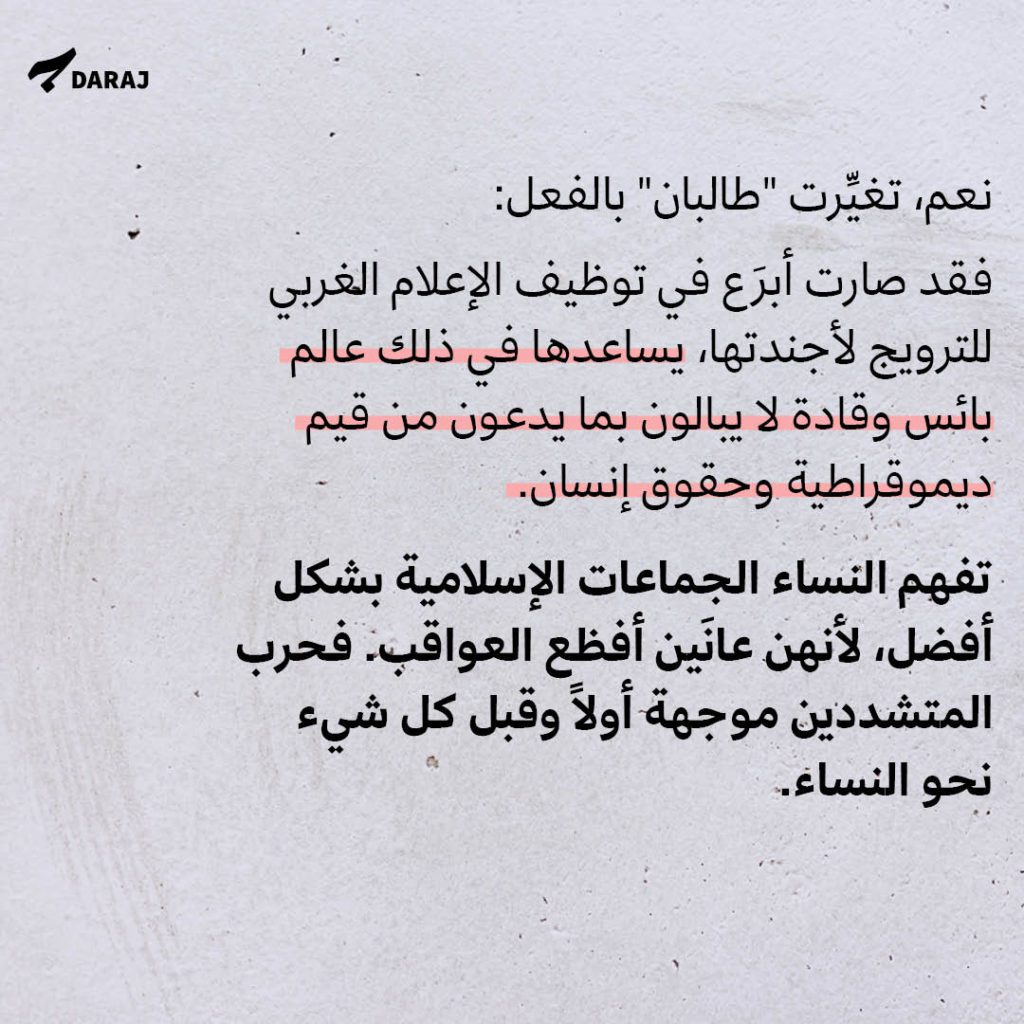
لم يكن مشهد تدفق الأفغان للتعلق بالطائرات المغادرة على عجل وتساقط بعضهم من السماء خارجاً عن الدراما الهائلة التي تحيط بمستقبلهم.
في السنوات القليلة الأخيرة، عادت قطر مثلاً لتتصدر المشهد الخليجي وما كان يبثه الإعلام السعودي من صورة بهية عن المجاهدين الأفغان، تقوم به بخبث منقطع النظير اليوم قناة “الجزيرة” التي لعبت أدواراً في تسويق “طالبان” بوصفها “معتدلة”.
اعتقدتُ أن ذاكرتي عن رحلاتي الأفغانية والباكستانية باتت من الماضي، لكنني أجدُ نفسي اليوم أستعيدها بكل تفاصيلها، وكأنني أعاود رؤيتها من جديد لكن بوقع أكثر قتامة.
مشهد الستارة الفاصلة بين طلاب الجامعة في كابول وطالباتها، بعد سيطرة “طالبان” ردّني إلى الجامعة التي زرتها والتي قال أساتذتها إن الفتيات والنساء يجب أن يكن في المنزل وإن صروح التعليم هي للذكور.
عام 2000 كانت كابول غارقة بدمارها وبؤسها وعتمتها، وحين وصلتها وجدتها موحشة وصامتة. في الفندق أصرت الإدارة على أن أقيم في طبقة منفردة بعيدة من فريقي الصحافي. كنت الأنثى الوحيدة وكان هذا سبباً لأمضي ليلة مقلقة في غرفة معزولة ممنوع عنها التلفزيون والموسيقى. الصمت ليلتها ضجّ في أذنيّ بشكل بالغ حتى شعرتُ بأنني أكاد أجن.
عام 2001 وبعد سقوط “طالبان”، حضرت سهرة لفرقة أفغانية احتفت بأنها عادت للغناء وعزف الموسيقى. اليوم وما أن استعادت “طالبان” السيطرة حتى حطمت المعدات الموسيقية في المعهد العالي للموسيقى في كابول.
كم تبدو استعادة الماضي مشهداً ممجوجاً، إنما ثقيل ومرعب.
حوادث التحرش الكثيرة التي واجهتني من قبل مسؤولين ورجال دين، هي صدى للوجوه نفسها التي تريد أن تقود البلد بالأسلوب ذاته اليوم. ها هم يجلدون النساء لأنهن تظاهرن رفضاً لإقصائهن بعدما دفعن دماً عبر اغتيال ناشطات كثيرات وقتلهن في السنوات الماضية، لأنهنّ طالبن بحرية الأفغانيات.
كيف لي أن أنسى مريم، اللاجئة الأفغانية التي هربت إلى بيشاور الباكستانية بعدما خطفت “طالبان” زوجها ولم ترجعه، فغادرت محاولة النجاة بابنتيها الصغيرتين آنذاك من احتمالات مستقبل قاتم كزواج قسري من مسلح طالباني.
“الحياة تحت حكم طالبان تعني أننا لا شيء” قالت لي مريم حينها.
قبل أيام، جُلد صحافيون وعُذّبوا، لأنهم صوروا تظاهرة نسائية احتجاجية.
أعادتني حادثة ضرب الصحافيين بسبب التصوير إلى مسؤول طالباني قال لي في كابول: “أهلاً بك في افغانستان، يمكن أن تصوري ما تريدين، but non living things”. قالها بالإنكليزية حينها وعنى أنه يمكنني تصوير الجبال والطرقات والمباني لكن ليس البشر والحيوانات لأن ذلك “حرام”.
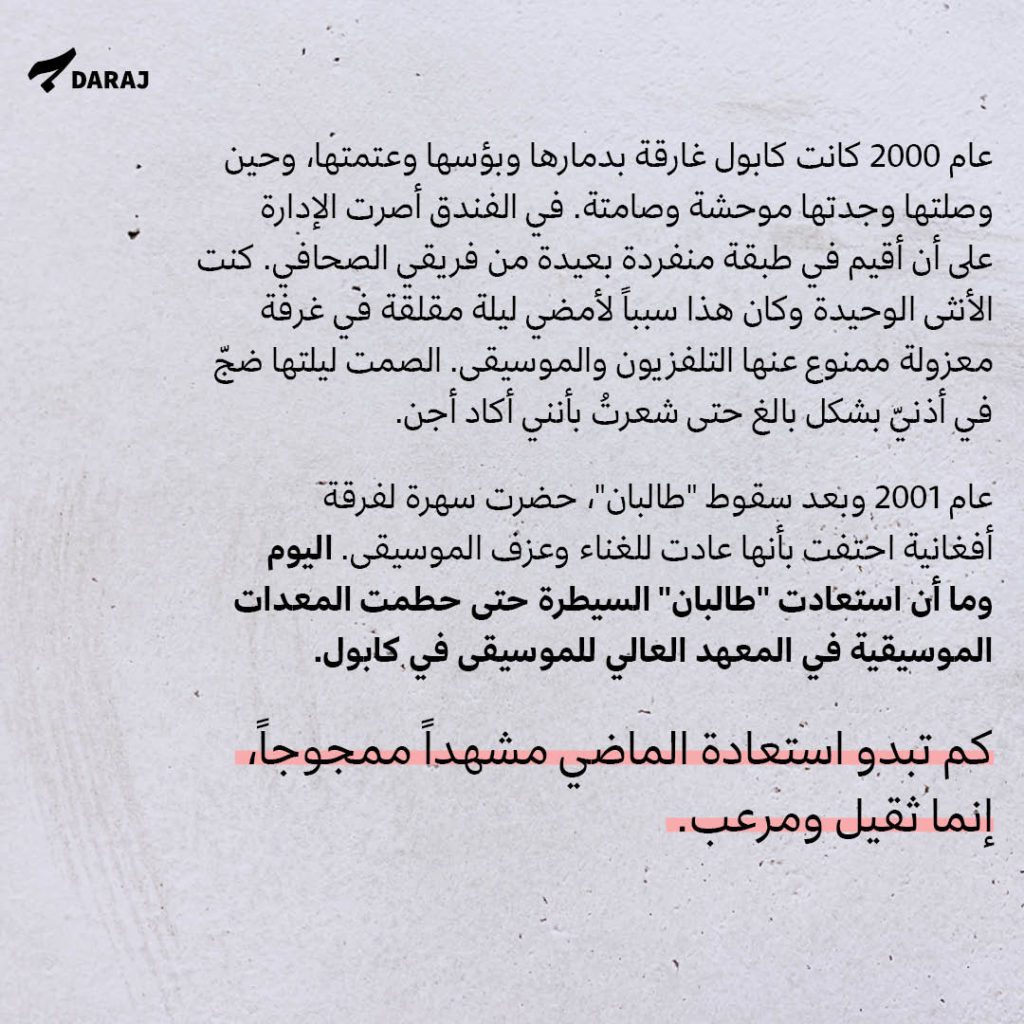
اليوم ليس كما الأمس، لكن هل الأفغانيات والأفغان عموماً سيرضخون لمصيرهم كما حل بهم قبل 21 عاماًَ؟
نعم، تغيَّرت “طالبان” بالفعل: فقد صارت أبرَع في توظيف الإعلام الغربي للترويج لأجندتها، يساعدها في ذلك عالم بائس وقادة لا يبالون بما يدعون من قيم ديموقراطية وحقوق إنسان.
الواقع في شوارع كابول يروي لنا قصة مختلفة.
تفهم النساء الجماعات الإسلامية بشكل أفضل، لأنهن عانَين أفظع العواقب. فحرب المتشددين موجهة أولاً وقبل كل شيء نحو النساء.
هل يفهم المحتفون بـ”طالبان” لا لشيء سوى لتسجيل انتصار على الولايات المتحدة، معنى أن تعود امرأة إلى ارتداء البرقع بعدما صدقت وخلعته على مدى عقدين؟ هل يعنيهم أن تمنع امرأة من الخروج والعمل والعيش كما تريد وهذه أبسط حقوقها؟
خلال فترة حكمها الوجيزة في السابق أذهلت “طالبان” العالم بقسوة نظامها. وكان الجَلد والإعدامات العلنية وقمع النساء هي السمات المميزة لتلك الفترة.
خلال العقدين الماضيين، قدمت أمثلة كثيرة على استمرار الممارسات نفسها واستنساخ تلك الممارسات عبر جماعات إسلامية كثيرة في المنطقة. دعونا لا ننخدع، “طالبان” ومثيلاتها كارثة على النساء، ويزيد من هذه الكارثة أننا نعيش في عالم منافق يحكمه أوغاد.
إقرأوا أيضاً:











