كنت حينها طالباً في بريطانيا، أذكر جيداً أين وكيف وصلني خبر ضرب البرجين. أتذكر صدمة أصدقاء أميركيين وحزنهم، وشماتة بعض من أعرف من عربٍ ومسلمين. حاضرةٌ في ذهني ساعاتٌ من النقاشات على الإذاعة سمعتُ فيها انحيازاً ضد كل ما هو مُسلِم بعُدوانيةٍ فجة لم أعهدها، لا قبل هذا الحدث ولا بعده.
أذكر أكثر من حديثٍ مع سائقي أجرة بريطانيين من أصول ٍمسلمة عما يرونه عداء العالم كله للإسلام، وأن “الغرب”، حيث يعيشون، لا هم له سوى ذُل المسلمين، ونقاشاتٍ اخرى، ربما أكثرها طرافة وألماً معاً، ما تلا محاضرةً لأكاديمية مصرية محسوبة على الإسلام السياسي دُعيت إلى جامعتنا، فبعد حديثها في الأمر وتبعاته أتحفنا أول من رفع يده طالباً التعليق بـ”حقيقة” أن الإسلام لا يقبل إلا الحرب مع غير المسلم وصولاً للنصر أو الجزية، مرة اخرى: كان هذا في بريطانيا، بعد بضعة أشهر من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، أمام حضور أغلبه من غير المسلمين.
أحنيت رأسي وغطيت وجهي متمتماً: “لا! لا! لا! لا يمكن أن يكون أحدهم غبياً إلى هذا الحد. ناهيك بالمُعتَقد والاختلاف أو الاتفاق معه، هالني أن صاحبنا لم يعِ أن لكل مقامٍ مقال. “صاحبنا” هذا كان من حزب التحرير، كما أخبرني بعد انتهاء المحاضرة، وهو يقدم لي منشوراً يدعو إلى الانضمام إلى حزبه. لكن، كما رأينا مؤخراً: منطق، (أو لا منطق) أخو حزب التحرير حاضرٌ معنا، من ثم سيل التهاني لـ”طالبان” بـ”النصر”، كما لو أنها مثلٌ يحتذى أو أن “النصرَ” لم يكلف عقدين من العذاب أزهقا أرواح مئات الآلاف من الأفغان ليجر “المنتصر” بلادهم، عبر فهمٍ للإسلام وليد قبلية وانعزال وطنهم النائي، إلى القرون الوسطى التي ما زال جل أفغانستان يعيش فيها.
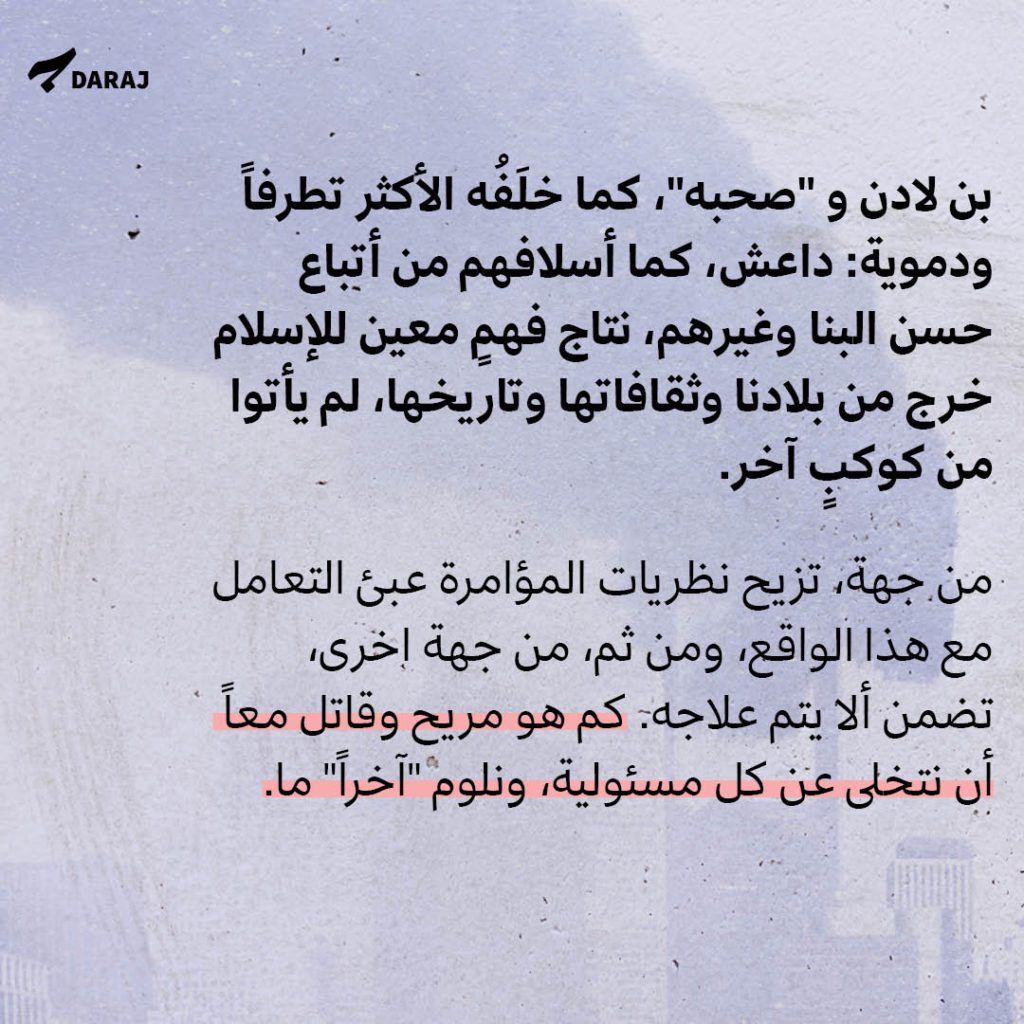
لكن إن اعتقدت أن السطحية قَصرٌ على منتمين للإسلام السياسي فأنت مخطئ. كان ممن دُعوا إلى الحديث، وإن في سياقٍ مختلف، الناشطة والكاتبة النسوية المعروفة الراحلة نوال السعداوي، هذه السيدة قالت، متسائلةً ثم مجيبةً على نفسها، بالحرف، بعد عرضٍ، أظن أنه رؤية بالغة التبسيط للعالم تتمسح بالماركسية، وامام حشدٍ من من جنسياتً مختلفة: “من فعل (ما جرى يوم) الحادي عشر من سبتمبر؟ كلنا نعرف! إنها المخابرات المركزية الأميركية”. عددٌ لابأس به من الحضور (الذين ربما لا يعرفون؟) تركوا القاعة.
التفسير المؤامراتي هذا يتجاهل أن هوية الفاعل أكدها المتهم نفسه حتى قبل وقوع الجرم. ألم “يُفتِ” أسامة بن لادن بقتل الأميركيين حيثما حلوا؟ ألم يتباهَ بـ”غزوتي” واشنطن ونيويورك، كما سمّاهما؟ حتى لو صدقنا نظريات المؤامرة التي لا دليل عليها سوى غياب الدليل، ما الذي سيغيره ذلك؟
بن لادن و”صحبه”، كما خلَفُه الأكثر تطرفاً ودموية: “داعش”، وأسلاف هؤلاء من أتباع حسن البنا وغيرهم، هم نتاج فهمٍ معين للإسلام خرج من بلادنا وثقافاتها وتاريخها، ولم يأتوا من كوكبٍ آخر.
من جهة، تزيح نظريات المؤامرة عبء التعامل مع هذا الواقع، ومن ثم، من جهة أخرى، تضمن ألا يتم علاجه. كم هو مريح وقاتل معاً أن نتخلى عن كل مسؤولية، ونلوم “آخر” ما!
كم من هذه الحركات وعنفها وليد سياقٍ معاصر أورثنا هذا القدر من ضيق الأفق وضيق الصدر بكل مخالف، وكم منها مرده أفكارٌ آتيةٌ من تاريخ الإسلام الذي يدعي كلٌ منها (أي هذه الحركات) أنها تمثل أنقى صوره؟ وهل سألنا أنفسنا أبداً ما “الإسلام” المقصود هنا؟ ولمن يحق، إن حق لأحد، أن ينسب هذا أو ذاك من الأفعال أو الأفكار إليه؟ أخو حزب التحرير السابق ذكره محور عقيدته أن عودة الخلافة هي الترياق لمشكلات المسلمين، يتشارك في ذلك، وإن بدرجاتٍ متفاوتة، مع كل حركات الإسلام السياسي السني. لكن أي قدرٍ من التاريخِ قرأ؟ بعلم أو من دون علم يتفق أخو حزب التحرير مع أسامة بن لادن في إطلاقه اسم “الغزوة” على ما حدث يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، و كذلك وصف “داعش” الرئيس الأميركي الأسبق “أوباما” بـ”كلب الروم” في رسائل تدعو إلى الضحك والبكاء على حالنا في آن.
لا يقف الأمر هنا عند العيش في زمنٍ آخر، بل في تاريخٍ يجمع تصوره بين الانتقائية والخيال. بدهي أن تعتقد أن حل المشكلات يبدأ بعودة الخلافة إن آمنت أنها لم تغب إلا مطلع القرن العشرين، بل وأنها كان لها من الوزن والسلطان ما لم يعرفه سواها. لكن أي قراءة منفتحة للتاريخ من مصادره الأصلية كفيلة بنسف هذا التصور.
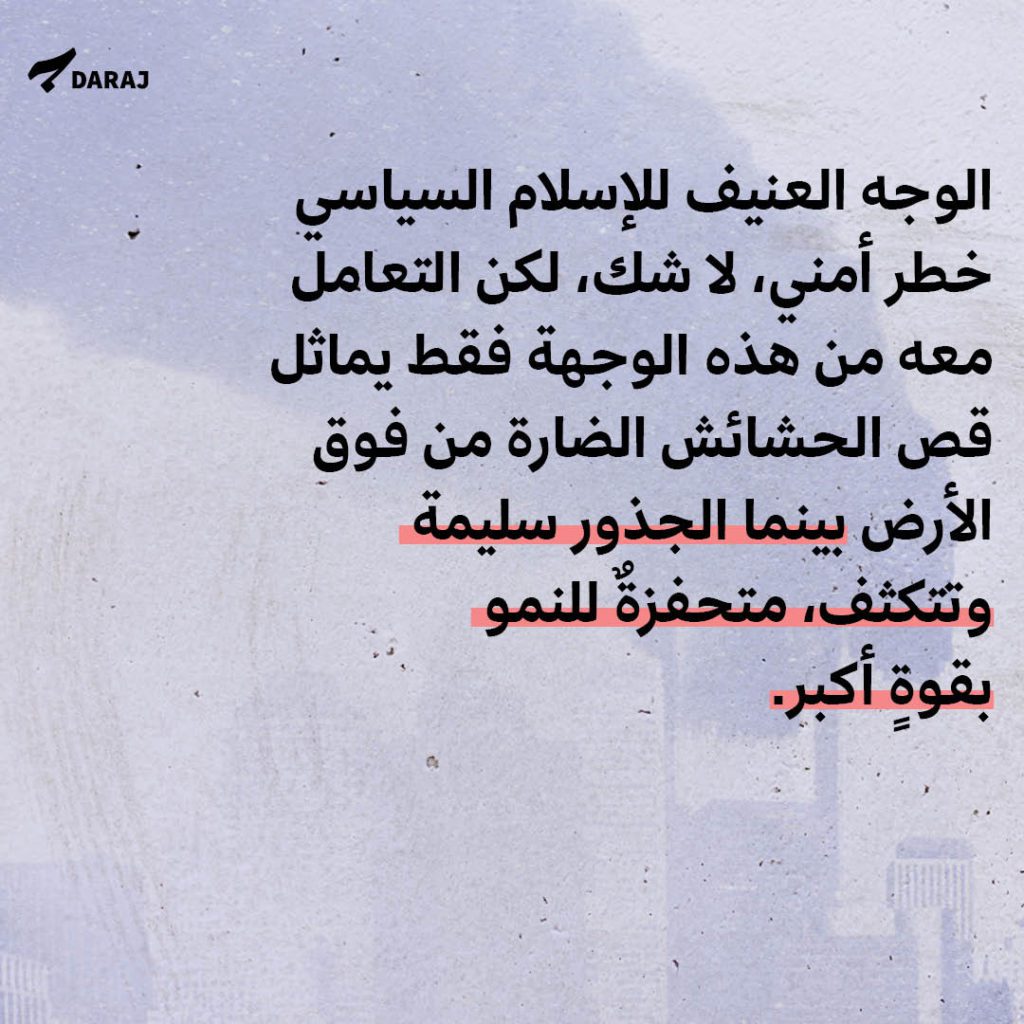
كما لا أمِل من التكرار: في روايات السنة قبل غيرهم، لم يجمع المسلمون على حاكمٍ بعد الخليفة الثاني، و خلال عهد الأمويين لم تنقطع الثورات عليهم، ثم كانت هناك خلافتان، ثم أكثر من خلافة عدا “الامامات” الشيعية. وخلال ذلك كله انحدر الخلفاء، بغض النظر عن شرعيتهم من عدمها، إلى ألعوبة في يد السلاطين وقادة العسكر. ومن جملة أسطورة الخلافة هذه اعتقاد راسخ أن آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة (الذي كان خاضعاً للمماليك في أي حال) تنازل للفاتح العثماني سليم الأول عن الخلافة. المصادر المعاصرة لدخول سليم مصر (تحديداً كتابات ابن إياس الحنفي وابن طولون الدمشقي)، وسني حكمه حتى نهايتها، ثم أوائل حكم ابنه سليمان القانوني، لا تذكر شيئاً عن نقل خلافةٍ أو تنازلٍ عنها، بل إن أحدها (ابن طولون الدمشقي) يؤرخ لأحداث السنوات دون خليفة بعد موت آخرهم بمصر (بعد عودته من اسطنبول). في ما يبدو، لم يدّعِ العثمانيون، الذين افتقدوا النسب القرشي المؤهل للخلافة في أي حال، الخلافة إلا في القرن الثامن عشر بعد هزيمةٍ مذلةٍ من الروس، ولم يستثمروا في ادعائها بقوة إلا قبيل السقوط في القرن التاسع عشر. لكن إن آمنت بأسطورة الاستمرارية سترى مركزيةً للموهوم تشكل فهمك للواقع، لا العكس كما يقتضي المنطق.
وفي التاريخ المُتخيل يعيش من يعادي العالم كله، لهذا استخدم بن لادن تعبير “غزوة” ووصف “داعش” أوباما بـ”كلب الروم”. لكن هنا أيضاً السياقات مجتزأة، فغزوات صاحب الرسالة، النبي محمد، كانت أداةً سياسية لم تهدف يوماً للحرب في حد ذاتها، ناهيك بأن تجعل من المعتاد استباحة دماء غير المحاربين بالشكل شديد الفجاجة والبشاعة الذي يميز الجهادية السلفية اليوم، والرسول في نظر أعدائه قبل أتباعه كان سياسيا قديراً يعرف جيداً متى يجرد السيف مثلما يعرف متى يغمده، أما حروبه فلم تكن أبداً انتحاراً جماعياً يساوي الفَناء بالشهادة، من ثم تاريخ المسلمين فيه من التعايش مع المختلف أكثر بكثير مما فيه من الصراع، هذا يعمى عنه أمثال بن لادن وأتباعه، ناهيك بمن زايد عليهم في تطرفه. ولكن في سياق رؤيةٍ تختزل العالم إلى اللونين الأبيض والأسود تغيب التفاصيل، فرؤية التاريخ هنا تساوي اللاتاريخانية، ودقائق الصورة لا محل لها من الإعراب. بذلك يتساوى “الروم” (التي تعني بالمناسبة اليونانيين) مع الأميركيين، كما تتشكل “القاعدة” لمحاربة “الصليبيين واليهود” بغض النظر عن أن الصليبيين الكاثوليك كانوا ربما أشدُ عداءً لليهود منهم للمسلمين وأن بلاد الصليبيين اليوم تغلب عليها اللا-دينية.
هل يمكن رد رؤية كهذه للتاريخ، ومن ثم للهوية وللآخر وللواقع، حصراً، لفهمٍ معين للإسلام؟ من جهة، قطعاً لا، لا يختلف فهم الإسلام السياسي للتاريخ عن أي مشروع قومي معاصر، يهدف، لا للتحقق من وقائع الماضي، بل لبناء هوية جماعية تُعرّف، ولو جزئياً، على كونها نقيض جماعاتٍ أخرى. ألم ندرس التاريخ، كل التاريخ، على هذه الصورة في عموم مدارسنا؟ من جهة اخرى، نعم، السلفية الجهادية امتدادٌ لتياراتٍ فكرية معينة عرفها الإسلام عبر تاريخه، لكنها لم تكن يوماً بهذا القدر من علو الصوت ولا هذا الحضور الواسع، بل إن فرط العنف منهم، كغالبية فرق الخوارج مثلاً، ضمن تهميشهم. لكن الخوارج سابقاً، على عكس ما يسمى بالسلفية (التي أمست ترادف الوهابية) اليوم، لم يتمتعوا بثروة نفطية هائلة تساعدهم على نشر أفكارهم . كذلك بينما تدعي أنظمة أن كل همها هو محاربة الإسلام السياسي، ناعتةً إياه بالإرهاب، فإنها تتعايش، أو ربما تتحالف أو حتى تتبنى بعض أفكاره، متخذةً للمزايدة عليه سبيلاً للشرعية. نموذج “الرئيس المؤمن”، صاحب دولة “العلم والإيمان”، أنور السادات، ليس بالنادر ولا الإستثنائي، علماً أن المأساة الكبرى ليست أن هذا قتله تيارٌ ممن أعان على التمدد والانتشار، بل أنه سلَم مجتمعنا لهؤلاء ثقافةً وفكراً، و من ثم فعلاً وعنفاً.
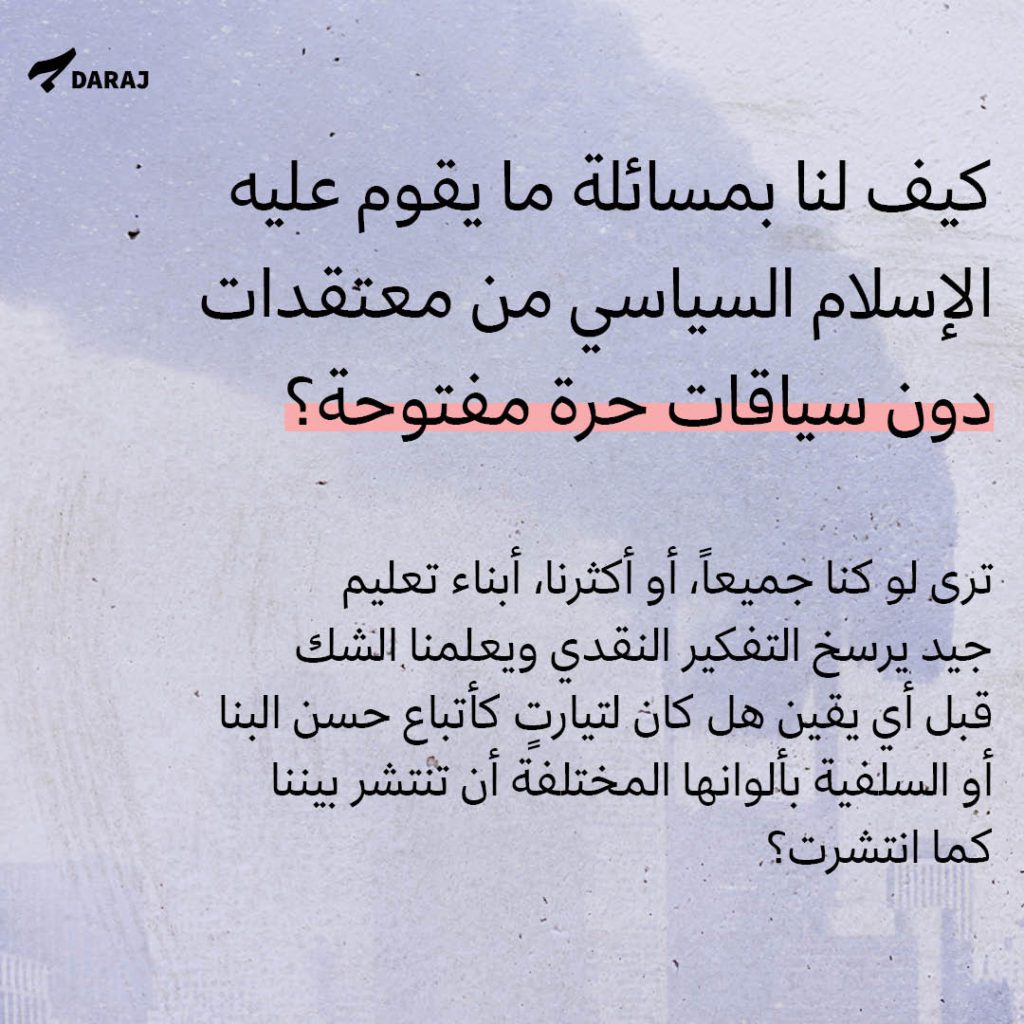
أسامة بن لادن وجد طريقه إلى أفغانستان بمساعدةٍ من أكثر من بلد مسلمٍ لـ”الجهاد الأفغاني”، صاحبه طبعاً دعمٌ أميركي، لكن الفكر الذي صدر عنه بن لادن و”جهاده” باقٍ معنا في صورٍ كثيرة، كما بقاء الثقافة التي تربى فيها خاطفو الطائرات الـ19، معنا. هذه الثقافة المتجذرة لن تتغير بين عشية وضحاها، ولن تعين عليها أنظمة تتوانى عن محاربتها صراحة، إن لم تتحالف معها أو توظفها.
ثُم كيف لنا مساءلة ما يقوم عليه الإسلام السياسي من معتقدات من دون سياقات حرة مفتوحة؟
ترى لو كنا جميعاً، أو أكثرنا، أبناء تعليم جيد يرسخ التفكير النقدي ويعلمنا الشك قبل أي يقين، هل كان لتيارتٍ كأتباع حسن البنا أو السلفية بألوانها المختلفة أن تنتشر بيننا كما انتشرت؟ كيف إذا حين يجتمع التعليم الرديء مع سياقاتٍ مجتمعية وسياسية تقيد الحريات إن سمحت بها أصلاً؟ من أين يأتي التسامح والقدرة على التعايش مع الآخر، ناهيك عن تقبله والحوار معه، في مجتمعات كهذه؟
الوجه العنيف للإسلام السياسي خطر أمني، بلا شك، لكن التعامل معه من هذه الوجهة فقط يماثل قص الحشائش الضارة من فوق الأرض بينما الجذور سليمة وتتكثف، متحفزة للنمو بقوةٍ أكبر.
إقرأوا أيضاً:







