لم تكتف وسائل الإعلام بإدراج خبر القبض على مواطنين يحاولون الهرب من سوريا عبر البحر. بل استغّلت الموقف وأثنت على جهود الأجهزة الأمنية السورية في ضبط الخارجين بطريقة غير شرعية من البلاد.
من يهرب بأطفاله على زوارق مطاطية في البحر؟ ومن يجد نفسه عائداً إلى دياره على الزورق الذي حلم أنّ فيه خلاصه وقد دفع جنى عمره للمهرّبين؟
السوريون … حتماً!
نحن.
نحن وكما في مسلسل لوسيفر الشهير، عقوبتنا أن نعيد تمثيل الحدث المؤلم إلى الأبد. وكأننا ارتكبنا ذنوب البشرية جمعاء نجد أنفسنا في الجحيم مراراً وتكراراً.
بالأمس شنق مصباح نفسه في غرفته في إحدى قرى ريف دمشق بعدما يئس من محاولة توفير بعض المال لتكاليف بيته. لم تفجّر هذه الجريمة ربيعاً ولا حتى خريفاً عربياً جديداً. ونقلتها ألسن الناس فقط، مرددة بمنطق واحد: مات كافراً.
ومعظمهم يقول بينه وبين نفسه: لقد ارتاح.

والآن مات صياد من جزيرة أرواد غرقاً لأن محرّك زورقه توقف عن العمل بسبب نفاد المازوت فارتطم بالصخور ولم يتمكن الرجل من إنقاذ نفسه بسبب ارتفاع الأمواج.
جريمة أخرى تناقلها موقع محلّي.
وردّد الجميع قدره أن يموت في البحر في يوم عاصف. لو كان الطقس صحواً لجدّف بهدوء نحو الشاطئ.
ومعظمهم يقول بينه وبين نفسه: لقد ارتاح.
وجريمة “القنبلة اليدوية” الشهيرة في طرطوس حيث قتل محامٍ على يد صهره بقنبلة يدوية كان يهدّد بتفجيرها. صارت طرفة يتداولها الناس ومجالاً للنكات والضحكات المريرة.
وردّد الجميع: لقد ارتاح.
وكل يوم هناك قصة مختلفة لشعب يعيش على هامش حياة الشظف والتقشف من دون معين.
الآن لم يعد هناك متّسع من الوقت لإحصاء الخسائر.
الوقت قصير والخسائر لا محدودة.
وعندما نلتفت قليلاً إلى الوراء، نكتشف أن حارات الفقراء كانت تحيط بمدننا ولكننا لم نلقِ بالاً إليها وتجاهلنا نظرات الحزن في عيون المحرومين.
وكانت العصا تهوي على رؤوس المظلومين أمامنا فندير نظرنا باتّجاه آخر. وتعمّدنا أن ننسى قصص التعذيب وانتهاك الحريات معلّلين أنفسنا بأسباب نعلم أنها واهية.
واستمعنا إلى الخطب الفصيحة لمدعّي الوطنية وصدّقنا كل ما كان يشاع عن البناء والمستقبل مع أننا كنا نرى بأعيننا كيف يتم نهب الأموال العامة ويستطيع المواطن العادي أن يذكر في أي وقت أسماء حديثي الثراء الفاحش المحليين والذين عادة ما يهربون بما سرقوه خارج البلاد ومن دون أن تعترضهم قوات أمن الشواطئ الباسلة.
مارسنا نفاقنا الذي تربينا عليه ولم نزل.
وأطربتنا أغنية: “أنا سوري آه يا نيّالي” …
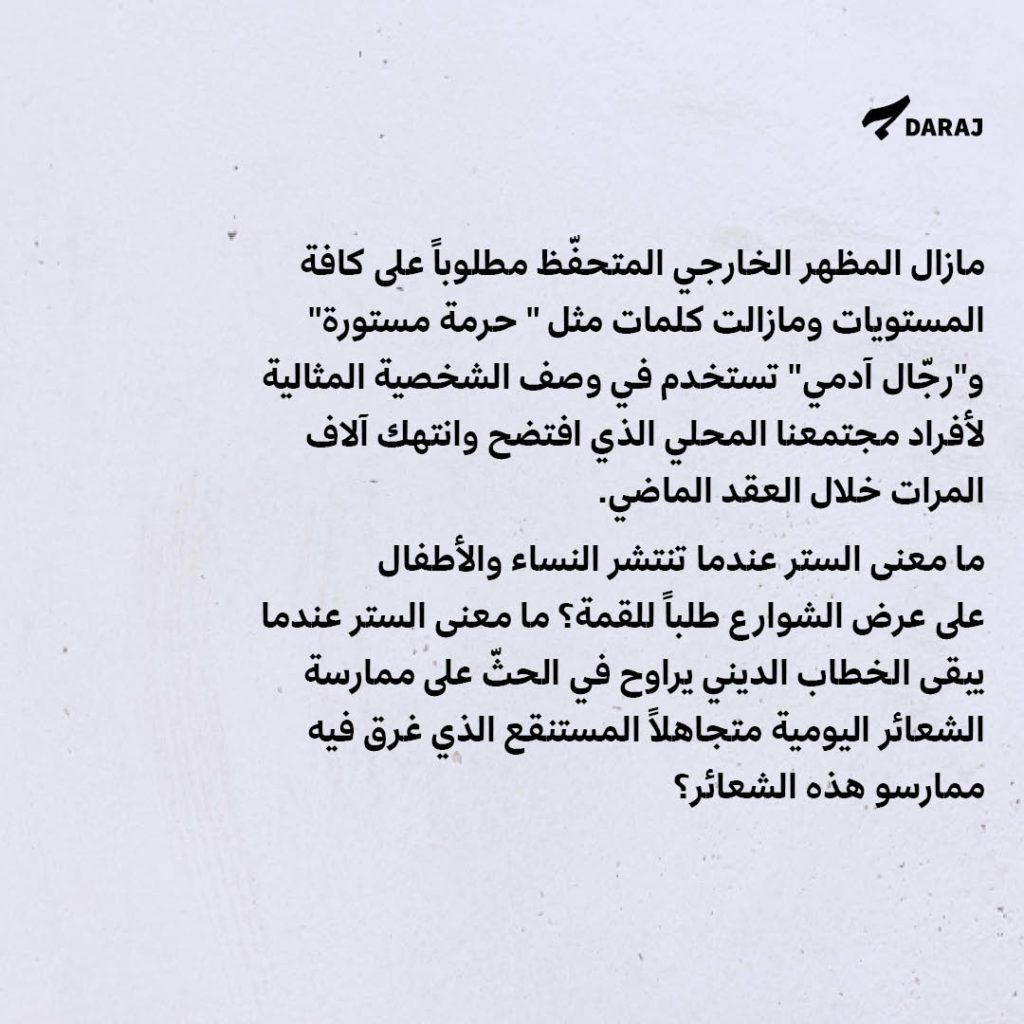
في دمشق الستينات كان النفاق دعامة المجتمع. وكان اسمه : الستر. وكان هو المعروف الذي يسديه الناس لبعضهم بكل إيمان ومن دون انتظار مقابل.
كنا نسمع قصص خيانات زوجية تروى همساً في الآذان.
وكانت “جرائم الشرف” تدفن وقائعها مع بطلتها بصمت ومن دون مظاهر حداد.
سمعنا بميول مثلية تم القضاء عليها بالتكتم التام، واعتداءات جنسية تذكر بدون تفاصيل ولغرض تخويف البنات والأطفال.
وفي حال الخروج عن الحدود ووقوع جرائم من أي نوع، يحتفظ الجميع بمعلوماته لنفسه، وكأن هناك عهداً سريّاً يقدمه الأفراد للمجتمع كي يحافظ على مظهره الرصين.
وهكذا يبقى المنطق القديم بالستر قائماً، كأننا نخشى أن يتغير شيء فينا حتى لو تهدّم العالم كله حولنا.
فهل بقي المظهر رصيناً؟
هل تعجبنا صورتنا الحالية في مرآة العالم؟
المصيبة أننا ما زلنا نراوح في مجال منطقنا القديم ونختبئ وراء أصابعنا النحيلة.
ما زالت المحاولات للخروج عن هذا الصمت خجولة وضمن إطار التقاليد والأعراف.
ما زال المظهر الخارجي المتحفّظ مطلوباً على المستويات كافة وما زالت كلمات مثل “حرمة مستورة” و”رجّال آدمي”، تستخدم في وصف الشخصية المثالية لأفراد مجتمعنا المحلي الذي افتُضح وانتُهك آلاف المرات خلال العقد الماضي.
ما معنى الستر عندما تنتشر النساء والأطفال على عرض الشوارع طلباً للقمة؟ ما معنى الستر عندما يبقى الخطاب الديني يراوح في الحثّ على ممارسة الشعائر اليومية متجاهلاً المستنقع الذي غرق فيه ممارسو هذه الشعائر؟
ما معنى الستر حين تقوم النخب المثقفة المتبقية كل يوم بنشر أخبار انتصارات وهمية ينجزها بعض من خرجوا من هذه البلاد، متناسين هزائمنا اليومية؟
لا نور في الشارع المظلم… والقمر في السماء
لا قدور فوق المواقد المطفأة … والطقس رائع
لا أمل في الأفق… وأنغام تتسرب من قهوة الرصيف.
هذي دمشق وهذي الكأس والراح… كتب نزار قباني ذات قصيدة دمشقية.
إقرأوا أيضاً:






