لا مراء في أن البعد العسكري في تجربة العمل السياسي الفلسطيني يدلل على البنية الفكرية والسياسية لمجمل الوعي السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية، ويعطي إلى هذا الحد أو ذاك مؤشرات واضحة الدلالة على أن الوعي النظري لمسألة العمل المسلح كان وعياً طفولياً، أو لنقل بدائياً، أي أنه لم يستند إلى دراسة الوضع الخاص جغرافياً وسياسياً وإقليمياً للحالة الصراعية مع إسرائيل، بقدر ما جاء كرد فعل قوي وواضح، على حالة النكبة الثانية، والتي سمّيت نكسة، وكأنها أقل فداحة مما لحق بنا في نكبة فلسطين الأولى عام 1948.
النقاش حول مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني يعتبر من القضايا المسكوت عنها في الفكر السياسي الفلسطيني، طبعاً مع استثناءات قليلة جداً، كالكتاب المميز ليزيد صايغ “الكفاح المسلح والبحث عن دولة” (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ط1، 2002).
الفكرة الرئيسة التي سعى إليها صايغ في كتابه الموسوعي الكبير (1328 صفحة) هي سرد حكاية الحركة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1949 و1993، أي ما بين النكبة وأوسلو، وذلك من خلال تركيزه على تجربة الكفاح المسلح ودوره في إيجاد الدفع السياسي والدينامية التنظيمية اللازمين لتطوير الهوية الوطنية الفلسطينية، ولظهور مؤسسات مشابهة لمؤسسات الدولة، ولتشكل نخبة بيروقراطية كنواة حكومية. وبذلك يمكن القول إن كتاب صايغ شكّل مدماكاً أساسياً في فهم التوظيف السياسي للكفاح المسلح الفلسطيني برمته، لبناء حالة فلسطينية جديدة، على رغم أن هذه التجربة لم تحرر شبراً واحداً من الأرض المحتلة.
من هنا يأتي كتاب “نقاش السلاح… قراءة في إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية” لماجد كيالي في محاولة لكشف المسكوت عنه في التجربة الوطنية الفلسطينية، بشقها العسكري تحديداً.
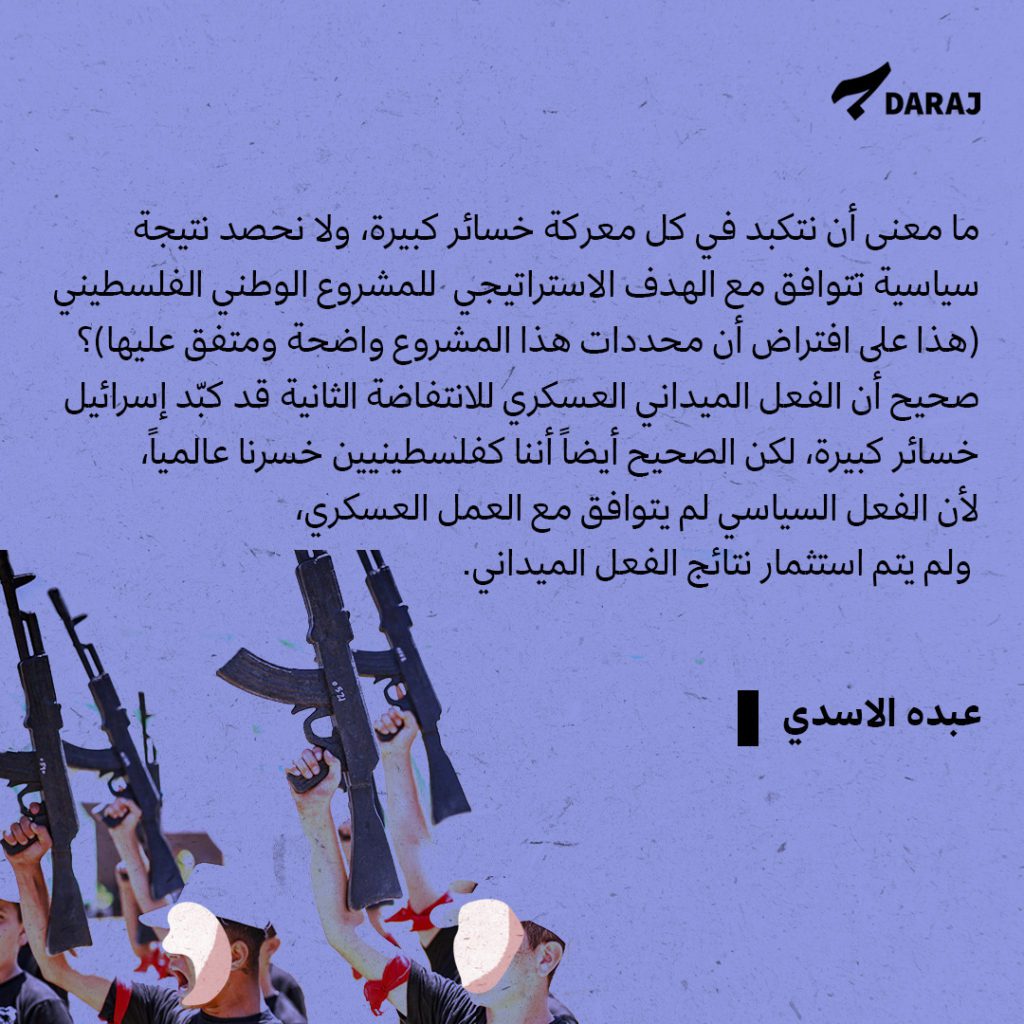
ويتداخل الكتاب بهذا القدر أو ذاك مع المساهمة التي دشنها يزيد صايغ في كتابه “الكفاح المسلح والبحث عن دولة”.
ولربما يأتي كتاب كيالي في سياق نقد التيار الديموقراطي داخل “حركة فتح” لمسارات فهمه وإدراكه للتجربة العسكرية، ولمَ لا، إذ يحسب لكيالي أنه كان من أنصار هذا التيار ومن رموزه، فهل نقاشه هو في جانب منه نقاش مع الذات، ومراجعة لها، وجردة حساب للخسارات الكبيرة التي دفعتها التيارات الديموقراطية في مجمل العمل الوطني الفلسطيني. خسارات تجسدت في فقدانها رموزها وتغييبهم اغتيالاً وتصفية، أو إزاحة بهدوء وصمت ودون صخب. ناهيك بإزاحة الفكر السياسي الذي امتلكوه، في زمن لم يكن زمنهم، بل كان زمن البندقية حيث “لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والبندقية”.
الكتاب يضع، بتكثيف شديد، كل القضايا التي خبرها العمل الوطني الفلسطيني ببعدها العسكري تحت مبضع النقد والمساءلة، انطلاقاً من أن الحرص على التجربة لا يعني عدم مساءلتها أو نقدها، بل العكس تماماً. و فوق ذلك، يعتبر الكتاب محاولة مهمة لنقد التجربة العسكرية والاستفادة من دروس الماضي وعدم تكرار الأخطاء.
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نتاج الكاتب ماجد كيالي يأتي في سياق نشاطه المستمر لنقد التجربة الفلسطينية المعاصرة، إذ سبق أن أصدر كتابين هما: “الثورة المجهضة”، و”فتح خمسون عاماً”، وذلك في إطار نقد تجربة العمل الوطني الفلسطيني بمستوياتها السياسية والفكرية والتنظيمية والعسكرية، وبتعدد طبقاتها القيادية والشعبية.
“التوريط الواعي”
يذهب المؤلف بعيداً في البحث عن ماهية العمل العسكري للحركة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر أن “فتح” كانت الطليعة في تأكيد البعد العسكري، بهدف التركيز على البعد الوطني الفلسطيني، واستعادة القضية الفلسطينية من الأنظمة العربية السائدة، والعمل على تحريك الجبهات، وفقاً لفكرة “التوريط الواعي” التي انتهجتها “فتح”.
المؤلف كان دقيقاً في تحليله فكرة “التوريط الواعي”، كونها فكرة ساذجة وعفوية لناحية أن الأنظمة العربية كانت لها أجنداتها واستراتيجياتها، فبدلاً من توريطها مع إسرائيل تم توريط المقاومة في صراعات بدأت مع النظام الأردني، وصولاً إلى تداعيات الأحداث في لبنان.
“فقد تورطت مجمل الفصائل بصراع مع النظام الأردني عام 1970، ما أدى إلى خروج المقاومة من ذلك البلد. ولم تنجح سياسة التوريط الواعي في لبنان، ما أدى إلى هدر معظم طاقة فتح والفصائل الفلسطينية في صراعات جانبية مضرة خارج الصراع مع العدو الإسرائيلي” (ص13).
فكرة “التوريط الواعي”، كما يورد المؤلف، طرحتها “فتح” في “بيان التوقيت”، وهو من الأدبيات الداخلية المؤسسة لفكرها السياسي، والتي صدرت في أواخر الستينات، وجاءت في سياق رد الحركة على اتهامات من قبل قوى أخرى بـ”التوريط” و”التوقيت” و”التفتيت”، أي بالتاءات الثلاث التي طرحت آنذاك رداً على مبادرتها لإطلاق الكفاح المسلح، كما وردت في كتاب يزيد الصايغ “رحلة الكفاح المسلح والبحث عن دولة” (ص 196).
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن شعار “التوريط الواعي” طرح قبل حرب حزيران/ يونيو 1967، وتحديداً في العامين 1965-1966، وقد استندت الثورة الفلسطينية إلى مبدأ أنه لا يجوز أن تبقى القضية الفلسطينية مجمدة، بل يجب العمل على زج الأنظمة العربية في النضال ضد المشروع الصهيوني، ووضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتهم، أي جرّهم إلى المعركة مع العدو الصهيوني، باعتبار أن هذا العدو لا يستهدف فلسطين فحسب، بل له دور وظيفي للحؤول دون وحدة الأمة العربية، لذا وجب العمل على جرّ الأنظمة العربية إلى دائرة الصراع، وتوريطها “الواعي” في المعركة، لا أن يكون الفلسطينيون وحدهم في معمعة النضال.
صحيح أن كيالي تناول فكرة “التوريط الواعي” وموقعها في التجربة العسكرية الفلسطينية، لكنه لم يتطرق إلى كيفية توريط النظام الرسمي العربي فصائل العمل الوطني الفلسطيني وزجها في معارك مع إسرائيل، مع أنها(أي الفصائل) تعرف مسبقاً أنها ستكون الخاسرة عسكرياً، بمعنى أن النظام الرسمي العربي استثمر سياسياً في النشاط العسكري للفصائل الفلسطينية وورطها في معارك كثيرة، بهدف حصوله على شرعية عربية، بهوية مقاومة، إذ إن القضية الفلسطينية شكلّت بيضة القبان في أي اختبار يراد به قياس مدى صدقية النظام ووطنيته.
المفارقة التي تدعو إلى الدهشة أن فكرة “التوريط الواعي”، وعلى رغم كونها تحمل صفة الوعي، إلا أنها تفتقد إلى السياسة الواعية، بل تنم عن سذاجة في التفكير السياسي، سذاجة تعبر عن المآلات التراجيدية لمسيرة الكفاح المسلح، التي بدأت بفكرة التحرير تارة وحرب الشعب طويلة الأمد وغيرها، فإذا بالنظام الرسمي العربي يذهب، إلى ممارسة التطبيع اللاواعي مع إسرائيل، بدءاً باتفاقيات كامب ديفيد وصولاً إلى مسار مدريد وملحقاته (أوسلو تحديداً)، أهي مصادفة، أم أن التاريخ ينتقم من سذاجات الطروحات السياسية والعسكرية لمسار العمل الوطني الفلسطيني؟
إقرأوا أيضاً:
مآلات العمل العسكري
يحاول المؤلف كيالي تتبع مسار تجربة العمل العسكري في المشهد الفلسطيني برمته، إذ يغوص في تاريخ التجربة العسكرية منذ الثورة الفلسطينية الكبرى في العام 1936، ويعتبر أن تلك التجربة قد بددت إمكانيات وقدرات الحركة الوطنية الفلسطينية في توجيه دفة الصراع مع الانتداب البريطاني بدلاً من الاستيطان اليهودي وتجلياته العسكرية، الأمر الذي أتاح للمشروع الاستيطاني التفرغ لبناء قواه العسكرية والاقتصادية، وبدّد في الوقت ذاته من القدرات الفلسطينية، وجعلها تدخل المعركة الفاصلة عام 1948 من دون سند عسكري حقيقي ومن دون ترتيب للبيت الفلسطيني بمكوناته السياسية والاقتصادية.
ويبدو هذا التحليل مسلماً به لدى الكثير من الكتاب والمؤرخين، بيد أن الواقع يشير إلى أن سلطات الانتداب البريطاني كان لها الدور الأبرز في نشوء الكيان الإسرائيلي وتأسيس الدولة، إذ لا يمكن تحديد التناقض مع الانتداب البريطاني على أنه تناقض ثانوي، مقابل الإقرار بأن التناقض كان رئيسياً مع الييشوف اليهودي آنذاك (الييشوف تطلق في الكتابات الصهيونية على التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين قبل قيام الكيان الصهيوني، الموسوعة الفلسطينية، الجزء الأول). فقد كان التحالف بين كليهما استراتيجياً، وكلاهما نقيض للفلسطينيين، ولولا بريطانيا لما قامت دولة إسرائيل.
المشكلة تكمن في أن بنية المجتمع العربي في فلسطين، وأطرها وتمثيلاتها السياسية والعسكرية، كانت أطراً مهترئة وتعاني من أزمات كبيرة، في حين أن البنية التنظيمية والعسكرية والسياسية للحركة الصهيونية، بكل مستوياتها، آنذاك، كانت خلاصة أوروبا الحديثة، ونتاج الدعم الغربي اللامحدود للمشروع الصهيوني، فلا قائمة للمشروع الصهيوني دون شقّه الامبريالي، ولا مصلحة للمشروع الإمبريالي في دعم المشروع الصهيوني من دون أن يحقق أهدافه في إقامة كيانه والاضطلاع بدور وظيفي عدواني على العرب، وإلا كيف يمكن أن نفسر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956؟
أتفق مع كيالي في كون مسار العمل العسكري الفلسطيني لم يكن مساراً مدورساً وقائماً على فكرة ضرب العدو في المواقع التي توجعه، وجعل كلفة احتلاله الأرض أعلى من المردود. فمثلاً لنتصور أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية حافظت على مدنيتها وشعبيتها، ولم تتعسكر، هل كان لإسرائيل أن تجد مسوغاتها لبناء الجدار الفاصل الذي قطّع أوصال الضفة الغربية، وجعلها كالفهد المرقط؟ وهل كان المجتمع الإسرائيلي أكثر ميلاً نحو التطرف والشوفينية لولا العمليات التفجيرية التي ضربت العمق الإسرائيلي، من دون تمييز في الأهداف، وساهمت في توحيد الإسرائيليين بتعدد ألوانهم وأطيافهم السياسية؟ أليس من الضروري تحديد الأهداف السياسية من كل عمل عسكري، أم أن المسألة هي من يحصد أكبر عدد من ضحايا الطرف الآخر؟
صحيح أن الفلسطينيين قد استدرجوا إلى ميدان الحسم العسكري، لأن إسرائيل تمتلك قوة فائقة لحسمه لمصلحتها، لكنها لا تمتلك فعل إبطال العمل الجماهيري ونضالاته الشعبية. فلست بالضرورة بحاجة “أر.بي.جي” لكبح تقدم دبابة، ولربما يبدع الفلسطينيون شكلاً آخر، قادراً على تعطيل الفعل العسكري الإسرائيلي، وجعل تأثيراته شبه معدومة.
ولربما كانت استعادة “حماس” لتجربة مجهضة، كما سماها كيالي، تعبيراً عن استعادة التجربة من دون مراجعة نقدية، فـ”حماس” كررت ما بدأته “فتح”، من دون أن تستخلص الدروس والعبر، فظنت أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كان حصيلة تصاعد العمل العسكري الفلسطيني، لا باعتباره تنفيذاً لاستراتيجية إسرائيلية تقوم على مبدأ “ترك الفلسطينيين ليقلعوا شوكهم بأيديهم”، وخوفاً من الخطر الديموغرافي، ناهيك بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، والأهم من ذلك تشتيت قضية الشعب الفلسطيني الكبرى إلى قضايا متناثرة مبعثرة. تكفي الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين هو 230 فقط إبان فترة احتلالها قطاع غزة (1967 – 2005).
في المقابل، لا يمكن التقليل من أهمية الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتجربة فلسطينيي الـ48 في مقارعتهم المشروع الاستيطاني وتمسكهم بالأرض والهوية. فالتجربة الأولى كشفت حقيقة إسرائيل كدولة استعمارية، في حين أن التجربة الثانية، أعطت دلائل على أن سياسة إسرائيل هي سياسة أبارتهيد. والتجربتان لم تسيرا على خطى العمل العسكري الفلسطيني التقليدي، وهما، فعلاً، بحاجة لدراستهما معمقاً.
من المهم ملاحظة أن كيالي لم يقدم إدانة للعمل العسكري، بل قدم رؤية نقدية لمساره، ونتائجه، انطلاقاً من ضرورة تلازم الفعل الميداني العسكري مع الفعل السياسي، لا أن يكون خبط عشواء، وهو ما يشكل مساهمة مهمة في ضرورة القراءة النقدية لمجمل تجربة العمل الوطني الفلسطيني بتعدد مستوياتها وطبقاتها. لكن المؤلف خطا منحى قسرياً في تفسيره ونقاشه للعمل العسكري الفلسطيني، انطلاقاً من مقولة الكلفة والمردود، ففي تجارب نضالية، كالحالة الفلسطينية، لا يمكن قياسها بهذا الشكل بل بما حققه الفعل العسكري الفلسطيني في وظيفته ومثابرته على الحضور السياسي، عبر مساهمته في تشكّل الهوية الوطنية الفلسطينية الحديثة. فالفعل العسكري الفلسطيني أحدث تغييراً جوهرياً في الوعي الفلسطيني، وأحدث تراكماً كمياً وتاريخياً هاماً في بلورة الإطار النضالي الفلسطيني.
الواضح أن همّ كيالي كان نقد هذه التجربة، نقداً بنيوياً وعميقاً، لكنه لم يرَ الجوانب المضيئة في هذه التجربة، ربما باستثناء العقد الأول من عمر الثورة، وهو بذلك يضعنا أمام تجربة فاشلة، في حين أن ثبات الإرادة الفلسطينية وصمودها ومثابرتها في النضال، بمختلف الوسائل كانت إحدى الأزمات العميقة للمشروع الصهيوني، إذ لم يستطع هذا الأخير تغييب الفلسطينيين لا مادياً ولا حضارياً ولا سياسياً، ولا يمكن التقليل من أهمية التجربة العسكرية أمام بنية استيطانية عسكرية.
في المقابل، يبدو السؤال مشروعاً، إن كانت التجربة العسكرية الفلسطينية فاشلة إلى هذا الحد فما هو البديل، وما هي الخيارات المستقبلية، هل نعيد تكرار الماضي عبر تجربة عسكرية جديدة، أم يتم تخليق عمل نضالي آخر؟ ما هو؟ لماذا لم يجتهد المؤلف في البحث عن مقاربات جديدة، ما دامت كل التجربة العسكرية فاشلة ولم نحقق فيها إلا المزيد من الخيبات السياسية؟
أتساءل لو لم تمر تجربة العمل الوطني الفلسطيني بمسار العمل المسلح ما هو شكل الهوية الفلسطينية الحديثة؟
صرخة ناقدة
حاول كيالي جاهداً تتبع المسارات السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية، عبر سعيها لانتهاج طريق العمل العسكري، فوجد أن الفلسطينيين متفقون في توصيف طبيعة إسرائيل، لكنهم مختلفون في ما بينهم، وبشدة في كيفية التصدي لعدوهم. فمنهم من طالب بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر (هم فلسطينيو الشتات)، ومنهم من دعا إلى إقامة دولة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
لكن الملاحظ أن نضال فلسطينيي الـ48 قد اتخذ طابعاً خاصاً بهم، طابعاً سلمياً يسعى إلى تأكيد الهوية ونيل الحقوق في إطار التعايش مع الإسرائيليين. في حين لم يتمكن فلسطينيو الضفة والقطاع من انتهاج شكل نضالي خاص بهم، إلا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، باعتبارها محطة فاصلة سبقتها هبات واحتجاجات.
لكن في الانتفاضة الثانية (أواخر 2000) حدث تطور دراماتيكي باتجاه عسكرة الانتفاضة، فبحسب المؤلف، كوادر الفصائل الفلسطينية التي عملت في الخارج، وانتقلت إلى الداخل، بفعل اتفاق أوسلو، قد نقلت خبرتها العسكرية ومنظورها السياسي، وكانت “بمثابة الحامل الموضوعي لهذه التجربة”، ناهيك بحالة التنافس بين الفصائل، ما أدى إلى بروز ظاهرة الكتائب والسرايا.
لكن الباحث لم يتطرق إلى دور بعض الدول الإقليمية الأخرى، إيران مثلاً، في دعم حركتي “حماس” و”الجهاد” الإسلاميتين وتشجيعهما على المضي في الخيار العسكري، فقد بدأت الأجنحة العسكرية لحركتين بالتشكل عبر دعم خارجي إيراني شديد الوضوح.
إن التوريط الإيراني كان واضحاً وجلياً لاستثماره في صراعاتها وأجنداتها الخارجية، وذلك في إطار مزاعمها أن “دفاعها” عن فلسطين يأتي في إطار دفاع ما عُرف بأن فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية.
واضح أن المؤلف استطاع تتبع مسار أسطرة الكفاح المسلح، وقد عزاها إلى ما سماه بالأسطورتين الأساسيتين: إن قضية فلسطين قضية كل العرب، والشعب الفلسطيني لديه من القوة لتحقيق ذلك. وإزاء ذلك تضخم من جديد العمل العسكري، وباتت النظرة التقديسية له خارج أي نقد أو مساءلة أو مراجعة.
صحيح أن كيالي انطلق في نقده تجربة العمل الفلسطيني بشقه العسكري من الشعارات التي راجت من قبيل: لا سلاح يعلو فوق البندقية، إلا أن الصحيح أيضاً أن السلاح شكّل رمزية فلسطينية بالغة الأثر والتأثير للحيز المكاني للاجئين الفلسطينيين، فمن دون وجود رمزية مقاومة ومسلحة للاجئين الفلسطينيين، لا معنى أبداً للوجود الكياني للفلسطينيين.
المقصود أن الوجود الفلسطيني في المخيمات قد ارتبط عضوياً بتجربتهم العسكرية، بغض النظر عن نتائج هذه التجربة، لكن هذا الحيز ما كان له أن يتشكّل وفق المنطق التاريخي الذي آل إليه دون مروره الطبيعي، أو غير الطبيعي، في مرحلة الكفاح المسلح الفلسطيني.
ما أعنيه أن الوجود الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية قد صبغ بالنزعة العسكرية، ولولا هذه النزعة ما كان له أن يصقل بهذا الشكل أو ذاك الهوية الفلسطينية الحديثة. لماذا أقول ذلك، لأن الفلسطيني، ابن المخيمات، ابن اللجوء، حُرِم الهوية، وبات اللجوء هويته، وعنوان لجوئه يتحدد بنضاله ومثابرته على الحضور سياسياً ومقارعة المحتل الإسرائيلي عسكرياً، لكأن طغيان العمل العسكري كان موضع تقديس عال بالنسبة للفلسطينيين.
كيالي لم يأخذ في الاعتبار أن تجربة العمل العسكري الفلسطيني كانت أساساً تجربة اللجوء وتجربة المخيمات وتجربة التشتت، ولو أخذ كيالي بذلك، ربما سيكون أمام استنتاجات سوسيولوجية وسياسية مختلفة، وأقل حدة مما توصل إليه.
إن فقدان الفلسطينيين الأرض – القاعدة، واختبارهم تجربة اللجوء المر جعل من الارتجال والعفوية في العمل العسكري منهجاً مسيطراً، لكنه ارتجال ولّد نمطاً كفاحياً مميزاً يستوجب المراجعة والنقد.
أتساءل لو لم تمر تجربة العمل الوطني الفلسطيني بمسار العمل المسلح ما هو شكل الهوية الفلسطينية الحديثة؟ هل كان وعي الفلسطيني بذاته مثلما هو عليه الآن؟ هل كان ممكناً الاستمرار بالتعبير عن الهوية الفلسطينية بعد مرور أكثر من 7 عقود على نكبة فلسطين؟ أعتقد أن الراهن قد أخذ مشروعيته من السابق، لكن من الأهمية بمكان نقد السابق للتأسيس لمرحلة جديدة، مرحلة تستفيد من الأخطاء الاستراتيجية، وتبني أفقاً نضالياً جديداً، وهنا تكمن أهمية الكتاب.
نقد العفوية في التجربة الفلسطينية
شكّلت المساهمة الفكرية والسياسية التي قدمها كل من الياس مرقص وياسين الحافظ وصادق جلال العظم تحولاً جوهرياً في فهم ماهية الصراع مع إسرائيل، لأن المفكرين الثلاثة ربطوا قضية فلسطين بواقع التخلف العربي وعلى مستوياته كافة.
فمن المعروف أن الياس مرقص كان واضحاً وجلياً في نقده عفوية العمل الفدائي، لا سيما في كتابيه: “عفوية النظرية في العمل الفدائي” (دار الحقيقة، 1970) و”المقاومة الفلسطينية والمواقف الراهن” (دار الحقيقة، 1971)، وأيضاً ياسين الحافظ في كتابيه: “اللاعقلانية في السياسة” (دار الطليعة، 1975)و “الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة” (دار الطليعة، 1978) و صادق جلال العظم في كتابه: “النقد الذاتي بعد الهزيمة” (دار الطليعة، 1968) لكن كيالي اختار أن يناقش مساهمات مرقص والحافظ، بينما لم يتناول أفكار العظم بالنقاش في هذا الخصوص.
فقد اعتبر مرقص في كتابه “المقاومة الفلسطينية والموقف الراهن” أن أكبر خطأ وقعت فيه المقاومة الفلسطينية، على الصعيد العسكري، أنها لم تصغ نظريتها العسكرية، بل تركت لعفويتها وسذاجتها ومنتفعيها وأوهامها. عاشت شطحاً فكرياً بالغاً، لم يقنع التجربة العسكرية الفلسطينية بأن العمل الفدائي لن يحرر فلسطين، ولن يكسر شوكة المشروع الصهيوني.
فبرأيه: “نمت المقاومة الفلسطينية بعد عدوان حزيران (يونيو) 1967، وخلال عام 1968 (معركة الكرامة)، وبعد مدة من الزمن أخذت في الانحسار. ففي عام 1970 خاضت معاركها الكبرى خارج فلسطين، في عمان وإربد والسلط، إلخ. وكانت هذه المعارك أكبر مئة مرة من معاركها في نابلس والخليل وغزة وحيفا ويافا”… و”بدلاً من أن تكون لدينا نظرية واستراتيجية وتكتيك، وبدلاً من أن يكون لدينا تصور عن الواقع والمستقبل والاحتمالات والسبل والمراحل والهجوم والدفاع والسياسة والحرب يكون لدينا شعارات” (ص 15ـ 21)… و”إن الأيديولوجيا المقاومة قد منحت براءة ذمة وجواز مرور لجمعية المنتفعين بالقضية الفلسطينية. تلك هي وظيفتها الموضوعية المشهودة في العيان” (ص 102).
هكذا انتقد مرقص العمل الفدائي وتجربة العمل العسكري، وهكذا سعى كيالي للاستفادة من نقد إلياس مرقص لتدعيم وجهة نظره، بأن العمل العسكري الفلسطيني لم يحكمه سوى النزعة الإرادوية والأوهام، والأخطر من ذلك الأيديولوجيا التي جعلت من المقاومة الفلسطينية جوهراً مقدساً لا يجوز الاقتراب منه أو نقده.
إقرأوا أيضاً:
كما أن ياسين الحافظ قد اشتغل على الموضوع ذاته، فوجد أن اللاعقلانية في السياسة هي أهم الأسباب في إخفاق المشروع العربي التحرري برمته، وأن الأيديولوجيا تسلب الواقع، لأنها تخلق واقعاً متخيلاً، بدل واقع حقيقي. يقول في كتابه “التجربة التاريخية الفيتنامية”: “في الصراع العربي- الإسرائيلي كثير من الأوهام ينبغي أن تبدّد، وتبديد هذه الأوهام، هو الشرط الذي لا بد منه لقلب التفوق الإسرائيلي. إن التطور الفكري للشعوب يتلخص في انتقالها الطويل البطيء المتلاحق من الأسطورة والأيديولوجيا إلى الحقيقة الواقعية… ينبغي أن نخرج رؤوسنا من الواقع لا أن نخرج الواقع من رؤوسنا، وهذه هي نقطة البداية في مواجهة عقلانية، وبالتالي ناجعة للتحدي الإسرائيلي. يقيناً إن الأيديولوجيا ترزقنا بأمل ما يشدّ عزائمنا، غير أن الأمل الواهم لا يصنع تقدمًا ولا ينتزع تحرراً… آن لنا أن نجعل آمالنا مرتكزة على صخرة الواقع الصلبة لا الأوهام والأيديولوجيا… لأن آمالنا لم تكن ترتكز على أرض الواقع تكسرت رؤوسنا وما تزال على صخور هذا الواقع” (ص 26).
بالمقابل اعتبر العظم في كتابه (النقد الذاتي بعد الهزيمة) أن الهزيمة كانت بسبب عوامل داخلية، وأنها ليست بفعل عامل خارجي، بمعنى أن هزيمة النظام الرسمي العربي في حرب حزيران سنة 1967 كانت تحصيل حاصل لهزيمتنا كعرب في كافة المجالات، يقول العظم: “من الأخطاء المريعة التي وقع فيها العرب بالنسبة لقضيتهم الأولى الاستخفاف الشديد بقوة العدو. أما الخطأ المريع الثاني… فهو تضخيم قوتها ونفوذها إلى حد صبغها بقدرات أسطورية فائقة، تجعلها سيدة النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي ومجرى التاريخ مرة واحدة. وبطبيعة الحال إن تضخيم قوة العدو وسطوته ونفوذه على هذا النحو الخيالي هو أسلوب من أساليب تبرير فشلنا، وإسقاط مسؤولية الهزيمة على أسباب خارجة عن نطاق إرادتنا” (ص 69).
واضح أن اختيار كيالي لهذين المثقفين العربيين (مرقص والحافظ) كان غايته التأكيد على أن العقل السياسي الفلسطيني لم يستطع أن يخرج من إطار عفويته وسذاجته ولربما طموحه وأحلامه في تحقيق الحد الأقصى، عبر التمني بكون الشعب الفلسطيني هو الطليعة لتحرير فلسطين، في حين أن هذا الشعب هو مشتت، ولاجئ، ويعيش تحت سطوة أنظمة قمعية همّها المحافظة على استقرارها، والذي هو بحد ذاته استقرار للكيان الإسرائيلي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يعالج كيالي موقف العظم سيما أن له تجربة واحتكاك ثرية في العمل الفلسطيني والبحثي؟
عن “نقاش السلاح”
حصيلة ما أراد الباحث تأكيده أن فكرة الكفاح المسلح أدّت دورها في استنهاض الفلسطينيين، كما يسميها، “من الضياع والتشتّت، ومكّنتهم من وعي مكانتهم كشعب”، والآن آن الأوان للتفكير بصوت عال، ومناقشة مستقبل النضال الفلسطيني بلا خوف من كسر المحرمات، وبعيداً من لغة التحامل أو التخوين أو الشك.
كتاب نقاش السلاح، وإن كان يعالج المستوى الميداني للتجربة الفلسطينية، إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال التقليل من أهمية تلك التجربة، بكل علاتها وإشكالياتها، لأنها كانت تجربة اللجوء والمخيم ولأنها أساس تشكّل الهوية الوطنية الفلسطينية الحديثة. على رغم التحول الاستراتيجي والنوعي في التجربة العسكرية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، ودخول قيادة منظمة التحرير القفص الحديدي الإسرائيلي، ما يعني استثماراً سياسياً بالغ السوء للانتفاضة الفلسطينية الأولى.
كتاب “نقاش السلاح” يحمل في طياته فكرة أن أي مشروع سياسي دون حامل سياسي- ثقافي مآله الفشل، لأن العفوية والسذاجة سوف تتحكمان به، وتصوغان مساره ومآلاته، وهو دعوة إلى إعادة التفكير بحاضرنا، والاستفادة من دروس ماضينا، حتى نستطيع أن نرسم لمستقبلنا، مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية والحلم الفلسطيني أفقاً جديداً.
كما أن كتاب كيالي، وإن كان كتاباً سياسياً، لكنه يحمل من الطهارة السياسية بعداً كبيراً، لأنه يتأسس على النقد والمساءلة والمكاشفة والمصارحة. قد نختلف هنا وهناك، لكننا نتفق بالجوهر على أن البعد الطهراني والأخلاقي هو ما يجعل من الكتاب أفقاً مفتوحا للنقاش، ويدعو للتفكير خارج الصندوق، لأنه يرى أن مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني كانت تسير دون استراتيجية واضحة، بل طغت عليها العفوية والارتجال، ما زاد من أعباء الكلفة على حساب المردود، لهذا كان هم كيالي هو مقاربة عقلانية لسؤال أخلاقي – سياسي وهو: كيف يمكن للفلسطينيين أن يناضلوا وفق استراتيجية نضالية مجدية وذات كفاءة عالية؟
من الواضح أن كيالي اشتغل على تفكيك معادلة الفعل السياسي مع الفعل الميداني في الحالة الفلسطينية، فوجد أن الفعل السياسي لا يتوافق مع العمل العسكري الميداني، والأخير كان يخط طريقه من دون وجود رؤية استراتيجية واضحة، وإلا فما معنى أن نتكبد في كل معركة خسائر كبيرة، ولا نحصد نتيجة سياسية تتوافق مع الهدف الاستراتيجي للمشروع الوطني الفلسطيني (هذا على افتراض أن محددات هذا المشروع واضحة ومتفق عليها)؟
صحيح أن الفعل الميداني العسكري للانتفاضة الثانية قد كبّد إسرائيل خسائر كبيرة، لكن الصحيح أيضاً أننا كفلسطينيين خسرنا عالمياً، لأن الفعل السياسي لم يتوافق مع العمل العسكري، ولم يتم استثمار نتائج الفعل الميداني.
حقيقة ثمة مفارقة كبيرة في القضية الفلسطينية تتجسد في تفوقها الأخلاقي، مع العجز مقابل القوة العسكرية الإسرائيلية، لكن كيف يمكن تحويل هذا البعد الأخلاقي لقوة سياسية تتضافر مع نتائج الفعل الميداني، هذه إحدى الإشكاليات التي يطرحها كتاب كيالي، من دون أن يغوص فيها، لكنه يدعونا إلى التفكير ملياً في هوامشها وإشكالياتها.
لا يمكنني أن أصف الكتاب”نقاش السلاح… قراءة في إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية” إلا باعتباره كتاباً يحرّض العقل السياسي الفلسطيني على إعادة النظر ليس في النقاش والسجال حول التجربة العسكرية، وحسب، بل أيضاً في مجمل القضايا الفلسطينية الشائكة، وهو حقل كان المؤلف قد دشنه عبر نتاجاته السابقة.
إقرأوا أيضاً:












