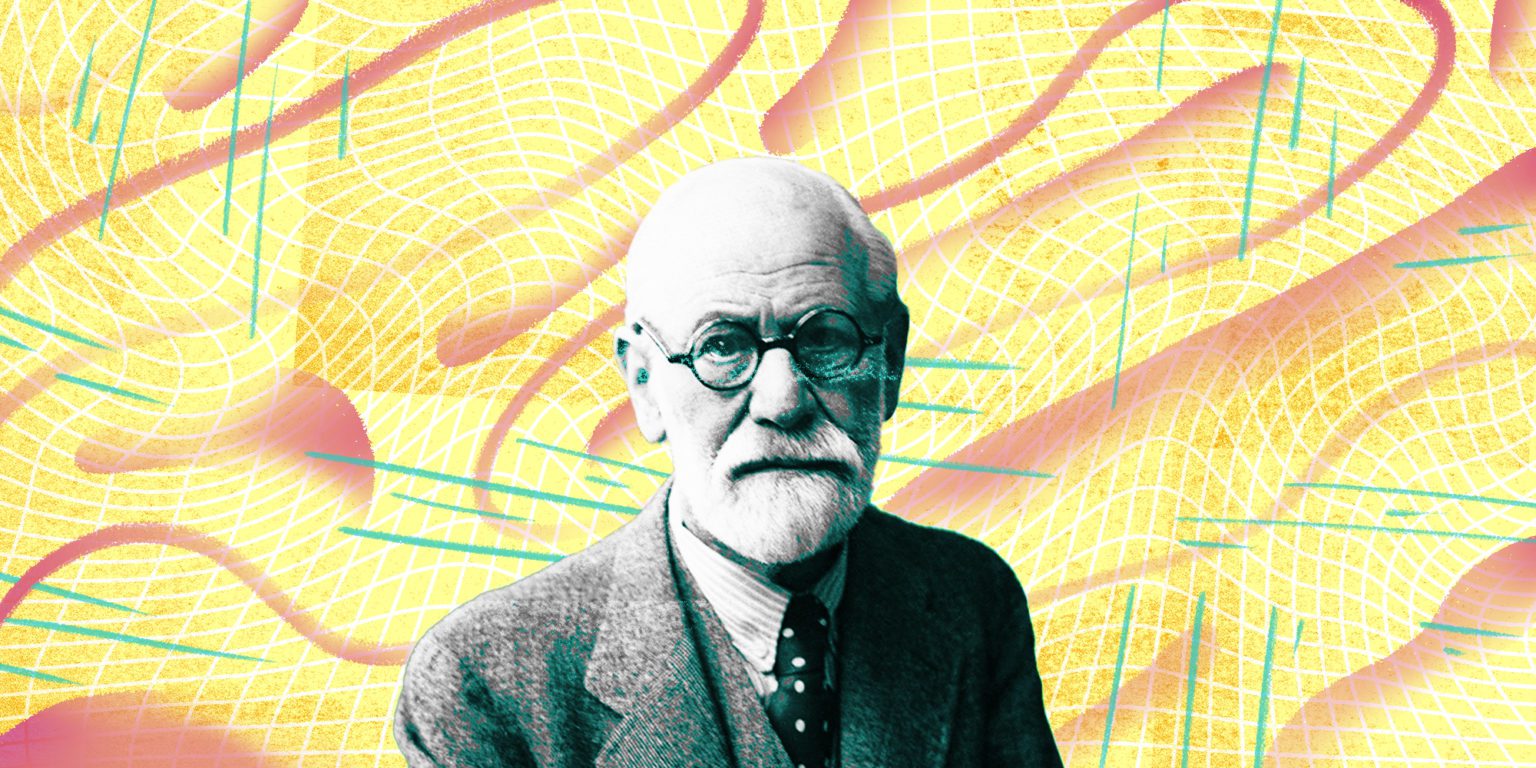عام 1922 كانت أفكار الآباء الأوائل لعلم نفس الجماهير، خصوصاً سيغموند فرويد، تنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأميركية. وقتها نشرَ الكاتب السياسي الرائد والتر ليبمان كتابه “الرأي العام“، قال فيه: “إذا كانت القوى غير العقلانية هي من يقود الإنسان، إذاً يجب أن نعيد النظر في الديموقراطية”.
كان ليبمان وهو الكاتب السياسي الأكثر شهرة ونفوذاً في الولايات المتحدة آنذاك يرى، كفرويد، وويلفريد تروتر، وغوستاف لوبون- أن الآلية الأساسية للعقل الجَمعي هي (اللامنطقية)، و (اللاعقلانية)، و (الحيوانية)، بحيث أننا لا نستطيع أن نُعوّل على رَجَاحة عقول الجماهير، إذ تقودهم بشكل طبيعي نزوة حيوانيّة، ومحفزات غير واعية، وغرائزية كامنة أسفل سطح الحضارة.
لهذا السبب رأى ليبمان أن المطلوب هو وجود نخبة لتقود ما سماه “القطيع الحائر” The Bewildered Herd ، هذه النخبة، بحسبه، هي طبقة متخصصة من المثقفين وخبراء وسائل التواصل الجماهيري، يجب أن تعمل ضمن نطاق حكومي (بروباغندا حكومية) تَستخدم أساليب سيكولوجية، من أجل التغلّب على العيب الأساسي في الديموقراطية عبر إبقاء المشاعر اللاواعية لدى الجماهير تحت السيطرة.
تعبير مشابه جاء على لسان شخصية أخرى بارزة كانت ذات تأثير كبير على صنّاع القرار في الولايات المتحدة آنذاك، ألا هو عالم الأخلاق واللاهوت الأميركي رينهولد نيبوهر، الذي كان يرى أن العقلانية تنتمي إلى ذاك “المراقِب الهادئ”، بينما الإنسان العادي، بحكم غبائه، فإنه لا يتّبع العقل، بل ينصاع للإيمان، وهذا الميل الفطري نحو الإيمان الساذج لدى الإنسان العادي يتطلّب وجود “أوهام ضرورية”، ومبالغة في التبسيط العاطفي للقضايا، وأن تتم الاستعانة بصنّاع الأساطير وأفلام الخيال، وذاك -على حد تعبير نيبوهر- لـ “إبقاء الإنسان العادي في المسار الصحيح”.
الفكرة التي تقول بالحاجة الضرورية لوجود أسطورة، أو وهم، أو كذبة كبيرة لإقناع الناس بالمضي قُدماً ضمن “المسار الصحيح”، أقصد أن الفكرة التي تقول بضرورة وجود كذبة لإقناع الناس بأن يمنحوا ثقتهم لسلطة معيّنة، هي فكرة لم تبدأ من ليبمان، ولا من نيبوهر، بل هي قديمة، كان الوهم ولا يزال لصيقاً بالإنسان منذ بداياته الأولى، وهمٌ يصبُّ الأمل الإنساني في قالب واحد إذ ينوء الناس تحت وطأة العبء الفادح للوجود، كذبة تمدّ الجهد الإنساني بالطمأنينة والعزاء، أسطورة تبعث في النفس الحماسة للتحرك والمتابعة والعمل والبناء.
يتابع هذا المقال موضوعاً غاية في الأهمية: كيف استَخدمَ مَن بِيدهم زمام الأمور نظرياتِ فرويد والتحليل النفسي ليَحكموا الجموع “الخَطِرة” في عصر الديموقراطية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؟ كيف اتخَذَت الحضارة الإنسانية ذاك المنعطف الذي أودى بها اليوم ضحيّة في قبضة وسائل الدعاية والإعلان، صُنّاع الرغبات، شركات الإنتاج، الديكتاتورية بشكلها “المستنير” الحديث؟
والأهم: كيف تتم صناعة الذات الاستهلاكية العالمية بصيغتها المتوحشة والبذيئة التي غيرت شكل الحياة على الأرض إلى غير رجعة، والتي تقود الجنس البشري بخطى ثابتة نحو الانقراض، الفناء، أو الموت؟
حين أدركت “الدولة الحديثة” أنها لن تستطيع في ظل الديموقراطية استخدام العصا في تلقين شعوبها، وحين أدركت في ظل الديموقراطية أيضاً أن صوت الشعب هو المسموع، ارتأت أن تلجأ بالتالي إلى التحكّم بما يفكرون، ولهذا السبب كانت البروباغندا، أي: خلق الأوهام من أجل صناعة الموافقة، ونيل القبول والشرعية والرضا.
آنا فرويد ابنة عالم النفس الشهير، إلى جانب ابن اخته إدوارد بيرنيز الذي اخترع مهنة “العلاقات العامة”، لعبا دوراً محورياً في صناعة الوعي والرأي العام الأميركي منذ الثلاثينات، أثّر استغلالُهُما أفكار فرويد عن “اللاوعي الإنساني” في قلب الاقتصاد والسياسة، اعتقد الاثنان أن ذاتاً غير عقلانية كامنة أسفل السطح، وأن هذه الذات يجب أن تخضع للرقابة وإعادة الصياغة والتوجيه، وذلك لمصلحة الفرد، ولمصلحة استقرار المجتمع والدولة.
غير أن هذا لم يدم طويلاً، ففي أواخر الخمسينات بدأت تنهال الانتقادات على شركات الإنتاج وصنّاع القرار في الولايات المتحدة، تم اتهامها باتّباع أساليب نفسية للسيطرة على الناس، وتحويلهم إلى (دمى)، وصرفهم عن التشكيك بواقع حياتهم أو مآلاتها، وذلك عبر صناعة رغبات وهمية من جهة، ودفع الناس إلى العمل والانشغال في تلبيتها من جهة أخرى.

وتزامناً مع هذه الانتقادات التي توّجها كتاب “المقنّعون المخفيّون” لفانس باكارد عام 1957، كانت مجموعة من المحللين النفسيين المنشقّين عن المدرسة الفرويدية تقوم بتجارب من نوع جديد: ماذا لو شجّعنا “المرضى” على التعبير عن مشاعرهم بصراحة حتى لو كانت غاضبة أو عنيفة؟!
شكّلت هذه الفكرة انقلاباً على إرث عائلة فرويد والتحليل النفسي الذي نال حصّته من الثراء والشهرة، اعتبرَ الخصومُ الجدد أن آل فرويد كانوا مخطئين في ما يخص “الطبيعة البشرية”، فمن وجهة نظرهم لم يكن اللاوعي الإنساني خطيراً يجب قمعه وتوجيهه، بل على العكس، يجب تشجيعه ودفعه للخروج، فشأن ذلك أن يمنح الإنسان المزيد من الثقة حين لا يؤرّقُهُ كبتُ ما يجول في خاطره، من شأن ذلك، على حد تعبيرهم، أن يساهم في تكوين إنسان أقوى وأكثر وضوحاً وصراحة، وبالتالي مجتمع أكثر تحرراً وقوة وفاعليّة.
لكن في الحقيقة، ما كان على وشك أن يتمخّض عن هذه الفكرة هو هذا الإنسان الجشع كخنزير، الإنسان الأكثر قابلية للتلاعب والخداع، الإنسان الذي سيشكّل عِماد اقتصاد عالمنا اليوم وفساده واستبداده، إنسان يمكن تدجينه داخل حظيرة الدولة، عبر تغذية رغبات لانهائية، رغبات وهمية صنعتها وفرضتها وسائل الدعاية والإعلان، ووسائل التواصل الجماهيري، ومن ورائها النظام السياسي والاقتصادي.
زعيم هذه المجموعة المنشقة كان شخصاً يكرهه فرويد وعائلته، يُدعى فيلهلم رايش، خلال العشرينات كان طالباً مخلصاً لفرويد في فيينا، لكنه عارضه في ما يخص أسس عمل التحليل النفسي، ففي حين جادل فرويد بأن الناس تقودهم غرائز حيوانية بدائية على المجتمع أن يكبح جماحها، ذهب رايش إلى النقيض تماماً، وهو أن جوهر الناس طيب لو لم يُشوّههم قمع المجتمع لهم، وأن المجتمع حين يضغط عليهم كيلا يكونوا على طبيعتهم (الأصليّة الطيبة) إنما هو بذلك يحوّلهم إلى متوحشين، مرضى.
بحسب رايش كان الدافع الإنساني الطبيعي الأساسي الذي يتعرّض لضغط المجتمع هو الدافع الجنسي (ليبيدو) الذي يُشكّل كبتُه أصلَ الشرور جميعها، كما رأى رايش أن مرض العُصاب ناتج عن عدم حصولنا على هزة جماع مُرضِية.
هذه الفكرة وضعت رايش في مواجهة مع آنا فرويد التي اعتبرت الدافع الجنسي خطيراً يجب التحكم به؛ وصل الصراع بينهما إلى ذروته حين أجبرت أنا فرويد رايش أن يغادر مؤتمراً يخص التحليل النفسي عام 1934 في سويسرا.
بنى رايش منزلاً ومختبراً في الولايات المتحدة، قال أنه اكتشف مصدر الطاقة الجنسية وأطلقَ عليه اسم “أورغون”، بنى مسدساً عملاقاً قال إنه يستطيع التقاط الطاقة الجنسية من الجو وإرسالها نحو الغيوم لصناعة المطر، لا بل قال أيضاً إن مسدسه قادر على التصدي للكائنات الفضائية التي قد تهدد مستقبل البشرية.
عام 1956 ألقت الشرطة الفيدرالية القبض عليه بتهمة بيع جهاز زعم أنه يستخدم الطاقة الجنسية لعلاج السرطان، فتعاملت معه السلطات على أنه مجنون، تم سجنه وأحرقت كتبه بأمرٍ من المحكمة ليموت في السجن عام 1957.
خلال الخمسينات، وبفضل التحليل النفسي الفرويدي كان النظام الاستهلاكي الأميركي يتصدّر المشهد الاقتصادي العالمي، وظّفت كبرى شركات الإعلان محللين نفسيين اشتغلوا ضمن نطاق واسع على صناعة مستهلك شغوف، وخرجوا من ذلك بغلّة كبيرة على المستويين المادي والمعرفي.
لكن، مع بداية الستّينات كان جيل أميركي جديد قد بدأ التفكير بطريقة مختلفة، لم تُعجبه طريقة إدارة الأمور، فصبّ جام غضبه على شركات الأعمال، انتقدها وهاجمها بشدة، واتّهمها باستخدام تقنيات علم النفس للتلاعب بالناس وخداعهم وتحويلهم إلى مستهلكين مثاليين لضمان سير أعمالها وزيادة رأسمالها.
وهكذا بدأت احتجاجات جامعية في الولايات المتحدة قبل أن تصل في ما بعد إلى أوروبا، اتهم الطلاب الحكومة الأميركية بغسل أدمغة مواطنيها، وبأن تعزيز النزعة الاستهلاكية لم يكن مجرد وسيلة لكسب المال وتحسين سير عمل النظام الاقتصادي، بل وسيلة للحفاظ على الجماهير تحت التخدير لمواصلة حرب دموية في فيتنام.
ماركوزه والبعد الواحد
أحد الآباء الروحيين للحركة الاحتجاجية في الولايات المتحدة كان الفيلسوف الألماني هربرت ماركوزه، مؤلف كتاب “الإنسان ذو البعد الواحد“، درس ماركوزه التحليل النفسي، وهو من أشد المنتقدين لمدرسة فرويد.
بحسب ماركوزه، تمتلك السلطة الحديثة وسائل متطورة لا لتتحكم بوعي الأفراد فحسب، بل في لا وعيهم أيضاً، وذلك باستخدام تقنيات علم النفس، فحاجات المجتمع الحديث وهمية، تمّت صناعتها من قبل وسائل الدعاية، لتحسين الاقتصاد ولإبقاء الناس تحت السيطرة، هكذا تتم عملية تكوين الإنسان ذي البعد الواحد.
والمجتمع ذو البعد الواحد، بحسب ماركوزه، هو المجتمع الذي يُزيّف وعي الفرد، فيستبدِل السلطة الخارجية المفروضة عليه بنوع من المحَاكَمة الداخلية التي يُمارسها الفرد على نفسه، فحين يرتهِن هذا الفرد لحاجاته الوهميّة التي تمّت صناعتها يصير عبداً لها، وبالتالي يصير صالحاً ومُطيعاً، لا بل يصير هو نفسه الساهر على حماية النظام كي يستمر هذا النظام بتلبية حاجاته المادية، يصير إنساناً يتوهّم بأنه حر لمجرّد أنه يستطيع أن يختار بين تشكيلة واسعة من البضائع والمنتجات.
لا يقف الموضوع عند هذا الحد، لأن المجتمع ذا البعد الواحد لا يسعى إلى تزييف الحاجة المادّية فقط إنما الفكرية أيضاً، إنه يسعى عبر أجنداته وتقييماته وجوائزه التي يمنحها إلى تحجيم دور الثقافة والقدرة على الحكم والتفكير، إذ يسلب الأفراد قدرتهم على الشك في النظام وانتقاده، لدرجة يتم اعتبار التمرّد بحد ذاته ضمن هذا الوضع نوعاً من الاعتلال النفسي والرغبة السوداوية بالتخريب.
بتأثير من أفكار ماركوزه خرج الطلاب في الولايات المتحدة إلى الساحات للتظاهر، عبّروا عن رغبتهم بنظام يخلو من قيم الماديّة والجشع التي تهيمن على النظام الأميركي، ودعوا عبر شعاراتهم إلى أن يتخلّص كل فرد من الشرطي الجالس في رأسه، هذا الشرطي الذي يمثّل الدولة والشركات، وهكذا، شيئاً فشيئاً، انزلق المتظاهرون إلى العنف.
في مقابل عنف الطلاب، ردّت الحكومة الأميركية بوحشية على التظاهرات، في شيكاغو عام 1968 أطلقت الشرطة العنان لمهاجمة الآلاف من المتظاهرين، كانت تلك الحادثة بمثابة القمع الوحشي لليسار في الولايات المتحدة.
استنتجت جماعات اليسار الأميركي بعد هذه الحادثة أنه من المستحيل تجاوز شرطيّ الدولة بالعنف، لكن على الأقل يجب أن يسعى كل فرد إلى إخراج ما يمثّله هذا الشرطي داخل رأسه، أن يتأمل كل شخص مجموع أفكاره ويعيد النظر فيها، أن يبحث عن تلك القيود التي قيّد بها النظام السياسي عقول الناس، بُغية التحرر منها والانعتاق، وبالمحصّلة فإن مجموع هذه الذوات الجديدة- بحسب تصوّرهم- ستشكّل في ما بعد نواة المجتمع الجديد.
هكذا انكفأت جماعات اليسار الأميركي على نفسها أواخر الستّينات، ظنّوا أنه إذا اشتغل كل فرد على نفسه وحرّرها من القيود التي فرضتها السلطة فإن هذا الأثر سيطرأ على المجتمع ككل، أي: ذات اجتماعيّة جديدة في مجتمع صحّي دون الحاجة لمقارعة الحكومة أو ممارسة السياسة أو الخوض في تعقيداتها؛ ولأجل ابتكار هذه الذات المتحررة الجديدة انجذبوا إلى أفكار فيلهلم رايش.
إقرأوا أيضاً:
العلاج الغشتالتي
لم يكن العمل على أفكار رايش قد توقّف مع موته وإحراق كتبه، إذ كانت هناك بالفعل مجموعة من المعالجين النفسيين تعمل على تطوير وسائل جديدة بالاعتماد على أفكاره، تتضمن هذه الوسائل تعليم الأفراد كيفية تحرير أنفسهم من الضوابط التي وضعها المجتمع وربّاهم عليها، أحد أفراد تلك المجموعة كان يدعى فريتز بيرلز، صاحب ما يُسمّى بـ “العلاج الغشتالتي“.
تلقى بيرلز تدريباً على يد فيلهلم رايش، وكان أحد مساعديه، عام 1964 انتقل للعمل في فندق صغير على الساحل الغربي لكاليفورنيا، كان هذا الفندق تحوّل إلى معهد شارك في تأسيسه الكاتب الشهير ألدوس هكسلي، وكان الغرض من المعهد أن يتم العمل فيه على مفاهيم (تطوير الذات)، سُمّي وقتها: معهد إيسالِن.
داخل المعهد قام بيرلز بعقد حلقات لقاء جماعية، كان يحرّض فيها الأفراد كي يُعبروا علناً عن مشاعرهم التي يعتبرها المجتمع خطيرة، ويسألهم عما إذا كانوا يشعرون بالثقة، القوة، الاستقلالية، الحرية، أو الصراحة، حين يقومون بذلك.
اعتَبرَ المحللون النفسيون القائمون على معهد إيسالن أنهم يعملون على مساعدة الأفراد كي يكونوا “حقيقيين” في التعبير عن ذواتهم، وذلك على اعتبار أنهم “لن يتحرروا قبل أن يتحرر تعبيرهم عن أنفسهم”.
بالنسبة إلى شبّان اليسار الذين شهدوا الهزيمة أمام الشرطة الأميركية في شيكاغو كانت هذه التقنيات المستخدمة في معهد إيسالن بمثابة الشرارة التي سيبدأ معها تكوين الذات الأميركية الجديدة، ذات حرّة ومستقلة وقوية بما يكفي لتغيير النظام السياسي.
وهكذا مع بداية السبعينات كان معهد إيسالن أشبه بالمغناطيس، يستقطب الأميركيين الذين جاءوا لاكتشاف هذا الإحساس الفتّان بـ”الحرية” التي يَعِدُهم إياها، صار المعهد نواةً لحركة شهيرة على مستوى أميركي وعالمي تدعى “حركة الإمكانات البشرية“، وبعد نحو 5 سنوات سيتأسس نحو 200 معهد على شاكلة معهد إيسالن في الولايات المتحدة.
كالنار في الهشيم انتشرت فكرة “اكتشاف وتطوير الذات”، في الولايات المتحدة مطلع السبعينات، حتى صار رُوَّادُها بمثابة “مركز” للثقافة البديلة المناهضة لتلك التي يُروّج لها النظام، ثقافة تقوم على فكرة تخليص الذات من قيم “الرأسمالية الفاسدة”.
سبَّبَ هذا التغيير الحاصل في المجتمع الأميركي أزمةً للشركات التي ما عادت- كما في السابق- قادرة على التنبؤ بما يريده المستهلكون، ولهذا الغرض لجأت الشركات كالعادة إلى علماء النفس والاجتماع.
دانيال يانكلوفيتش، محلل نفسي وعالم اجتماع، صاحب خبرة بالطب النفسي وأبحاث السوق من جامعتي هارفارد والسوربون، استشارَتهُ إحدى الشركات للتحقيق في توجّهات هؤلاء المستهلكين الجدد بأفكارهم الثوريّة.
راح يانكلوفيتش يعمل على تحقيقه، وحين انتهى خرج مصدوماً بخلاصة مفادها أن هذه الذات الجديدة ليست لا جماعة ثورية ولا سياسية وليست لديها مطامح جادة لتغيير الواقع الاقتصادي أو السياسي، بل هي ذات تدور في فلك الحق بالتعبير عن النفس، والرغبة العارمة بالتعبير عن النفس.
قام يانكلوفيتش بتتبع نمو وسلوك هذه الذات التعبيرية الجديدة، وأخبر الشركات أن هذه الذات هي مستهلِكَة كسابقتها، لكنها ببساطة سئمت من المنتجات التي تسعى إلى تصنيفها بشكل نمطي ضمن الطبقات التقليدية للمجتمع الأميركي، أخبر الشركات أن هؤلاء الأفراد يريدون تلك المنتجات التي من شأنها أن تساعدهم على التعبير عن فردانيتهم واختلافهم في عالم يتشابه فيه المستهلكون.
لطالما كان للمنتجات معنى عاطفي، هذي هي الفكرة المركزية التي قامت عليها مهنة العلاقات العامة منذ العشرينات، لكن ما استجدّ في السبعينات هو الفردانية، فكرة أنّ هذا المنتج يعبّر عنك، هذه السيارة المصنوعة في البلد الفلاني تعبّر عن شخصيتك، كذلك الأمر نوع الموسيقى الذي تسمعه، أو الكتاب الذي تقرأه، أو الملابس والاكسسوارات التي ترتديها… كل هذه الأشياء بدأت تشكّل في ذلك الوقت محور علاقة الناس بإنفاق أموالهم، يدور كل ذلك لغرض أن يقولوا للعالم من هم، وأن يعبّروا عن ذواتهم.
في الستّينات كان الغرض من فكرة “تطوير الذات” هو الانتقال من تحرّر الفرد إلى تحرر المجتمع، وبالتالي تغيير “ناعم” للنظام السياسي؛ لكن في السبعينات ومع ظهور الفردانية أخذ الموضوع بعداً آخر، إذ بدأت تنبثق جملة من الأفكار الجديدة التي ستدير دفّة التاريخ إلى منعطف خطير، منها تلك الفكرة القائلة بأن الناس يمكن ببساطة أن يكونوا سعداء مع أنفسهم، دون الحاجة للمجتمع، وأنّ الهدف من سعينا نحو التغيير -على المستوى الفردي- ليس الغرض منه تغيير المجتمع أو الخوض في مسائل السياسة، إنما أن نظل سعداء مع أنفسنا، بما نختاره لها.
من خلال هذا الفهم الأميركي – السبعيناتي للحرية تم إبعاد المجتمع والسياسة عن حيّز علاقة الإنسان بالعالم، صارت الحرية تعني أن تكون “كريماً” تجاه نفسك، أن تُدلّلها وتشاركها الدلال، بعيداً مما يحصل على مستوى المجتمع، السياسة، والعالم. إنها فكرة تعني أن تكون اشتراكياً لكن على نطاق فرداني، أو بعبارة أخرى: أن تكون رأسمالياً باعتبار شخصي وخاص عن الحرية، إنها فكرة نيو- ليبرالية.
لطالما كان للمنتجات معنى عاطفي، هذي هي الفكرة المركزية التي قامت عليها مهنة العلاقات العامة منذ العشرينات، لكن ما استجدّ في السبعينات هو الفردانية، فكرة أنّ هذا المنتج يعبّر عنك.
كيف نعبّر عن هذه الذات؟
خلال الثمانينات كانت الغالبية العظمى من الأميركيين قد انشغلت بموضوع “اكتشاف الذات”، ظهرت جماعات الهيبيز، والطوائف والأديان الجديدة، والمرشدون أمثال أوشو، وجيم جونز، وغيرهم، ومع هذا الانشغال تمظهرَ السؤال الكبير: كيف نُعبّر عن هذه الذات؟ لهذا السبب ارتأت الرأسمالية الأميركية بذكائها المعهود في تحصيل المال أن تتدخل لتساعد هؤلاء المواطنين المساكين الجدد في التعبير عن أنفسهم؛ ولأنه لا تمكن معرفة احتياجات هذه الذات الجديدة دون الدخول إلى رؤوس الناس، قررت أن تستعين كالعادة بعلماء النفس والاجتماع، هذه المرة بأقوى معاهد البحث العلمي في الولايات المتحدة: معهد ستانفورد للأبحاث في كاليفورنيا.
لجأ معهد ستانفورد إلى الآباء المؤسسين لمعهد إيسالن، تحديداً إلى عالم النفس أبراهام ماسلو، أحد قادة “حركة الإمكانات البشرية”، والمبتكر آنذاك لما يسمى “هرم ماسلو” الذي وزّعَ الحاجات الإنسانية ضمن تسلسل هرمي، ووصفَ المراحل العاطفية المختلفة التي يمر بها الناس لدى تحقيق كل حاجة منها، في أدنى الهرم كانت تقبع الحاجات الأساسية كالمأكل والمشرب، وفي الأعلى “حاجة” أطلق عليها ماسلو: “حاجة تحقيق الذات”.
من خلال العمل على هرم ماسلو تمكّن معهد ستانفورد من تصنيف مجموعات واسعة من السكان، كما صنّف مجموعات أخرى كانت تريد التعبير عن نفسها، غير أنها كانت خارج تصنيف هرم ماسلو، لذلك ارتأى المعهد أن يُطلق على هذا الصنف الجديد وصف: جماعة “قِيَم اللايف ستايل” (قيَم أسلوب الحياة).
بالمحصّلة خلُص المعهد إلى أن المنتَج إذا ما عبّرَ عن مجموعة من القيم فسيتم شراؤه من قبل أولئك الناس الذين يتبنّون هذه القيم.
بهذه الطريقة استطاع معهد ستانفورد أن يُعيد المستهلك الجديد إلى دائرة “قابلية التنبؤ”، بحيث تصير الشركة المنتِجة قادرة على معرفة رغبة زبائنها من خلال مراقبة تطوّر نظام القيم التي يحترمونها، فبزيارة إلى المسرح، أو بحضور حفلة موسيقية يُحييها بوب ديلان مثلاً يمكن الخروج بالكثير من الأفكار التسويقية الجذابة، عبر معرفة نيات المستهلكين.
غير أن “قابلية التنبؤ” هذه لا تطرأ على نيات اختيار الناس المنتجات، وحسب، بل تطرأ أيضاً على نيات اختيارهم الشخصية التي ستقود الدولة، وهذا هو مَربَط الفرَس في الحكاية.
عام 1980 ترشّح عن “الحزب الجمهوري” رونالد ريغان لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية، سيتبنّى خِطابُ هذا الوجهِ الجديدِ خِطابَ الغالبيّة وفهمَهَا الجديد للذات والحرية، وسيبدأ إلى جانب مستشاريهِ بالهجوم على 50 عاماً من تدخّل الحكومة في حياة الناس، سيَعِدُ الأميركيين بحرية اتخاذ القرارات الأساسية التي تخص ولاياتهم، بعيداً من سلطة القضاة، والبيروقراطيين، ومركز الحكومة في واشنطن.
اعتقد الجمهوريون المعاصرون لريغان أن برنامجه انتحاري، ووصفه المنافس الخاسر جيمي كارتر بأنه سخيف، وكانت الصحافة سلبية تجاهه، ولم يستطع أيٌ من استطلاعات الرأي التقليدية أن يفهم الروابط بين برنامج ريغان وشعبيّته لدى المنتخبين.
غير أن أولئك الذي اشتغلوا على هرم ماسلو للحاجات و”قيم اللايف ستايل”، كانوا يعرفون أن رسالة الحرية الفردية التي يوجّهها ريغان في الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر في بريطانيا ستجذب الأغنياء والفقراء على حد سواء في الدولتين، لأنها تتناسب مع الطريقة التي يرى بها الأفراد الجدد أنفسهم: أن يُتركوا وشأنهم، ويختاروا ويُعبّروا عن أنفسهم بـحريّة.
كان ريغان وتاتشر يُمثّلان تلك الحرّية (الجديدة) التي ستكفّ يد الدولة عن التدخّل في السوق، وستترك الناس كالأطفال لِـما يَشتهون في أحضان الشركات الأمّهات، وستضمن تدّفقاً سلساً وانسيابياً للرغبة والبضائع من سلسلة الإنتاج، وإثارةً مِن بعدها لا تنتهي.
إنّ الفكرة التي تقول بأنّنا نتوق بشكل أصيل للحرية هي فكرة لا تجد ما يناصِرها في هذا المقام، لأننا نرتهن لـ”رغباتِنا” التي لا نستطيع أن نتجاوزها. وهذه الكلمة بالتحديد (رغباتنا) هي كلمة ضبابية، غير حصريّة المعنى والدلالة، فلكل واحد منا “رغبة” يختار مدفوعاً بها ولأجلها في المحصّلة.
في أية حال، اختار جيل الحرّية والإمكانات البشرية واستكشاف الذات رئيساً يمينياً عام 1981.
تولّى ريغان مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية، وكانت آنذاك تواجه كارثة اقتصادية سببها التضخّم الرهيب في السبعينات، كان الملايين عاطلين من العمل، ولأجل ذلك، تماشياً مع حملته الانتخابية، لن تتدخّل حكومته للمساعدة بابتكار مشاريع وطنية مثلما فعل روزفلت، بل سيترك الاقتصاد الأميركي المريض لباحثي السوق، الذين سيصبحون المحرك الأساسي لما تمكن تسميته اليوم “الاقتصاد الجديد“.
بدأت شركات أبحاث السوق أعمال التنقيب داخل أذهان الناس لمعرفة ما يريدون، واستعانت بالتقنيات القديمة التي كان استخدَمَها إرنست ديكتر والفرويديّون في الخمسينيات، وبدأ عهدٌ جديد من الصناعة، وتدفّقت تلك المنتجات المتكاملة التي من شأنها أن تسمح لشتّى أصناف الناس بالتعبير عما يشعرون بأنه يمثّل هويتهم.
أدركت الشركات في عهد ريغان أن من مصلحتها تشجيع الناس على الشعور بأنهم أفراد مميزون، وهي لا تزال حتى اليوم تتعهّد بأنها لن تتوقّف عن (مساعدتهم) كي يعبّروا عن تفرّدهم واختلافهم.
تقدّم لنا المنتجات اليوم الكثير من الطرق للحياة، للوجود، وحتى للتفكير، إنها تَبيعُنا القيَم، من خلال شكل المنزل الذي نعيش فيه، الكمبيوتر الذي نستخدمه، أو الثياب التي نرتديها، بحيث نصير وسط هذه اللعبة الدراماتيكية كمن يشتري هويّته بنقوده.
طوّرت الرأسمالية صناعة متكاملة تهدف إلى إثارة أكبر إحساس بالذات في داخلنا، ومع هذه التقنيات التي طوّرتها في حقبة ريغان بدا أن الذات الإنسانية غير محدودة، لا نهائية التعلّق المادي، لا نهائية الهوية المادية، ولا نهائية الرغبة… والألم.
كانت الفكرة الأساسية التي انطلقَت منها جماعات اليسار المهزوم في شيكاغو إبّان الستّينات هي أنّ تحرير الذات من شأنه أن يُساهم في صناعة ذات جديدة خالية من قيود السلطة. لقد تحقق هذا التغيير الجذري في المجتمع الأميركي فعلاً، لكنّ هذه الذات الجديدة التي انبثقت نحو الحرّية باتت تعتمد أكثر من سابقتها على المنتجات في التعبير عن هويّتها.
لقد تداعَت أحلامُ (مجتمع الرفاه) حين سقط مفهوم (المجتمع) من حساباتها. فالمجتمع في العصر الحديث يعني مجموعة الأفراد الذين يتّخذون خيارات فردية تخصّ رفاههم الفردي.
هذا هو الإنسان ذو البعد الواحد الذي تحدّث عنه ماركوزه، إنسان تم تزييف وعيه، بحيث تكفّ السلطة الخارجية يدها عنه، ويُترك لضميره الداخلي الذي تمّت صناعته باستخدام تقنيات علم النفس، إنسان بضمير ذي بُعد واحد مرهون لحاجات وهمية تمّ إقناعه بها حتى صار عبداً صالحاً ومُطيعاً، إنسان يتوهّم بأنه حر لمجرّد أنه يستطيع أن يختار بين تشكيلة واسعة من البضائع والمنتجات.
إقرأوا أيضاً: