عن حكايات لم ترو ولم ينقلها أحد…
على مدار عشر سنوات من الحرب في سوريا، حاولتْ وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسميّة، الغريبة والقريبة، والمنصّات الالكترونية، والقنوات المتلفزة، المُعارِضة والمؤيّدة، بشتى أنواعها وتطوّر أدواتها، الاقترابَ من الحقائق قدر الإمكان، لتوثيقها وتدوينها، إمّا كتأريخ مكتوب، أو غير مكتوب، كالتسجيلات المرئيّة والصوتية، وصولاً إلى شهود العَيان، وكاميرات الهواتف في جيوب الناس، التي كانت تلتقط وبمحض مصادفة أحياناً، صوراً أُولى لمَا قبل انفجارٍ ما، أو مشهداً قصيراً وخائفاً، لمعركة بين البيوت المأهولة، والمزارع حولها.
وهناك مناطق، لم تصل إليها كاميرات العالم، وظلّت بعيدة المنال، لتوثيق المجازر فيها، والجرائم الّتي حدثت بصمت، من دون جلبة، وبقيت دفينةً حتى اليوم، في جعبة من كان شاهداً عليها فقط.
لم تسمح الفرصة، بشكل مناسب بأن يُخرج الناس الّذين مرّت الحرب ببيوتهم أو تحت نوافذهم، ما يدّخرونه من تلك الحكايات، التي غالباً لن يصدّقها أحد، على رغم أنّها حدثت فعلاً وراح ضحيّتها أناس كثر، وبيوت وأرزاق، وربّما ذكريات كانت بالنسبة إلى أحدهم، تعني حياة كاملة.
كان الخوف من أجهزة المخابرات والاعتقالات العشوائيّة، هو المانع الأكبر، من أن يتداول الناس الوقائع التي كانت ترتكب خلال السنوات العشر الماضية بشكلٍ معلن، ما أدّى إلى نسيانها تدريجيّاً مع مرور الوقت.
لو ألقينا نظرة عامّة إلى الحرب في سوريا، لشاهدنا العشرات من الأطراف المشتبكة ببعضها بعضاً، في حروب ومعارك سريعة مُتكرّرة، واحدة في الجنوب، وأخرى في الشمال، وبينهما معركة ثالثة، تفجيرٌ هنا، وبراميل تمحو حارات بأكملها هناك…
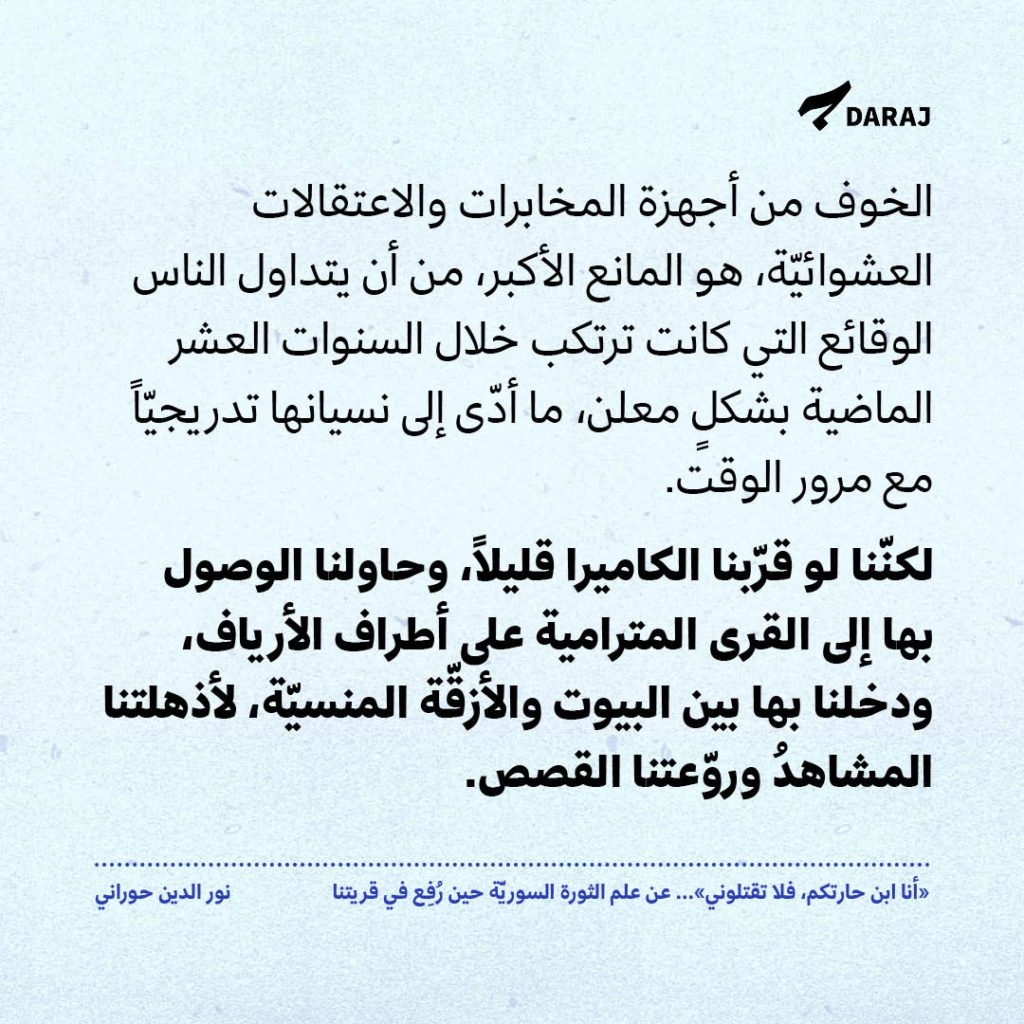
لكنّنا لو قرّبنا الكاميرا قليلاً، وحاولنا الوصول بها إلى القرى المترامية على أطراف الأرياف، ودخلنا بها بين البيوت والأزقّة المنسيّة، لأذهلتنا المشاهدُ وروّعتنا القصص، وربّما خنقتنا رائحة الجثث وأبكتنا ولولات الأمّهات خلف كواليس حربٍ، لم ينجُ منها أحد.
كان أكثر ما يثير الدهشة والرعب في آنٍ معاً، هو تلك المعارك الّتي تندلع فجأة، من دون أي خبر أو تحذير للناس الآمنين، إذ كنّا نجد أنفسنا، كسُكّانٍ لتلك المناطق، بشكل مباشر أمام دبّاباتٍ ومدرّعات وناقلات للجنود، تقتحم الشوارع والأسواق، في مشهدٍ تنعقد الألسن من شدّة هوله، إذ تبدأ الأخبار بالانتشار بين الأهالي، تحت عبارات وعناوين مبطّنة، كأن يقول جار لجاره “هَجَمُوا” أو “قرّبتْ ترعِد” أو “عِلْقَتْ”، بما يشير إلى عمليّة اقتحام، ربما لن يلتقي من بعدها، أحدٌ بأحد.
أمّا بالنسبة إلي، أنا ابن محافظة درعا، فقد كنت شاهداً على معارك عدة، دارت ضمن الحيّ الذي كنت أقطن فيه، وكان أكثر ما يميّز تلك المعارك، الأسماء الّتي تطلق عليها، “معركة العلم” و”معركة المدرسة” و”معركة الوادي” و”معركة المساكن”… ولا أعتقد أنّ هذه المعارك، تم الإتيان عليها في حديث ما، أو توثيق تستحقّه.
كانت هذه التسميات، تنطلق من اسم المكان الذي تدور المعركة فيه أو بالقرب منه، حيث سأحاول من خلال الكتابة، تصويرها، والحديث عن أبرز ما دار فيها، من خداع وتكتيكات ونهايات مرعبة.
كان بيتنا يتوسّط القرية، وساعدني مكانه الاستراتيجي على رؤية معظم الأحداث بعيني، وساعدتني أيضاً ذاكرتي، على الاحتفاظ بما رأيته، لأكتبه في ما بعد، كي لا يظلّ الذين قتلوا في تلك المعارك، طيّ النسيان.
إقرأوا أيضاً:
أيلول/ سبتمبر 2011
استيقظت عائلتنا، كما العائلات الأخرى، في أحد أيام ذلك الشهر، على أصوات تصفير وتصفيق كثيف، آتٍ من نوافذ الجيران وسطوح منازلهم، وعلى بعض الزغاريد من نساء الحيّ. خرجنا على الفور من دون أن نغسل وجوهنا، لنستدرك ما فاتنا ممّا يحدث، وإذ بنا نندهش بعلم الثورة ذي اللون الأخضر والنّجوم الثلاث الحُمر، يُرفرف مرفوعاً على قمّة أعلى برج في القرية، البرج العائد لشركة “سيرياتل” التابعة للنظام منذ تأسيسها، علماً أن منطقتنا في تلك الفترة، كانت ما تزال تحت سيطرته، وكان بمقدوره- النظام- في أيّ لحظة اقتحامها، لولا الهدوء الذّي حافظت عليه القرية، خلال الشهور الأولى من بدء الثورة، على رغم انتشار كثيف لعناصر الجيش الحر وقتها، وتجولهم خلسة بين بيوت متعدّدة، اتّخذوها مقرّات لهم.
كان منظر العلم وهو يرفرف بحجمه الشاسع في الأعلى، بنجماته الثلاث، يثير الرهبة في الأنفس، صوت خفقانه في الهواء يختلط بأصوات قلوب الناس المتفرّجين، ولا أثر لمن رفعه، ولا أحد يدري ما سيحصل بعد قليل..
لم يمر وقت طويل، قبل أن تبدأ البيوت بالاهتزاز، إثر وصول الدبابات والمدرّعات إلى مكان البرج، بعدما تسلّمت فرقة من جيش النّظام تقارير عن الحادثة، فلم توفّر جنديّاً واحداً كرمى لإنزال العلم في أسرع وقت ممكن، ورفع العلم ذي النجمتين الخُضر مكانه.
كان البرج مبنيّاً في ساحة بلديّة القرية، قريباً من بيتنا، للدرجة التي كنّا نقول -حين نريد أن ندلّ على عنواننا-: قرب البلديّة- تحت البرج.
هذا القرب، سمح لي وبسبب فضولي، بأن أقف خلف نافذة أحد الغرف المطلّة على البرج، وكان إلى جواري، والدي، وعمي وبقيّة العائلة، متجمّعين، وكنا نراقب بخوف وذعر وصول عناصر الأمن وأرتال المشاة وتطويقهم مبنى البلديّة.
في البداية كان الهدوء مريباً. فقط صوت العلم يخفق في الهواء، على ارتفاع 80 متراً، ثم انتبهنا فجأة، إلى جنديّ، بدأ يصعدُ السلّم المبني داخل البرج، المؤدي إلى القمّة حيث يُرفع العلم، وكان واضحاً، أنّ صعوده بطيء، وأنّ الخوف يسيطر على حركته، بينما من الأسفل أصوات الضباط يأمرونه بالاستعجال أكثر، مع شتائم مهينة جدّاً، لم نكن نسمعها بوضوح…
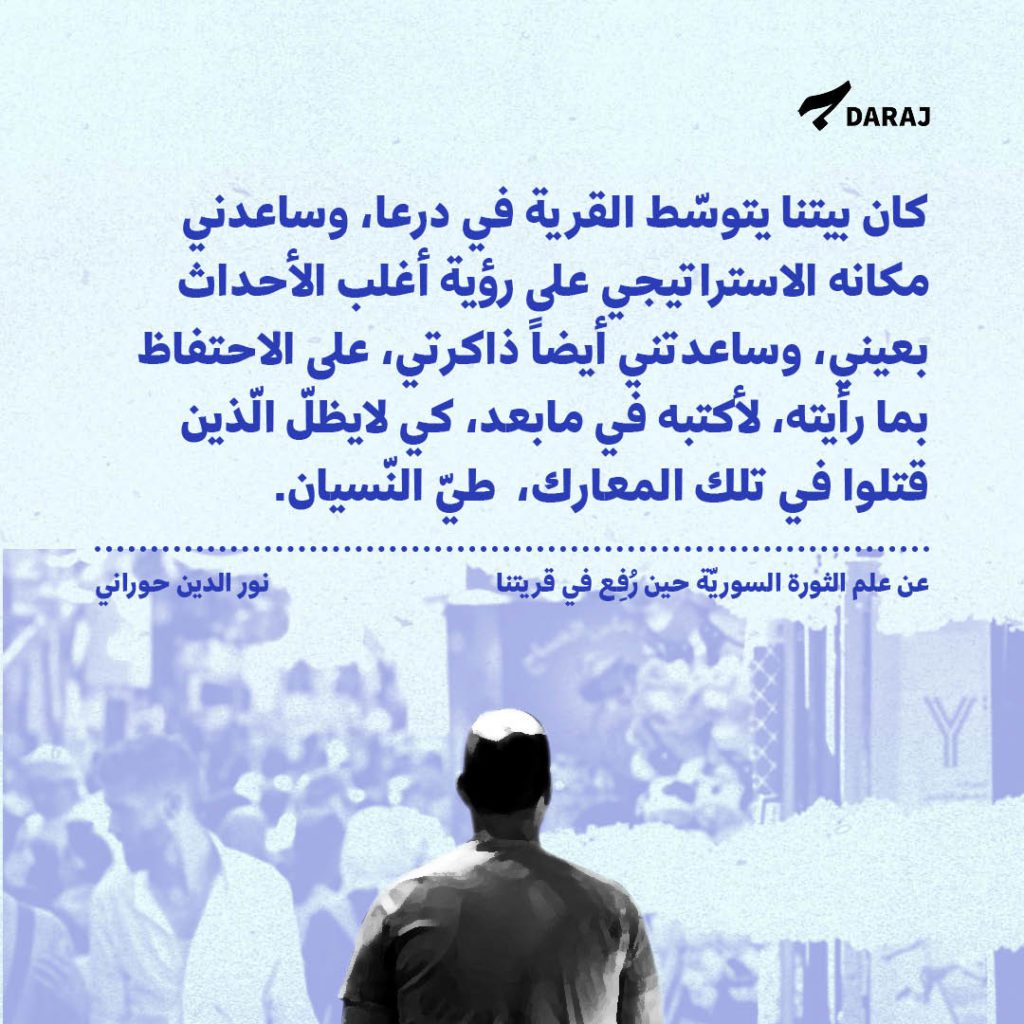
وصل الجندي إلى منتصف المسافة، على ارتفاع يقارب الخمسين متراً. لقد شَلَّ الخوف قدميه، ما جعله يتشبّث بالسلّم، كأنّه يعانقه، متجمّداً في مكانه، يتوسّل أن يُعيدوه إلى الأسفل، بينما أصوات الشتائم تصعد إليه، تحثّه وتجبره على الاستمرار، إلّا أنّ رصاصة موجّهة من قناصة تابعة للجيش الحر، أسقطته من ذلك الارتفاع، وكان سقوطه سريعاً ومرعباً، لدرجةٍ سمعنا صوت تحطم جسده على الأرض لحظة ارتطامه بها.
في تلك اللّحظة، أدرك عناصر النظام، أنّ الأمر أكبر من قصة علم مرفوع في الهواء، فاندلعت إثر ذلك أصوات الرصاص، تملأ الجو، في اشتباك دام لأكثر من نصف ساعة، ثم هدأ بعدها لفترة وجيزة، تلاها مباشرة صعود جنديٍّ آخر، وسط ذهولنا جميعنا، لكن هذه المرّة كان الجنديّ يصرخ بصوت عالٍ، مُحاولاً إسماع كل من لا يسمع، أنّه ليس جنديّاً، متوسلاً أن لا يطلق أحد الرّصاص عليه، وكنت أسمعه جيّداً وهو ينادي “مشان الله يا شباب، أنا فلان ابن فلان، ابن حارتكم، لا تقتلوني”…
كان هذا الشخص الآخر، هو أحد شباب القرية الذين تمّ اعتقالهم مُسبَقاً، إذ اقتاده جيش النظام من السجن إلى ساحة البلديّة، وألبسوه بدلة عسكرية، كي يوهموا عناصر الجيش الحر بأنّه جنديّ، ليُقتل في حال حاول أحد قنصه، على يد أبناء قريته.
كانت تلك أقذر خدعة على الإطلاق، على رغم نجاحها، إذ أردك القنّاص، أنّه في المرة السابقة، قتل شخصاً من أبناء القرية، فأوقف مُجبراً، التصويب جهة الشاب الّذي كان يظنّه جنديّاً تابعاً للنظام.
وصل الشاب- الذي لم نسمع عنه شيئاً بعد ذلك اليوم- إلى أعلى البرج، وبصعوبة بالغة، أرخى العلم، وتركه يسقط في الهواء، تحت تأثير حجمه الشّاسع، ليستقر في النهاية على سطح أحد المنازل القريبة، بينما يُرفع مكانه علم النظام في انتصار جبانٍ كسائر الانتصارات الّتي تلت تلك المعركة.
لفّ الصمتُ أجواء القرية، لا شيء سوى أصوات ركض الجنود بين المنازل، وجنازير المدرّعات تحرث اسفلت الشوارع في عمليّة مداهمة للبيوت، كانت الأوسع على الإطلاق، اقتحموا المنازل، فتّشوها بحراب بنادقهم، مزّقوا بها كل شيء يظهر في طريقهم، بحثاً عن “المسلّحين” على حدّ قولهم، ولم يوفّروا شابّاً إلّا واعتقلوه، بينما فرقة كاملة من الأمن توجّهت نحو المنزل المشؤوم، الذي سقط العلم على سطحه، إذ لم يكلّفوا أنفسهم عناء الصعود إليه، بحجة خوفهم من القنّاص، إنما أخرجوا أصحابه منه في مشهد اعتقالٍ لا يوصف، وأضرموا فيه النار، بكلّ ما يحتويه من أثاث، ثمّ غادروا، بعدما تأكّدوا من وصول النار إلى العلم، واحتراقه بالكامل.
إقرأوا أيضاً:










