آخر قبلة شغلت الشارع السوريّ كانت في مسلسل “شارع شيكاغو” لمخرجه محمد عبد العزيز، إذ أقامت الدنيا ولم تقعدها، أما اليوم يثير مشهد في فيلم الإفطار الأخير للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد موجة غضب جديدة بين السوريين. يتلخّص المشهد بتبادل قبلة قصيرة بين الممثلين كندا حنا وعبد المنعم عمايري، ثم تتوجه كندا إلى المطبخ حيث تسقط قذيفة وتفقد الزوجة حياتها. يحتد النقاش السوريّ ما بين رافض للقبلة، وبين من اعتبرها أمراً عادياً ولا عيب فيه، مستشهداً بأسماء أفلام عربية ومصرية قديمة احتوت بالفعل على الكثير من المشاهد الحميمية والقبل.
يعيدنا هذا النقاش حول القُبل في الأعمال التلفزيونية والأفلام السورية إلى السؤال الأول: كيف يمكن أن نوقف الوصاية على أجساد النساء؟ ولو بدت موجة السخط إثر قبلة حنا وعمايري ذات دوافع أخلاقية مزعومة إلّا أنه لا يخفى على أحد جذورها الذكورية الضاربة عميقاً ومعاداتها للنساء والجمال إذ عكستها التعليقات الرافضة والساخرة والتي نعتت زوج حنا بصفات غير لائقة من باب أنه سمح لزوجته بفعل “لاأخلاقي”، فالرجل الذي “يسمح” لزوجته بتمثيل قبلة على العلن هو “طرطور” كما يقال في السوريّة الدارجة دلالة على أنه بلا سلطة على نساء عائلته كزوجته وأخواته.
وهنا يمكننا التركيز على نقطتين، الأولى هي اعتبار النساء أملاكا خاصة بالرجال والثانية هي ربط “شرف” الرجل بـ”ملكيته” لزوجته، ولنا أن نتخيل حجم العبء الذي يتحمله من يقفون إلى جانب زوجاتهم في اتخاذ أو القيام بقرارات مشابهة، تتعلق بحريتهن وشكل حياتهن وقراراتهن ابتداءً بتمثيل قبلة وليس انتهاء بحقوق أكبر، كحق الوصاية على الأطفال أو منح الجنسية لهم وغيرها.
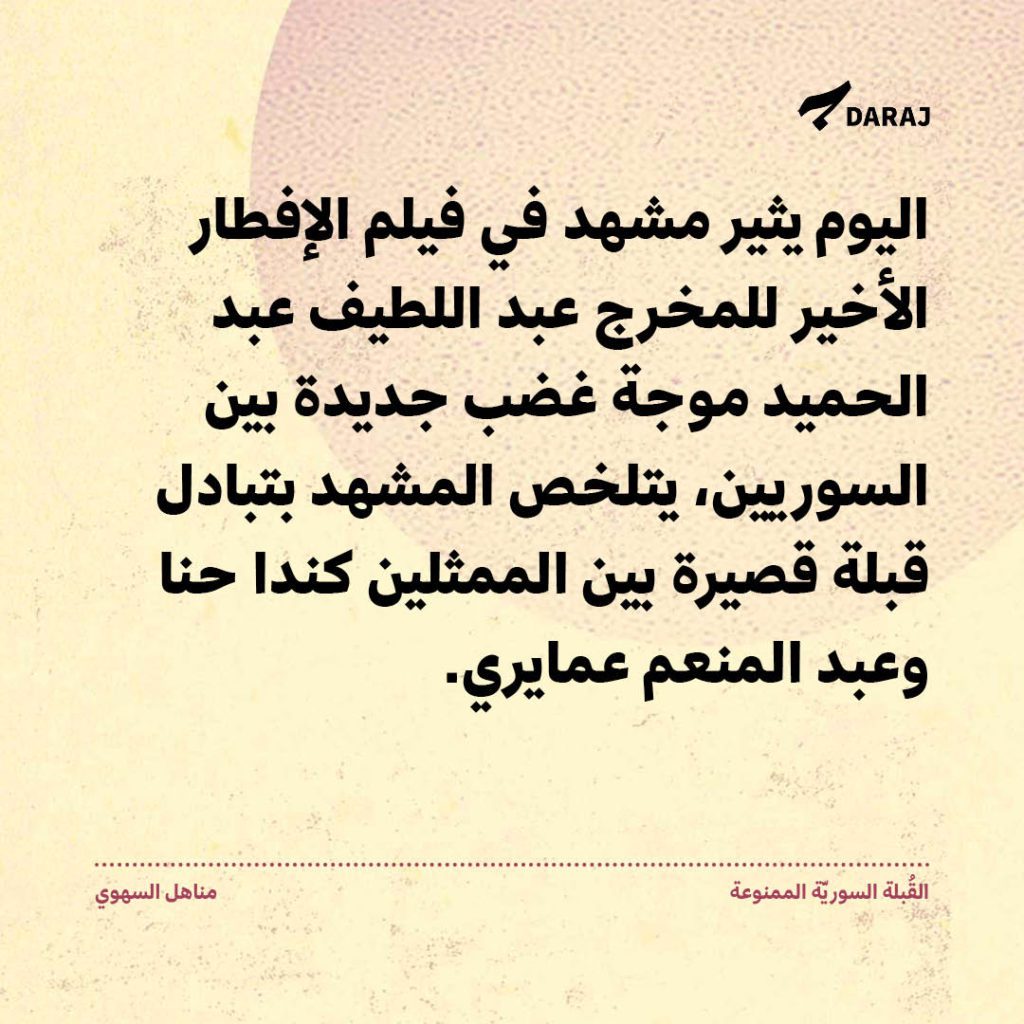
قبلةٌ قبل الموت
على المستوى الفنّي يمكن ملاحظة عجز فئة من الجماهير عن الفصل بين الممثل كصاحب مهنة يمارس في عمله أدواراً مختلفة عن طبيعته وأفكاره، وبينه كشخص له حياة مستقلة تماماً، فما الذي يجعل فعل القتل الذي تقوم به ممثلة ما أمراً مقبولاً بينما لو قامت الممثلة نفسها بتمثيل قبلة، يثير الأمر موجة رفض، وهذا ما يفتح الباب على التمييز بين القتل والتقبيل كفعلين متعارضين أحدهما يعبر عن الكره والآخر عن الحب، يعبّر الأول عن القبح والآخر عن الجمال إلا أن الأول مقبولٌ اجتماعياً إلى حد كبير والآخر مرفوض سينمائياً وتلفزيونياً من قبل هذه الفئة من المشاهدين.
إلّا أن الحديث عن الجمال هنا أكثر تعقيداً، إذ أنه مفهوم مجرد، والمشككون به يحتاجون إلى ما يلمسونه، الجمال طريقة حياة، نتقنها منذ الطفولة عن طريق تشذيب أرواحنا من خلال تذوق الفن وممارسته والقراءة وسواها من الأنشطة. ما بين القبلة الجميلة والقذيفة القبيحة مساحة شاسعة وفوارق جلية، وما يجب إدراكه هو عجز المنتقدين عن رؤيتها. إننا بالفعل أجيالٌ كبُرت وهي ترى في المعارك والشهادة والموت شرفاً ما بعده شرف لا بل هو في قمة هرم الإنسانية، لم يحدّثنا أحد عن الجمال، عن القبل الدافئة والحبّ والعائلة والسكينة، لم يخبرنا أحد أن الحب أهم من الحروب، لذلك كان من الطبيعي تجاهل مشهد مؤلم وصادم كموت امرأة والتركيز على مشهد “خدش الحياء العام”، من دون أن يمحي موتها السخط من قبلة طبعتها على فم زوجها قبل ثوانٍ من موتها. قد تكون المعضلة بالفعل هي عجز المنتقدين عن إدراك أن الفن والسينما لديهما مهمة وهي نقل حالة إنسانية محددة، وللجمهور حرية مشاهدة هذه الحالة أم لا.
قد نتفهم حرية البعض في عدم التطرق لحياتهم الحميمية أو عدم تقبل ظهور أي جزء منها وهذا حقٌّ لهم، إلّا أن منع الآخرين من التعبير عن أنفسهم أو تقديمها بالشكل الذي يودونه والمطالبة بإقصائهم احتراماً لهذه الشريحة، يعكس ازدواجية نستطيع ملاحظتها من خلال عشرات الأمثلة من حولنا.
لا يمكن المطالبة بحريّة تعبيرك عن نفسك ورفضها عند الآخر في الوقت ذاته، من دون الأخذ بالاعتبار أن عدداً لا بأس به من اختياراتنا هي نتيجة حتمية للتنشئة الدينية والاجتماعية والسياسية التي لم نخترها بالفعل والتخلص منها يحتاج وقتاً وجهداً لإعادة هيكلة معتقداتنا التي هي في جوهرها متغيرة. إذاً نحن نتيجة المكان الذي ولدنا فيه لا أكثر، ألا تكفي هذه الحقيقة لنعيد التفكير مالياً في توجهاتنا والمبادئ التي ندافع عنها في كلّ يوم؟
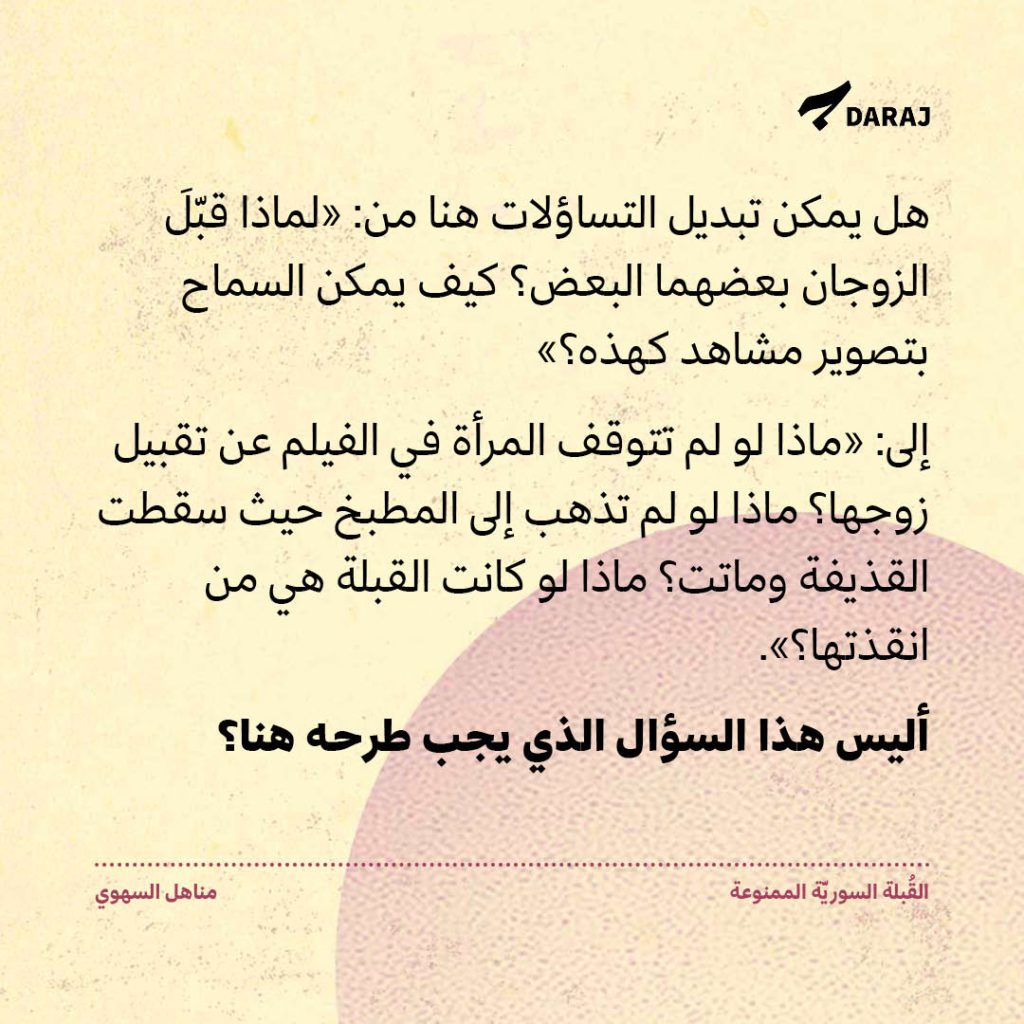
مقصلة الجلاد على عنق اللحظات الحميمية
هذه الحالة ليست بجديدة في المجتمع السوري. لطالما ظهرت جدالات تتعلق بعناق حميمي بين عاشقين في حديقة عامة أو قبلة تبادلها مراهقين، يسلط الجلاد مقصلته على كلّ لحظة حميمية تمرّ، ليحذر الرافضون من انهيار أسس هذا المجتمع في حال لم يوضع حدٌ للقبل والأحضان العلنية متجاهلين بشكل كامل المصائب الواقعة على رأس هذا المجتمع من فقر وبطالة وانهيار اقتصادي وجرائم قتل وسواها من الإشارات التي تقول إن انهيار هذا المجتمع بدأ بالفعل منذ زمن. وفي الوقت الذي تحتاج فيه آلاف النساء والفتيات في الشوارع السورية والمنازل إلى الحماية من التحرش والتعنيف والقتل، يُطَالبُ المسؤولون بفرض المزيد من الرقابة على قُبلة في فيلم، من دون أن يرف للمطالبين جفن مقابل عشرات النداءات والحكايات اليومية عن التحرش، والمعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي كلّ الأحوال ليست ردة الفعل هذه بغريبة، فالرفض القاطع مفهومٌ إلى حد ما لكنه غير مبرر، فلا ضير لدى بعض المعارضين من مشاهد أفعال حميمية في أفلام أجنبية وتركية أو حتى مشاهدة أفلام البورنو لأنه وحسب منطق هذه الشريحة فتلك الفئة لا أخلاقية بالفعل، ودينها أقل شأناً من باقي الأديان ولذلك فهي خسرت امتياز “الطهارة والعفة” المفترضة! لا يمكن بأي حال إنكار هذه الحقيقة التي يعرفها الكثيرون بالفعل، فالامتياز الديني الإسلامي الذي تشعر به هذه الشريحة غالباً ما يمنحها الثقة “الأخلاقية” والجرأة على تصنيف الناس، فكل امرأة تعبّر عن نفسها بالطريقة التي تريد، تبدو كما لو أنها مباحة حتى ولو بمنطق هذه الشريحة “عاشت هذه المرأة عقوداً من العفة والطهارة العربية”، فخطأ النساء، “كعود الكبريت”، يحدث مرة واحدة وينسف كل تاريخهن وحياتهن.
هل يمكن تبديل التساؤلات هنا من: “لماذا قبّلَ الزوجان بعضهما البعض؟ كيف يمكن السماح بتصوير مشاهد كهذه؟” إلى: “ماذا لو لم تتوقف المرأة في الفيلم عن تقبيل زوجها؟ ماذا لو لم تذهب إلى المطبخ حيث سقطت القذيفة وماتت؟
ماذا لو كانت القبلة هي من انقذتها؟”. أليس هذا السؤال الذي يجب طرحه هنا؟
إقرأوا أيضاً:








