في اللحظات المروّعة الأخيرة لصدّام حسين ثمة ما يستحق التوّقف. فمن بين الجمل الأخيرة التي نطق بها، وسمعها ملايين البشر، ما قاله للجلاّد المقنّع، ولحشد يراه ولا نراه من الواقفين أمام منصة الإعدام: “هاي هي المرجلة؟”.
ينطوي هذا السؤال على دلالات كثيرة، منها الاستنكار، فما يفعله هؤلاء برجل قيّدت يداه خلف ظهره، وأحاط به جلاّدون أقوياء، لا يدل على “رجولة” (بمعايير صدام حسين الذكورية)، أو شجاعة. كما تنطوي على الاستكبار، والسخرية من جبناء استأسدوا أمام رجل في لحظته الأخيرة، بلا حول ولا قوّة. وربما نعثر فيها، أيضاً، على قدر من العتب، واللوم.
ومهما تكن حقيقة تلك الدلالات، فمن المؤكد أن مشهد الجلاّدين، والأصوات التي نسمعها ولا نرى أصحابها، والصيحات البدائية المتدفقة من حناجرهم، لا تدل على شجاعة، بقدر ما تفضح الطبيعة المرعبة والدموية لفكرة الثأر، التي لا يكتمل حضورها إلاّ إذا غابت فكرة العدل. فاحتكار الدولة، مطلق دولة، للعنف وتقنين القتل، للحفاظ على السلم الاجتماعي، والقانون العام، كان ولا يزال مصدر نقاشات وتأملات لا تنتهي حول معنى القانون، وتطبيق العدالة.
فالعدالة، وطرائق تطبيقها، مسألة إشكالية، بخاصة إذا كان معناها حرمان شخص الحق في الحياة، بصرف النظر عن طبيعة ما ارتكبه من جرائم، والعقاب الذي يستحقه. لذلك، وبقدر ما يبدو القانون في يد الدولة صارماً، وقاسي الملامح، وبلا شفقة تقريباً. فإن القانون نفسه يشكّل مصدر قلق، وتردد، وحيرة، وشكوك، ومراجعات، لدى المشتغلين بفلسفة القانون.
وفي هذه المنطقة الرمادية، بالذات، التي يغيب فيها اليقين، وُلدت الأفكار المعادية لفكرة الإعدام، ومنها استمدت مبرراتها الأخلاقية، والفلسفية. وفيها، أيضاً، تكتشف الدولة الحديثة، المعنية بالقوانين وحقوق الإنسان، أن في فعل القتل ما يشبه فضيحة تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الحيطة، والتكتم، والحياد. لذلك، يُمارس فعل القتل على يد سلطات الدولة بطريقة شبه سرية تقريباً، كأنه أقرب إلى الفضيحة منه إلى فكرة تحقيق العدالة.
بهذا المعنى فإن ما يميز تحقيق العدالة عن الثأر لا يتمثل في الموقف من القتل وحسب، بل في طريقة ممارسته، أيضاً. استناداً إلى هذا الفهم يصعب العثور على ما يميّز قتل صدام حسين عن طريقة قتل الزرقاوي لضحاياه. في الحالتين نجد أنفسنا أمام موت متلفز، لا ينم عن أي علاقة بالعدالة، بقدر ما يكشف عن الوجه الدموي لفكرة الثأر. والمفارقة في هذا الصدد، كيف تضيع الفروق بين سلطات دولة، لن يناقش أحد في حق احتكارها العنف، وبين قاتل مريض يذبح ضحاياه أمام الكاميرا. فعندما تفشل الدولة في إدراك أن احتكار العنف يشترط الحيادية والتعالي، والتجريد، تتصرف كعصابة.
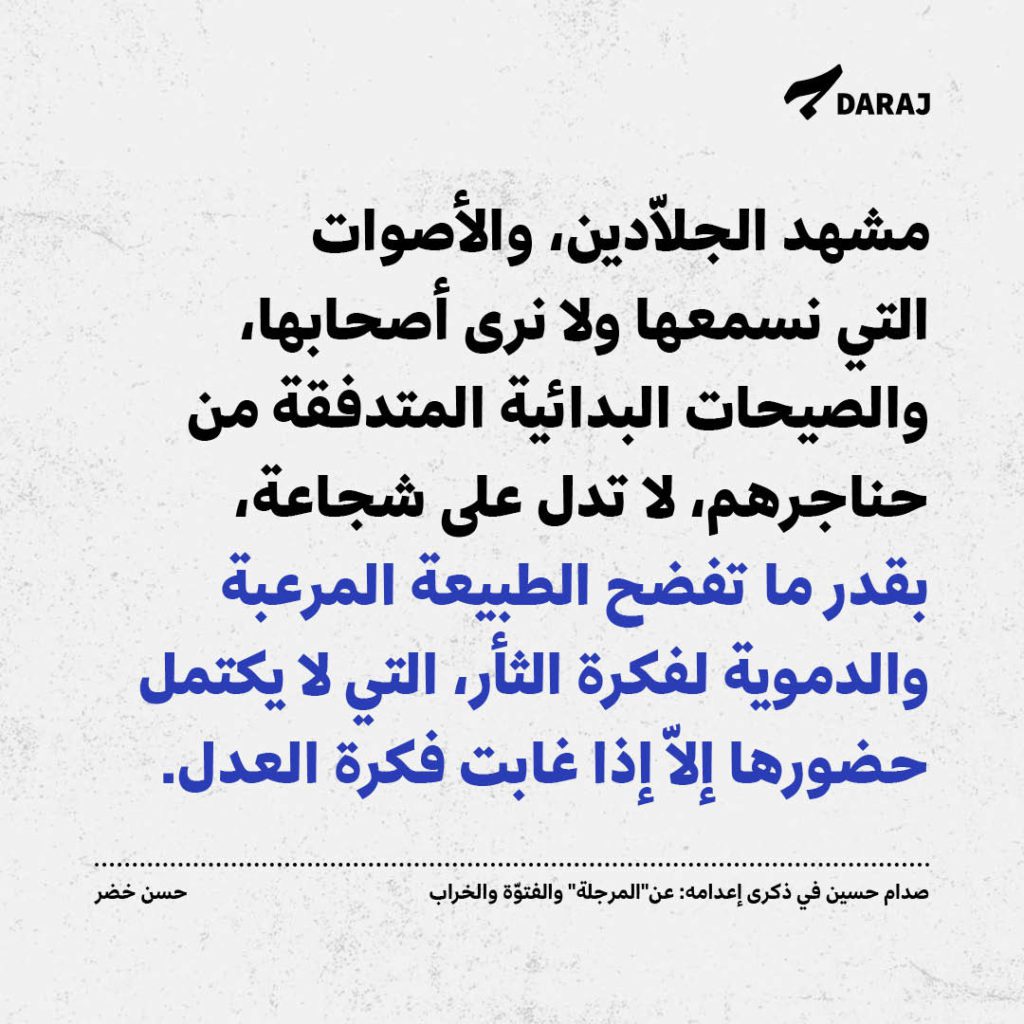
ولو كانت للمواقف الشخصية أهمية خاصة في هذا المقام، فلا بد من تأكيد حقيقة الوقوف ضد إعدام صدّام حسين، ليس لأنه لا يستحق الإعدام، بل لأنني ضد عقوبة الإعدام نفسها.
ومع ذلك، وفي لحظة التشديد على قدر مروّع من التشابه بين الطريقة التي قُتل بها صدّام حسين، وطريقة الزرقاوي في قتل ضحاياه، وعلى صعوبة العثور في عملية إعدامه على ما يميّز بين عصابة ودولة، ينبغي التأكيد، أيضاً، على حقيقة أن صدّام حسين قتل ضحاياه بالطريقة نفسها، وأن دولته لم تكن أفضل حالاً من الدولة التي أعدمته.
وإذا كانت في أمر كهذا مفارقة ذات أبعاد تاريخية بامتياز، فإن فيه، أيضاً، ما يبرر العودة إلى كلام “المرجلة”.
كانت “المرجلة” التي انتقدها صدّام حسين، وعاب عليها جلاّديه، هي “المرجلة” نفسها التي تحلى بها، ووسمت سلوكه على امتداد 35 عاماً من الحكم المطلق، تجاه خصومه، ومعارضيه، وضحاياه على حد سواء.
نحن لا نعرف، بالضبط، عدد الذين قتلهم صدّام حسين، ولا أريد الكتابة، هنا، عن استخدام الغازات الكيميائية السامة ضد القرى الكردية، وغيرها من الحوادث الكبرى، بل عن حادثة تخص أفراداً من عائلته، رواها الدكتور علاء بشير، طبيبه الخاص.
ففي أواسط التسعينات هرب اثنان من أبناء عمومته إلى الأردن، ثم عادا إلى العراق بعدما وعدهما بالعفو. وفي الخامسة من صباح أحد الأيام حوصر البيت الذي يقيم فيه الأبناء مع أبيهم وشقيقتهم وأولادها في بغداد. كان ابنا صدّام عدي وقصي في سيارة يراقبان المشهد من بعيد، وكان علي حسن المجيد، الذي يحاكم هذه الأيام بتهمة قتل الأكراد بالغازات السامة، على رأس المهاجمين، وهم من أبناء العائلة، ومن عشيرة صدّام، جاءوا من العوجا، ومن تكريت لسفك الدماء.
استمر إطلاق النار لفترة من الوقت بلا جدوى، لأن الهاربين لم يستسلما بل أصرا على المقاومة، فقرر علي حسن المجيد قائد الهجوم استخدام القذائف المضادة للدروع. وهذا ما كان، قُتل المحاصرون، الأب (وهو شقيق علي حسن المجيد) وقُتلت ابنته، وثلاثة من أولادها تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة والسادسة، وقُتل اثنان من الإخوة الثلاثة، ثم ظهر الأخ الثالث، حسين كامل نازفاً ومصاباً في معدته على مدخل البيت، فانهمرت عليه الطلقات، واقترب منه عمه، القائد المغوار، صاحب المراجل، ليدوس عليه بقدمه، ويطلق النار على رأسه.
المهم في هذه الحادثة ليس تفاصيلها السياسية، وما إذا كان هؤلاء يستحقون الموت أم لا، بل حقيقة أنهم كانوا من أبناء العمومة (كان اثنان منهم متزوجين من ابنتي صدّام، أيضاً) وحقيقة أنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة، ولم يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم، ولا بتوكيل محامين… إلخ، كما أن آخرين مثل الأب والبنت، قُتلوا بلا سبب، وبلا تهمة محددة، ناهيك عن ثلاثة أطفال بطبيعة الحال. ومع هذا كله، وفوقه، وقبله، عاد الهاربون بناء على عفو من صدّام حسين، لكن العائلة التي قتلتهم وصفت عملية القتل بالهبة المضرية. وانتهى الأمر.
أين هي “المرجلة” في عمل كهذا؟
أليست هي “المرجلة” نفسها التي عابها على جلاّديه؟
لكن الكلام عن “المرجلة” يحيل إلى دلالة إضافية، تتعلّق بالصورة التي حاول صدّام حسين رسمها لنفسه، وإقناع الآخرين بها. وهي صورة لا تقتصر أهميتها على سيرة حياته، وما أصاب العراق على يديه، بل تتجاوزه وتتجاوز العراق لتمس طبيعة السياسة، وصورة الحاكم، في النسق والمخيال العربيين.
تكاد “المرجلة” على الطريقة الصدّامية تتماهى مع الصورة الشعبية للفتوّة، ولدينا في ميراث الراحل نجيب محفوظ الكثير من الشواهد الأدبية في هذا الصدد. وأهم ملامح هذه الصورة القوة العضلية، والشجاعة، والاحتكام إلى منطق الهراوة والنبوت. ولو اقتصر الأمر على الأدب لنجونا من كثير من الويلات التي لحقت بنا على امتداد القرن العشرين، الذي شهد محاولات بناء دولة عربية حديثة على يد فتوّات.
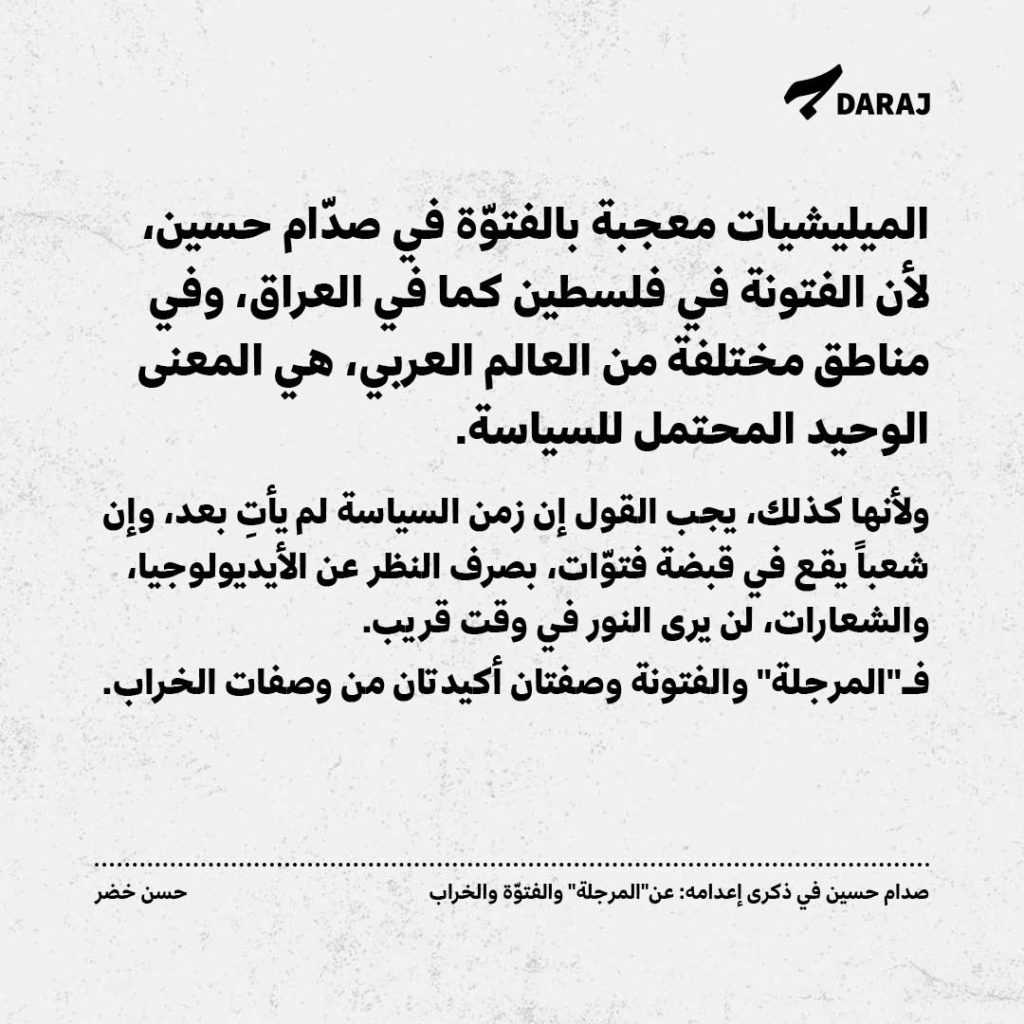
وبما أن “الفتوّة”، الذي لم يعش في زمن التلفزيون، اعتمد على الروايات الشفوية في ترويج صورته، وأساطير قوته، فإن “الفتوّة” حاكماً في زمن التلفزيون يعتمد على الصورة، وعلى المكتوب أكثر من الشفوي والمسموع.
لذلك، شاهدنا صدّام حسين سابحاً في النهر، ولابساً بزة عسكرية، ومطلقاً النار من بندقية صيد وفي فمه سيجاره الكوبي الغليظ بيد واحدة للتدليل على القوّة (بكل الدلالات الفالوسية للسيجار والبندقية بطبيعة الحال).
ولا شك في أن في الأمر ما يستحق التحليل بطريقة أبعد من الكلام عن النرجسية، ففي التكوين النفسي لصدّام حسين ثمة ما هو أبعد من ذلك، إلى حد يحرّض على القول إنه كان مسكوناً بشخص يسمى صدّام حسين، معجباً به، وقريباً منه، وناطقاً باسمه، ومدافعاً عنه، ومثنياً عليه، وغالباً ما أشار إليه بضمير الغائب. حتى في المحكمة، وأمام عدسة الكاميرا، قال للقاضي إن أحداً لا يستطيع محاكمة صدّام حسين حتى صدّام حسين نفسه.
وفترته الأخيرة في الحكم ذات دلالة بشكل خاص، فمنذ هزيمته في الكويت، دخل في مرحلة تدّين لم يكن في سيرته الأولى، وفي أيديولوجيته القومية ما يبررها، وما ينم عنها، أو ينبئ بها. لم يعد يتكلّم في السياسة، بل أصبح كلامه عن المطلق وفي المطلق عن الخير والشر، عن الحق والظلم، وعن الظلام والنور.
يمكن فهم الأمر بطريقة مختلفة بطبيعة الحال، فبعد هزيمته في الكويت، وإفلاس الدولة بالمعنى المادي بعد حربين في إيران والكويت، وبعد إفلاسه بالمعنى السياسي حيث بدأت الدولة في الانهيار، وتعطلت إمكانية التنمية، أصبحت القدرية وسيلته الوحيدة لتبرير ما حدث وما سيحدث. لم تعد الهزيمة نتيجة موضوعية لما أقدم عليه من سياسات، ولم يعد المستقبل المغلق، والقابل لكل أشكال الخراب احتمالاً يمكن تفاديه، بل دخل ما يحدث، وما سيحدث، في ثنايا خطة إلهية لم يطل على مكنونها أحد سواه.
وإذا كانت القدرية في السياسة وصفة سحرية للحاكم المستبد لتبرير الإفلاس، وانسداد الأفق، والفشل، فإن علاقة صدّام حسين بالشخص الذي يسكنه، ولا يكف عن الثناء عليه، وتمجيده، وتصديق ما يقوله عن نفسه، عادت عليه كما عادت على العراق بالويل والثبور وعظائم الأمور.
أخيراً، مسألة تخص موقف الميليشيات الفلسطينية من إعدام صدّام حسين. كالت الميليشيات المديح لصدّام، وصبّت اللعنات على رؤوس قاتليه. وثمة صلة هنا بين ما لحق بالقضية الفلسطينية من خراب على يد تلك الميليشيات، وموقفها من صدّام حسين. فلو كانت أفضل حالاً بالمعنى الفكري والسياسي لما وصل الأمر في فلسطين إلى ما وصل إليه. والفقير في الداخل فقير في الخارج أيضاً.
الحركة الوطنية الفلسطينية التي عرفناها، وعشنا في صفوفها، وحلمنا بها، في طور الاحتضار. هذا لا يعني أن المسألة الفلسطينية ستموت، أو أن الزمن سيتوقف، بل يعني أن شيئاً جديداً يحدث هنا.
وإذا شئنا الكلام بطريقة مجازية فلنقل إن الإنسان الذي يصيبه الهرم يعاني من ضعف في القدرات الجسدية، لكنه لا يعاني من ضعف في القدرات العقلية بالضرورة. والعكس صحيح في حالة الحركات السياسية التي يصيبها الهرم، فقد يزداد وزنها، وتنتفخ عضلاتها من الخارج، لكن قواها العقلية تضمحل. وهذا ما حدث في أماكن مختلفة من العالم، وما يحدث هنا.
الميليشيات معجبة بالفتوّة في صدّام حسين، لأن الفتونة في فلسطين كما في العراق، وفي مناطق مختلفة من العالم العربي، هي المعنى الوحيد المحتمل للسياسة. ولأنها كذلك، يجب القول إن زمن السياسة لم يأتِ بعد، وإن شعباً يقع في قبضة فتوّات، بصرف النظر عن الأيديولوجيا، والشعارات، لن يرى النور في وقت قريب. فـ”المرجلة” والفتونة وصفتان أكيدتان من وصفات الخراب.
إقرأوا أيضاً:







