“الشعب عم يستغل الزعما والزعما معترين”.
العبارة التي ساقها رشيد (زياد الرحباني) في مسرحية “فيلم أميركي طويل”، لم تكن مجرد سخرية يقتضيها نص مسرحي قديم، وكنا نرددها لسنوات خلت كطرفة تفتقر إلى متن حقيقي. فمعظمنا شاهد زعماء لبنانيين وهم يُسقطون فوق رؤوسنا مرشحيهم وبرامجهم الانتخابية “الجديدة”، والتي على أساسها يُفترض أن يكونوا ممثلين عن الشعب اللبناني في البرلمان الذي سيُنتخب نوابه في شهر أيار/ مايو من العام الحالي.
خمسة زعماء ممن لم تقذفهم علينا السياسة كما لو أنهم حديثو نعمتها، بل أن أقلهم التصاقاً بها، هو ضيف على أبصارنا كسياسي منذ أكثر من عشر سنوات. ومن هنا تماماً تبدأ المفارقات سياقها الساخر والمؤلم في آن.
سامي الجميل، حسن نصرالله، نبيه بري، جبران باسيل، سمير جعجع، كانوا توالياً ضيوفاً على حواسنا المتعبة بهم. فيما سعد الحريري كان أكثر رفقاً بتلك الحواس التي لن تفتقده بالطبع. هو فقط خفف من ثقل آخر عليها تحت سماء لم يعد لزرقتها معنى، تماماً كوليد جنبلاط الذي قذف نجله في وجوهنا، وتقمص شخصية “الغرِّيد”على ضفة النهر.
“حزب الكتائب” هو الحزب الأكثر التصاقاً بأدوار السلطة حيناً، والمعارضة أحياناً، كما راهنه. والتناوب المذكور تم وسامي الجميل رئيس لحزب، ما يُفضي بالمرء عادةً إلى اقتراف سوء الظن بمعارضته.
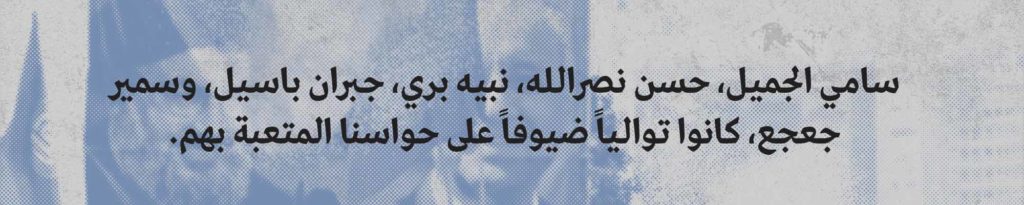
“حزب الكتائب” بوجهه المعارض كان وليد افتقاره دائماً حيثية شعبية، وبالتالي نيابية، يمكن تسييلها بالتوازي في سلطة ظلت تأسره بهذه المعادلة. وتجاربه في أكثر من استحقاق حكومي يشي غالباً بجنوح إلى السلطة أكثر من العزوف عنها. فيما مشاركته في تلك الحكومات تحفظ له مكاناً لا بأس به في التأسيس للانهيار الكبير. ولعل تجربة وزير العمل الكتائبي سجعان قزي، في حكومة الرئيس تمام سلام، وقرار “الرشوة” المقنعة بمساهمة المواطنين بمبلغ خمسين ألف ليرة لتسريع معاملاتهم مؤشر عن “كتائب” السلطة التي يحاول رئيسها محاكاة وجدان اللبنانيين كما لو أنه المُنقِذ.
“باقون نحمي ونبني”، هو الشعار القديم الجديد الذي غلف به أمين عام “حزب الله” برنامج حزبه الانتخابي. والنظر في مفهومي البناء والحماية كمتنين لجذب الناخب، سيجدان لا شك صداهما لدى مناصري الحزب. لكن اقتفاء أثرهما سياق لبناني عام، فأغلب الظن أننا أمام متنين صارا في راهن اللبنانيين، استحالتين صادرتين عن رجل لم يعد معه منطق الحماية التي كانت دالته علينا تعني أكثر اللبنانيين في زمن خراب عميم يتحمل فيها حزبه حماية طبقة سياسية هدَّامة، يُفترض بالضرورة أن يتشارك معها مستقبلاً مفهوم البناء.
رئيس “التيار الوطني الحر النائب” جبران باسيل هو أكثر من تصح فيه عبارة زياد الرحباني.
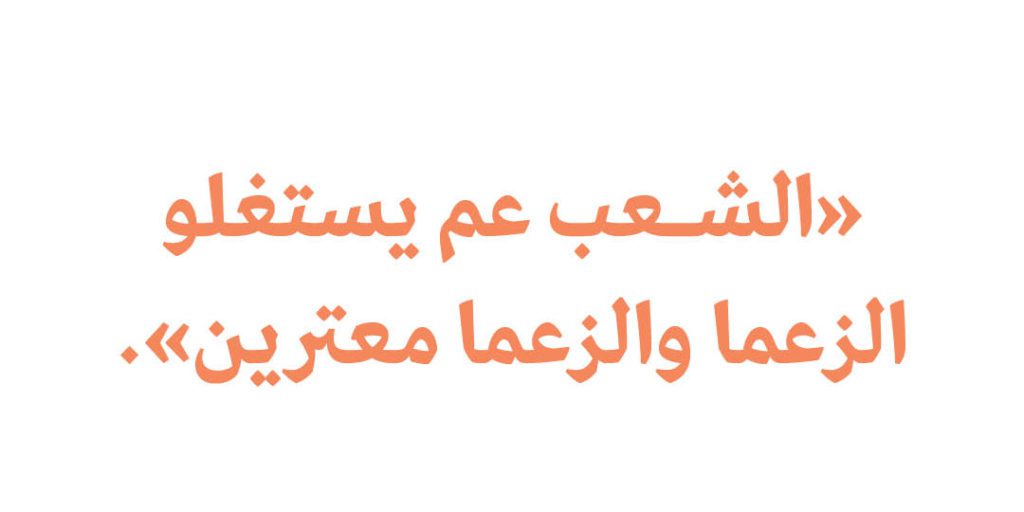
منذ عام 2008 وجبران باسيل الفتى المدلل في كل الحكومات اللاحقة. كان صهر ميشال عون يطلب فيجد، والسلطة كانت، وما زالت، تتشكل وقوفاً على خاطره. لكن باسيل حين أسقط برنامجه الانتخابي فوق رؤوسنا، شعرنا كم أن الرجل “معتر”، وكم أننا نستغله.
تكفي هنا استعادة لبنان النموذج الذي حاكه باسيل في خطابه الأخير للاعتراف بأننا مجرد شعب لا يملك بصراً ولا بصيرة. وباسيل السلطوي طبعاً، سرد مضبطة اتهامية ضمَّنها إلى جانب شركائه في السلطة، لبنانيين كثراً، بوصفهم محطّمين مفترضين للحلم الباسيلي الذي سعى إليه منذ وجد نفسه في قلب هذه السلطة، وبالمناسبة سيكون “حزب الله” رافعة الفتى المدلل لانتخابية في أكثر من دائرة على ما وشى به كلام نصرالله لكوادر حزبه المكلفين إدارة العملية الإنتخابية.
منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وحركة “أمل” هي التنظيم السياسي الوحيد الذي لم يغب عن “جنة” السلطة. المرة الوحيدة التي صدقنا فيها أن الرئيس نبيه بري يمكن أن يفعلها، ويصبح معارضة، كانت عند انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وعلى خلفية حصول جبران باسيل على الثلث المُعطِّل.

يومها أوحى الرئيس بري بأنه قاب قوس المعارضة أو أدنى. وجمهور حركة” أمل” بدا يومها أيضاً مصدِّقاً أن الرئيس تستهويه معارضة لم يختبرها يوماً. وعلى نموذج الجمهور المُقَدِّس زعيمه أطلق هذا الجمهور هاشتاغ”، “#معارضة لعيونك”، كمواءمة كنا ألِفناها بين عيون رفيق الحريري وجمهوره. لكن بري، وعلى قاعدة “من ترك دارو قل مقدارو” عاد إلى سيرته الأولى كشريك أساسي في كل الحكومات التي تشكلت بعد اتفاق الطائف، وحتى قبله.
الرئيس بري قدم للبنانيين في إعلان مرشحي كتلته، جردة عن رؤيته لدولة لبنانية لم تسعفه ثلاثون من سنوات السلطة في تحقيقها. هنا يفترِض حسن الظن أيضاً أن نكون أمام نبيه بري المعارض!
ما يصح في سواه، قد لا يصح بالمطلق في سمير جعجع.
رئيس “حزب القوات اللبنانية” يكاد يُصعِّب على المرء تصنيفه كرمز من رموز السلطة، وهذا أقرب لحقيقة ترفدها تجارب لم تكن سلبية بالمعنى الإداري للكلمة. سلبية “القوات اللبنانية” هي في شراكتها لسلطة كانت تعرف مسبقاً حدود التأثير فيها. ومحاولة تكثيف هذا التأثير، أنتج لاحقاً “اتفاق معراب” الذي ساهم بإيصال ميشال عون إلى الرئاسة، والذي فضحت بنوده لاحقاً نزعة قواتية لتقاسم النفوذ المسيحي في السلطة، قبل أن يحصد رئيسها خيبتها.
والحال، نحن إذاً أمام نماذج تقدم نفسها راهناً كما لو أنها آتية من خارج أي سياق سلطوي وضع اللبنانيين أمام قدرهم البائس. وأغلب الظن أن هذه النماذج التي عصفت برأسنا راهناً، تقارب الاستحقاق الانتخابي، وتحديداً في رؤاها للبنان، كما لو أننا في مستشفى للأمراض العصبية، وأن في داخل كلٍّ منا “رشيداً” سيردد العبارة الرحبانية الأثيرة.
نحن فعلاً أمام فيلم لبناني طويل.
إقرأوا أيضاً:







