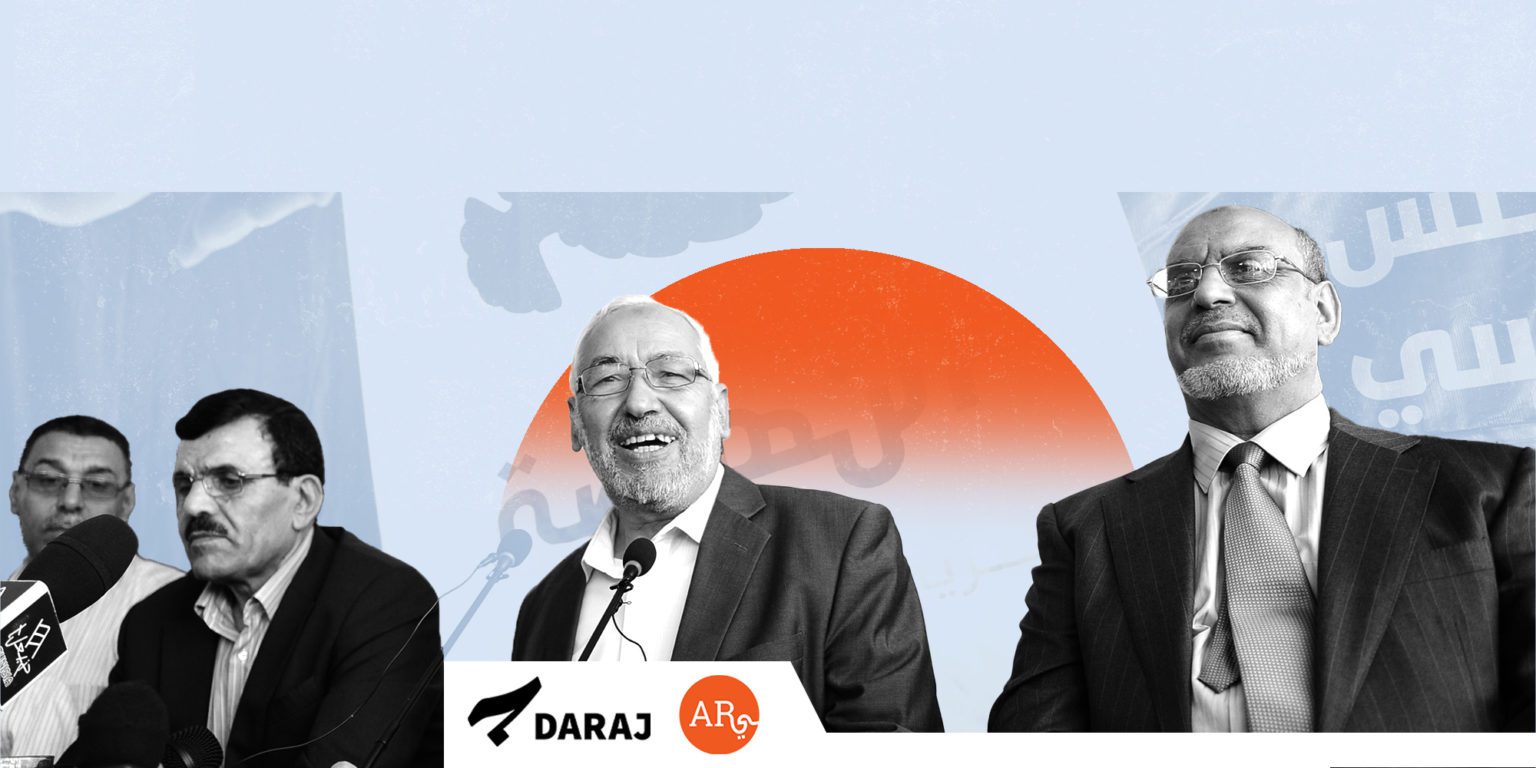مشهد راشد الغنوشي، أمام مدخل قصر باردو، منتصف ليلة 25 تموز/ يوليو 2021، وهو يُمنع من قِبل أفراد من الجيش، من دخول مقر مجلس النواب الذي يرأسه، بُعيد إعلان قيس سعيد تجميد المجلس، يُشكل الصورة الناطقة عن فشل تحقيق طموح قديم: جعل من النهضة، حزباً محورياً في النظام السياسي التونسي، بعد أن كان منبوذاً لفترة طويلة.
تلا ذلك، الاستقالة الجماعية يوم 25 أيلول/ سبتمبر، لأكثر من مئة عضو في الحركة، ومن جملتهم، اثنان من أبرز الكوادر التاريخية (عبد اللطيف مكي وسمير ديلو)، تعبيراً عن معارضتهم العلنية لراشد الغنوشي، لتشكل هي الأخرى مؤشراً على رفض استراتيجية تبحث لنفسها عن موطئ قدم: ربط الاعتراف بالحزب كممثل شرعي في الحياة الوطنية، بمصير راشد الغنوشي، رئيس الحزب، منذ تأسيس حركة التيار الإسلامي (MTI) تقريباً في أوائل الثمانينات. وتم تصوير انتخابه رئيساً للبرلمان في كانون الثاني/ يناير 2020، أمام مناضلي الحركة، على أنه تتويج ثمين لهذا السعي نحو الاندماج في الحياة السياسية التونسية، ورمز لهذا الانتصار الجماعي بعد سنوات من التضحية، وصمام أمان لهم.
وبتبوّئه هذا المنصب الحساس والمصيري، أمسك رئيس النهضة بزمام العمل البرلماني، وضمِن مهمة التنسيق مع الحكومة المدعومة بأغلبية، شكلت النهضة مكوناً أساسياً فيها. وبموازاة ذلك، سمح له منصبه هذا من السيطرة على المجموعة البرلمانية للحركة ومنحه نفوذاً لتسيير شؤون الحزب. وبذلك أصبح راشد الغنوشي، الذي سبق أن حُكِم عليه بالإعدام شنقاً من قِبل الرئيس الحبيب بورقيبة في عام 1987، قبل وقت قصير من الإطاحة به (ثم إصدار عفو بحقه من قِبل بن علي)، أحد أبرز الفاعلين في الفترة الانتقالية، وحظي باحتفاء دولي.
زلزال 25 تموز/ يوليو 2021 وارتداده في 25 أيلول/ سبتمبر 2021 – فقدان الحزب السلطة والانشقاق المتعاظم عن قيادة متنازع عليها – وضعا نهاية لمرحلة من حياة “النهضة” السياسية، وفتحا صفحة عصيبة، يلوح في أفقها غموض وجودي. هل باستطاعة التنظيم تجديد نفسه واستعادة الدور الذي لعبه منذ 2011؟
هل ما زالت “النهضة” تملك، بشكل أو بآخر، ما تقدمه للتونسيين؟ في الواقع، نحن أمام السؤال الجوهري المتكرر حول وجاهة الإسلام السياسي كحزب وكفاعل محتمل قادر على تقديم حلول محددة للمشكلات المعاصرة التي طرحتها الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة. هذا السؤال الاستشرافي يدعو إلى إلقاء نظرة إلى الوراء لاستقصاء مسار النهضة منذ عام 2011.
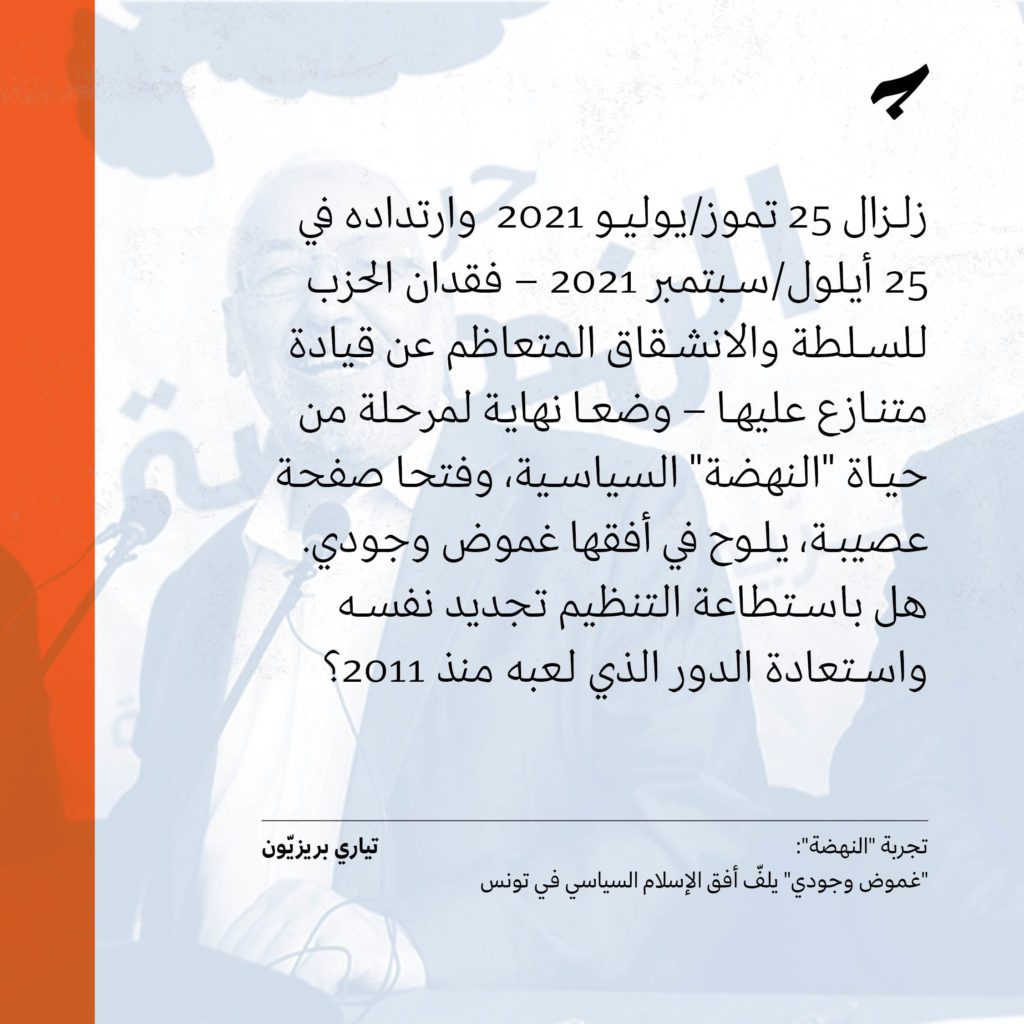
النهضة: مجتمع تحت الصدمة
ثمة عنصرٌ ثابت يتخلل هذا المسار: بصفتها جماعة بشرية، تُشكل النهضة مجتمعاً تحت الصدمة، ينتابه القلقُ باستمرار، بفعل التهديد المصيري المسلط على رقبة الحزب وأتباعه، والمتمثل في طرد الحزب من السلطة. إن شبح محاولة الاستئصال التي ذاق مناضلو الحركة، من المنفيين، والمعذبين والمعتقلين، والمطاردين، وعائلاتهم التي أصبح محكوم عليها بحكم الأمر الواقع، العيش في حالة تدني اجتماعي، وتجرعوا مرارة تجربتها الرهيبة منذ عام 1991 حتى الثورة، شبح هذا التهديد المستمر لعب دوراً حاسماً في تطور الحزب. هذه الصدمة دفعت الحزب إلى جعل من وحدة التنظيم أمراً مقدساً، ينظر إليها على أنها إطار وقائي وحصن منيع؛ وجعل المشاركة في السلطة ضرورة استراتيجية. وأخيراً، منح راشد الغنوشي، بصفته الوسيط والمتحدث مع القوى الخارجية، حجة الملاذ الأخير، التي تمكنه من فرض خيارات محددة وتنازلات على الحزب.
من الهيمنة إلى الصفقة
بعد استقبال الأبطال الذي حظي به راشد الغنوشي لدى عودته إلى تونس في 30 كانون الثاني/يناير 2011، ثم الانتصار الانتخابي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر التالي، والذي منحه أغلبية 89 مقعداً من أصل 217 في المجلس الوطني التأسيسي، شعرت النهضة بطفرة ديناميكية مزدوجة. على المستوى الوطني: الجمع بين الهيمنة الثقافية الإسلامية في المجتمع والأغلبية السياسية. وعلى الصعيد الدولي: الانتصارات الانتخابية، في خضم موجة “الربيع العربي”، لمنظمات مقربة من حركة الإخوان المسلمين، والمسار الذي فتحه رجب طيب أردوغان في تركيا، وبدعم من قطر.
لكن سرعان ما واجهت هذه الهيمنة معوقات وقيود، خاصة وسط النخب والأطر العليا في الإدارة، بما فرض على النهضة الاكتفاء بعلامات إسلامية رمزية في الدستور. بلغ التوتر ذروته في صيف 2013 عندما أدرك الحزب أن السبيل الوحيد لحماية نفسه يفرض عليه التفاوض مع نخب الحزب الدستوري سابقاً، المتجمعة خلف الباجي قائد السبسي في إطار نداء تونس. اجتماع آب/ أغسطس 2013 في باريس بين الزعيمين فتح الباب أمام فترة “انتقال توافقية”.
وجاءت انتخابات 2014، التي فاز بها نداء تونس، لتُكرس هذا “التوافق”. انضم حزب النهضة إلى الأغلبية، وعلى الرغم من المكانة المتواضعة الممنوحة له في الحكومة، فقد عزز مع ذلك موقعه في المشهد السياسي وفي جهاز الدولة. وساهم هذا التحالف في حماية السلم الأهلي والحزب، خلال هجمات 2015 الثلاثة التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
شكّل مؤتمر 2016 ذروة هذه الاستراتيجية بحضور الباجي قائد السبسي شخصياً ليحيي دور النهضة في استقرار الدولة، وأعلن راشد الغنوشي بهذه المناسبة “مصالحة كاملة” للنهضة مع الدولة. وقد صادق المؤتمر على “تخصص” الحزب بالنشاط السياسي وتركه العمل الدعوي والنشاط “الثقافي” للحركة الجمعوية المستقلة. واختتم المؤتمر أشغاله بطرح تصوّر لإصلاح الحركة لكي تتكيف مع طموحها كحزب حاكم رئيسي: من خلال تبسيط إجراءات العضوية لجذب نخب جديدة، ومراجعة الهياكل الداخلية لتعزيز النقاش داخل هياكل الحزب، وإطلاق عملية إصلاح شامل تمس البرامج، بخاصة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. لكن، أثناء المؤتمر هدد راشد الغنوشي بالاستقالة، عندما وافق غالبية المشاركين في المؤتمر (بعد الاقتراحات التي قدمها عبد اللطيف مكي وعبد الحميد الجلاصي) على مناقشة إمكانية تكليف مجلس الشورى للحركة، بتعيين جزء من المكتب التنفيذي، الذي يصر الغنوشي على السيطرة عليه بالكامل، مبرراً ذلك بعدم خروج الحزب بعدُ من منطقة الخطر.
إقرأوا أيضاً:
من الصفقة إلى القطيعة
زاد شعور النهضة بالاطمئنان ورسوخ طموحها خلال العهدة التشريعية 2014-2019، خاصة في أعقاب انقسام شريكها، “نداء تونس”، بين مجموعات متنافسة، غير أن الباجي قائد السبسي بدا عازماً على إبقاء السيطرة على هذا التحالف، في جو من التوتر بين القوتين الرئيسيتين في البلاد. في حزيران/يونيو 2016، فرض الباجي قائد السبسي يوسف الشاهد، العضو في “نداء تونس”، على رأس الحكومة، وحاول تمييع حضور النهضة في إطار “اتحاد وطني” أُبرِم بموجب اتفاقية قرطاج. “إلى أي حد، سيجبرنا راشد الغنوشي على اتباع الباجي قائد السبسي؟” سأل بقلق برلمانيون أُجبروا على التصويت على حجب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، في الوقت الذي بدا فيه الطريق أخيراً معبداً لانطلاق عملية الإصلاح.
وبدلاً من أن يسهم تعيين يوسف الشاهد في حل الأزمة الداخلية الناشبة داخل صفوف نداء تونس، فقد زادها تعقيدا. تحرر رئيس الحكومة الجديد من قبضة أستاذه ومعلمه، وشن هجوماً ضد نجله حافظ قائد السبسي على رأس حزب “نداء تونس”. وفي جو مشحون ناجم عن نزاعات الأغلبية واستدامتها، زاد شلل عمل الحكومة، وتوّسعت رقعة فقدان ثقة الجماهير في الطبقة السياسية برمتها وتشويه سمعتها.
بفضل قوة حضوره المحلي وتنظيمه، نجا حزب “النهضة” نسبياً، خلال الانتخابات البلدية في أيار/ مايو 2018، التي قاطعها الناخبون (65 في المئة من الممتنعين عن التصويت): جاءت “النهضة” في المرتبة الأول وراء القوائم المستقلة، بنسبة 30 في المئة من الأصوات. وفي مجلس النواب، أصبحت تشكل مجموعة الأكثرية عقب الانقسامات المتتالية التي عصفت بنداء تونس. لكن يبدو أن قيادة الحزب لم تنتبه ولم تدرك إلى أي مدى أصبحت هذه الهيمنة محصورة بشكل متزايد في فضاء المؤسسات، ومن دون انتباه حقيقي لموجة غضب الشارع وانعدام الثقة وسط الرأي العام.
بدلاً من استثمار رأسماله السياسي في خطة إصلاحية (استكمال تطبيق الدستور وحل المشاكل البنيوية للبلاد) في إطار التحالف مع الباجي قائد السبسي، فَضّل راشد الغنوشي وضع ثِقله السياسي في خدمة طموح يوسف الشاهد. وفي أيلول/ سبتمبر 2018، تمت القطيعة النهائية مع رئيس الجمهورية.
“التوافق” في خدمة تثبيت الوضع القائم
لم تقدّم الأغلبية “الراسخة” والمُشَكَلة من 155 من أصل 217 عضواً من حزبي “نداء تونس” و”النهضة”، في انتخابات 2014، أي إصلاح حاسم ملموس، ولا يملك أي من الحليفين رؤية بديلة عن الرؤية التي فرضها المانحون، بل ولم يتمكنا حتى من تنفيذها. وبدلاً من تجاوز مصالحهم الخاصة، وتوجيه جهودهم في سبيل مشروع لتغيير وضع البلاد، ظل “التوافق” يترنح باستمرار، بفعل التوترات والمناورات التي سعى من خلالها كلا الشريكين إلى جلب أكبر قدر ممكن من المصالح وجعل المواطنين ينسون فسادهم.
تمثلت أولوية حركة “النهضة”، بالدرجة الأولى، في تأمين موقعها داخل مؤسسات الدولة، في وقت زاد الوضع الجيوسياسي تعقيداً بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين مما أضعف موقع “النهضة”، إلى جانب إعادة فتح ملف محرج، كفيل بأن يعيد إلى السطح شبح سنوات الرصاص: اكتشاف مخزون من الوثائق التي تم الاحتفاظ بها في وزارة الداخلية بعد مصادرتها من بيت أحد نشطاء حركة “النهضة”، وثائق تشير بقوة إلى وجود جهاز استخبارات مواز (تسعى مجموعة من المحامين لربطه باغتيالات شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013)، مما يؤجج من جديد النظرة القديمة حول المؤامرة ضد الدولة التي لطالما استخدمتها دعاية النظام القديم لتبرير حملة القمع ضد الحركة الإسلامية.
وقد تم التضحية بالعدالة الانتقالية التي دفعت فاتورة الطبيعة “التجارية” للتوافق. وبينما استُخدمت هيئة الحقيقة والكرامة كمتنفس ومعالج لجراح النشطاء الإسلاميين على مر السنين، راح الحزب يتقرب بمسؤولين كبار سابقين في جهاز الأمن للتأكد من عدم توظيف الإجراءات القانونية لعرقلة التسويات السياسية.
وفي وضعية الحزب المحاصر داخل تحالف هش غير مؤتمن، وتحت التهديد المستمر للكشف عن “معلومات” تورط أصحابها، لم تتمكن “النهضة” أبداً من ترسيخ وجودها أو اكتساح الساحة، بحيث تتمكن من طرح رؤية خاصة بها، ولم تنجح يوماً في الظهور كحزب طبيعي على غرار غيرها من الأحزاب.
عشية انتخابات 2019، بدت حصيلة ” التوافق” هزيلة إلى حد ما. بالفعل سمح هذا التوافق من تهدئة المشهد السياسي، لكنه منح في نهاية المطاف، الأولوية لتثبيت الوضع القائم وقوّض مصداقية الطبقة السياسية برمتها. وبذلك تفاقمت المشاكل الاقتصادية، في ظل استمرار تعمق الشروخ الاجتماعية، فضلاً عن توّغل الفساد والمحسوبية في دواليب أجهزة الدولة التي فقدت فاعليتها.
في هذه الأثناء، أعاد الحزب تركيزه على قضاياه الداخلية. بدا راشد الغنوشي عازماً على جني ثمار جهود الاندماج الحزبي. ومع تزايد موجة الانتقاد الموّجهة له في محيطه، تراجع عن الوعود المقطوعة بخصوص الإصلاح الذي تقرر في مؤتمر 2016، وخلال صيف 2019، تجاهل تصويت مناضلي الحزب لفرض رؤساء القوائم في الانتخابات التشريعية، بل بدا وكأنه يحلم، بتشجيع من دائرته المقربة، بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2019 أو 2024.
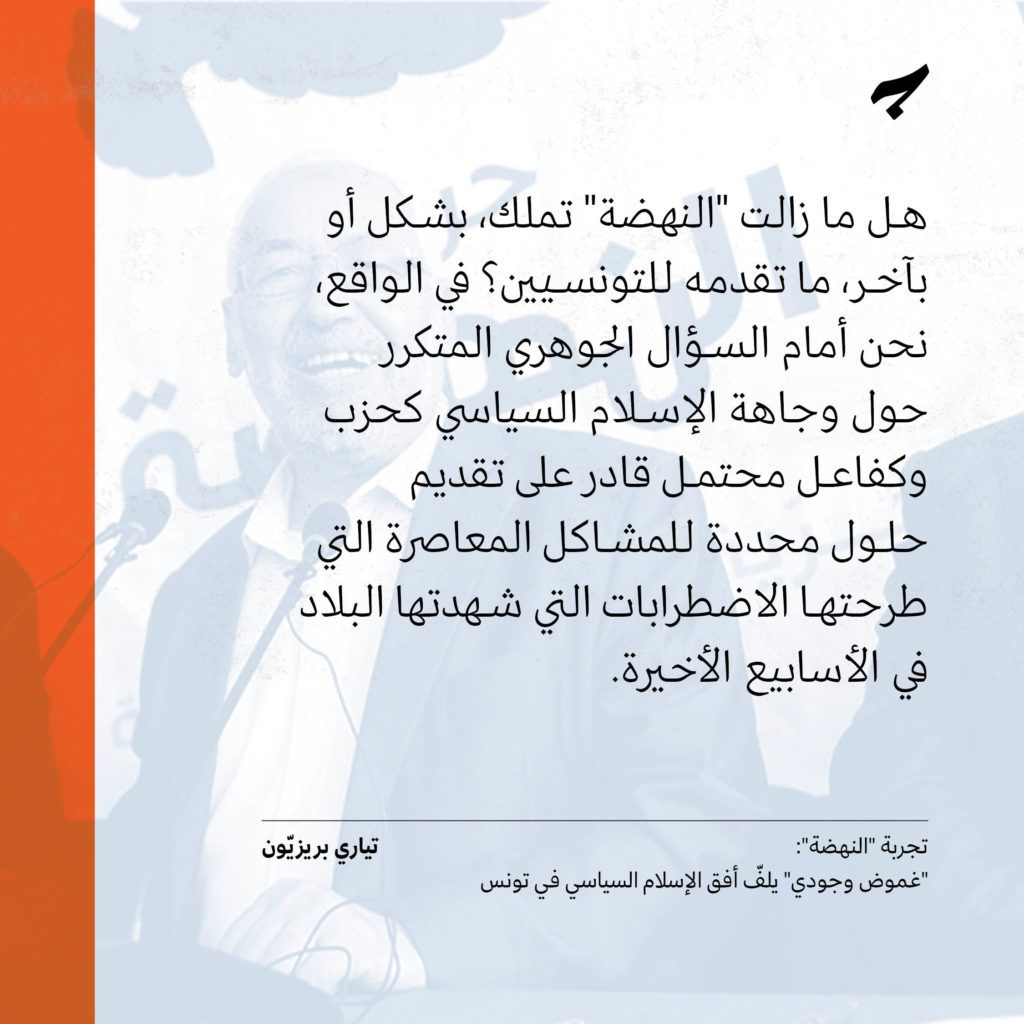
الفرصة الضائعة لعام 2019
وفي وضع حساس، اتسم بوقوع الحزب رهينة قضايا السلطة، وتعاظم صراعاته الداخلية، ورأيٌ عام يعتبر النهضة شريكاً في المسؤولية عن إخفاقات المرحلة الانتقالية، من دون حليف طبيعي، وجدت “النهضة” نفسها تستعد لانتخابات 2019. صحيح أنها فازت بأغلبية نسبية في المجلس، ولكن بنسبة 19.7 في المئة من الأصوات فقط و54 مقعداً (بدلاً من 69 في 2014)، غير أن الحدث الرئيسي الذي ميّز هذه السلسلة الانتخابية، هو انتخاب قيس سعيد رئيساً للجمهورية بنسبة 72.8 في المئة من الأصوات (أو 2.7 مليون). كانت رسالة هذه الاستحقاقات واضحة: رفض شعبي لهذا “التوافق” وانتظار التجديد، لكن، لم يولِ الحزب الأهمية الكافية لهذه الهزة ولم يقدرها حق قدرها، وركز بدل ذلك على البعد البرلماني الضيق للانتخابات: باعتبار النهضة المجموعة الأولى في المجلس، وبمقتضى ذلك يعود لها تعيين رئيس الحكومة، وهي مسألة تدار في إطار توازن القوى الداخلية في الحزب.
من جهة، ضمن راشد الغنوشي، انتخابه رئيساً للمجلس، معتمداً على صيغة جديدة من “التوافق” القائم على تسوية بين الأطراف: أضيف إلى مقاعد حركة النهضة الـ54، 21 مقعداً من ائتلاف الكرامة عن المكوّن الإسلامي، و38 مقعداً لقلب تونس، حزب نبيل القروي، المكون “العلماني” الذي كانت النهضة تصفه بـ”حزب الفساد” خلال الحملة الانتخابية قبل تراجعها عن ذلك.
من ناحية أخرى، عاد لجهاز الحزب مهمة تعيين المرشح للقصبة (رئاسة الحكومة). وقع الاختيار على شخصية يعتقد أنه يمكنه التحكم فيها، وهو الحبيب الجملي، المرشح الذي لا يتمتع لا بالكاريزما ولا الاستقلالية الكافية التي تمكنه من حشد الأغلبية، وقد فشل بالفعل من الفوز بالترشيح في 12 كانون الثاني/ يناير 2020 ، ما “جعل” النهضة تخسر زمام المبادرة، لصالح قيس سعيد الذي اختار إلياس الفخفاخ.
حتى وإن استطاع الحزب في نهاية المطاف إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ في تموز 2020 وإعادة تفعيل “التوافق” لصالح هشام المشيشي، فلم ينجح مع ذلك، لا في إعادة إطلاق ديناميكية الإصلاحات، ولا في تسوية التوترات الداخلية، بل على العكس من ذلك، فإن آفاق انعقاد المؤتمر، التي سمحت الأزمة الصحية بتأجيله على نحو يخدم مصالح البعض، زادت من حدة الخلافات حول خلافة راشد الغنوشي، المفتوحة نظرياً.
في أيلول/سبتمبر 2020، وجّه إليه حوالي مائة مسؤول في الحزب رسالة مفتوحة يطالبونه بالتخلي عن تعديل النظام الأساسي للترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة، وجاء جواب “الشيخ” حاداً في تجاهل تام لهذا المطلب. في هذه الأثناء ومن داخل مجلس النواب، قادت مجموعة حزب الدستوري الحر (الذي نَصّب نفسه وريثاً للتجمع الدستوري الديمقراطي (RCD)، حزب النظام سابقاً) حملة عرقلة برلمانية حقيقية مُوّجهة ضد رئاسة الجمعية.
وعندما انطلقت انتفاضة اجتماعية شملت ربوع الوطن، احتفاء بطريقتها الخاصة بالذكرى العاشرة للثورة، ساندت “النهضة” الحملة القمعية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين، تتويجاً لعقد من الاندماج في صفوف السلطة.
وفي خضم مجموعة من الأزمات المتشابكة (أزمة حزبية داخلية، أزمة اجتماعية، عرقلة الإصلاحات، أزمة مالية، أزمة صحية، تشويه سمعة الطبقة السياسية، إلخ) اندلعت الاحتجاجات الشعبية في 25 تموز ونُفِذ انقلاب قيس سعيّد، بما يُعتبر إدانة وعقاباً على الفشل الشامل لعملية الانتقال التي يرتبط بها مسار النهضة ارتباطاً وثيقاً.
ملامح الشعور بالأزمة
بينما تنطلق مرحلة سياسية جديدة ويلوح في الأفق تشكيل مؤسسي جديد، على الرغم من الضبابية التي تغلب على ملامحه، فلا بد للحركة من إعادة النظر في استراتيجيتها وتحالفاتها وهويتها ومقترحها وحتى في مدى الجدوى منها وأهميتها.
إذ يُشكل النيل من ناخبيها التوجه السائد: فبين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 2011 والانتخابات التشريعية للمجلس في 2019، فقدت النهضة قرابة المليون ناخب (من 1.5 مليون إلى 571000) وتراجعت من 37 في المئة إلى أقل من 20 في المئة من إجمالي الأصوات الانتخابية (وتشير استطلاعات الرأي العديدة المنشورة منذ ذلك الحين إلى أن المنحنى لم يعكس اتجاهاً انحدارياً، وآخرها بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر ينسب له 14 في المئة من النيات المتعلقة بالتصويت).
وحتى لو سمحت قاعدة قوامها حوالي 400 ألف صوت لحركة النهضة بالبقاء لبعض الوقت، فستظل نقاط القوة الخاصة بتوطيد دعائمها الانتخابية المتدهورة، أقل قطاعات المجتمع حيوية (في المناطق الريفية، الناخبون الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً والأقل تعليماً). ولم يستطع الحزب جذب الجماهير الواعدة مثل الشباب المنخرطين في الحركات الاجتماعية أو غيرهم من الكوادر.
تجد “النهضة” نفسها واقعة في شراك سلسلة من التناقضات التي تحدد ملامح شعورها بالتأزم جراء وجودها في حد ذاته. ففي حين أنها لم تنجح في التخلص تماماً من صورتها كحركة منبوذة من السياسة التونسية، إلا أن مرور عشر سنوات على مشاركتها في السلطة جعلها تصبح جزءاً عضوياً من نسيج “النظام”.
وفي حين أن جزءاً من ناخبيها الأوائل في عام 2011 انقلبوا عليها بعدما بالغت في خلط الدين بالممارسة السياسية “الدنيئة” (الغوغائية القائمة على أساس الحسابات الانتخابية المجردة، والإنكار المتكرر، والمناورات التكتيكية، والتورط في التربح من وراء المنصب، وما إلى ذلك)، يلومها ناخبون آخرون على تخليها عن أهدافها الإسلامية. وبين كونه إسلامياً للغاية بالنسبة للبعض أو ليس إسلامياً بما يكفي في نظر آخرين، فهذا الحزب يكافح من أجل إقناع الجميع بأن هويته الدينية تميزه تمييزاً واضحاً عن أي حزب سياسي عادي بينما يستمر في المعاناة من ربطه المُخزي بـ “الإسلام السياسي”.
وأصبحت نقاط القوة لدى الحزب – أقدميته وقدرة زعيمه على التكتيك وانضباطه ومرجعيته الإسلامية – هي ذاتها الأعباء التي يرزح تحت وطأتها؛ مما يجعل وصمة كونه حزباً “ظلامياً” أو “دخيلاً” بل وحتى “إرهابياً” التي تنتشر منذ الثمانينيات ضمن النخبة الإدارية والفكرية، ملتصقة به. وتظل شخصية راشد الغنوشي، وذلك على الرغم من الاعتراف الدولي بدوره في قيادة الفترة الانتقالية، تجسيداً لهذه الشخصية البغيضة في نظر شريحة واسعة من الجمهور. كما عزز تقديس الوحدة والطاعة لقرارات القيادة رؤية النهضة كجماعة منغلقة على نفسها. أما المرجع الديني الذي يرسخ هوية الحركة، فقد أصبح شيئاً فشيئاً مصدراً للغموض أكثر منه مصدراً للإلهام الذي يمنحه برنامج ما.
إقرأوا أيضاً:
مرجعية دينية جوفاء
عند بداية ظهورها في عام 1981، كانت حركة التيار الإسلامي (التي عُرفت باسم “النهضة” عام 1989) وليدة رد فعل ضد التحديث الاستبدادي الذي كانت تمارسه “السلطة العليا”. وبدت النهضة حينها كـ”مجتمع مضاد” كان يعتزم تكوين طوباوية لجمهورية إسلامية، والتي تتناقض تمام التناقض مع الحزب الدستوري ومشروعه العلماني. وهو الأفق الذي كان ولا يزال إلى اليوم بعيد المنال مثله في ذلك مثل “دكتاتورية البروليتاريا” التي تُعد تمهيداً “للمجتمع اللاطبقي” الذي يطرحه المشروع الشيوعي.
ولكن، في الوقت الحالي، تخلت الدولة عن طموحها كمؤسسة سلطوية في المجتمع ولم يعد أفق الجمهورية الإسلامية أكثر من مجرد فرضية نظرية. وحتى لو بقيت اليوتوبيا الإسلامية عالقة في أذهان المناضلين السابقين، فلم يعد لها دور عملي يُذكر. فعلى إثر محاولات تكيفها المتتالية مع الحداثة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ورغبتها في أن تكون جزءاً من المعارضة الديمقراطية لنظام بن علي، ثم الانتقال الديمقراطي بدايةً من عام 2011، انتهى الأمر بـ”تطبيع” الحركة.
وللكشف عن مرجعيتها الدينية، انتهجت الحركة (مثلما هو الحال في حزب العدالة والتنمية المغربي) ما يُعرف بـ “فقه المقاصد”، وهو مفهوم أعاده الطاهر بن عاشور (1879-1973) إلى النور، وهو علم من أعلام علماء الدين الإصلاحيين في تونس، وقد أوجزه في خمس نقاط، الحفاظ على الدين، والحياة، والعقل، والممتلكات المادية، والنوع. كما تضيف نصوص النهضة المذهبية لهذا المفهوم: العدالة الاجتماعية والبيئة. لكن هذه الأهداف العامة للغاية يمكن أن تتوافق مع مجموعة واسعة من التوجهات الاقتصادية والسياسية ولا توفر أي إطار تحليلي يمكن ترجمته على الفور إلى سياسة عامة ما. وإذا تم التذرع أحياناً بآيات قرآنية وأحاديث (أقوال تواترت عن النبي) للجوء إليها على الجبهة الداخلية لدعم قرار ما، فهي تعود بدرجة أكبر للتبرير العقائدي بأثر رجعي أكثر من كونها قاعدة ملزمة.
لا تزال الحجة المتعلقة بالهوية بمثابة وقود للاستراتيجيات الانتخابية ومصدر لشرعية النخب الراسخة، لكن قيمتها الحاشدة تتهالك أكثر من كونها تتلاشى منذ الانتخابات السابقة لتفويض التحالفات التي شُوهت صورتها أثناء الحملة الانتخابية.
عبثية الشأن الاجتماعي
بعبارة أخرى، لا يزال الإطار المرجعي الديني يحدد هوية الجماعة المناضلة، لكن ما اكتسبته من المرونة، على حساب المفهوم المعياري الصارم للإسلام، لم يعد يسمح للنهضة باقتراح مسار فردي، ولا سيما في ما يتعلق بالتفكر في التناقضات الاجتماعية وقوى الاقتصاد الخفية بعيداً عن القيم الأساسية للتضامن والمعايير الأخلاقية. فهو لا يأتي بأي حل للعقد الإشكالية للمسألة الاقتصادية التونسية: كيف يمكن التخفيف من قبضة التبعية المالية؟ كيفية المشاركة في التبادل الدولي مع التواجد في موقع أقل تبعية؟ كيفية تنظيم الاقتصاد من أجل توزيع أفضل للفرص؟ كيف يتم إنشاء سوق داخلي وإعطاء أساس مادي لسيادة اقتصادية ما؟ ما النموذج الزراعي الأفضل استجابة للتحديات الاجتماعية والبيئية؟ كيف يمكن إعادة الدور الاستراتيجي للدولة، وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية؟ وغير ذلك.
كان الطابع الثقافي الغالب على النهضة في أول عهدها، يضعها ضمن فئات الخاسرين فيما يتعلق بـ”التحديث”: المناطق الريفية، والمناطق شبه الحضرية، ولا سيما جنوب البلاد. كان ذلك أساساً محتملاً للنظر في الاختلالات الاجتماعية والإقليمية والتي كان من شأنها أن تجعل من الممكن إعادة صياغة الدولة، والنموذج الاقتصادي، والطابع الغالب على الإقليم. في المؤتمر السنوي للحزب الذي عُقد في حزيران/ يونيو 2019، نوقشت المسألة الاقتصادية بشكل خاص من زاوية “الاستعمار الداخلي” (في ضوء أعمال الصغير الصالحي). وهو التفكير الذي لم يسفر عن تحقيق نتائج ملموسة. وعلى النقيض من ذلك، دفعت الحاجة للقبول على الصعيد الدولي النهضة لتأييد النهج النيوليبرالي التقليدي للتوصيات التي صاغتها الجهات المانحة.
إذا كان حزب النهضة يمثل، قبل عام 2011، المعارضة “العضوية” للنظام الذي رفضته النخب وجزء من المعارضة اليسارية كذلك، باعتباره جزء دخيل على المشروع الوطني، أصبح جلياً أنه لم يكن يمثل معارضة “منهجية”، بحيث بدا، بعد عام 2011، أنه لم يكن ينوي التصدي لجذور النظام الذي طالما سعى لتكوينه، والتي تضم: التواطؤ بين عالم المال ومجالات السلطات المؤسسية والقضائية والإعلامية؛ – انعدام الشفافية وإفلات قوات الأمن من العقاب؛ والانفتاح الاقتصادي الذي نتج عنه تصدعات إقليمية واجتماعية…
الدفاع عن نموذج ديمقراطي متأزم
تمنح معارضة ما يسمى بـ”انقلاب” 25 تموز/يوليو النهضة (ومن انشق عنها مؤخراً) فرصة تقديم أنفسهم كمدافعين عن الديمقراطية البرلمانية، لكن دون معالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها أثناء تعاطيها والتي مهدت الطريق لمشروع قيس سعيد، وعلى نحو أكثر تحديداً، عدم قدرتها على إدراك التوقعات الشعبية وتحقيقها، وهو عجز جعل غالبية السكان لا يجدون من يمثلهم.
وتكمن صلابة وشرعية الديمقراطية النيابية في نوعية ممثليها، إلا أن تونس ورثت في عام 2011 تشكيلاً تحزبياً مشتتاً ما بين تشكيلات صغيرة محصورة في مساحات ضيقة قد سمحت بها السلطة من جهة أو تخفت بالتواجد سراً أو في المنفى، ومن جهة أخرى، حزبان مجتمعيان: حزب السلطة والتجمع الدستوري الديمقراطي المنتشر على جميع مستويات المجتمع كأداة للسيطرة والوساطة مع الإدارة، و”المجتمع المضاد” الذي تشكل حول النهضة، وهو مرن بشكل مذهل على الرغم من القمع الممارس في الثمانينيات وعقدين من التخفي عن الأنظار منذ عام 1991.
تم القضاء على معظم التشكيلات الصغيرة بعد عام 2011. وتم حل التجمع الدستوري الديمقراطي في آذار/ مارس 2011 وتحاول بعض الرموز بشكل متتالي إعادة العائلة الدستورية (نداء تونس، وتحيا تونس، وقلب تونس، والحزب الديمقراطي الليبرالي …)، بينما كانت أحزاب أخرى تدخل المنافسة، إما حول مسائل مجزأة (كمكافحة الفساد، والتحرر الاقتصادي، وما إلى ذلك) أو الارتكاز الإقليمي (تحالف الكرامة في الجنوب)، سواء بحمل طموح شخصي (مثل مشروع تونس لمحسن مرزوق، وتحيا تونس ليوسف الشاهد أو الرحمة لسعيد الجزيري). لكن لا يوجد حزب واحد منهم يعبر نظامياً عن التعبئة الشعبية، أو المصالح المحددة، أو الحساسية الأيديولوجية القادرة على تسييس مجموعة كبيرة للغاية وحديثة بما يكفي من الإشكاليات لتشكيل مشروع وطني تعبوي. وبوصفها الناجي الأخير مما حدث قبل عام 2011، تظل النهضة عالقة بدورها في مسألة تمثيلها ومدى أهمية هويتها السياسية.
في حين منع “توافق الآراء” استعداء المجال السياسي، وأيد “النسيان الممنهج للشأن الاجتماعي” وتنشئة اقتصاد يصنف بوصفه “ريعي” لصالح الأقلية الحاكمة، كانت الانتخابات قد شابتها المحاباة السافرة، والتحيز الإعلامي الصارخ والتمويل غير القانوني الذي أقره ديوان المحاسبة، مع التغاضي والإفلات التام من العقاب.
وفي ظل مثل هذه الظروف، هل أصبحت الأحزاب تمثل الأصوات أم أنها أصبحت بمثابة أجهزة لالتقاط الأصوات التي تشكل حاجزاً بين الناخبين والمؤسسات؟ هل أصبح التصويت حقاً شكل من أشكال المشاركة والتفويض للسلطة، أم بالأحرى تجريداً للسلطة السيادية؟ يعد الوهم المؤسس للديمقراطية النيابية الذي يجعل الإرادة العامة للأغلبية البرلمانية تتقدم، أمراً لا يمكن قبوله، عندما تذوب السيادة الشعبية لهذه الدرجة وتصبح مغرقة في الشكلية. وفي حين أن القاعدة السياسية للانتقال الديمقراطي آخذة في التقلص باطراد منذ عام 2011، فالأحزاب هي أول من يُسأل عن ذلك. ومن المؤكد أن الدعوة لممارسة الضغوط الدولية للعودة نحو المؤسسات الديمقراطية التي أطلقتها النهضة من ضمن جهات سياسية تونسية فاعلة أخرى، ليس من المرجح لها أن تعيد تشكيل قدرتها النيابية.
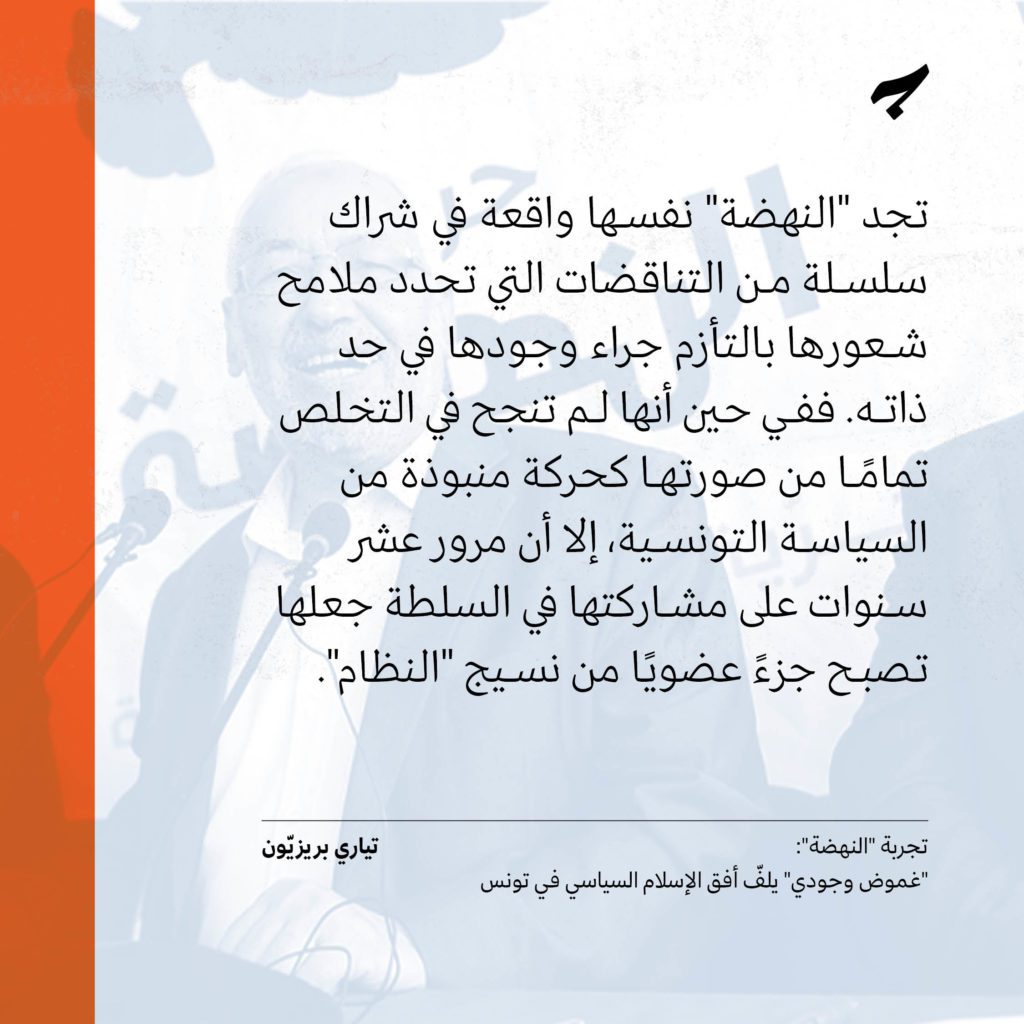
ما الفائدة العائدة من الحزب المحافظ؟
لقد خرجت كافة الأحزاب من هذه السلسلة من التحول الديمقراطي في حالة ضعف شديد، كما أن الانفجار الكبير الذي وقع في 25 تموز، تركها في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بدورها في تشكيل المؤسسات التالي الذي قد يرى النور في الأشهر المقبلة. فكيف يُعاد بناء الطابع التمثيلي؟ وما هي التحديات التي يجب هيكلة العرض السياسي حولها؟
منذ انتخابات عام 2019، أصبح هناك انقسام في الرأي يزداد وضوحاً حول السيادة، ولا سيما حول السيادة الاقتصادية: هل يجب علينا الامتثال للمبادئ التوجيهية الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الجهات المانحة والشركاء التجاريون الذين يربطون ما بين التكامل غير المتكافئ في مجال التبادلات الدولية في حالة التبعية المالية، وبين نموذج الديمقراطية الليبرالية. أم يجب محاولة شق طريق جديد، واستعادة الاستقلال المالي، واعتماد الخيارات الاقتصادية على أساس الاحتياجات المحلية التي تحددها المؤسسات، مما يضمن تمثيل المواطنين بشكل أفضل.
في إطار مثل هذا التشكيل، ما الذي ستكون عليه الوظيفة المنوط بها الحزب الذي يمثل الاتجاه المحافظ؟ هل نقاوم تطورات مجتمع مر بزخم فردي واختلطت عليه المرجعيات بعيدة المنال، من خلال محاولة تعريفها بواسطة الدولة؟ تُدل التجربة على أن إعادة تسييس مسألة الهوية هي استراتيجية ستكبد الحزب الكثير: فهي تعزله وتوصمه بالعار. ففي سياق هيكلة المجال السياسي الذي تحدده مسألة السيادة، وفي الوقت الذي يخيم فيه انتخابياً على السيادة المتعلقة بالهوية والثقافة، تجد النهضة نفسها مرتبطة مادياً بالانفتاح الاقتصادي والسياسي على الخارج للنموذج التونسي، والذي يتعارض مع الدعوة “لإنهاء الاستعمار الرمزي”، التي تمخضت عنها الحركات الإسلامية منذ البداية.
مع اقتراب المؤتمر المقرر عقده في عام 2022 والذي لا يتوقعون منه جديداً، والذي سيدور بالأساس حول القضايا المحلية، يتخلى العديد من الكوادر عن مسؤولياتهم وينأون بأنفسهم بعيداً عن الحركة. ومن جانبهم، يعمل المستقيلون في 25 أيلول/سبتمبر حالياً على تشكيل حزب جديد يُعرّف بكونه محافظاً وليبرالياً وذي خلفية اقتصادية، إلى جانب حفاظه على الدور الاجتماعي للدولة، مما يعد استمراراً لذلك النهج الذي اتبعته النهضة خلال السنوات الأخيرة. ولكونهم قد أظهروا معارضتهم في خضم الأزمة وانشقوا عن الصف، ينظر لهم غالبية المناضلين نظرة استياء، ولا يزال دورهم القيادي محدود في الوقت الحالي. ولن يكفي تقديم شخصية تختلف تمام الاختلاف عن شخصية راشد الغنوشي واستحداث هياكل داخلية أكثر ديمقراطية من تلك الخاصة بالحزب التاريخي، أو تصدر الدفاع عن الديموقراطية الليبرالية في الوضع الراهن، لتجاوز التناقضات والحدود التي تعرقل مسيرة الحزب.
الرهان الخاسر
قدمت النهضة اتجاهاتها المغايرة على أعتاب النظام السياسي حيث كانت تريد أن تحظى بالقبول، والتي تتمثل في: تأسيس ما يسمى بالمدينة الفاضلة، والجوانب الأكثر معيارية لمرجعيتها الدينية، وأول دوافعها المناهضة للإمبريالية والقومية العربية، وسوسيولوجيتها الواقعة خارج إطار المدن. فقد علقت مصيرها على نوع من النظام التمثيلي الذي يعتمد استقراره على البرامج الانتخابية الشاملة، تلك التي يسفر عنها أغلبية توافقية في خدمة النهج الاقتصادي التقليدي الخاضع لتدبير الخبراء، ولكن تطغى عليها آثار الإقصاء الاجتماعي واستبعاد المواطنين، في تونس كما في الديمقراطيات القديمة التي كانت تواجه بروز عناصر “شعبوية”. لا أحد يدري كيف ستستمر الأحداث المتتالية التي برزت في 25 تموز، لكن الرهان على العودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق، والهيمنة التي كانت تمارسها حركة النهضة، هو رهان خاسر سلفاً.
إقرأوا أيضاً: