“التقيتُ عبقرياً اليوم على القطار
في السادسة تقريباً
كان جالساً قربي
وبينما
عبر قطار الخط الساحلي
وصلنا إلى المحيط
وعندها نظر إليّ
وقال:
ليس جميلاً.
كانت المرة الأولى
التي أدرك فيها
ذلك”.

يحيّرني البحر. وأعتقد أنه يحيّر كثيرين غيري. وهو لطالما كان مادة للشعراء والأدباء، سرّاً من الأسرار، التي لا يدركونها، وحيرةً لا يستطيعون التغلب عليها. وهو إذ يوحي النظرُ إليه بطمأنينة لدى كثيرين، إلا أنه في هيجانه وأعماقه الدفينة، لا يوحي إلّا بالقلق والاضطراب. وهو على ما قيل فيه “صانع الأرامل واليتامى”، وهو الذي يفرّق الأحبّة، وهو الذي في أعماقه تنام الأرواح الغارقة مع الأسماك.
“ليس جميلاً”، يقول الطفل ذو الست سنوات للشاعر الأميركي شارلز بوكوفسكي عن البحر (المحيط). صدم الصبي الشاعر وحيّره هو الآخر. لم يكن قد انتبه قبل ذلك، إلى أن البحر ليس جميلاً. غالباً ما يعتقد الناس أن مشهد البحر جميل. ويرى كثيرون أن هذا من المسلّمات. “هيلا يا واسع” تغنّي فيروز. “مركبك راجع” تغنّي فيروز. ويكون البحر جميلاً. لكن عندما لا يعود المركب، ويغرق، يصير الوجع واسعاً. “بحّر وقول يا كبير/ وتبقى سفريتنا سعيدة”. هكذا فعل من تركوا “اليابسة”(بكل ما للكلمة من معنى) في طرابلس وركبوا البحر. لكن “سفريتهم” لم تكن سعيدة. بل انقلبت إلى مأساة. لم تحنّ عليهم الريح، ولا الجيش، ولم يصلوا إلى “المينا الغجرية” كما تقول الأغنية. “شايفة البحر شو كبير” يا فيروز…؟
“هذا البحر لي” أردّد مع محمود درويش. لكنّه يحيّرني. وليس جميلاً. كيف يمكن لبحر كهذا، ابتلع أطفالاً يحاولون الهرب من الجحيم، أن يكون معياراً للحب؟
“كبر البحر بحبك”؟! أتخيّل الأب الناجي من الغرق في مدينة طرابلس شمال لبنان، يغني هذه الأغنية لابنته، فيغمرني دفق من الأسى. أطرد الأغنية. أخنقها. أُغرقها في دموع مكتومة. أشعر بطعم الماء والملح في جوفي. أشمّ رائحة البحر وقد اختلطت برائحة الخوف. الطفلة التي غرقت، وبقيت لعبتها طافية على السطح، أنزلت خوفها معها إلى الأعماق.
لكن لا شيء يمكن أن يسعفها. لا هذه الكلمات ولا غيرها. لن تستطيع ان تتنفّس تحت الماء كما فعل نزار قباني، حين شبّه حبّه بالغرق: “إنّي أغرق أغرق…” يغنيها عبد الحليم حافظ واستمعتُ إليها آلاف المرات، من دون أن أعي معنى الغرق الفعلي. كثر غيري مرّ الغرق عليهم كلاماً ملحّناً ليس إلّا. على اليابسة، في بيوتنا، أو سياراتنا، نستمع إلى الأغنية، وبعضنا ربما سمعها في الماء على متن قارب أو سفينة، أثناء رحلة استجمام. لكن أحداً لم يفكّر في حرفية المعنى، أحداً لم يجرّب حقاً معنى الغرق حتى الموت. هل تسنّى للطفلة الطرابلسية الصغيرة أن تستمع في حياتها القصيرة إلى “رسالة من تحت الماء”؟
إقرأوا أيضاً:
حيرتي تتلاطمها الأمواج. وجه الطفلة التي انتشلوها من تحت الماء لا يفارقني. عيناها المفتوحتان كسؤال أبديّ عن الذنب الذي اقترفته. فمها المفتوح على كلمات أخيرة منعها الماء من نطقها. وجهها، كما تقول فيروز في أغنية عاطفية أخرى، “ما كان يفارقني/ وجرّب اسبح ويغرّقني”. وجه الفتاة الصغيرة الميتة يغرقني معه، ومع ذلك، أجد استعارة الأخوين الرحباني قاصرة عن لمس قسوة الموت غرقاً. ما هذا الاستسهال، استسهالنا جميعاً، تشبيه عذاب الحبّ بعذاب الغرق؟
أتذكّر قصيدة قديمة قاسية لسامر أبو هوّاش عن الغرق، مهداة إلى أبيه “الرجل الجميل جداً”، وهو عنوان القصيدة: “هكذا وجدوه/ جسدٌ ما، وعار فقط/ نبتة خضراء/ كانت تربط ظلّه بالأرض/ قالت:/ لكي لا يسقط في النوم سهواً/ ثم بكت/ هكذا وجدوه إذاً/ الرجل الجميل جداً/ جنباً إلى جنب/ ذات ظهيرة/ مع أسماك”. أستعير القصيدة من سامر لأعطيها للأب المكلوم، لعلّ كلماتها تسعفه على رثاء ابنته الجميلة جداً، التي وجدوها أيضاً جنباً إلى جنب مع أسماك.
“يا بحر قول للسمك طول ما الشبك فوقك/ لا العشق كارك ولا رمل الشطوط شوقك/ انزل قرار النجا واغطس ولا تقبّش/ موج العلالي خطر في النوه ومغبّش”، يصرخ الشيخ إمام بكل ما أوتي من صوت، وكأنه لا يحذّر الأسماك وحدها من خطر “موج العلالي”، بل أيضاً يحذّر من يركبون البحر، بلا شباك، بحثاً عن فرص جديدة، لكنهم يجدون الشباك العسكرية فوقهم لتصطادهم وتغرقهم.
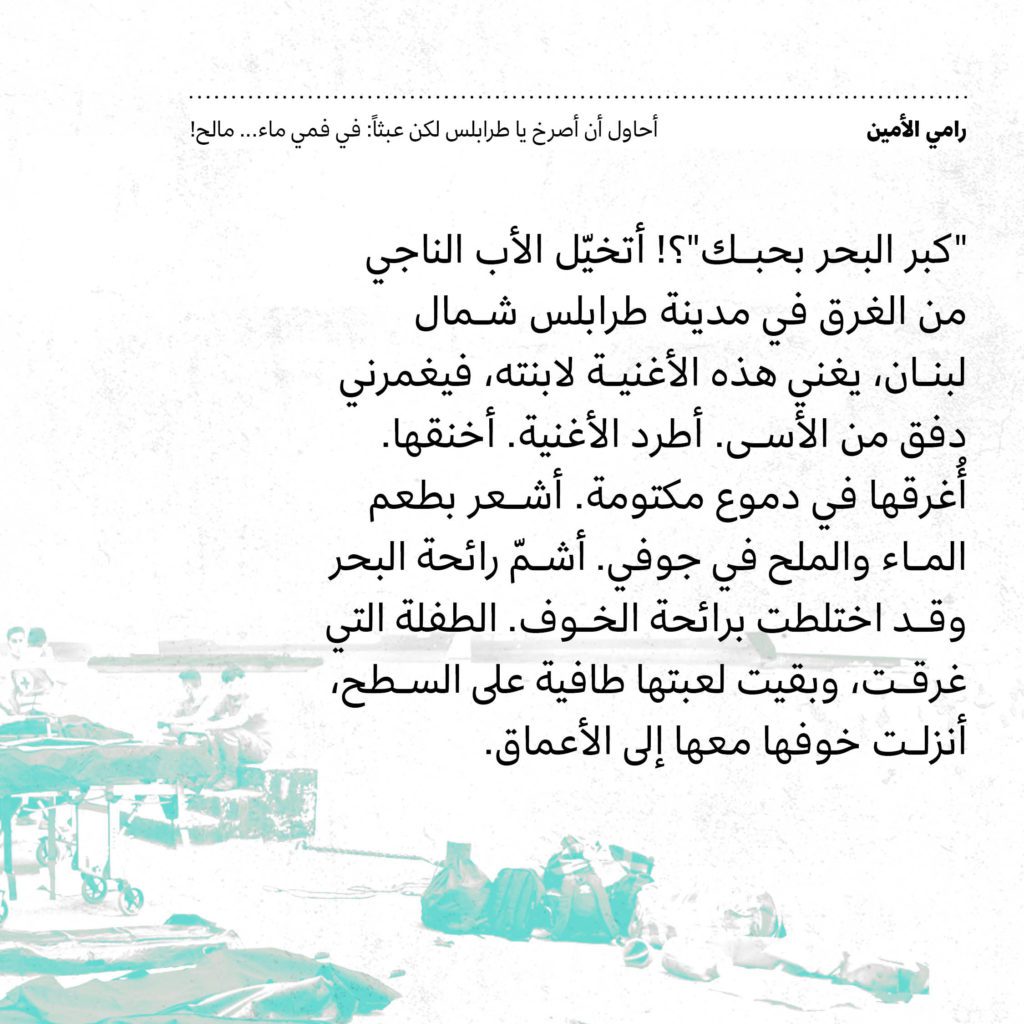
يحيّرني البحر، كما حيّر نجيب سرور من قبلي: “البحر بيضحك ليه؟”. يسأل الشاعر الكبير، ثم يجيب: “البحر غضبان ما بيضحكش/ أصل الحكاية ما تضحّكش/ البحر جرحه ما بيذبلش/ وجرحنا ولا عمره ذبل”. جرحنا لا يزال طازجاً يا عمّ نجيب. لكن البحر الغاضب ابتلع الحكاية، وابتلع معها أبطالها، الذين هربوا من السرديات القاتلة إلى احتمالات الحياة، هربوا من شرب “قلّة الذل”. الحكاية “ما تضحّكش”، قبل أن يفعل البحر فعله، وقبل ان يفتح أعماقه كفم حوت كبير ويبتلع الهاربين من الحكاية، فيجدونها معهم على متن القارب الهزيل المترنّح. لكنها صارت حكاية مؤلمة ومبكية بعد ذلك. صارت صرخة مكتومة تحت الماء كإصبع ديناميت. صارت جريمة.
“سالمة يا سلامة/ رحنا وجينا بالسلامة” يغني السيد درويش. الأغنية كأنها مكتوبة كتحذير من مآسي الهجرة: “صفّر يا وابور واربط عندك/ نزلني في البلد دي/ بلا أميركا بلا أوروبا ما في شيء أحسن من بلدي”. كان بديع خيري مؤلف الكلمات متفائلاً ببلاده في تلك الفترة من بداية القرن العشرين. كان متفائلاً لأن “الوابور” كان بإمكانه أن يبحر إلى أميركا وأوروبا وأن يعود سالماً إلى مينائه. ويخلص في الأغنية، إلى أن “المركب اللي بتجيب/ أحسن من اللي بتودّي”. لكن المركب الطرابلسي، بعد أكثر من مئة عام على هذه الأغنية، لم يكتب له لا أن “يجيب” ولا أن “يودّي”، ولا أن يصل إلى أميركا ولا إلى أوروبا. كانت شِباك العسكر له بالمرصاد.
أحاول أن أصرخ، لكن عبثاً: في فمي ماء مالح.
إقرأوا أيضاً:








