قلة من الصحافيات يستعملن اسمهن الثلاثي. أنا من بين هؤلاء اللواتي تستخدم اسمها هكذا: هلا نهاد نصرالدّين.
البعض قد يعتبر هذا شأناً مناقضاً لمبادئ النسوية التي نناضل لأجلها، ولعلهم يرونه مظهراً من موروثات المجتمع الأبوي الذكوري.
هذا رأي اتفهمه لكن ليس قصتي الخاصة!
إنها المرة الأولى التي أكتب فيها عن السبب الذي لم أتمكن من الحديث عنه حتى مع المعالج النفسي الذي لجأت إليه بعد سنوات من التعايش مع اضطراب ما بعد الصدمة (Post Traumatic Stress Disorder PTSD). فهل وصلت، بعد 6 سنوات، لمرحلة المصالحة مع الواقع؟
والدي رحل باكراً، قبل ثلاثة أسابيع من تخرجي من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU). فبعد أسبوع من وفاته المفاجئة، تلقيت اتصالًا من جامعتي لتبلغني أنني ممن نالوا أعلى المعدلات في الجامعة وبالتالي لأهلي مكان في المقاعد الأمامية المخصصة للـ VIP.
بدل أن يكون هذا الاتصال مفرحًا، كان وقعه مؤلمًا، لأنني فقط حينها تيقّنت أنّني خسرت فرصة أن أشارك أبي فرحتي وأردّ له بعضاً من تعبه. فعندما حان الوقت لجني ثمرة ما زرعه، رحل، دون أن يتسنى لي أن أردّ له ولو القليل من فضله وكأنّه يسخر منّي كعادته قائلًا، “كِفّيني شرّك وما بدّي منّك شي”. لطالما اتّسمت علاقتي بوالدي بمناكفات الوديّة وسخرية متبادلة.
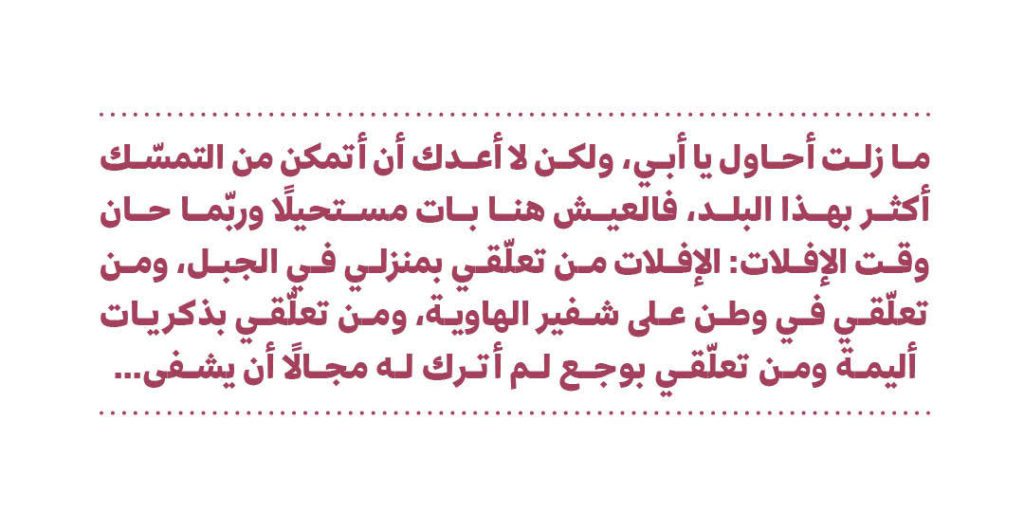
يقول المثل الشعبي “ما حدا بموت وإله عند التاني شي” ولكن ذلك غير صحيح، فبعض الديون يستحيل تسديدها. ولكن لم أستطع تقبّل ذلك، حاولت إيجاد أي طريقة لمواجهة شعوري بالإحباط والعجز، فقرّرت في حينها أن أضع اسم والدي بجانب اسمي في كل بحث أو مقال أكتبه، ليس لترسيخ الأفكار الأبوية البالية بل لشعوري وقناعتي أنّني بذلك أفيه القليل ممّا قدّمه لي.
للمرّة الأولى منذ وفاة والدي، تصادف ذكرى وفاته في 17 أيار يوم الثلاثاء وهو اليوم الذي توفي فيه عام 2016… أعود بالذاكرة اليوم وأعيش اللحظات من جديد ولكن بشكل هادئ أكثر، إلا أن الجرح لم يلتئم بعد. بت أشعر اليوم أكثر من أي يوم مضى أنّني انعكاس له ولشخصيّته، رغم الاختلافات التي بيننا. اقتنع اليوم أكثر بقول جلال الدين الرومي “الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه فلا ثمة انفصال أبداً”.
اكتشفت كيف ارتبط تعلّقي بوالدي بتعلّقي الجغرافي غير المبرّر بمنزلي في الجبل من ناحية وببلدي من ناحية أخرى. أمضيت سنتي الدراسية 2015 – 2016 في بيروت، حيث كنت أقيم بالقرب من جامعتي، فغابت عنّي كل تفاصيل وجه والدي المنهك ولم أتنبّه كيف تغيّرت معالمه كالإسوداد تحت عينيه والتجاعيد في وجهه. قبل وفاته ببضعة أيّام، تركت سكني في بيروت وعدت إلى المنزل ولكنّني كنت منهمكة بالدرس والعمل ولم يتسنّ لي الحديث معه أو حتى الاطمئنان عليه. “كانت الدنيي مش سايعتني”، كما نقول في لبنان، أريد أن أتعلّم وادرس وأعمل في نفس الوقت، وأن أستفيد من كل دقيقة لأحقق أمنياتي الكثيرة وطموحي الكبير وأطير في فضاء أحلامي اللامتناهي، فيقول لي مازحًا “مفكرة حالك بنت لورد”، فأردّ بسخرية “بيّي أهم من لورد”، وما زلت أؤمن بذلك اليوم أكثر من أي وقت، فهو، ووالدتي، اللذان كانا دائمًا يحثّونا أنا وأخواتي على الايمان بأنه لا شيء مستحيل وأنّ أحلامنا ليست عصيّة عن التحقق دون اللجوء لأحد أو منّة من أحد.
ولكن بعد الفاجعة، وكأنّما العالم انتهى وفضائي انهار والدنيا ضاقت بأصغر وأهم أحلامي: وجود عائلتي بجانبي. غضبت وحقدت على قسوة الحياة التي حرمتني من والدي، وفي سياق تلك المشاعر السلبيّة غضبت على بيروت وحقدت عليها، شعرت أنّها غدرتني وأنّها إحدى الأسباب التي حالت دون أن أودّع أبي وداعًا يليق به في أيّامه الأخيرة وقرّرت ألّا أسكن تلك المدينة مجدّدًا خوفًا من غدرها. أخذتني أربع سنوات وفاجعة جديدة، هي انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لكي أشفق على هذه المدينة واتصالح معها وأعي أنّها ضحية مثلي تمامًا، فتآلفت معها وشعرت بآلامها. تحوّل حقدي عليها إلى خوفٍ منها وعليها في آن. ورغم أنّني لا أؤمن بالمعتقدات الخرافيّة الّا أنّني ما زلت أنظر لفكرة العيش في بيروت كفالٍ فأتجنّب ذلك على قاعدة “لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة”.
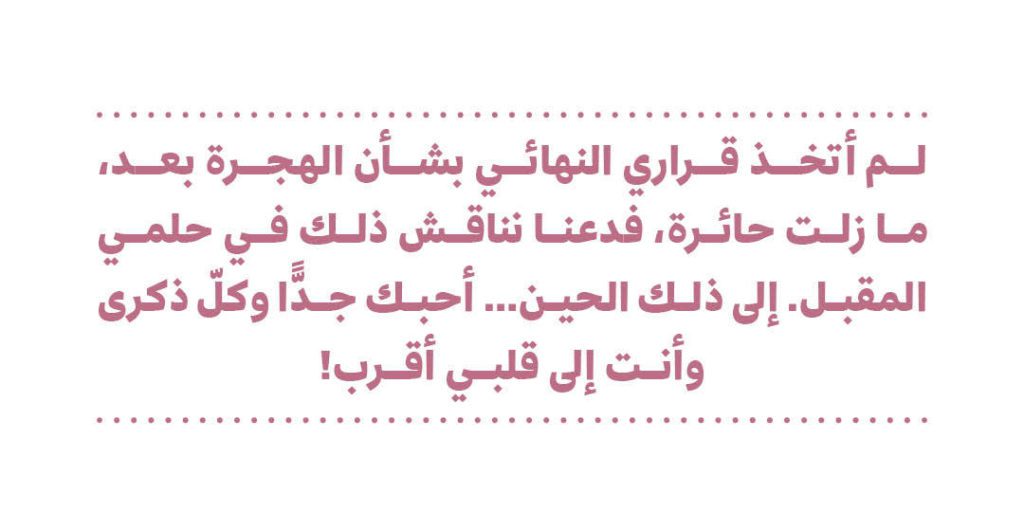
أمّا من جانب آخر، أدرس اليوم جديًّا خيار الهجرة من لبنان، ولكنّني كلّما أبدأ بالتخطيط، أتذكّر والدي وأتردّد. فهو كان “وطنيّ”، يحب لبنان، رفض الهجرة رغم أن جميع إخوته هاجروا إلى كندا وحازوا على الجنسية منذ أكثر من ثلاثين عامًا. هو أبى ذلك، وفضّل أن يستثمر هنا لمستقبل أفضل له ولأولاده.
ولكن ها نحن اليوم نقاوم ونعافر، إلا أن المهمة باتت شبه مستحيلة يا أبي… قد نخذل طريقك وقرارك آنذاك، فآمالك بالغد الأفضل قد خابت… ما يعزّيني اليوم أنّ والدي رحل قبل أن يرى ما آلت إليه أحوال البلاد. كان شخص مفعم بالأمل، مقتنع أن غدًا أجمل. لم أسمع منه يوماً خطاب كراهية أو كلمة طائفية أو حاقدة، فكنت دائمًا أستغرب وأسأله “كيف لرجل بعمرك أن يكون ما زال بكل هذه الطيبة؟!”، كيف لشخص عايش حروب ومآسٍ عدّة في هذا الوطن، أن يكون مسالمًا إلى هذا الحدّ، ولكنّني اليوم أيقنت أنّه ربّما هذه كانت معركته وقضيّته في الحياة: المحبّة، التسامح، العيش المشترك والعلم، الذي لطالما حثّنا عليه، ربّما كانت هذه مساهمته لمجتمعه وبلده.
ولكن لا يسعني اليوم إلّا إعادة النظر والتشكيك بالكثير من القيم الوطنية والإنسانيّة التي غرسها والدي فينا، والأمل بأيام أفضل، فكلّما تأمّلنا قليلًا، يأتي الواقع المرير ليصفعنا من جديد ويعيد تذكيرنا أنّنا في لبنان، “قطعة السما” التي نبذها الفضاء. تفيض الكلمات والمشاعر وأفقد السيطرة عليها، ربما لأنني قمعتها لستة أعوام، أو ربّما لأنّها هي من قمعتني وقرّرت اليوم أن تخرج للعلن.
منذ تلك الفاجعة وعلاقتي مع الموت متقلبة وغريبة، تارةً أعتبره الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتنا وسنّة الحياة وأقنع نفسي بأقوال سقراط: “الموت قد يكون أعظم النعم البشرية”، وسيغموند فرويد: “الهدف من كل الحياة هو الموت”. وطوراً أهلع لفكرة أي تجربة مماثلة وأجد نفسي أقرب لإيليا أبو ماضي في قوله “كلّ ما في الأرض من فلسفةٍ .. لا يُعزّي فاقِدا عمّن فقد”، فعلًا، ما من قول أو منطق أو نظريّة علميّة يمكنها أن تعزّي الفاقد بما فقد. فما همّني تفسير الفلاسفة والعلماء ونظريّاتهم المعقّدة وأنا قلبي ينفطر إلى أجزاء لا تعدّ ولا تحصى؟ أخفّف سقراط أو فرويد من آلامي ومن الوحشة التي عشتها؟ أساعدني العلم على التخلّص من كابوس الفراغ الذي شعرت به على مدى سنوات وكأنّ داخلي بيت مكسور مهجور معتم؟! وعندها فقط اكتشفت، أنا عاشقة العلم والأكاديميا، أنّ العلم عصيّ عن مداواة الوجع الحقيقي، وأنّ الدواء هو مزيج من الفن والأدب والكتابة والعائلة والصداقة والحب والبكاء والصبر والصبر والصبر!
لا زال الدفن أسوأ ما في ذاكرتي، كان مؤذٍ ومحطّم بكل ما للكلمة من معنى، غابت الكثير من تفاصيله عن ذاكرتي، فالعقل يطمس هذه الذكريات المدمّرة ليحافظ على صحته، ولكن ما زلت أتذكر جيّدًا جملة رجلٍ في الخمسين من عمره، لا أعرفه ولم أعرف حتى اسمه، ولكنه قال لي وكأنه يواسي طفلة صغيرة “لا تقلقي سيزورك دائمًا في المنام، والدي توفى منذ زمن ولا زلت أراه” وبالفعل، بين الحين والآخر يزورني والدي في المنام، أراه في صور مختلفة.
أراه في الكثير من الأحيان في السيارة ينتظرني لنذهب سوياً في مشوار بعيد دون وجهة محدّدة، كنت أفسر هذا دائماً في رغبتي باللحاق به. ولكنني مؤخرًا بدأت أعيد النظر في تفسيري، أليس من الممكن أن تكون هذه الأحلام طريقة يحثّني بها على الخروج من هذه الحلقة المفرغة ومن هذا البلد؟! أيحاول أن يوصل لي رسالة أنّه ما عاد متمسّكًا بلبنان كالسابق وأنّ مستقبلي وأماني وطموحي هم الأولويّة في هذه المرحلة؟
ما زلت أحاول يا أبي، ولكن لا أعدك أن أتمكن من التمسّك أكثر بهذا البلد، فالعيش هنا بات مستحيلًا وربّما حان وقت الإفلات: الإفلات من تعلّقي بمنزلي في الجبل، ومن تعلّقي في وطن على شفير الهاوية، ومن تعلّقي بذكريات أليمة ومن تعلّقي بوجع لم أترك له مجالًا أن يشفى… حان الوقت لأفلت الكثير من الأشياء ولكنّي لن أفلتك أنت من حياتي ولن أسقط اسمك من اسمي… فلكلّ انسان منّا آليّة للتأقلم ولمواجهة الوجع، ووجود اسمك بجانب اسمي هو إحدى آليّاتي!
على كلّ حال، وبالعودة إلى حديثنا السابق، لم أتخذ قراري النهائي بشأن الهجرة بعد، ما زلت حائرة، فدعنا نناقش ذلك في حلمي المقبل. إلى ذلك الحين… أحبك جدًّا وكلّ ذكرى وأنت إلى قلبي أقرب!
إقرأوا أيضاً:








