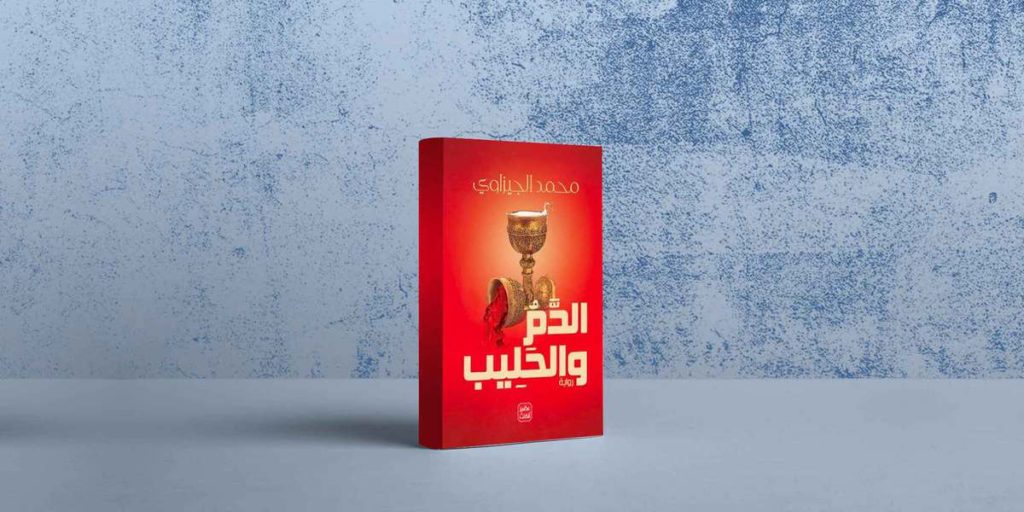على طاولة صغيرة في مقهى الحرية في وسط البلد يجلس الكاتب المصري محمود الورداني بصحبة أصدقائه، الابتسامة لا تفارقه، أحاديثه لا تنضب ولا تمل منها، وهو، بهدوئه أقرب لصياد مستعد دائماً لاقتناص الحكايات من الشارع القريب ومن ذاكرته البعيدة. في جلساتنا معاً على المقهى يقول لي “ذاكرتي تخونني أحياناً” وفي مقدمة كتابه “الإمساك بالقمر”، يطلب من القراء أن يلتمسوا له العذر إذا ضللته ذاكرته في بعض الأحداث، وكأن حياته زورق يبحر فوق نهرٍ جارٍ اسمه الذاكرة، وإذا جف النهر اختل كل شيء.
يكتب الورداني في أحدث أعماله “الإمساك بالقمر” فصولاً من سيرته الذاتية التي يتقاطع فيها الخاص بالعام، وما حدث في الغرف المغلقة وفوق أسطح البيوت وحجرات المعتقل وشوارع القاهرة التي كانت يوماً أرضاً للتظاهرات والاعتصامات.
يمر الزمن وتتغير ملامح مدينتنا، لم تعد شوارع القاهرة كما السابق مؤهلة للاحتجاجات الغاضبة، ولم تعد الأنظمة السياسية على الوجه القديم نفسه، لكن الإنسان في كل الأحوال واحد لا يتبدل؛ أسأل نفسي هل أصبح توثيق التاريخ حكراً لا يكتبه إلا من يملك السلطة فحسب؟ أنظر إلى كتاب “الإمساك بالقمر”، وأقول “لا، ثمة تاريخ موازٍ يسجل ما حدث بالفعل، فالبشر أفواه للزمن، وذاكرة متجولة لا تخون”.
يبدو أن السلطات السياسية مهما اختلفت إلا أن أقنعتها واحدة، البطش والإقصاء والعداء المستميت.
إعادة كتابة الماضي
تتنوع فصول الكتاب بين محطات متفرقة من حياة الورداني، الأديب اليساري، السائر مع رفاقه عكس التيار، ابن جيل السبعينات، صديق الكتاب والشعراء، المنطوي داخل دفاتر الهزائم الكبرى منها والصغرى، والمنتمي إلى واقع التاريخ المصري الحقيقي لا المزيف. يشتبك الكتاب مع الواقع المصري في عهد السادات على الصعيدين السياسي والثقافي، فالورداني باعتباره كاتباً ومثقفاً لم ينفصل عن عالمه، لم ينعزل في غرفته لينظّر بعلياء على أحوال البلاد وأوضاعها، بل كان طرفاً من الواقع، مشتبكاً ومحركاً للأحداث أيضاً، بالكتابة، وبالهتافات العالية في الساحات والميادين.
في الفصل الخامس من الكتاب المعنون بـ”حكاية الضباب” يحكي الورداني عن اعتصام طلاب الجامعة عام 1972 الذي كان مشاركاً فيه وانتهى باعتقاله مع زملائه من الطلبة. كانت التظاهرات والاعتصام على خلفية خطاب أنور السادات الشهير المعروف بالضباب، في فترة كان الشعب المصري راغباً في النصر، غارقاً في شعوره بالهزيمة بعد النكسة التي حولت أحلامه إلى يأس يومي متكرر، بينما السادات، رئيس الدولة، لا يلتفت لأصوات الشعب ولا يأخذ قراراً حاسماً بشأن الحرب على إسرائيل. يصف الورداني مشاعره ومشاعر رفاقه المعتصمين بأنهم، وبرغم الشعور الجارف بالهزيمة، كانوا قادرين على الإمساك بالقمر ولا أقل، هذا الوصف الشاعري لا ينبع إلا من أديب استطاع أن يطوّع لغته ليختزل مشاعر النشوة والقدرة على التغيير باعتبارها ممكنة، كأن تمسك القمر وإن بدا أقصى الأحلام. ولأن مشهد انتفاضة الطلبة يجلب معه المزيد من المشاعر المتأججة بالحماسة والحنين مثل وصف الشاعر أمل دنقل المعتصمين في قصيدته “الكعكة الحجرية”:
“شمعدان غَضَب
يَتَوَهَّجُ في الليل
والصوتُ يكتسح العتمة الباقية
يتغنى لليلة ميلاد مصر الجديدة!”.
إقرأوا أيضاً:
كل الألوان “بمبي”
بينما كنت أتنقل بين صفحات الكتاب شعرت وكأنني استأجرت حجرة داخل عقل الورداني أتجول فيها بأريحية ووفق ما تجود به ذاكرته. في منتصف القراءة قررت أن أستعين بـ”غوغل” ليعينني على العثور على بعض الصور أو الفيديوات لمشاهد تظاهرات الطلبة واعتصاماتهم، التي يحكي عنها الورداني بحماسة، لكنني بعد بحث عميق لم أجد شيئاً عدا صور باهتة بالأبيض والأسود لا توضح شيئاً عن اشتباكات الجيش مع الطلبة، بتواريخ متضاربة. تذكرت مشهداً من مسلسل “بنت اسمها ذات” -المأخوذ عن رواية “ذات” لصنع الله إبراهيم- عندما جلست البطلة ذات -التي تعمل مونتيرة في ماسبيرو- تشاهد ما صورته الكاميرات من تظاهرات الشعب في “انتفاضة الخبز” احتجاجاً على غلاء الأسعار عام 1977 وكانت البطلة تستعمل مقصها الرقابي لتحذف مشاهد العنف الذي مارسه أفراد الجيش تجاه المتظاهرين قبل عرضها على شاشة التليفزيون.
لم يكن التلفزيون المصري يبث الحقيقة كاملة بل نصفها الذي يروق له، في كتاب الورداني قرأت الصفحات التي وصف فيها التظاهرات والاعتصام وترحيل الطلبة إلى المعتقل، وحاولت أن أتخيل بصرياً ما حدث، فامتزجت في عقلي مشاهد من تظاهرات متفرقة تعود لثورة يناير التي عشتها وشاركت فيها، وكأن ذاكرتي امتزجت بذاكرة الورداني لتصنع مشهداً يبدو عبثياً لاختلاف الزمان والسياق، لكنه بدا لي منطقياً وحقيقياً أكثر من أكاذيب السنوات الوردية التي تربينا على ألوانها الخادعة في الأفلام، حيث السبعينات والحياة “بمبي” بشكل مبالغ فيه.
لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أقارن فيها بين جيل الورداني وجيلنا الحالي، إذ شعرت مراراً بالغيرة من هذا الجيل الذي كان يقاوم بكل ما أوتي من قوة ليصنع من خسائره اليومية انتصارات صغيرة.
يتحدث الورداني عن جماعة “غاليري 68″، وهي جماعة أدبية قررت أن تخلق حراكاً أدبياً بالجهود الذاتية لتعبر عن نفسها بالكتابة، والحقيقة أن الهزيمة السياسية عام 1967، أفرزت جيلاً بل موجة من الكتابة والكتاب الجدد، ظاهرة كانت جزءاً من الحديث اليومي للمثقفين في مقاهي وسط البلد. جمع الشباب التبرعات من المثقفين والكتاب منهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس وأنشأوا مجلة “غاليري 68″، وفي تصدير العدد الأول كتب رئيس التحرير أحمد مرسي “على الرغم من أن مجلة 68 ليست مجلة سياسية فهي تؤمن بأنها لو نجحت في الكشف عن حقيقة ما يختلج في جوانح الكتاب والشعراء والفنانين من أبناء جيل اليوم، تكون قد أوفت بالعهد الذي قطعته على نفسها بالمشاركة في معركة التحرير والبناء”.
استوقفتني الجملة كثيراً، قرأتها مراراً وأنا أغبط هذه النبرة التي في مضمونها تمنح الكاتب قيمة ثمينة، وتضعه في سياق يتماس مع المشهد الاجتماعي والسياسي، فالكُتاب بحاجة لخلق مساحة آمنة للكتابة والبوح، مساحة لا تجعلهم -كما يتصور الكثيرون عن المثقفين- بمعزل عن مجتمعهم الذي يحاول أن يخفض صوتهم أحياناً ويقصيهم في أحيان أخرى.
يقول الورداني متحدثاً عن جيل الستينات والموجات التالية له “أولئك الكتاب والفنانون ألقي على عاتقهم عبء إضافي، أتجرأ على وصفه بالعبء الأيديولوجي واليساري بالتحديد… وإذا تناولت جيل الستينات مثل إبراهيم أصلان أو البساطي أو بهاء طاهر أو أمل دنقل، لم ينتموا للحلقات والمنظمات اليسارية السرية… إلا أنهم كانوا متورطين في الهم السياسي والاجتماعي شأنهم شأن كتاب آخرين انتموا لتلك المنظمات”. المشترك بين كتاب هذه الأجيال أنهم، ورغم اختلافاتهم الأيديولوجية، إلا أن كتاباتهم خلقت نَظْماً شبه متكامل للمشهد الإبداعي لهذه المرحلة، بل إضافة للمتن الكتابي العربي.
يبدو المشهد الثقافي الحالي مختلفاً، فقنوات الكتابة ووسائل النشر كثيرة، بل أسهل من السابق، بخطوات بسيطة يمكنك أن تدوّن أو تنشر محتوى خاصاً بك على مواقع التواصل، أو حتى تنشره في دار نشر بمقابل مادي، لكن هل هناك جدوى في ظل مساحات محفوفة بالمتاريس والبنادق؟ إذا كتبت بحرية فأنت مهدد لا محال، ستصادر أعمالك، ستهدد بالسجن، وبالرفض، وستلاحقك أبواق السلطة وعيون المجتمع، فإذا عبرت عن أفكارك يجب أن تتمهل في لغتك ومجازاتك، إذا قررت أن تكتب بحرية فاعرف أنك ستدفع الثمن، حتى لو كان ما تكتبه قصيدة أو قصة قصيرة جداً.
بات الأمر أشبه بكتابات تتحايل على عيون الرقابة أو تجاري الذوق العام. ربما فقد جيلنا الحالي هذه الروح التشاركية، مذ تفرقنا بالغاز المسيّل للدموع لم نتجمع مرة أخرى، فالهم واحد والمأساة فردية، والقصص، والحكايات، والكتابات، حتى الأحلام الكبرى باتت فردية.
بالعودة إلى أرشيف مجلة “جاليري 68” تجد أسماء الكتاب المشاركين في أعدادها الأولى: إبراهيم أصلان، أمل دنقل، نعيم عطية، صافيناز كاظم، يحيى الطاهر عبدالله، فؤاد التكرلي، عبدالوهاب البياتي، محمد البساطي، مجيد طوبيا.. وغيرهم. أنظر إلى المشهد الثقافي الحالي فأجد فراغاً وصمتاً طويلاً برغم الأصوات الأدبية المتداخلة. وهنا لا أقول إن الاجيال السابقة لم تعاقب على كتابتها أو لم تدفع ثمنها، ولكنها برغم كل شيء كان يحركها الهم الاجتماعي، وبرغم المخاطر كانت تحاول وتكتب.
لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أقارن فيها بين جيل الورداني وجيلنا الحالي، إذ شعرت مراراً بالغيرة من هذا الجيل الذي كان يقاوم بكل ما أوتي من قوة ليصنع من خسائره اليومية انتصارات صغيرة.
عداء المثقفين
يبدو أن السلطات السياسية مهما اختلفت إلا أن أقنعتها واحدة، البطش والإقصاء والعداء المستميت، لكن عداء الرئيس الراحل أنور السادات للمثقفين كان جلياً، يمكن تلمسه وتتبعه في كل التضييق على أصواتهم في عهده، وهو ما توثقه الكتابات الذاتية سواء في “الإمساك بالقمر” وغيره من كتب.
يتحدث الورداني في كتابه عن الدور الذي لعبه يوسف السباعي وزير الثقافة في عهد السادات باعتباره متواطئاً ضد المثقفين، بالتضييق عليهم وبتسليم أسماء عدد منهم لأجهزة الأمن بتهمة الانتماء إلى تنظيم شيوعي جديد، وهو الاتهام الذي وجه لـ”جمعية كتاب الغد”، وانتهى الأمر بحملة اعتقالات شرسة أودعت أكثر من 30 كاتباً وفناناً يسارياً في السجن. واللافت في كتابة الورداني الإشارة لعداء السلطة في عهد السادات لأي تيار يساري، وفي المقابل فتحت نافذة جديدة للإخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية التي زرعت بذورها مرة أخرى في عهد الرئيس المؤمن. يمكننا الآن التفكير في نتاج هذه البذور التي ندفع أثمانها بشكل أو بآخر بأثر رجعي، برغم أن السلطات حينها كانت تعلم أن لا وجود لتنظيم يساري جديد، الأمر كله كان تنكيلاً متعمداً بالمثقفين.
تموج صفحات الكتاب بين السياسة والأدب، بين ذكريات المجال العام والثرثرة مع الأصدقاء، إلى محاولات لتسليط الضوء على كتاباتهم الإبداعية وآراء الورداني في مشروعاتهم الأدبية. بين هذا وذاك لم تغب الأماكن عن ذاكرة الورداني، بل يمنحها صوتاً ومساحة، باعتبارها بطلاً لا ينسى في ذاكرته، يتحدث عن المقاهي والبيوت والشوارع وحتى جدران السجون. في حوار صحافي معه يقول الورداني عن الإمساك بالقمر، “هي أيضاً قصة مقاهينا وأماكن تجمعنا وبيوتنا وبحثنا وكتاباتنا الأولى. كيف انتزعنا استقلالنا عن الأجهزة الرسمية التي سلمنا بفشلها، وكيف أصدرنا في هذا السياق كتاباتنا الأولى، كما خضنا العديد من تجارب النشر والعمل الثقافي”.
يتحدث أيضاً عن بيته الذي كان يستقبل الأصحاب بأبواب مفتوحة على الدوام، وبيوت الأصدقاء التي كانت ملتقى للجميع يقول “بيني وبين أسطح البيوت علاقة خاصة”، ويستخدم مفردة “الراحة” ليصف بها الجلسات في بيوت الأصدقاء حيث التسكّع وأحاديث السياسة والأدب والفن، بل ويتسلل إلى القارئ الراحة ذاتها عندما يصف بيت صديقه الكاتب الراحل عبده جبير قائلاً “كان من النادر أن تتوجه إلى عبده ولا تجده، سوف تجد أصدقاءك وتمضي الوقت الذي تشاء… وعند عبده هناك مكان لمبيتك وجلباب لنومك إذا تعذر عودتك”.
ربما تمر الذكريات سريعة، خاطفة، تتوه الكلمات وتنسى، لكن تعيدنا السير الذاتية إلى أصل الحكاية، والجزء المكمل لفراغات روايات التاريخ الأحادية. هذا الكتاب وإن كان خلاصة لحظات خاصة بين الكاتب وذكرياته، إلا أنها وثيقة تاريخية لجيل كامل اختبر الحياة والحلم، ولمس الأمل. يمر العمر ويختزل في كلمات ومجازات، وتبقى دهشة الذاكرة، ببهائها الأول، تبحث عن صياد ماهر يسرد حكايتها على مهل.
إقرأوا أيضاً: