تشهد منطقة الجزيرة السورية وأقصى الفرات حالة من السيولة والتحول منذ أكثر من قرن ونصف القرن، وربما جاء تأسيس مخيم الهول الذي يضم عائلات تنظيم “داعش”، ليكون جزءاً مما اعتادت عليه من تحولات. إذ تشير معلومات تاريخية إلى أن الصراعات بين القبائل العربية المنتشرة هناك كانت كبيرة، بخاصة ما حدث في عهد إبراهيم باشا والعشائر التي رافقته من حمص إلى الفرات بعد مجيئه من مصر، والصراعات بين قبائل “العقيدات” و”الجبور” في القرن التاسع عشر، وكذلك بين “العقيدات” و”شمر” التي شهدت معارك عدة كان آخرها عام 1982، برغم أن الجذر القبلي واحد، وهو الجذر “الزبيدي” وصولاً إلى القحطانيين.
أما على صعيد العلاقة بين الكرد والعرب؛ فإن معلومات تاريخية تشير إلى أنّ قسماً كبيراً من الكرد السوريين نزحوا من تركيا بسبب أحداث تاريخية وثقها مختصون في مطلع القرن العشرين.

قبل أكثر من مئة عام كانت تلك الجغرافيا المجاورة للهول، موئلاً لجزء من الشعب الأرمني، الذي هجَّرته الدولة العثمانية إلى تلك الصحارى في ما يشبه إرساله إلى الموت البطيء لأسباب عرقية ودينية، وقد حاول الأرمن الهاربون النجاة من الموت عامي 1915 و1916، إلى أن لحقهم الجنود الأتراك، بخاصة المتطوعون في فصيل “الخيالة الحميدية” في موقعة “مركدة ” الشهيرة، وقضوا على آخر قوافلهم، وكان الوالي العثماني سعاد بك قد تعهد بحمايتهم، لكن رغبة الإمبراطورية العميقة بالتخلص منهم وإبعادهم من الدولة، وإن كان عبر النفي، كانت أقوى من الجانب الإنساني، فهرب من هرب، أما من “رقد من الأرمن” وقتل، فقد سمي المكان باسمه (مركدة).
أقام الأرمن لاحقاً هناك كنيسة، ويأتون كل عام لزيارة الأضرحة تخليداً لذكرى تلك المذبحة التي ذهب ضحيتها المئات. كما أنشأوا مستشفى في مركدة، تقديراً لأهالي عشائر تلك المنطقة، الذين هرَّبوا عدداً من الأطفال الأرمن، مدعين أنهم أولادهم، كي لا يُقتلوا، وقد وصل عدد من الأطفال والنساء إلى دير الزور وعشائر العكيدات، وصاروا جزءاً منها، وقد كان لي جيران وزملاء في المدارس التي درست فيها، ورفاق من الجيل الثاني والثالث من الناجين من مذابح الأرمن، وقد ذاب معظم أولئك في المجتمع العشائري كونهم أتوا إلى المكان أطفالاً.
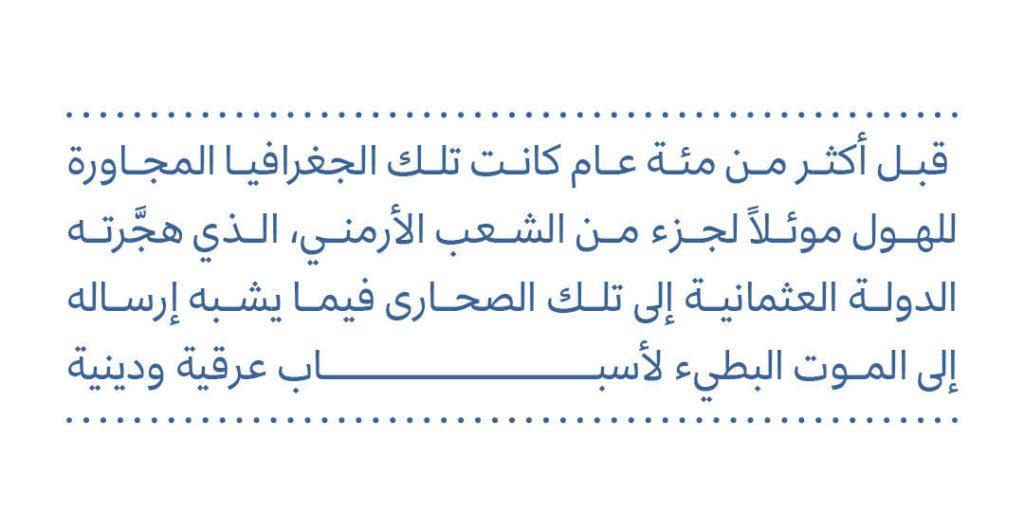
في حالة مخيم الهول اليوم يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، إذ تغدو تلك البقعة الجغرافية معسكراً لمن بقي من “داعش”، المفارقة اللافتة أن الأرمن كانوا ضحايا هاربين من الموت الذي يلاحقهم، أما من بقي من “داعش” فهم في منطقة رمادية ما بين أقارب القاتل، والضحية، لأن الرجال المحاربين من التنظيم يقطنون في السجون التي تديرها “قسد”، وما سكان مخيم الهول الذين يحسبون على “داعش”، إلا ضحايا من الأطفال والنساء.
كانت جغرافيا الجزيرة السورية منفى بالنسبة إلى أبناء المدن الكبرى، وكانت أقسى العقوبات بحق موظف سوري منذ 70 عاماً هي نقله من دمشق إليها، بعدما تحولت الجزيرة من قضاء إلى محافظة عام 1952. وقد كرست الحكومات المتتالية صورة أن تلك الجغرافيا منفى، على رغم أنها لاحقاً صارت منبعاً للنفط السوري ومصدراً للقمح، لكن ذلك لم يشفع لها، فقد بقي تهميش الدولة لها مرتكزاً على محاربة الشخصية الكردية، وتسليم إدارتها للأمن، وتأخير التنمية فيها، ومنع تأسيس الجامعات حتى القرن الحادي والعشرين، ووضعها في حسابات الولاء للعراق، وصدام حسين شخصياً، من أجل إبقاء النعرات بين القبائل العربية والكرد.
من جهة أخرى، أدت حالة الجفاف التي ضربت منطقة الخابور بين الحسكة ودير الزور، (بطول نحو 200 كيلومتر)، في تسعينات القرن الماضي إلى نزوح الآلاف إلى دمشق وحلب والساحل، لكنهم لم يفكروا بالنزوح إلى القامشلي مثلاً، فالمدن الكبرى هي التي يمكن أن توجِد فرص عمل، لا المدن الصغرى، إضافة إلى أن تلك المناطق كانت زراعية، وأفقد دخول المكننة غير المخطط له كثيرين فرص عملهم، دون أن تضع الدولة أي خطط بديلة، من دون أن تفوتنا الإشارة إلى أنَّ منطقة القامشلي، تحديداً “خط العشرة” المحاذي للحدود التركية- السورية، قد اكتفت من نزوح “العرب” إليها نتيجة الغمر الذي أحدثه إنشاء سد الفرات، وتكوين بحيرة خلفه غمرت آلاف الدونمات ودفنت عشرات القرى، ما جعل الدولة تبحث عن حل تبين أنه أحدث مشكلة جديدة، وأوقع ضحايا جدداً من الضيوف والمستضيفين.
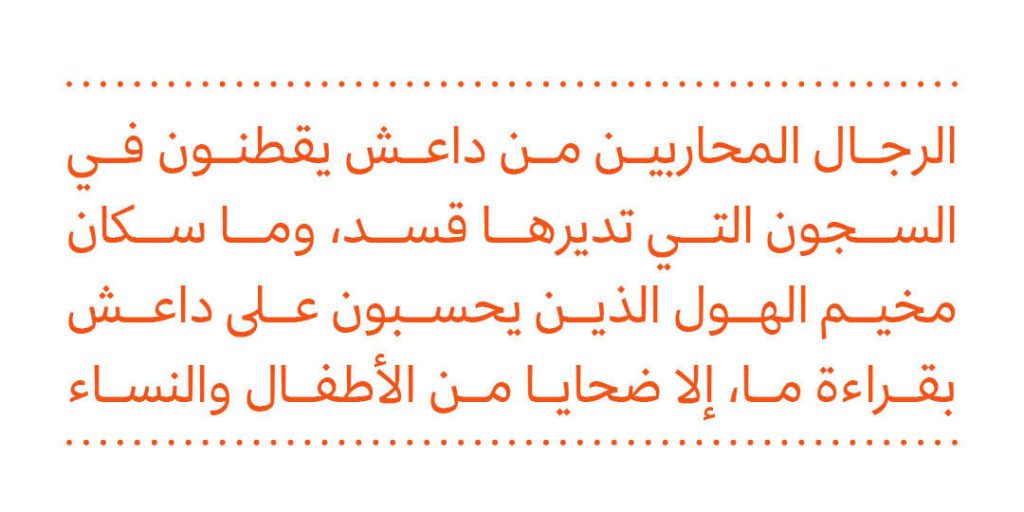
لا يمكن فهم تلك الصراعات في تلك الجغرافيا حالياً وماضياً، دون سياقها التاريخي، ومفهوم الدولة والإمبراطورية والحدود والخلافة والسلطة العثمانية، والبعد الاقتصادي ودوره في تنقل القبائل والأقوام، وليست فكرة الأقدمية أو التنقل والجذور معياراً لتحصيل الحقوق، أو سلبها من السكان. ويمكن أن نقارن هذه الفكرة مع ما يحصل عليه اللاجئ السوري في هولندا مثلاً، منذ لحظة وصوله، إذ يتمّ تخصيصه برقم وطني، كأنه من بناة هذا البلد، ويحمل جنسيته أباً عن جد على صعيد الحقوق الواجبات.
وفي الوقت نفسه لم يعد من المجدي أن يقول الكرد لأبناء القبائل العربية التي تعيش منذ مئات السنين في الجزيرة السورية: إنكم جئتم من الجزيرة العربية وهذه الأرض أرضنا التاريخية. أما تسمية قرى الغمر بالمستوطنات العربية فهي إساءة للضحايا الذين غمرت أراضيهم مياه بحيرة سد الفرات التي استفاد من كهربائها وأثرها في تنمية سوريا، كل السوريين.
مالكو أرض المخيم والأميرة خاتون
ينظر أبناء “قبيلة الخواتنة” ملاك أرض مخيم الهول، نظرة انثروبولوجية إلى ما يحدث في أرضهم، فقد سبق أن قبلتْ هذه البقعة الجغرافية التنوع الإثني. بل إن هذه الأرض قبلت تغيراً أهم، فقد نُسِبَتْ قبيلة الخواتنة إلى الأميرة خاتون كما تقول عدد من الروايات، وأتمت إدارة شؤون العشيرة، بعد وفاة زوجها، في مجتمع ذكوري لا يقبل عادة بأن تقود المرأة العشيرة، وقد اشتهرت تلك الأميرة بالكرم وحسن استقبال الضيف والفراسة والدهاء.
تتقاطع قبيلة الخواتنة مع القبائل الأخرى في تلك الجغرافيا في نقاط عدة، لكنها ميزت نفسها في لهجة عربية خاصة لا تخفى جمالياتها، وقد توزعت أفخاذ تلك العشيرة ما بين العراق وسوريا في “تلعفر وبعاج والموصل وعامودا والخاتونية والهول”، قبل وجود الحدود وتشكل الدول بالمفهوم الحديث.
وقبول الآخر ومناصرة الضعيف عند “الخواتنة”، ليسا بجديد إذ سبق أن احتمى بتلك الجغرافيا “الايزيديون” إبان مرحلة ما من الحكم العثماني، في القرن الثامن عشر، نتيجة حملة والي بغداد حسن باشا عليهم.
وكانت أشجار بحيرة الخاتونية موئلاً لعدد متنوع من الطيور، وكانت مياهها مسكناً لأنواع مختلفة من الأسماك. أما في عهد حافظ الأسد وابنه، فقد حوَّل الجفاف والصرف الصحي والإهمال دلالات البحيرات والأنهار إلى غير ما كانت عليه.
يبدو الخاتوني اليوم مقيَّد اليدين في جغرافيته، هو الذي “تغلب يوماً على الشيطان”، وفقاً لمثل شائع في محافظة الحسكة في إشارة سردية إلى دهائه، ونباهته، وقدرته على التخلص من المخاطر، غير أن هذا الانتصار على الشيطان كان ممكناً، يوم كانت أدوات الصراع والأسلحة بين الطرفين متكافئة، أما اليوم فلا يملك القدرة على الصراع مع المجتمع الدولي.

عددٌ من المهتمين بالتحليل السياسي من “الخواتنة” يعدّون إحياء وجود المخيم ضمن قراهم جزءاً من معاقبة قوات “قسد” والقبائل الأخرى لهم، بتهمة وقوفهم مع “داعش” حين كان في زهوه عامي 2015 و2016 قبل أن يُهزم هناك، وكما في كل الأماكن التي دخلها التنظيم أو فلوله والمتحمسون له، تثق أطراف الصراع بأنه سيتمّ ترحيل عناصره باتفاقات محلية بإشراف مخابراتي دولي ذات يوم، كما حدث أكثر من مرة، وقد يحرسها إبان الرحيل الخصوم أنفسهم، كما حدث مع “حزب الله” في صفقة الترحيل الشهيرة، من جرود لبنان إلى قلب الصحراء السورية بالقرب من الحدود العراقية في آب/ أغسطس 2017.
فيما يدفع الأهالي المدنيون بعد رحيل بقايا “داعش” الثمن، حيث يُوصَمون بـ”الدواعش والدعشنة”، هم الذين كانوا عاجزين عن مواجهة عنف التنظيم ووحشيته، لتغدو هذه التهمة، مع تهمة التطهير، مدخلاً لنهب بيوتهم وممتلكاتهم واضطهادهم والاعتداء عليهم وهضم حقوقهم، كما حدث في مناطق سورية عدة، بخاصة في حوض الفرات الشرقي.
من الواضح أنه ما دام ملف مخيم الهول قابلاً للاستثمار، باعتبار أن من يعيشون فيه يشكلون “بعبعاً” للآخرين، يمكن إطلاقه في لحظة ما من قمقمه؛ فإنه باق على حاله، وما من حلّ قريب لتفاصيله، إذ سيبقى الحارس حارساً، والمشرف مشرفاً، والضحية ضحية، إلى أن ينضج ظرف دولي آخر يسمح بزحزحة الثبات إلى حراك، وتثبيت الرمال بأشجار العدالة والمساواة.
إقرأوا أيضاً:







