دائماً ما كانت تساورني الشكوك حول فصلَي الربيع والخريف، أيكونان مجرد فضلات مناخية مغلفة بإسقاطات زمنية متممة للطبيعة؟ أم هما استعراض للآلهة في قدرتها على فعل وخلق ما تشاء؟ لا أعلم إن كان للحيوانات رأي آخر على الصعيد المناخي، يكفي أنها تسير في جماعاتٍ. تنتقل بين سهولٍ وبرارٍ. تنفذ مشيئة الفصول وتحتكم لتغيراتها دون امتعاضٍ. وهذا ما أحسد اللافقاريات عليه، لا شيء يعلوها سوى العقل، على عكس الإنسان الغارق في زيفه ونكرانه. يختلق ويبتكر فصوله. يشهر نصوله كلما سنحت له قضيةً خاسرة.
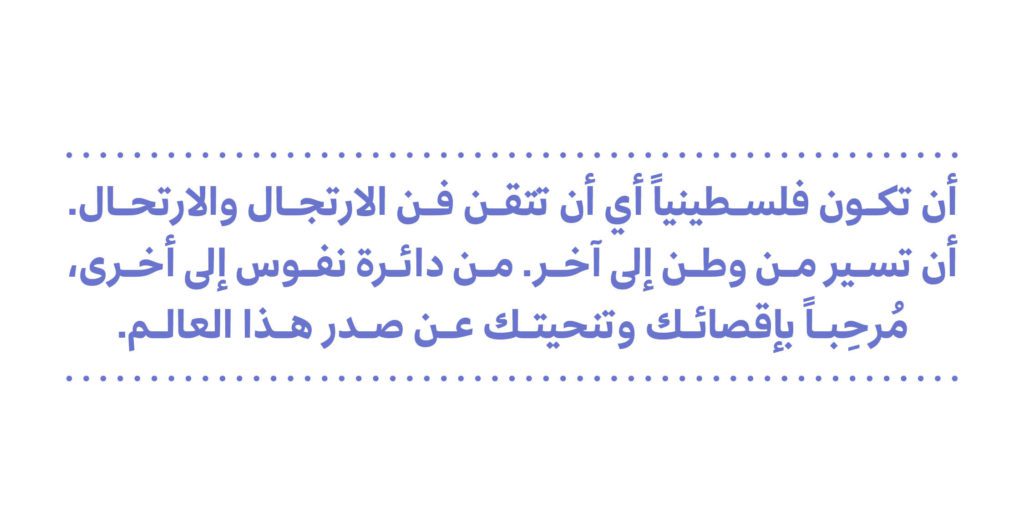
ليس الأمر تعدياً على حكمة الآلهة أو معتقدات الغير، كل ما هنالك أنني أشعر بلبسٍ في الأمر، والالتباس، نقطة أقف عندها كلاجئ فقد هويته قبل أن يلتقطها، بعدما تاهت بي فلسطينيتي بين أقاصيص أجدادي وقيودي على دفاتر “الأونروا”. برنامج “خبرني يا طير” السوري، كان أملي الوحيد قبل أن إيقاف تصويره، الذي عنى وقتها إسقاط سذاجتي في مقتبل الوعي. لا بد أن أدواته أربكت أولئك الذين وقعوا في شرك انسانيتهم. فمضى البرنامج إلى الذاكرة العابرة، وجهاد سعد إلى الكثافة الدرامية، والفلسطينيون إلى شتاتهم المعهود من أمل إلى آخر، يسيرون في ممر دودي، لا يفضي سوى إلى برامج الأخبار. كنت قد تأسفت أيضاً في ما مضى على التغريبة الفلسطينية مسلسلاً وقضية، لكن مع تقدم يأسي وبجاحة تشردي اللذين جذباني نحو بلاد المهجر، أصبحت الحلول الإلكترونية والدرامية أشياء لا تستهوي غضبي أو تلائم حريتي. علماً أنني لم أكن من المتهكمين مما حدث وما قد يحدث، إذ أثر في نفسي لو مجرد عابر اتصال كنت أتخيله في صباي، لكن جاءني ما ورد على لسانه: “لم يعد أحد من الموتى ليخبرنا الحقيقة”.
لم يقصد المخرج الإيراني بهمان قوبادي في فيلمه “السلاحف تستطيع الطيران” أن يصور حال جميع المخيمات والمشردين عن أوطانهم. بل أشار إلى الأثر الذي خلفته وراءها صراعات الأمم ومصالح “الفيلة” من خلال بقعة صغيرة يمكن معها فهم المعاناة الفلسطينية بشكلها ومضمونها من الناحية الوجدانية والإنسانية، والتي لا تزال رهينة صمت دام أكثر من سبعة عقود. لتكون المحصلة في النهاية كلمة بالخط العريض “أجنبي” أمام شبابيك التذاكر، و”كنيتك” لاجئ، أمامك كتيّب إرشادات بلون الخيبة، تشير أهم نقطة فيه إلى “يمنع إدخال الزيتون”. طبعاً لو كان للفيلة أن تشرب الماء كلّه حتى تصير الأرض عجافاً، ثم تدمرها بأقدامها، لكانوا سألوك وأنت تقف عند حافة الهاوية، هل في إمكان السلاحف أن تطير؟ ومن وراء عدسة التصوير، سيسألكَ أحدهم، من أي وطن جئت؟ تجيب: “وطني هناك، عند …” يقاطع منادياً: “المتألم التالي”.
صرت موقناً أن لهاثنا أبطأ من نجاتنا، أسرع من احلامنا، أقل من أنفاس ” أم سعد” وهي تنفض عن وعينا غبار الجهل والخنوع. أن تكون فلسطينياً أي أن تتقن فن الارتجال والارتحال. أن تسير من وطن إلى آخر. من دائرة نفوس إلى أخرى، مُرحِباً بإقصائك وتنحيتك عن صدر هذا العالم. متهماً بجدليتك ووجوديتك، درجةً، تمنح معها المشاهد الناعس فضوله، ليسأل: ما حالكم؟، أما زال الربيع والخريف يشبهانكم؟ علماً أن لا شيء يشبهنا. نحن “موكلي”، ذاك الفتى الكرتوني الذئب- البشري، الذي تربى بين الذئاب فصار مثلهم، لكن دون غابة تجمعنا. يخيفنا “الضحك والنسيان”. يؤازرنا “الغريب” قبل “الأبله” وننتصر “للخبز الحافي”، قبل أن نمرَ على جنبات الدهشة لنشاهد رايات الأمم مزروعةً فوق تل أبيب تهلل “أمة عربية واحدة… ذات نجمة خالدة”. نتابع مسيرتنا. نحاول التحليق فوق ذاكرتنا، فنقع.
إقرأوا أيضاً:







