جرس المدرسة الذي يعلن انتهاء الدوام، ساعات الدوام التي ينتظر التلاميذ انتهاءها للعودة إلى منازلهم ليرتاحوا من الصفوف ويتفرغوا للعب. في حالتي حُرمت منها أربع سنوات.
كانت تنتهي ساعات الدراسة في مبنى “المدرسة” لأخرج إلى المبنى المقابل حيث “قسم الداخلي”. أربع سنوات في المدرسة الداخلية أو “المؤسسة”، لم تكن سوى مادة دسمة، لاحقاً، لمعالجتي النفسية لتحليل كيف كنت أتحدث مرات ومرات عن العنف الذي كنت أتعرض له في طفولتي بنبرة هادئة وكأنه أمر عادي لا يحتاج إلى مقاومة أو انفعال. تأخرت لأبكي على كل ما كان يحدث وجعلت منه امراً عادياً. قد لا أستطيع اختزال تلك السنوات في نص واحد. ولا يمكن اختزال المعاناة التي تمر بها الفتيات في المدارس الداخلية في قصة واحدة، أنا لم أكن الوحيدة وجميعنا كنا صامتات.
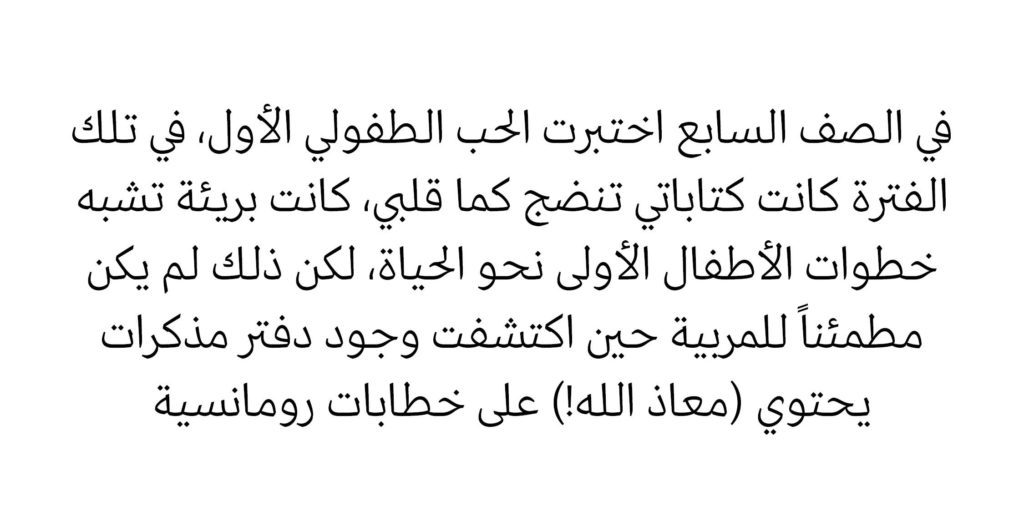
الفتيات البيض
بعد حرب تموز/ يوليو 2006، وبسبب تدهور الوضع المالي للعائلة، قرر والداي نقلي إلى مدرسة داخلية في مدينة صور جنوب لبنان، لأكون برفقة أختي الكبرى التي أمضت أكثر من عشر سنوات في المؤسسة نفسها.
المؤسسة كانت، في الشكل، بمثابة منتجع سياحي بالنسبة إلي: ملاعب ومراجيح، مقاعد ملونة وابنية فاخرة بعيدة جداً من بيوت الإيجار التي كنت أتنقل إليها مع عائلتي لعدم امتلاكنا منزلاً خاصاً. ولهذا “المنتجع” شروط وقوانين: والقانون الأول كان وجوب ارتداء الحجاب. لم يسألني أحد عن رأيي بذلك. كنت أرتدي الحجاب في المدرسة و”المؤسسة”، وأنزعه فور وصولي إلى منزل العائلة في العطل، وهذا بالطبع حدث بعد عامي الأول هناك، عندما تمردت على العائلة وأخبرتهم أن بامكاننا إخفاء حقيقة أنني “سافرة” كما تفعل بعض صديقاتي. كنا جميعنا نخفي هذه الحقيقة حتى إننا لم نخبر بعضنا بها، كنا نخاف أن تشي إحدانا بسرّ الأخرى، كنا نكتشف تلك الأسرار مصادفة. كنا طفلات، في الثامنة تقريباً، لا يُسمح لنا سوى ارتداء الحجاب الأبيض. ارتديته في البداية. لم يكن أزمتي الوحيدة في ذلك المبنى الكبير. لم أكن أرى شعري سوى في الليل على ضوء القمر المتسرّب من شباك غرفتي الذي كان أشبه بقضبان السجن. في المبنى جميعنا فتيات، لكن قد يمر من الطبقة الأرضية عمال الصيانة وقد يرفعون أنظارهم إلى أعلى فيرون ابنة الثامنة بلا حجاب وهذا “حرام”.
ما زلت أملك صور حفل “التكليف” (بلوغ سنّ التكليف الشرعي). أكره تلك الصور، أكره الفستان الذي لا يشبه الفساتين التي أحبها وأكره إكليل الورد الذي وضعوه على رأسي وأكره أنه كان على أمي المريضة أن تأتي إلى المدرسة لتحتفل بما كان أشبه بجنازة بالنسبة إلي. ندخل القاعة على موسيقى كلاسيكية، ثم نعتلي المسرح، بعد ذلك تصعد “الست” صاحبة المدرسة إلى المسرح لتلقي كلماتها عن أهمية ارتداء الحجاب والسترة بلكنتها الفارسية وعربيتها “المكسّرة”، تقدم لنا كتب القرآن، والأصغر بيننا تحصل على قبلة على الرأس من “الست”. وأنا أفكر ألا يحق لنا أن نختار؟ ألا يحق لشعري أن يرى الشمس متى أردت أنا. في ذلك المكان لم تعط لنا الحرية لنفعل أي شيء ولا حتى لنختار وجبة الغداء.
في قسم المدرسة كانت المعلمات لطيفات، كنا جميعنا نرتدي الحجاب الأبيض، لكن كانت لبعضنا امتيازات أخرى: “فتيات الخارجي” اللواتي دفع أهلهن مالاً لإدخالهنّ هذه المدرسة التي تعدّ من أفضل المدارس في صور. كنت أتفاجأ كيف لأحد أن يدخل أطفاله بإرادته إلى الجحيم، ويدفع بدل ذلك مالاً كثيراً. لكن على الأقل لم تتلق أي منهن صفعة واحدة يوماً. “فتيات الخارجي” بنات الأغنياء لا يجدر بهن أن يكن يتيمات لدخول المدرسة، كن مختلفات يأتين عند الثامنة صباحاً ويرحلن عند الثانية. أما فتيات “الداخلي” ممن كن إما يتيمات أو بنات أب من ذوي الاحتياجات الخاصة كحالتي، كنا نخرج من قسم المدرسة إلى المطعم حيث “يلي موجود بتاكلوه ويلي ما بتاكل رح تتعاقب”، أو “يلي ما بتاكل ممنوع تتعشى” أو “يلي ما بتاكل محرومة من المصروف”. لم أكن محظوظة سوى بمربية واحدة خلال الفترة التي أمضيتها هناك، لكنها غادرت بعد أشهر من رعايتنا. لم تصمد. أما أختي فلم تكن محظوظة بأي واحدة.
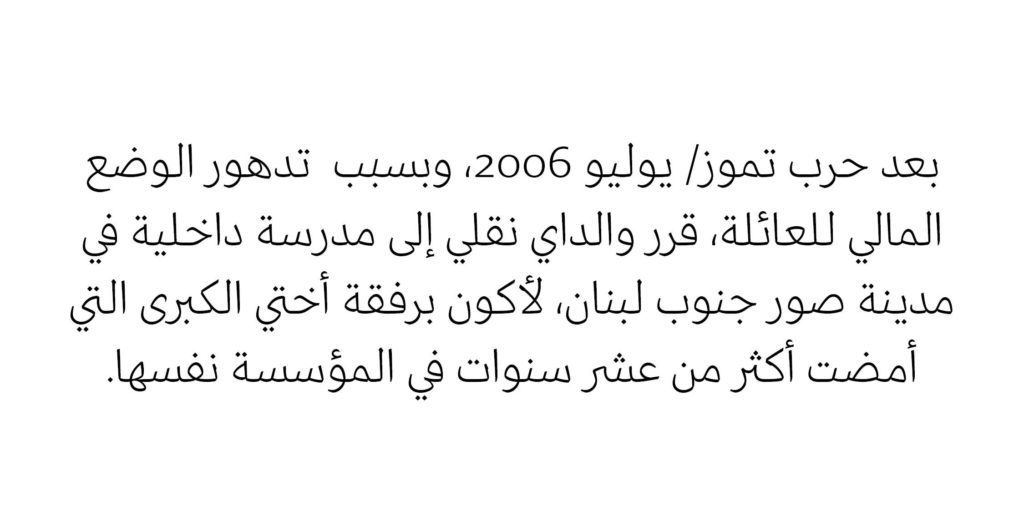
أحلام ما قبل النوم
بعد الغداء نصعد إلى قسم “الداخلي”. نصلّي وتراقبنا المربية. إذا تغيبت إحدانا عن فرض الصلاة تُعاقب. ثم نصعد إلى الصفوف حيث ننجز واجباتنا المدرسية. وتجلس أمامنا المربية، تضع إلى جانبها المسطرة الخشب لضربنا حين نخطئ أو تهددنا بها كي لا نقع في الخطأ. ثم في المساء بعد العشاء ندخل إلى غرفنا المكتظة، عشر فتيات على الأقل في الغرفة الواحدة، الأسرّة ذات طبقتين، والمحظوظة منا تحصل على الطبقة العلوية المطلة إلى الخارج. حصلت على هذا “الترف” مرة واحدة خلال فترتي هناك. العودة الى السرير في الليل هي الأسوأ رغم أنها الفرصة الوحيدة لعدم تلقي الصفعات أو التوبيخ. الغرفة المظلمة حيث لا يمكنك البكاء أو إبقاء النور. أخلد إلى النوم من دون الحصول على قبلة النوم من أمي ولا أحصل على قصة قبل النوم، ومن دون أن أخبرها أن المربية صفعتني لأنني تأخرت خمس دقائق في تناول الغداء، أو عن رغبتي بزيارة مدينة الملاهي هذا الأسبوع، أو الحصول على أقلام “باربي” كالتي مع زينة التي أحضرتها لها أمها الأسبوع الماضي. لم أكن أحصل على أي اتصال بأمي في نهاية الأسبوع. في تلك الفترة لم تكن أمي تملك هاتفاً، وإن حصلت على واحد، سيبقى الأمر ناقصاً لأنني لن أحصل على حديث مماثل مع أبي صاحب الاحتياجات السمعية التي أثّرت في نطقه، ولو أني حصلت لكنت سأخبره بالكثير. كنت أرغب بأن يعلم بكل ما يحدث هنا، خصوصاً مسألة الضرب. أبي لم يضربني يوماً.
كنت أشاهد زميلاتي وهن يجرين حديثاً مع آبائهن. هناك حكايات كنت أرغب أن أسمعها بصوته، وهناك شكاوى كنت أرغب أن يسمعها مني. فقدت الكثير كوني ابنة “الأخرس”، كنت أنظر الى صديقاتي يسترسلن بالحديث مع آبائهن وانا كنت أبحث عن الإشارة المناسبة لأخبر أبي عما يؤلم روحي وعن جرح آخر غير الجرح الذي في أعلى المعدة. عن نوبات الربو وعن رجفة يدي بسبب الوضع النفسي الذي كنت أمر به هناك، لكنني في الأعياد حين كنت ألتقي به كنت أبتسم فقط وأقبّل رأسه ثم نجري حديثاً عادياً عن الطقس وجدّي والضيعة، كل ذلك بلغة الإشارة التي أتقنتها منذ الصغر.
الجريمة والعقاب
كنا ننتظر رمضان بفارغ الصبر. هذا الشهر يعني الكثير من الدعوات والكثير من الهدايا. كنا نُدعى إلى الكثير من الأماكن والمدارس والمطاعم، وكان الناس يقدمون لنا الهدايا هناك. أذكر في إحدى الزيارات، أثناء تناول الإفطار، سقوط كوب اللبن من يدي. لم يكن سقوطاً عابراً. ترك اللبن على جلدي ثلاث بقع في مواضع مختلفة في جسدي وثلاثة أيام من العقاب، والعقاب في تلك المرة كان تنظيف الحمامات وعدم السماح لي بمشاهدة التلفزيون الذي لم يكن يعرض سوى قناة “طيور الجنة” والأدعية والقرآن .
لا أذكر كم عدد الكدمات التي تلقيتها هناك ولا كم مرة أهانتني المربية لأخطاء سخيفة كسقوط كوب اللبن، أو كم مرة سُحلت من شعري لظهور خصلة منه من طريق الخطأ أو لتأخري بحفظ جدول الضرب، أو لعدم تغيير حفاضات بنات الخمس السنوات اللواتي كن من مسؤوليتنا، أدركنا متأخرات أنهنّ كنّ في الحقيقة مسؤولية المربيات، لا نحن!
كنت أنتظر أن يأتي اليوم الذي نعود فيه إلى البيت لكي ينتهي هذا الكابوس. وكان قد تأخر كثيراً. وجود أختي الكبيرة لم يشفع لي هناك وهي كانت مثلي لا شيء يشفع لها. كنا نُعاقب على أخطاء لم نقترفها وكنا نحرم من أشياء لم تكن ذات ميزة عالية كالخروج من المبنى الاسمنتي عند العصر والجلوس على المقاعد الملونة. لم أخبر والدتي يوماً عن الصفعات التي تلقيتها. كنت أظنه أمراً عادياً، لم تتمرد أي من الفتيات، حتى صار الأمر روتينياً وصارت قسوة المربيات وخبثهن أمراً بدهياً.
بعد فترة قررت الإدارة أننا سننتقل الى مجموعة “النصف داخلي” أي نذهب إلى بيوتنا عند السابعة مساء ونعود في الصباح، ندرس في قسم المدرسة نأكل ثم ندرس وننجز واجباتنا المدرسية في قسم الداخلي ثم نعود إلى المنزل عند الغروب. أمضيت بقية فترتي تلك على الطريق في رحلة الذهاب من المدرسة وإليها.
بعد نهاية الصف السادس كنا نُنقل إلى مدارس أخرى خارج المؤسسة، لم تكن أمامنا خيارات. جميع المدارس كانت للفتيات فقط. لم يحدث أن اجتمعنا مع صبيان، كنا نلعب في العطلة لعبة العروس والعريس فننظم عرساً كبيراً كان على واحدة منا أن تلعب دور العريس وأخرى دور العروس وعلى البقية زفّهما. في المرة الوحيدة التي اجتمعنا فيها مع الجنس الآخر كانت في مخيم الصيف الذي أجرته المؤسسة بالتعاون مع مدارس أخرى. كانت علينا إعادة تجسيد قصص الأميرات. في هذه المرة كان بيننا أمير حقيقي، لكننا لعبنا دور “الأقزام” في قصة “بياض الثلج”.
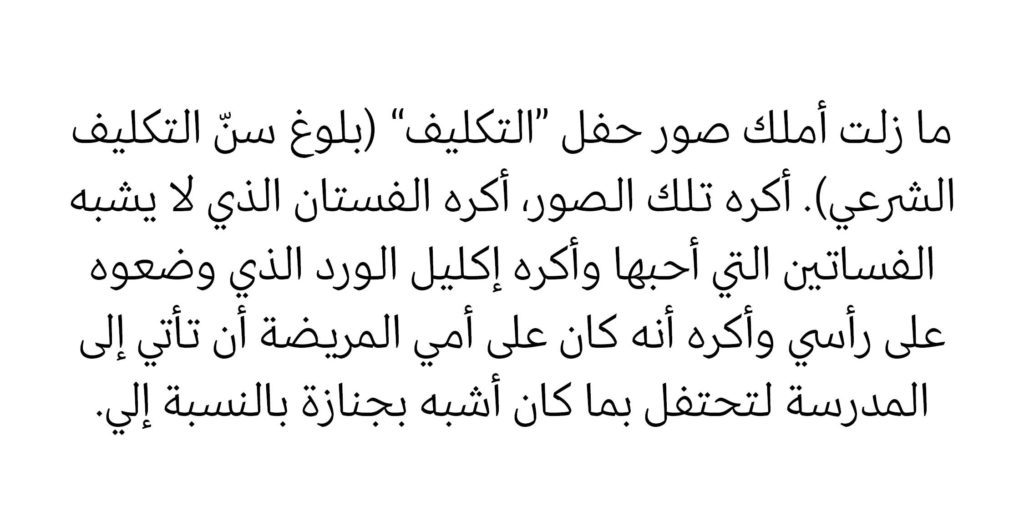
لماذا لا تكتب عن الربيع؟
تأخرنا لنقع في الحب. أغلبنا وقعن في حب أحد الأقارب في سنوات المراهقة الأولى. لم تكن أمامنا فرص أخرى. نحن نذهب إلى المنزل عند الغروب ونلتقي العائلة في الأعياد وهذه فرصة الحب الوحيدة. وكانت لي حصتي من هذا الحب، حين وقعت في حب أحد أقاربي، وتحولت كتابتي عن الحب الى قصص واقعية. في الصف السابع اختبرت الحب الطفولي الأول، في تلك الفترة كانت كتاباتي تنضج كما قلبي، كانت بريئة تشبه خطوات الأطفال الأولى نحو الحياة، لكن ذلك لم يكن مطمئناً للمربية حين اكتشفت وجود دفتر مذكرات يحتوي (معاذ الله!) على خطابات رومانسية للجنس الآخر. رغم أنها لم تحصل عليه، عرفت به من ناظرة الثانوية. عوقبت وضُربت بعدما أخفيت عنها استدعاء الناظرة لولي أمري ولم أخبرها هي. أغضبها ذلك. شعرتُ حينها أن والدتي ستكون أرحم في حال اكتشفت بنفسها تلك الكتابات. خفت كثيراً من أن تعرف المربية بوجود ذلك الدفتر. حضرت أمي إلى المدرسة مزقته قطعاً كي لا تعرف به مربيتي وأُفصل من المؤسسة. لم تكن تعلم أن العقاب سيكون أكثر خطورة بالنسبة إلي من الفصل. كانت حجة الناظرة في ثانوية البنات في الصور “لماذا لا تكتب ابنتك عن الربيع؟ عن الأزهار؟ عيب تكتب عن الحب بهالعمر”. لم يكن هناك قبلة واحدة في تلك السطور. ومع ذلك تملّكني الخوف وتوقفت عن الكتابة لفترة طويلة.
في عامي الأخير بدأت أشعر وكأن لي شخصيتين. وعليّ أن أحسن التصرف في الاثنتين: الأولى وأنا أرتدي الحجاب الأبيض في المؤسسة والثانية وأنا حرة منه في منزل العائلة. تمردتُ أخيراً بعدما كشفت أمري إحدى المربيات، وعرف الجميع أنني لا أرتدي الحجاب خارج المؤسسة وهذا ممنوع. لا بل “حرام”.
أخبرت والدتي برغبتي في ترك المؤسسة ولا بأس بارتياد المدارس الرسمية، وبعد شهور من معاناتي لإقناعها بارتياد المدرسة الرسمية القريبة من المنزل، وافقت أخيراً .
غادرت “المؤسسة” ومعي حمل من الإشكالات النفسية والذكريات المؤلمة في مكان أشبه بغرف التعذيب. كثيرة هي قصصنا في تلك الأمكنة ومؤلم أن تمضي السنوات الأولى من حياتك الدراسية في سجون “تربوية”، يظن الجميع أنها آمنة ولا أحد يعلم ما يحدث خلف جدرانها وقضبانها.
كثيرة هي قصصنا هناك، في “المؤسسة”، في السجن. وحين نجتمع مصادفة نتبادل التهاني، على من نجت منا باكراً. لكن هل نجونا فعلاً؟
إقرأوا أيضاً:








