“لا يهمّ، ما إذا كنتِ قد أنجبتِ أطفالاً أم كتبتِ كتباً، ما يهمّ هو أن تكوني سعيدة”.
هذا ما قالته الروائية التركية إليف شفق، وهذه كانت رؤيتها للسعادة والرضا. لكن يبدو أنها غفلت حين صاغت عبارتها تلك، عن قيود الثقافة والقوانين.
إليف أنجبت أطفالاً، وبهذا حقّقت الشرط المجتمعي الأول لتحصل على القبول الاجتماعي، كما نشرت روايات ومنها انطلقت إلى العالمية. أتمّت إليف الشرطين على أكمل وجه، وقد حقق لها ذلك سعادة بلا شك. إلا أنه لم يمنع “مجتمعها” من تعقّب فرحها ومحاولة قتله. لماذا؟ لأنها رفعت علم قوس القزح.

على رغم ما حققته إليف من نجاحٍ عالمي، إلا أنها لم تمتلك الجرأة الكافية لتُعلن ميولها الجنسية المزدوجة إلا منذ 4 سنوات. اعتلت إليف مسرح TED وعليه قالت، “لم أكن أملك الشجاعة لأعلن على المَلأ أنني مزدوجة الميول الجنسية، فقد خشيتُ من السخرية والكراهية اللتين سَتليان إعلاني هذا”. حينها شُنت حملة شرسة ضد الروائية، لا سيما أن كتاباتها المعارضة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمجتمعات المحافظة، كانت أرضاً خصبة مهّدت الطريق للتصويب عليها. والحال أن المثلية الجنسية لا تتسبّب بعقوبة قانونية لصاحبها في تركيا، إلا أن القبول المجتمعي يظلّ محلّ قلقٍ في بلد تتحكّم استقطاباته السياسيّة والإيديولوجيّة الحادّة بمزاجه الشعبي. بعض المنتقدين اعتبر أن إليف “تهرّبت من إعلان هويتها الجنسية باكراً من أجل بيع كتبها”، فيما رأى آخرون باعترافها خطوة تستبق طرح كتابٍ جديد، أو حتى محاولة “لحصد جائزة نوبل”. ولكن كل ما في الأمر أن إليف علت عن القعر بنجاحها، وقرّرت أن تتصالح مع أفكارها ومخاوفها. فهي التي قالت “عندما أشعر أنني سأقول شيئاً سأقوله حتى لو أمسكني العالم من رقبتي وطلب مني أن أسكت”.
شاركت إليف شفق في إحدى التظاهرات الداعمة لحقوق مجتمع الميم/ عين هذا العام، حاملةً علم قوس القزح. هذه الخطوة مثلت ذريعة لمعارضيها لتجديد الحرب ضدها.
حين رفعت إليف علم ألوان الطيف أعادت إلى أذهان خصوم الحريات مراحل حياتها الجدلية كلها. بدءاً بتحقيق النيابة العامة التركية بروايات إليف، خصوصاً كتابي “نظرات ثاقبة – 1999” و”بنات حواء الثلاث – 2016″، بتهمة “نشر محتوى يُروّج للتحرش بالأطفال”، ومحاكمتها لاحقاً بتهمة “إهانة الهوية التركية”، وصولاً إلى دعوات إسقاط الجنسية التركية عنها.
إليف هي من أولئك الروائيات اللواتي يُشكلن مصدر قلقٍ دائم للسلطة ومناصريها، تماماً كما نوال السعداوي ورضوى عاشور، لمجرّد أنهن يشكّلن صورة “اللاأبوية” المشتهاة في وعيهن عن بلادهن.
دافعت إليف، الحاصلة على شهادة ماجستير في الدراسات الجندريّة ودراسات المرأة، عن حرية التعبير والفردانية في وجه الهويّات الجمعيّة القومية والدينيّة والثقافية المؤدلجة. كما نشطت بالدفاع عن الأقليات والمستضعفين، لا سيما النساء، عبر رصدها أساليب العنف الممنهج في المجتمع التركي ضدهن. حين سُئلت إليف عن سبب مناصرة تلك القضايا في أحد الحوارات الصحافية، أوضحت أنّ “المجتمع التركي يتآكل من الداخل، ما استدعى منها التدخل ككاتبة، بحيث يكون للضحايا والمنبوذين صوت”.
على رغم هجرتها النهائية إلى بريطانيا لكونها لاجئة سياسية قبل ما يزيد عن 10 سنوات، فإن النظام التركي لا يزال يترصّد إليف إثر كل عملٍ جديد يصدر لها، أو خبر يتناول تفصيلاً من حياتها.
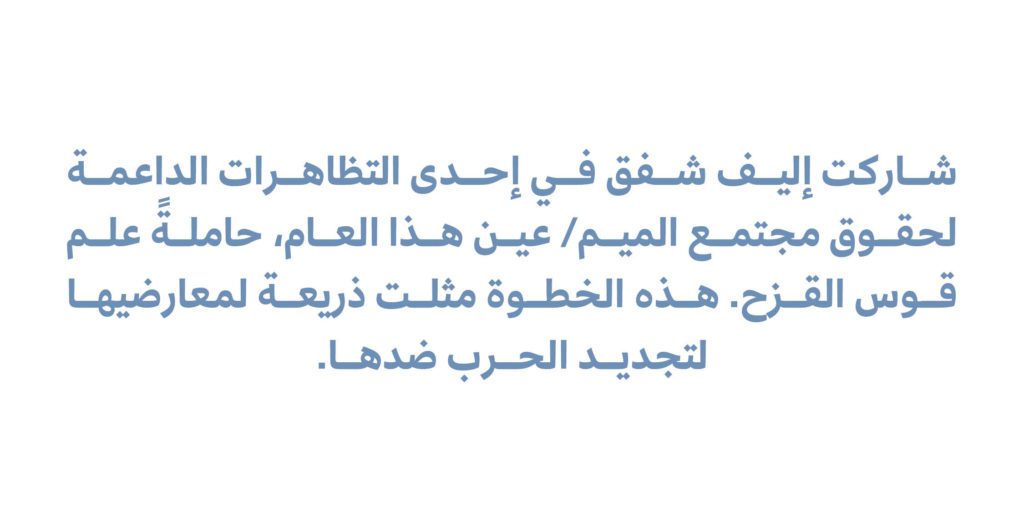
عام 2006، استُدعيت إليف للمثول أمام القضاء بسبب تلميحاتها حول الإبادة التركية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، واصفة إيّاها صراحة بـ”إبادة جماعية” في روايتها “لقيطة إسطنبول”، لتتمّ تبرئتها لاحقاً من تهمة “إهانة الهوية التركية”. حوكمت شفق من جديد عام 2009، للأسباب ذاتها، وهذه المرّة قرّرت الهجرة النهائية من تركيا، بعدما استعانت بحارس شخصي لمدة 18 شهراً قبل مغادرتها إلى بريطانيا، خوفاً على حياتها.
لإليف رواية اسمها “عشر دقائق و38 ثانية”، تجرّأت فيها على قتل بطلتها في الدقائق الأولى منها. ليلى، بطلة الرواية، تموت تُلقى جثتها في القمامة، وتدور الأحداث في الدقائق الـ10 والثواني الـ38 ثانية الأخيرة التي يعمل خلالها عقلها قبل أن تموت. حين سُئلت إليف عن جرأتها باستهلال الرواية بقتل البطلة، قالت إنها تأثّرت بالدراسات العلمية التي تشير إلى أن نشاط الدماغ البشري يظلّ يعمل بعد الموت لنحو 10 دقائق. كان ذلك اكتشافاً علمياً مهماً وتحدياً سردياً لإليف أيضاً، كيف تجعل بطلتها تروي قصّتها في تلك الدقائق العشر والثواني الـ38؟
في الرواية ذاتها، يُنقل جثمان ليلى من المكب إلى مقبرة للمنبوذين في المدينة، حيث لا يُمنح الموتى علامة مميزة على قبورهم، لا شواهد قبور، لا زهور، لا زوّار، ولا أسماء. فقط قطع خشبية مرقّمة… فيها يُدفن مُصابي الآيدز والمثليّون والعابرون جنسياً، وكلّ من رُفِضُوا من جانب أسرهم بسبب هويّاتهم الجنسانية، وعاملات الجنس، والأطفال اللقطاء والمشرّدون. وبالمناسبة، هذه المقابر موجودة في إسطنبول وليست من وحي خيال الروائية. في السنوات الأخيرة أضيفت إليها قبور اللاجئين الأفغان والسوريين الذين نرى جثثهم على الشواطئ في الصحف.
أُفكّر أن طيف تلك المقبرة لا بدّ أنه رافق إليف لفترةٍ كونها نُبذت اجتماعياً في بلدها، لكن أغلب الظنّ أنه غادرها حين أعلنت مصالحتها مع ذاتها. ولكن كيف يُغادر ذلك الطيف من لا يملك شجاعة الاعتراض أو البوح؟
إقرأوا أيضاً:








