تحوّل فلسطينيو قطاع غزة، في السنوات الماضية، إلى مثابة أسطورة في التضحية والصمود والمقاومة، في مواجهتهم جبروت الجيش الإسرائيلي، الذي بات يمعن في قتلهم وحصارهم وتدمير بيوتهم، في ظل موازين قوى غير متكافئة، أمام سمع العالم وبصره، بما في ذلك “الأشقاء” العرب.
بيد أن تلك الصورة لا يفترض أن تحجب الصورة الأخرى لغزة، أي المعاناة والقهر والإفقار والإحباط، التي يجري طمسها، بادعاء أن لمقاومة الاحتلال ثمن، أو أن تلك الصورة من شأنها اضعاف المعنويات، بدعوى انه يجب التركيز على المقاومة، وفقا لشعار: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، علما أن تلك الأصوات تروّج لفكرة أن إسرائيل آيلة للانهيار بفعل صواريخ “المقاومة” هنا وهناك، مع مقولات من مثل: “سنزلزل الأرض تحت أقدامهم”، و”توازن الرعب”، و”تبادل الردع”، و”قواعد اشتباك”، التي تصدر كدعاية، من دون أن تثبت عملياً.
في الحقيقة فإن تلك الادعاءات تتوخى طمس افتقاد الفلسطينيين لاستراتيجية واضحة للمقاومة، بخاصة في قطاع غزة (360 كم مربع)، الذي يشكل أقل من 1.3 بالمئة من فلسطين، أو 6 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
أيضا، تلك الادعاءات تطمس حقيقة أن المقاومة، سيما المسلحة، ليست شيكا على بياض، إذ يجب أن تخضع للنقد والمساءلة والمحاسبة، وحسابات الجدوى، كما لحسابات الاستثمار السياسي، وإلا تصبح مثل دائرة مفرغة يقتل فيها الفلسطينيون وتدمر حيواتهم وعمرانهم من دون مراكمة إنجازات سياسية (مع ملاحظة أن الحركة الوطنية الفلسطينية صار عمرها 57 عاما).
الأهم من كل ما تقدم أن المقاومة يفترض أن تستنزف العدو، لا أن تسهل له استنزاف المجتمع الفلسطيني، وأن تحيّد نقاط تفوق العدو ما أمكن، لا أن تستدرج لكشف شعبها أمام آلته العسكرية المدمرة، بحجة حرب صواريخ: صاروخ فلسطيني ضد صاروخ إسرائيلي، أو جيش لجيش، وشتان بين الإثنين، في مستوى الرعب، ومدى الدمار الذي ينجم عن جيش إسرائيل.
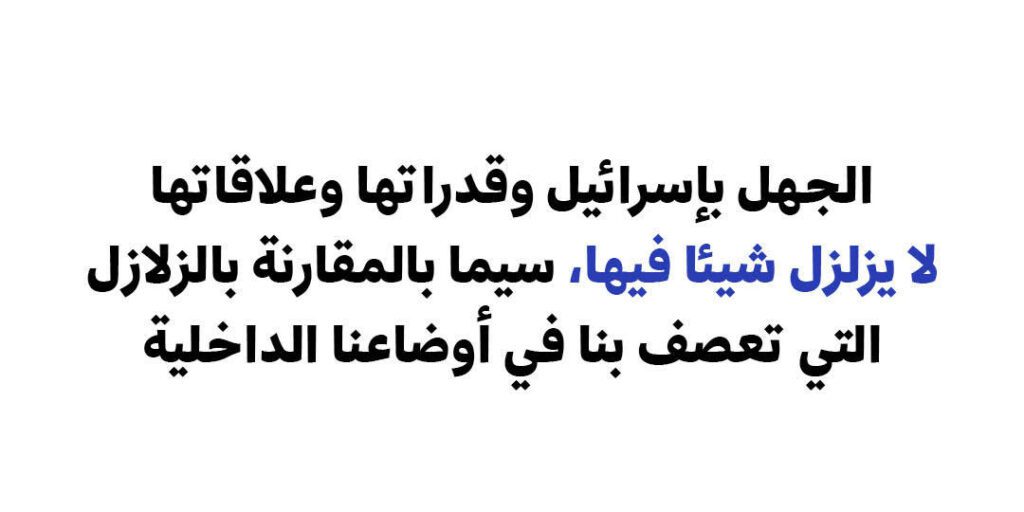
أيضا، يفوت أصحاب تلك النظرية أن تجاهل الواقع، ينطوي على نظرة استعلائية، وانفصام عن الشعب، تستخف بالمعاناة والتضحيات، وهي ظاهرة ملحوظة في كثير من الوقائع في علاقة الفصائل الفلسطينية، ولاسيما علاقة السلطتين في الضفة وغزة، بالشعب. ويمكن ملاحظة أن بعض الفصائل تحسب خسائرها المحدودة في الضربات الإسرائيلية، ما يوحي بالتخفّف من الضحايا الفلسطينيين المدنيين، الذين يتلقون معظم الضربات (لاحظ التقرير الاستراتيجي لعام 2006 الصادر عن مركز الزيتونة ص 84 مثلا). والمقصود أنّ تقدير تضحيات ومعاناة الشعب هي التي يمكن أن ترشد أشكال المقاومة، وتمكن من استثمارها، وتتجّنب الاستدراج لاستنزاف القوى في غير وقتها ومكانها.
لمعرفة واقع الفلسطينيين الصعب، والمعقد، في قطاع غزة، وحتى لا يتم تحميلهم فوق قدراتهم، يفيد التمعن في المعطيات المهمة الآتية:
أولا، يعيش مليونا فلسطيني في غزة في بقعة صغيرة، مزدحمة، وتفتقد إلى الموارد، ومصادر العمل، والأهم أنها تعتمد في معظم مواردها على الخارج، وضمن ذلك اعتمادها على إسرائيل في حاجاتها من المياه والكهرباء والمحروقات، وحتى مساحة الصيد في البحر تحددها إسرائيل (التوسعة أو التضييق). وفوق كل ذلك فإن فلسطينيي غزة يعانون من الحصار الإسرائيلي المشدّد على حركة الأفراد والسلع، فحتى معبر رفح (مع مصر) يخضع لقيود الحصار.
ثانيا، بخصوص الوضع الاقتصادي والمعيشي، يعيش فلسطينيو غزة في سجن كبير، مع نسبة فقر وبطالة عاليين، بحكم تداعيات الحصار منذ 15 عاما (منذ 2007)، وافتقاد القطاع إلى الموارد والاستثمارات، وتكرار الحروب المدمرة للمنازل والبنى التحتية. ومثلاً، فإن نسبة مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية متدنية، فبينما بلغت في الضفة 12,3 مليار دولار (83 بالمئة)، بلغت في غزة 2.5 مليار دولار (14.8 بالمئة)، للعام 2021؛ وبالمقارنة فإن الناتج المحلي لإسرائيل بلغ 481 مليار دولار. وبخصوص حصة الفرد من الناتج المحلي: بلغ في الضفة 4,2 ألف دولار في السنة، فيما لم يتجاوز 1,2 ألف دولار في غزة؛ وبالمقارنة فإن نصيب الفرد في إسرائيل من الناتج القومي بلغ 51 ألف دولار في السنة.
ثالثا، تكبد فلسطينيو غزة خسائر بشرية كبيرة في الحروب التي شنتها إسرائيل عليهم، فثمة: 1436 في الحرب الأولى التي استمرت 23 يوما (أواخر 2008). و155، في الحرب الثانية، التي استمرت ثمانية أيام (أواخر 2012). و2174 في الحرب الثالثة، التي استمرت 50 يوما (صيف 2014). و243 في الحرب الرابعة، التي استمرت 11 يوما (صيف 2021). و44 في الحرب الخامسة التي استمرت قرابة ثلاثة أيام (صيف 2022). في المقابل فإن خسائر إسرائيل من تلك الحروب كانت على التوالي 13، و3، 70، 12 إسرائيلياً.
بالإضافة إلى تلك الحروب ثمة 326 فلسطينيا قضوا بالرصاص الإسرائيلي ضمن ما سمي “مسيرات العودة” التي كانت تنظم يوم الجمعة من كل أسبوع طوال عامي 2018 ـ 2019 (بحسب إحصائية لمركز “الميزان” لحقوق الإنسان)، وحوالي 400 فلسطيني من ضحايا الحسم الأمني، أو ضحايا استيلاء حماس على قطاع غزة (2007). وقد يجدر التنويه هنا إلى أن القطاع شهد حملة عسكرية مشددة ضمن تداعيات خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت (25/6/2006) نجم عنها مصرع 556 فلسطينيا (من أصل 692 فلسطينيا قتلوا في العام ذاته).
رابعا، ثمة 20 ألف عامل من غزة يشتغلون في إسرائيل (من أصل 200 ألف عامل فلسطيني في سوق العمل الإسرائيلية)، وثمة مؤشرات لزيادة العدد إذ سجل 250 ألفاً من العمال في غزة أنفسهم لطلب الحصول على تصريحات عمل في إسرائيل (“الأيام” 15/8/2022)، علما أن العمال الفلسطينيين هناك تعادل أجورهم ستة أضعاف العامل الفلسطيني في سوق العمل الفلسطينية الضعيفة أصلا، في الضفة والقطاع.
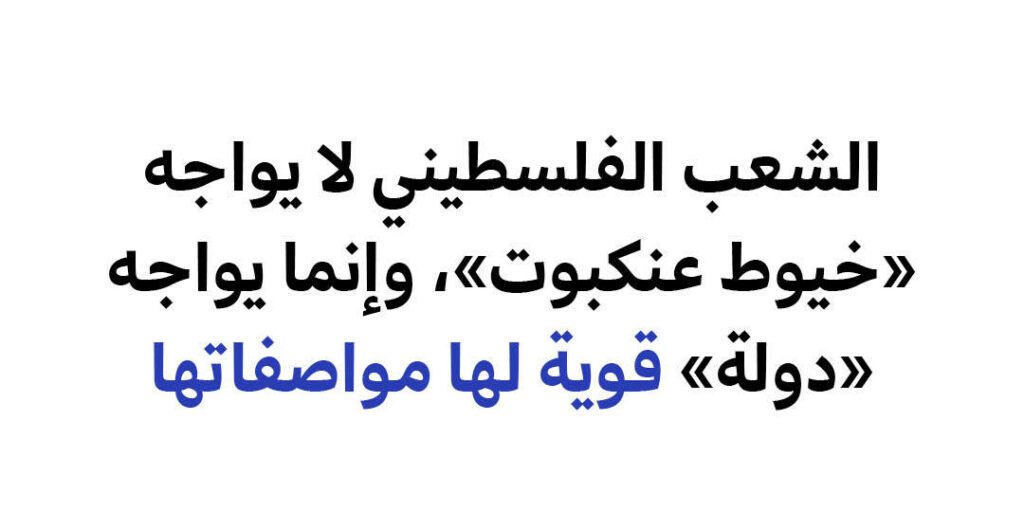
باختصار، مقاومة الاحتلال والاضطهاد والتمييز هي رد فعل إنساني، طبيعي ومشروع، تبعاً للتجارب والمعايير الدولية والقيم الإنسانية. بيد أن تلك المقاومة لها أشكال، ومستويات، ومعايير، أهمها أن تتناسب مع إمكانيات الشعب المعني، وتأتي بحسب قدرته على التحمل، وأن تجنّبه الاستنزاف، بتحييد نقاط قوة العدو، وهي تُخاض وفق استراتيجية حرب الضعيف ضد القوي، وليس كجيش في مواجهة جيش آخر، أو وفق استراتيجية الضربة القاضية. وهي بهذا المعنى يفترض ألا تنطلق من التجريبية والمزاجية والروح القدرية، بحيث تذهب إلى المبالغات والعواطف، معتمدة في ذلك ليس على استراتيجية سياسية وعسكرية واضحة ومسؤولة، وإنما على ايمان الشعب بقضيته، واستعداده للتضحية فقط، ما يسهّل على العدو إرهاقه واستنزافه، من دون الاقتران بتحقيق إنجازات وطنية ملموسة، على ما أثبتت التجارب المتكررة، المريرة وباهظة الثمن.
إقرأوا أيضاً:
ظلّت إسرائيل، طوال الفترة الماضية، تقوى وتتطور، رغم كل الشعارات عن “زلزلة الأرض” تحتها (يا ريت)، في حين ظلت أفواج الهجرة اليهودية تتدفق على فلسطين (إسرائيل)، إذ بلغ عددهم بين الأعوام 2000 ـ 2021 حوالي نصف مليون (بمعدل 20 ـ 25 ألفاً في السنة) بما في ذلك سنوات الانتفاضة الثانية (المسلحة) إذ بلغ عدد القادمين المستوطنين حينها حوالي 182 ألفا (بين الأعوام 2000ـ 2004). أما اقتصاديا، فقد زاد الناتج القومي لإسرائيل من 114 مليار دولار (عام 2001) إلى 481 مليار دولار (عام 2021)، وفي حين كان معدل دخل الفرد 19 ألفاً (2005) بلغ 51 ألفاً (في العام 2021)، هذا مع صادرات بمبلغ قدره 50 مليار دولار معظمها “هايتك” وصناعات متقدمة؛ وهذا كله في دولة صغيرة ومحدودة عدد السكان، ما يوضح حجم الضياع وتبديد الثروات البشرية والطبيعية في العالم العربي.
على صعيد مكانتها، باتت إسرائيل بمثابة الدولة الأكثر استقراراً وتطوراً في الشرق الأوسط، مع علاقات سياسية متميزة مع أقوى دول العالم، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وبشرياً، وهذا يشمل إلى الولايات المتحدة والدول الغربية، الدول الحليفة تاريخياً للعالم العربي مثل روسيا والهند والصين ودول أفريقية واسيوية، ويكفي أن نذكر أن التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل بلغ 15 مليار دولار (4,3 مليار دولار صادرات 10.7 مليار دولار واردات)، وكان بالكاد يصل إلى 2.5 مليار دولار في العام 2005. فوق ذلك فإن إسرائيل من أعلى الدول في نسبة الإنفاق على البحث العلمي إذ تخصص 3.5 من ناتجها على هذا المجال، لذا فهي تعتبر من أهم مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم، وهذا هو سر علاقاتها مع الصين والهند وروسيا، علما انها تخصص 20 مليار دولار سنوياً للأمن والدفاع.
الشعب الفلسطيني لا يواجه “خيوط عنكبوت”، ولا جرّة فخار، وإنما يواجه “دولة” قوية لها مواصفاتها، رغم كل تناقضاتها ومع كل عوامل الضعف التاريخي في مكوناتها، وهو لذلك شعب شجاع، وصامد، ومضحّي، ولا يحتاج لأحد في طهران أو في مخبأ في لبنان، كي يعلمه دروسا أو يعطيه شهادة.
يحتاج الشعب الفلسطيني إلى قيادة بمستواه المعرفي، والنضالي، قيادة تعرف كيف تدير موارده، وتعزّز وحدته، وترشد كفاحه، بأفضل ما يمكن.
القصد أن الجهل بإسرائيل وقدراتها وعلاقاتها لا يزلزل شيئا فيها، سيما بالمقارنة بالزلازل التي تعصف بنا في أوضاعنا الداخلية.
إقرأوا أيضاً:










