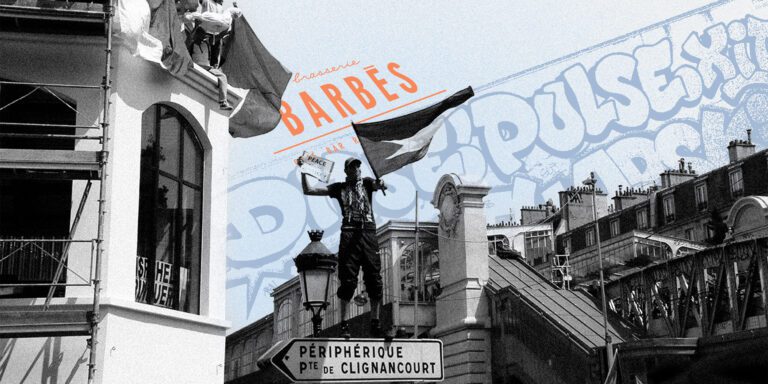الذكرى المئوية على وضع الحجر الأساس لمسجد باريس الكبير لم تجذب اهتمام الإعلام الفرنسي بقدر زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمسجد في هذا التاريخ، ما أعطى الحدث نكهة مختلفة.
لم ينس الرأي العام الفرنسي طرح الحكومة، العام الماضي، قانون محاربة النزعات الانفصالية، والذي ينظر إليه المسلمون بارتياب على اعتبار أنه يستهدفهم بشكل خاص. ربما سعى الرئيس الفرنسي إلى استغلال المناسبة لمد جسور التواصل مع الجالية الإسلامية، نظرا إلى الرمزية التي يجسدها مسجد باريس الكبير كونه أقدم مؤسسة إسلامية في البلاد.
لكن إذا وضعنا الزيارة في سياق أوسع، فتمكن حينها مقاربتها من منظار علاقة الدولة الفرنسية بالمسلمين المقيمين على أراضيها.
وجود مسلمين على الأراضي الفرنسية يجعل، الإسلام مسألة نقاش عامة، على اعتبار أن شريحة من المسلمين تنطلق من تعاليم عقيدتهم لتحديد شكل العلاقة التي تربطهم بمحيطهم الجغرافي.
علمانية فرنسا تحظر على الدولة التدخل في تنظيم شؤون المسلمين المقيمين على أراضيها. بالمقابل، للدولة كامل الحرية في اختيار “الشريك المدني” الذي تود التعامل معه.
وجود مسلمين على الأراضي الفرنسية يجعل، الإسلام مسألة نقاش عامة، على اعتبار أن شريحة من المسلمين تنطلق من تعاليم عقيدتهم لتحديد شكل العلاقة التي تربطهم بمحيطهم الجغرافي.
من هنا تندرج العلاقة بين الدولة ومسجد باريس الكبير التي ينتظر منه، على المستوى الرسمي، تصدير إسلام منفتح، متسامح ومتماه مع المجتمع الفرنسي وقيمه.
لكن ما تعرضت له فرنسا من اعتداءات إرهابية باسم الإسلام في السنوات الماضية، دفع بجزء من الرأي العام، وعلى وجه التحديد اليمين المتطرف، إلى استهجان أي شكل من أشكال التواصل مع المؤسسات الإسلامية بحجة عدم منحها أي شرعية.
والسبب أن هذه الفئات لا تكتفي باعتبار المسلمين تهديداً أمنياً للبلاد، بل ترى فيهم خطراً ثقافياً سيغير وجه فرنسا بعد اقتلاعها من جذورها. فاليميني المتطرف، إريك زمور، ظل يردد طوال حملته الرئاسية أن المسلمين سيشكلون نصف سكان فرنسا في العام 2050، محذراً من تحول البلاد إلى جمهورية إسلامية بحلول العام 2100.
رأي لا يستند إلى أي دليل علمي، إذ تشير الدراسات الديموغرافية إلى أن المسلمين (من فرنسيين وأجانب) لن يشكلوا أكثر من 18 في المئة من إجمالي المقيمين في فرنسا. برغم ذلك، تلقى هذه الأكذوبة آذاناً صاغية في الشارع الفرنسي، ربما لاقتناع البعض بتغلغل المسلمين ثقافياً بعد جولات من الكباش الإعلامي والقضائي مرة حول البوركيني وأخرى بخصوص اللحم الحلال، مروراً بالرسوم الكاريكاتورية والجدل الدائم حول الحجاب (الذي يطفو كل حين وآخر بأشكال مختلفة).
تعتبر شريحة غير قليلة من الفرنسيين أن المسلمين يعزلون أنفسهم في أحياء خاضعة لنمط حياة خاص بهم، لتتحول إلى ما يشبه الجزر المنفصلة، بمعنى آخر هم من يرفض الاندماج في محيطهم الفرنسي. طبعاً لا يمكن إنكار وجود مثل هذا التوجه لدى جماعات من المسلمين وهي بالمناسبة حجة يرد عليها الطرف الآخر بأن السياسات العامة هي التي عزلت المهاجرين في الضواحي.
إقرأوا أيضاً:
لكن رأياً آخر يرى العكس تماماً: يعود أصحاب هذا الرأي إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما احتاجت فرنسا إلى استقدام يد عاملة. لم يكن هناك أي إشكال في استقبالهم، ليسود انطباع أن استقرار المسلمين في فرنسا هو لفترة موقتة. لكن مع نهاية هذه الحقبة، بعد أزمتي الطاقة، وارتفاع معدلات البطالة في الثمانينات، بات ينظر لهم كمنافسين لليد العاملة المحلية، ليس هم فقط بل “ذريتهم” أيضاً. فالجيل الثاني والثالث ولدوا فرنسيين وارتقى كثر منهم اجتماعياً، ليحتلوا مواقع مرموقة في سوق العمل وفي الحياة العامة. وعليه، اعتبر عدد من علماء الاجتماع أن نبذ المسلمين هو نتيجة رفض الفرنسيين المساواة معهم، ويعطون مثالاً عملياً على ذلك وهو رفض بعض الشركات إسناد مناصب إدارية للمحجبات بموازاة تقبلها حجاب عاملات النظافة. بمعنى آخر، اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي هو ما أطلق العنان للإسلاموفوبيا، وليس العكس.
هناك عامل يساعد على تأجيج اللغط: الترسانة القانونية.
فالقوانين الفرنسية متشعبة وأحياناً متناقضة وفي أحيان أخرى تكون غائبة، ما يسمح لكل فريق بنبش نصوص وإصدار اجتهادات تدعم موقفه حتى بات الاحتكام إلى القضاء سلاحاً يصوبه كل فريق على خصمه لإضعافه، عوضاً أن يكون القضاء حلاً، بات عنواناً لصب الزيت على النار.
أياً تكن ملامح القضية المثارة (لحم حلال، بوركيني…) ينطلق الجدل من نقطة البداية ذاتها: هل يشكل ذلك تناقضاً مع قانون 1905 المؤسس لعلمانية فرنسا؟
من الأمثلة على ذلك، الجدل الذي أثير عام 2019 حول قانونية مرافقة الأمهات لأبنائهن/ بناتهن خلال الرحلات المدرسية وهن يرتدين الحجاب. فالمدرسة الفرنسية ليست مجرد صرح تعليمي، بل صرح تربوي تعول عليه الدولة للوصول إلى تنشئة مدنية وتهيئة أجيال للانخراط في عقد اجتماعي تسمو فيه المواطنة على أي اعتبار عقائدي. وبما أن الرحلات المدرسية جزء من العملية التربوية، فقد اعتبر مناوئو الحجاب أن العملية المذكورة يجب أن تتم في بيئة محايدة دينياً، حتى من الرموز. أما الرأي الآخر فيعتبر أن روحية قانون 1905 تفرض الحيادية على المنخرطين في العملية التربوية (الأساتذة على وجه التحديد) وليس على الأهل، فمشاركتهم في الرحلات المدرسية ليست تدخلاً في المنهاج التربوي الذي سيطبق بحضورهم كما بغيابهم.
إزاء هذا الواقع السياسي والقانوني المتشعب، تعتبر الدولة الفرنسية أنه لا بد من شريك مسلم للتعامل معه عند كل محطة من المحطات الملغومة. وهنا أتت مئوية مسجد باريس الكبير لتفتح الجدل القديم الجديد الذي ينال بدوره نصيباً وافراً من الأبحاث: هل الإسلام الفرنسي ممكن؟