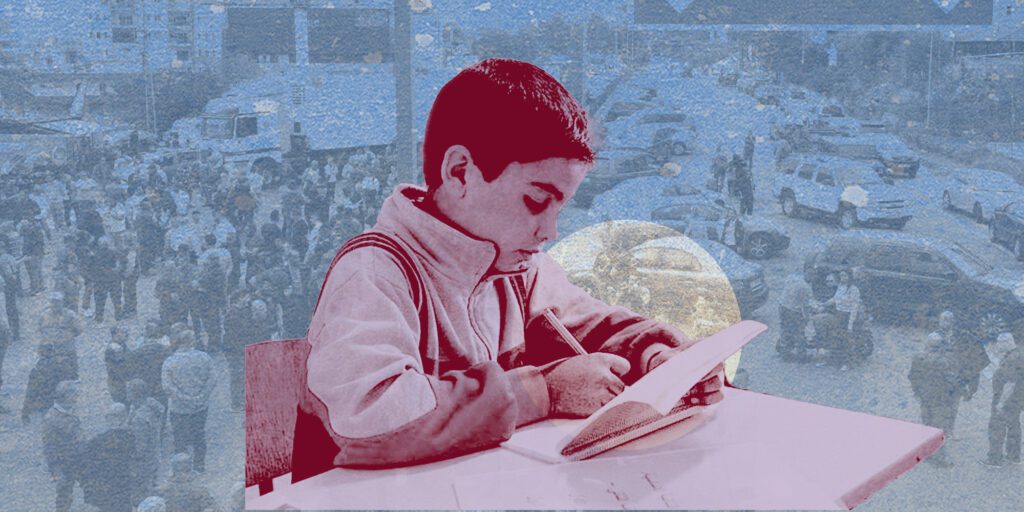ينفق زياد الرحباني مِن تراكمٍ يعود إلى السبعينات والربع الأوّل من الثمانينات. البعض يقول إنّ التراكم هذا لم يبق منه الكثير. البعض يقول إنّه نفد تماماً ولم يبق إلاّ الترّهات: كلمات لا تعني وحركات لا تُضحك و”أخبار” عائليّة أو صحّيّة لا تسلّي إلاّ المتلصّصين على التوافه. مُحبّوه يعاودون التذكير به: كم كان يُضحكنا. يقولون هذا من دون أن يتغلّبوا على حرجهم بما آل إليه اليوم. كارهوه ونقّاده يقولون إنّه لم يعد يُضحكنا على أنفسنا. صار يُضحكنا على نفسه. هذا يعني أنّ على الكوميديّ فيه أن يعتزل. الطيّبون بين النقّاد يستدركون: بل صار يُحزننا على نفسه. إذاً على التراجيديّ فيه أن يختفي أيضاً.
لا شكّ بأنّ ثمّة مشكلة. لنعد إلى النبع:
شبّ زياد الرحباني على نقد “لبنان القديم”، لبنان “المارونيّة السياسيّة” وما حفّ بها من سياحة واصطياف وخدمات واحتفال بمعرفة اللغات الأجنبيّة.
زياد كان هجّاء لذاك اللبنان: لاقتصاده ولغته وقيمه وللمفارقات الفادحة أحياناً التي تترتّب على وجوده.
هجاؤه كان مسكوناً بالكثير من مناكفة الأهل. من “قتل الأب” الذي ربّما كان الصائغ الأكبر، والمُعمّم الأوسع انتشاراً، لـ “الإيديولوجيا اللبنانيّة”. وبالفعل يُسجّل لعاصي ومنصور أنّهما كانا الأطروحة. سواهما، وفي عدادهم النجل زياد، كانوا الأطروحة المضادّة. ظلّوا الأطروحة المضادّة وتخبّطوا ولا زالوا يتخبّطون فيها كلٌّ بطريقته.
زياد، بالتالي، لم يكن ابن أبيه:

لبنان، مع الأهل، كان فوق الأرض. كان جاراً للقمر: “نحنا والقمر جيران”. مع الابن، انخفض إلى ما تحت الأرض بكثير: صار باراً أو مستشفى مجانين. اللبنانيّون، عند الأهل، كانوا خير أمّة أخرجت للناس. صاروا، مع النجل، نبتاً شيطانيّاً. مشاكلهم كانت خلافات عابرة أقرب إلى الصدف، يبدّدها الشاويش والمختار في القرية، أو ما بين قريتين. المشاكل، مع النجل، صارت جزءاً من جوهر لبنانيّ صارم وقاطع يعصى التغيير. الطائفيّة، بالتالي، كانت سوء فهم (نيوكولونياليّة مبكرة). صارت علّة وجود (هوبزيّة جلفة). المستقبل كان باسماً لنا، يفتح ذراعيه لاستقبالنا. صار مسدوداً في وجوهنا: إنّنا شعب بلا مستقبل. السياحة كانت ضيافة وكرماً هما من شيم اللبنانيّ. صارت نهباً وكذباً ودعارة هي شيم اللبنانيّ. المرأة كانت مقدّسة ومنزّهة. كانت فيروز. صارت مدنّسة وشريرة ونفعيّة بأيّ طريقة كانت. إنّها ثريّا. الأهل تمسّكوا بصورة مريم العذراء للمرأة. النيغاتيف احتفظ به النجل. اللغة، كذلك، جعلها الأهل مفتاح الضوء والوضوح بما يبدّد سوء الفهم العارض بين اللبنانيّين. صارت، مع النجل، مرآة نفوسنا المواربة والملتوية التي لا تعني ما تقول، أمّا ما يعني من أقوالها فبلا معنى.
لكنّ زياد كان ابن أبيه أيضاً. ذاك أنّ القاسم المشترك بين الأهل والنجل هو التبسيط. هو التسمّر عند جوهر مزعوم ما، لا مكان معه للزمن والتغيّر. هو العجز عن إدراك واقع متحرّك وسائل ومعقّد يقول إنّ اللبنانيّين ليسوا ملائكة ولا شياطين، فيما نساؤهم لسن قدّيسات ولا عاهرات.
عند الرحابنة الأهل، لا نستطيع أن نكون أشراراً حتّى لو أردنا. إنّ فينا خيراً جوهريّاً وعميقاً يسمو بنا إلى السماء. نحن بيت “الحقّ والخير والجمال”. عند زياد الرحباني، لا نستطيع إلاّ أن نكون أشراراً. هذا هو جوهرنا الأعمق. كلّ محاولة لعلاجنا آيلة حتماً إلى الإخفاق.
لقد كان طبيعيّاً، في هذا التكوين الذهنيّ، أن يستمرّ التثبّت عند مناكفة الأهل وهجاء لبنان ذي “الهيمنة المارونيّة”. أن يصبح ذاك الهجاء أقرب إلى دين أو عقيدة. بيد أنّ اللبنان ذاك صار قديماً. صار بائداً. لكثيرين بيننا صار ماضياً ذهبيّاً أرقى وأحسن ممّا أتى بعده. زياد الرحباني ظلّ هناك. عدوّه بات طاحونة هواء.
في مراجعة سريعة لعوالمه كما نقلتها أعماله يتّضح ذلك:
في “بالنسبة لبكرا شو؟” (1978) لبنان هو البار الذي تديره الزوجة ثريّا المشرعة على الاحتمالات كلّها. هناك البلجيكيّ والإنكليزيّ الطامعان، كسواهما، بها. هناك مسيو أنطوان النصّاب والطامع بكلّ شيء.
بعد عامين، في “فيلم أميركيّ طويل”، لبنان مستشفى للمجانين. الطوائف وحروبها أبرز أسباب جنونهم.

نشأ عهد الياس سركيس ومعه شُرّع وجود “الردع العربيّ” الذي صار سوريّاً فحسب. مسرحيّة “شي فاشل” قُدّمت في 1983، وكانت قد انهزمت “المارونيّة السياسيّة” بمقتل بشير الجميّل، فيما إسرائيل تحتلّ أجزاء مُعتبرة من لبنان. لكنّ المسرحيّة اهتمّت بسرقة “الجَرّة” في قرية “جبال المجد”. تزاحمت فيها لهجات الأرمن والدروز وسواهم من الجماعات مُعزّزةً انقسامهم. وفي استئناف لموضوعة متكرّرة عند زياد الرحباني، هي شعبويّة السخريّة من التحدّث بالأجنبيّة، تطلّ المتفرنجة المسيحيّة التي تعمل في “أوريون لوجور” فتخلط العربيّة بالفرنسيّة بالبلاهة. طبعاً هناك في المسرحيّة الفنّان الذي “يحبّ لبنان” ويحيي حفلات للمهاجرين، وهناك السخرية من الصبيّة “المندورة لبلدها” ومن “العناقيد والمواعيد” و”الجبال الما بتنطال”، وجرن الكبّة وسواها. أمّا “الغريب” العدوّ لهؤلاء اللبنانيّين، فهو “اللي بيوصّل مَرْتَك [و] بيقرط الجرّة”. هذه اللوحة بسائر تفاصيلها كانت تثبيتاً للهجرة والتكفير: هجرة من الواقع المستجدّ وتكفير لكلّ واقع.
المنعطف النوعيّ كان في 1993، مع “بخصوص الكرامة والشعب العنيد”. التطوّر الأبرز آنذاك، بعد اتّفاق الطائف وسلامه، كان صعود رفيق الحريري وحزب الله. الأخير لم يسترع انتباهه بتاتاً، أمّا الأوّل الذي كرهه فأعاد تدويره وتدوير نقده مارونيّاً: “الكرامة والشعب العنيد” ليسا من العمارة الإيديولوجيّة للحريري. إنّهما من عمارة “المارونيّة السياسيّة”. صحيح أنّنا نرى “مصاري” والهواتف المحمولة بكثرة أو الآلة التقنيّة المعقّدة المستخدمة لتنقية العدس!، لكنّ هذا لا يصلنا كتعبير عن صعود ثقافة المال في عالم العولمة وما بعد الانهيار السوفياتيّ، بما فيه لبنان الخارج من الحرب ومن الندرة. إنّه يصلنا كمشهد آخر من مشاهد السخافة والشره المتأصّلين في لبنانيّين يعيشون على العقاقير والمخدّرات.
لقد مهّد زياد الرحباني لمسرحيّته هذه بعبارة تقول إنّ أحداثها تحصل بعد انسحاب الجيوش الأجنبيّة جميعها من لبنان، “ما بين 1998 و2003 أو ربّما 2004 أو حتّى 2005”. بهذا نقلنا من تجاهل الحدث إلى نفي الحدث: فالاحتلالات وانسحاب جيوشها لا تؤثّر بتاتاً في الفوضى اللبنانيّة التي يؤسّسها ويعيد تأسيسها شعب ثرثريّ وزعبرجيّ ومجرم وطائفيّ حتّى العظم. ومع شعب كهذا، غاطس في تفاهته، وليس أصلاً بشعب، لا تنفع دولة ولا أحزاب ولا خطابات سياسيّة كائنةً ما كانت. إنّ الشعب هو التافه، بينما الدولة، ممثّلةً بالضابط زياد الرحباني، ممنوعة من أن تمارس القمع. هكذا لا يبقى أمامنا سوى الغرق في همجيّتنا وظهور القرود والدببة بيننا وسط صراع مُرّ على البقاء.
لقد حصدت “بخصوص الكرامة…” فشلاً أعلن انتهاء صلاحيّة الزياد رحبانيّة. لم يعد يمثّل شيئاً جدّيّاً. المسيحيّون الذين رفضوه في السبعينات والستينات لأنّه “ضدّهم”، صالحوه في التسعينات لأنّه لم يعد ضدّاً مُعتبَراً لأحد.
أمرٌ آخر فعل فعله: لقد جمع زياد الرحباني بين موهبة عليا وثقافة دنيا. الموهبة قضمت الثقافة. وفّرت من الأتباع والمقلّدين ما يلغي الحاجة إلى اطّلاع أوثق وأدقّ. صار الفنّان صاحب مأثورات، وأصحابُ المأثورات التي تُحفظ بالعشرات هم مَن يُفتَرض أنّهم “أتمّوا العلم” وما عادوا بحاجة إلى مزيد منه. لكنّ التثبّت على الموهبة العذراء كرّس الفهم الأعذر. كرّس صدّ النفس عن الخارج والاكتفاء الذاتيّ الذي يفيض على المعجبين. هكذا لا يبقى من الخارج، الذي ترفض العين أن تراه، إلاّ كلمات عارية تتراجع قدرتها على الإضحاك.
استطراداً، يقود صدّ الخارج وتحوّلاته إلى تآكل في الداخل. إلى فقر للداخل. إلى هلوسة أحياناً.
لكنّ أخطر ما ينتجه التبسيط الرحبانيّ، في جيليه، أنّه يلغي المبادرة الإنسانيّة في ما يلغيه. عند الأهل، كان سوء الفهم البسيط بين أخيارٍ لبنانيّين لا يستدعي أكثر من “شاويش”. فؤاد شهاب، مصحوباً بمكتبه الثاني، كان الشاويش الأعلى. استمرّ الأمر هكذا حتّى أواخر الستينات وصعود المقاومة الفلسطينيّة. مع النجل، صارت الأمور أخطر وضرورات القمع أعلى: الشرّ الجوهريّ المتأصّل فينا يستدعي هراوة بشّار الأسد أو حسن نصر الله. يستدعي هراوة ستالين. يستدعي الأمن وضبّاطه الأقوياء وسجونهم وزنازينهم.
ذاك أنّنا نحن، العطالة الكاملة، لا نقدّم ولا نؤخّر.
لقد آن للبطل أن يستقيل. زاد إحراجه حتّى لمريديه. فأن يقضي واحدُنا عمره وهو يناكف ماضياً مات فهذه مشكلة. لكنّ المشكلة الأكبر هي أن يشيب وهو يناكف أهله.