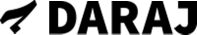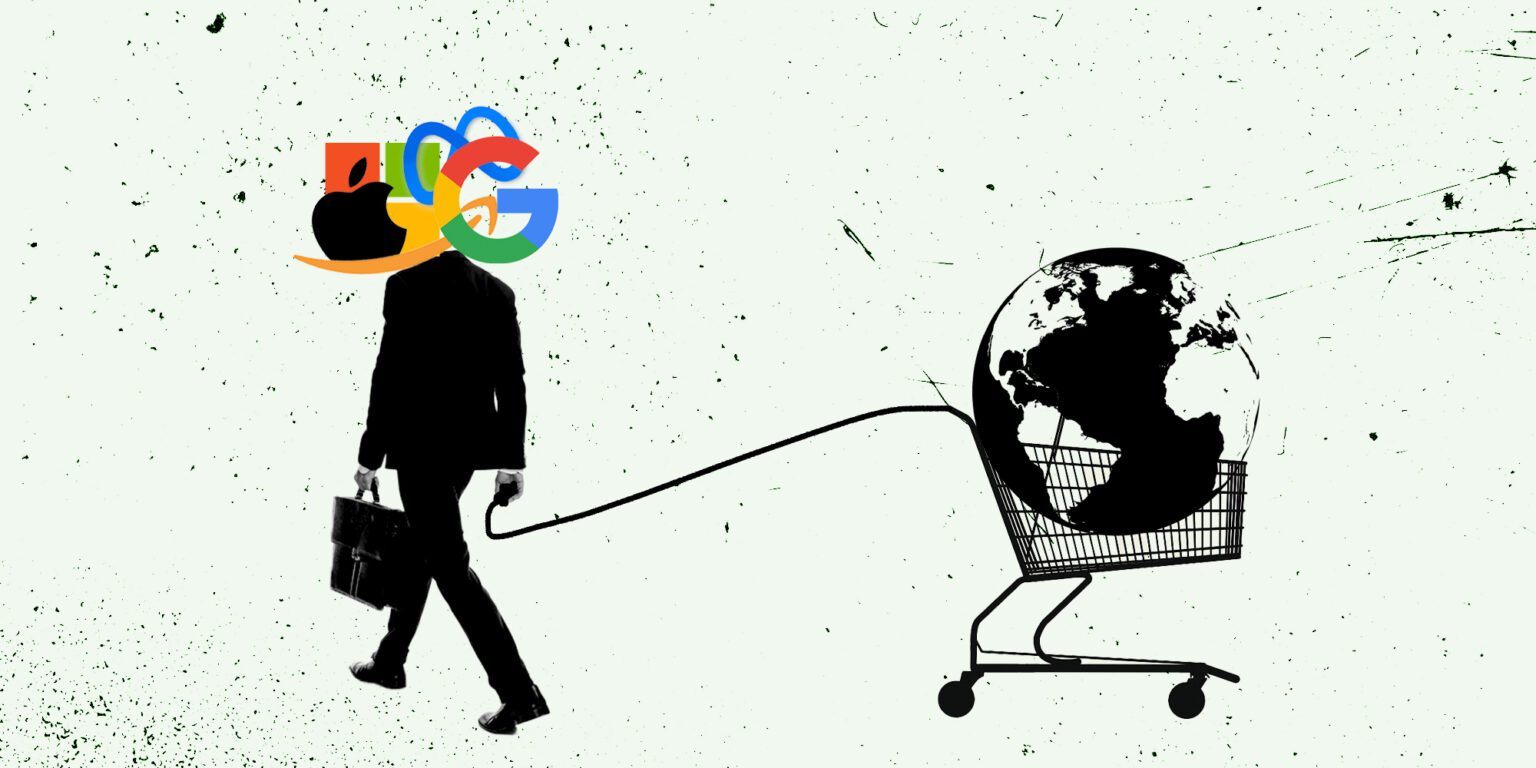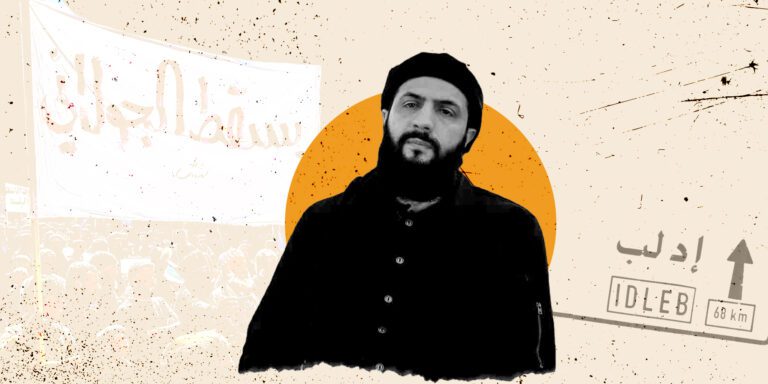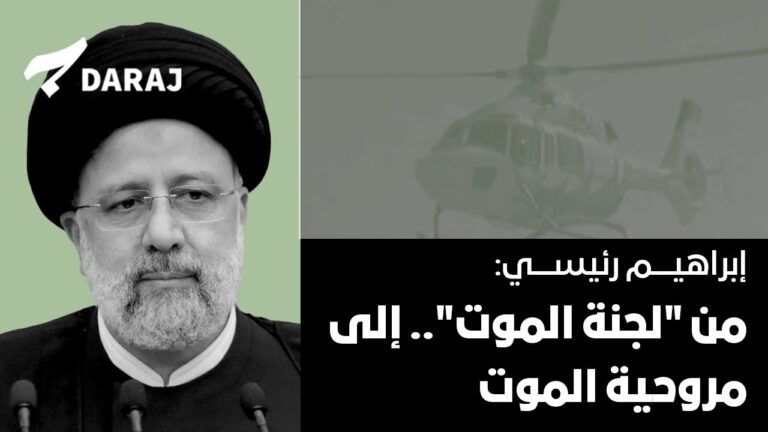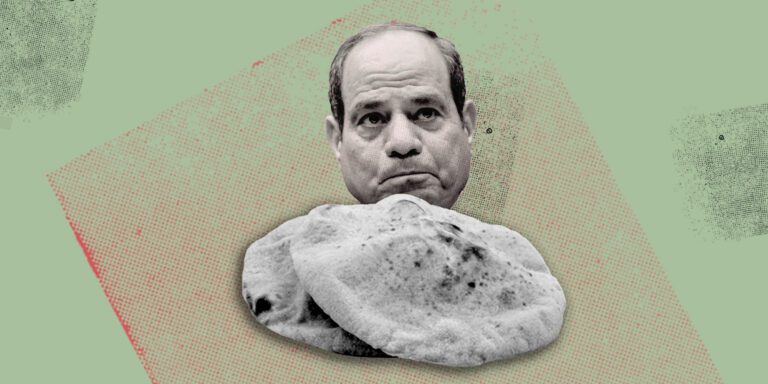“غالباً ما أسأل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيُحدثون التأثير الأكبر في القرن الواحد والعشرين، أيهما أقوى، غوغل أم بريطانيا؟ وعلى نحوٍ متزايد، معظمهم يجيب: غوغل”. هذا ما قاله الكاتب البريطاني وسفير المملكة المتحدة السابق في لبنان توم فليتشر في كتابه “الدبلوماسي العاري: فهم القوة والسياسات في العصر الرقمي” الصادر عام 2016، في إشارة لحجم القوة والتأثير الذي صارت تتمتع به الشركات التقنية الكبرى متعددة الجنسيات مقارنةً بالحكومات وصانعي السياسات التقليديين.
خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كان النفوذ العالمي موزعاً بين قوتين عظميين رئيسيتين، الولايات المتحدة الأميركية في الغرب والاتحاد السوفياتي في الشرق. إلا أن انهيار الاتحاد السوفياتي أدى إلى تفكيك هذا النظام العالمي ذي المعسكرين وبزغ عالم القطب الواحد، الذي لم يستمر طويلاً على أية حال. ففي أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي، بدأ لاعبون رئيسيون مثل الصين والهند في الصعود.
وفي نهاية التسعينات وبداية الألفية، تم دمج الصين في النظام العالمي المتأمرك على افتراض أنها ستصبح غربية بشكلٍ متزايد مع استمرار اقتصادها والاستثمارات الغربية فيها بالنمو، لكنها تحولت إلى قوة عظمى حقيقية في حد ذاتها، ما أدى إلى إعادة توزيع القوة الناعمة والصلبة في جميع أنحاء العالم، وإن كانت للولايات المتحدة حصة الأسد حتى الآن.
نوع ناشئ من القوى العظمى
عند ذكر مصطلح “القوى العظمى”، تتبادر إلى الذهن صورة الدول الكبرى التي ترسم مسار التاريخ العالمي. ولكن في العصر الرقمي، يجمع الخبراء على أن الوقت حان لتوسيع هذا التعريف ليشمل القوى التكنولوجية العظمى التي تعد بممارسة القدر نفسه من التأثير على مدار العشرين عاماً القادمة مثل أي دولة ذات قومية محددة، ويحدد بات جيلسينجر، المدير التنفيذي لشركة إنتل لصناعة المعالجات والشرائح الفائقة، أربع تقنيات ستشكّل القوى العظمى المتسقبلية؛ تكنولوجيا الهاتف المحمول، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
ويعتبر جيلسينجر أن تكنولوجيا الهاتف المحمول توفر وصولاً غير مسبوق، إذ تربط الأشخاص أثناء التنقل بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. بينما توفر السحابة سعة تخزينية على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل، ما يمكّن المؤسسات من إضافة أو إزالة مكونات مختلفة إلى بنيتها التحتية بسرعة وحسب الحاجة.
ويمكّننا الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق من استخراج كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي واستخدام تلك البيانات لتسريع الاكتشاف الأكاديمي وإنشاء نماذج أعمال جديدة تماماً. ويربط إنترنت الأشياء بين العالمين المادي والرقمي، ما يدخل التكنولوجيا في كل أبعاد التقدم البشري. ومع نضوج هذه الابتكارات بسرعة واعتمادها على بعضها البعض، فإنها تعيد تشكيل كل جانب من جوانب المجتمع، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى النقل والتعاملات المالية.
من ناحية أخرى، تبلغ القيمة السوقية المجتمعة للشركات التقنية الأميركية الخمس الكبرى، مايكروسوفت وآبل وأمازون وغوغل وميتا، المتحكّمة بتطوير تلك التقنيات ونشرها عالمياً، 10.562 تريليون دولار، أي نحو 10 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي كاملاً الذي يبلغ 101 تريليون دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
لكن السؤال الأساسي يبقى، هل نجاح شركات التكنولوجيا الكبرى مفيد لنا؟ وهل تلك القوى العظمى الخمس كبيرة ومهيمنة لأنها تصنع أشياء جيدة، أم أن حجمها وقوتها يضمنان فعلياً المزيد من الهيمنة؟ نحن نعلم أن الأشخاص والمؤسسات والشركات بحاجة ماسة إلى منتجات تلك الشركات الخمس وتكاد تكون غير قادرة على الاستغناء عنها. وفي الوقت نفسه، تميل تلك الشركات إلى القول إنها قد تموت في أي لحظة. وتاريخ التكنولوجيا يدعم تلك الفرضية، فالأمثلة لا تنتهي، من كوداك إلى بلوكباستر، إذ لا تميل الشركات التقنية المهيمنة إلى البقاء على هذا النحو لفترة طويلة جداً.
لكن هذه الحفنة من شركات التكنولوجيا أصبحت منخرطة في حياتنا واقتصاداتنا وشؤوننا العالمية وعقولنا، الى درجة أنها سيطرت عليها لسنوات. إذ يبلغ عمر كل من مايكروسوفت وآبل أكثر من 45 عاماً. بينما بدأت شركتا غوغل وأمازون منذ نحو ربع قرن. وإن كانت تلك الشركات مرّت بأوقات عصيبة في فترات معينة، لكنها كانت غالباً غنية وناجحة لأجزاء كبيرة من تاريخها. وتعد شركة ميتا هي الأصغر سناً والأكثر ضعفاً وتخبطاً بين هذه المجموعة في الوقت الحالي، لكنها أعادت اختراع نفسها لمدة تزيد عن عقدين من الزمن، وتغلبت – حتى الآن – على معظم العقبات والشكوك التي واجهتها.
رقابة الشركات المُرسمَلة
تعتبر التكنولوجيا دائماً دافعاً أساسياً في التغيير الجيوستراتيجي. فمن القارب الشراعي، والبارود، والمحرك البخاري، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطاقة النووية، وحتى الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، أحدثت هذه الابتكارات وغيرها ثورة في عصرها وغيرت حظوظ الأمم. ولا تختلف الحال اليوم كثيراً، إذ إن ما يسمى “الثورة الصناعية الرابعة” تعمل على تشكيل وإعادة تشكيل معالم النظام العالمي الناشئ.
لكن الشركات التي تقع في قلب هذه الثورة تتحول بسرعة إلى أصحاب مصلحة جيوسياسيين أقوياء، وكثيراً ما يتحدون سلطة الحكومات وسيادتها وقدراتها، مثلما فعلت شركة “أوبن إي آي”، المطورة أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، عندما هددت بالانسحاب من أوروبا بسبب التشريعات، وكما فعلت ميتا عندما حجبت المحتوى الإخباري في كندا عن منصاتها بعدما طالبتها الحكومة بمشاركة الأرباح مع الحسابات والمواقع المولّدة لهذا النوع من المحتوى.
فصار هناك عدد متزايد من شركات التكنولوجيا التي تتمتع بمصالح ونفوذ عالمي. في عام 2023، تجاوز الإنفاق العالمي على التكنولوجيا الـ4.6 تريليون دولار، ما جعل قطاع التكنولوجيا “ثالث أكبر قوة اقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ولم يسبقه إلا الولايات المتحدة والصين”.
وفي عام 2023 وحده، حققت شركة أبل 383 مليار دولار من الإيرادات؛ وكسبت أمازون 575 مليار دولار، وحصلت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، على 307 مليارات دولار؛ كسبت مايكروسوفت 211 مليار دولار. وحصلت “فيسبوك” على 134 مليار دولار. وتشكل هذه الشركات الخمس وحدها أكثر من 1.6 تريليون دولار من الإيرادات السنوية، وهو ما يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول ذات اقتصادات ضخمة مثل روسيا وأستراليا وكوريا الجنوبية لعام 2023، لكن هذا يعني أكثر من المال، بل يتعلق الأمر بالتأثير الذي تفرضه هذه الموارد.
ربما لا توجد صناعة أكثر عولمة من صناعة التكنولوجيا. على سبيل المثال، تتنافس جميع الشركات المذكورة أعلاه في كل الأسواق الرئيسية حول العالم، وتجري الأبحاث والتصميم في بلدان متعددة، وتوظف مجموعة من المواهب المستمدة والمنتشرة عالمياً لتطوير منتجاتها وخدماتها وبنائها.
وهذا يُترجم إذاً إلى حضور عالمي متوسع وقوائم متزايدة من مصالح الشركات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأحداث الجيوسياسية وتتأثر بها؛ ما يجعل أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تتحكم بمستوى من الثروة والنفوذ والحضور الدولي والمصالح العابرة للحدود الوطنية، التي لم تكن تتمتع بها سابقاً إلا الدول. لكن هذه الشركات ليست مجرد لاعبين في لعبة السياسة العالمية، فهي في كثير من الأحيان الساحة نفسها.
وبحسب ورقة بحثية نُشرت في دورية “ناشونال أفيرز” بعنوان “القوى العظمى الجديدة: كيف ولماذا تعمل صناعة التكنولوجيا على تشكيل النظام الدولي”، هناك اتجاهان آخران لهما أهمية خاصة في دفع هذا التغيير الذي جعل تلك الشركات قوة رديفة للحكومات بدلاً من مجرد “دوافع للتغيير”، بعيداً عن الأرقام.
الاتجاه الأول الذي يدفع صعود شركات التكنولوجيا في الجغرافيا السياسية هو الحضور المتزايد ودور وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية. في حين أن الدعاية وما يسمى بـ “التدابير النشطة” كانت ولفترة طويلة سمة من سمات المشاركة الجيوسياسية، فإن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 – وفي عدد من الانتخابات الأجنبية الأخرى منذ ذلك الحين – وفضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، ودور “فيسبوك” في التحريض ضد مسلمي بورما، وتسخير جهاز الدعاية الإسرائيلي “هاسبارا” جهوده لنشر السردية الإسرائيلية على وسائل التواصل، ومناوشات الإدارات الأميركية مع هواوي وتيك توك.
ما سبق حوادث تسلط الضوء على حقيقة أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة مجتمعةً مع وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أداة لا مثيل لها للمناقشة والعمل السياسي المشروع، لكن بات من الصعب درء هذه الأدوات عن الجهات الفاعلة السيئة والمجموعات الخارجة عن القانون.
والأكثر من ذلك، إن عبء منع هذا التدخل وتحديده ومواجهته يقع إلى حد كبير على عاتق الشركات نفسها. إذ قد يعاقب القادة السياسيون الشركات لعدم منعها المعلومات المضللة أو المواد التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، وقد تتوسل الحكومات لتلك الشركات أو تفرض عليها الحظر والعقوبات، لكنها لا تستطيع أن تفعل الكثير بمفردها لوقف ممارساتها.
أما الاتجاه الثاني هو أن شركات التكنولوجيا هي مركز الثقل في تطوير قدرات الأمن القومي ومنهجياته المهمة. فقد سعت الحكومات دائمًاً إلى مراقبة السلوك البشري والأحداث وفهمها والتنبؤ بها وتشكيلها. هذه جوانب أساسية لما يسمى تاريخياً بـ “الاستخبارات”. لكن شركات التكنولوجيا تطلق على المعلومات تسميات مثل “أبحاث السوق”، أو “تطوير المنتجات”، أو “فهم سلوك المستخدم”.
وبغض النظر عن التعبير المُلطَّف المستخدم، فإن الحقيقة الواضحة هي أن الدولة فقدت احتكارها الاستخبارات، وأن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تعرف عن الأفراد والمجتمعات أكثر من أي وكالة تجسس حكومية. ولهذا السبب، يُستخدم المصطلح المختصر “رأسمالية المراقبة” أحياناً لوصف نموذج أعمال عمالقة التكنولوجيا في العالم، ويكون مصطلح “المراقبة” مناسباً عند النظر في قدرة تلك الشركات على جمع البيانات وفهمها.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 7 مليارات شخص (أي نحو 87 بالمئة من سكان العالم) لديهم أجهزة محمولة، وأن معظم هذه الأجهزة عبارة عن هواتف ذكية. ومع زيادة عدد المستخدمين المتصلين بالإنترنت، تزداد بياناتهم أيضاً، وبدورها توفر تلك البيانات رؤى أوسع وأكثر دقة لمالكيها.
وكما لاحظت مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (Electronic Frontiers) للحقوق الرقمية في تقريرها الصادر عام 2019 بعنوان “خلف المرآة ذات الاتجاه الواحد: الغوص عميقاً في تكنولوجيا رقابة الشركات”، فإن “كل هاتف ذكي عبارة عن جهاز تعقب عبر الأقمار الصناعية بحجم الجيب، يبث موقعه باستمرار إلى جهات غير معروفة جميعها عبر الإنترنت. تحمل الأجهزة المتصلة بالإنترنت المزودة بكاميرات وميكروفونات، خطراً متأصلاً في التحول إلى أجهزة تنصت صامتة.
الأكثر انتهاكاً لخصوصيتنا هو الثبات والتراكم المستمر لجمع البيانات البسيطة والدقيقة نسبياً حول الطريقة التي نعيش بها حياتنا، بما في ذلك أشياء مثل سجل التصفح واستخدام التطبيقات والمشتريات وبيانات الموقع الجغرافي. يقوم المتتبعون بتجميع بيانات حول النقرات والانطباعات والحركة في ملفات تعريف سلوكية مترامية الأطراف، والتي قد تكشف عن الانتماء السياسي والمعتقد الديني والهوية والنشاط الجنسي والعرق ومستوى التعليم والفئة الاقتصادية وعادات الشراء والصحة البدنية والعقلية”.
وفي حين أن جميع مراقبي البيانات تقريباً لا يشاركون المؤسسة إنذارها، إلا أنه لا يمكن إنكاره. فجمع البيانات الرقمية يمنح هذه الشركات نظرة لا مثيل لها على السلوك البشري، والتي بدورها تمنحها قدرات لا مثيل لها للتنبؤ بهذا السلوك، بل وتشكيله. على سبيل المثال، قدم كل من غوغل وفيسبوك براءات اختراع تستخدم بيانات سجل الموقع الجغرافي والسلوكيات خارج الإنترنت للتنبؤ بدقة بمكان وجود المستخدمين مستقبلاً، وحتى بعد سنوات، بهدف تمكين الشركات من تقديم الإعلانات ذات الصلة بالسياق بشكل استباقي.
الأمن القومي كـ “صناعة”
مجرد الحصول على البيانات ليس له قيمة. إذ إن امتلاك القدرة على تحليل تلك البيانات وتسخيرها لأغراض تجارية أمر جوهري لتحقيق قيمتها، والشركات التقنية الخاصة هي التي تقود تطوير الأدوات والمنهجيات التحليلية – حتى الآن على الأقل – لتحقيق هذه القيمة. ولعل الأهم من ذلك، هو استخدام الذكاء الاصطناعي.
يمكن فهم الذكاء الاصطناعي على أنه استخدام الآلات لإنجاز المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل اتخاذ القرار، والتعرف على الأنماط، وترجمة اللغة، وتوليد النصوص والصور حديثاً، وإن كانت برامج الذكاء الاصطناعي “التوليدي” تقوم راهناً على إعادة التدوير والإنتاج أكثر من التوليد الأصلي.
ففي عام 2012 تقريباً، حقق تخصص الذكاء الاصطناعي الفرعي، التعلم الآلي، قفزة كبيرة إلى الأمام عندما دُمجت علوم الكمبيوتر والأجهزة الفائقة وكميات هائلة من البيانات الرقمية معًا لتمكين نوع جديد من البرمجة يقلل بشكل كبير من عبء تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى نهضة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمس حياة البشر بما يتجاوز هواتفهم الذكية.
التكنولوجيا السابقة صارت تستخدمها المستشفيات لتشخيص الأمراض والتنبؤ بمعدلات وفيات المرضى الداخليين، وتستخدمها شركات التأمين والرهن العقاري لتقييم المخاطر، وتستخدمها حتى جهات إنفاذ القانون في صيغ الأحكام لدى بعض الدول، من بين مئات الاستخدامات الأخرى. إن إمكانات تطبيق الذكاء الاصطناعي بعيدة المدى، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن القومي.
وإن كان من المبالغة القول إن جميع الحكومات تتخلّف عن القطاع الخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي، فإنه من الواقعي القول أن حتى الحكومات الأكثر تقدماً في المجال التكنولوجي ــ مثل حكومتي الولايات المتحدة والصين ــ تعاني من البطء المتأصل في البيروقراطية والافتقار الحاد إلى الكفاءة الفنية. إذ بإمكان الحكومات أن تقيم شراكات مع شركاء أكاديميين وتجاريين لإجراء البحوث ودعمها، ولكن يبدو أنها لا تستطيع جذب المواهب البشرية اللازمة لتنفيذ هذا البحث والاستفادة منه بالحجم أو السرعة اللازمة لمواكبة متطلبات الأمن القومي.
وينطبق هذا بالقدر نفسه على التقنيات الأخرى غير الذكاء الاصطناعي. والحقيقة التي لا مفر منها، هي أن الفجوات المتزايدة في البيانات والقدرات بين القطاع الخاص والحكومات تجعل قادة الأمن القومي يعتمدون بشكل متزايد على شركات التكنولوجيا للقيام بمهام الأمن القومي الأساسية.
بسبب ما سبق، قال الرئيس الأسبق لهيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جو دانفورد، “إن قدرة الأمة على تأمين نفسها تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص بطريقة جديدة ومستدامة”. ويتقاسم الزعماء السياسيون في مختلف أنحاء العالم هذا الشعور نفسه، وهذا ما تفسره الشراكات الحكومية مع عمالقة التقنيات لتنفيذ مهام بحساسية بناء مراكز البيانات وتطوير جدران الحماية السيبرانية.
كيف سيكون شكل النظام الرقمي العالمي؟
ساعدت أسلحة الناتو واستخباراته وتدريبه الأوكرانيين في الدفاع عن أراضيهم ضد الغزو الروسي. ولكن لو لم تهب شركات التكنولوجيا الغربية للإنقاذ في الأيام الأولى من الغزو، لصد الهجمات السيبرانية الروسية والسماح للقادة الأوكرانيين بالتواصل مع جنودهم على الخطوط الأمامية، لكانت روسيا قد عطّلت المنظومة الأوكرانية تماماً عن العمل في غضون أسابيع فعليا. أي أن الحرب التي غيرت الكثير من معالم حاضرنا كانت ربما ستُفضي إلى مآلٍ آخر لولا شركات التكنولوجيا ونفوذها في النظام الرقمي العالمي الجديد.
كما تقرر شركات التكنولوجيا وجود السياسيين – وإن كان أحدهم رئيس الولايات المتحدة – الرقمي وما إذا كان بإمكانهم التحدّث من دون فلاتر إلى جمهورهم. ومن دون وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على التأثير، سلباً وإيجاباً، لن يكون هناك تمرد في 6 كانون الثاني/ يناير في الكابيتول هيل، ولا أعمال شغب لسائقي الشاحنات في أوتاوا، ولا ثورة 8 كانون الثاني في البرازيل ولا تظاهرات مليونية حول العالم دعماً لفلسطين وتنديداً بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
ولكن كيف ستستخدم شركات التكنولوجيا قوتها المُكتشفة حديثًا؟ هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة يضعها الباحث السياسي ورئيس مجموعة “يوريجا” لدراسة السياسات إيان بريمر، إذا استمر الساسة الأميركيون والصينيون في محاولات بسط سطوتهم على الفضاء الرقمي، وإذا اصطفت شركات التكنولوجيا مع حكوماتها المحلية – وهو ما تفعله حتى الآن – فسينتهي بنا الأمر إلى حرب باردة تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وسينقسم العالم الرقمي إلى قسمين، وستضطر البلدان الأخرى إلى اختيار أحد الجانبين، وستتفتت العولمة عندما تصبح هذه التكنولوجيات الاستراتيجية المنفصلة هي القمة المهيمنة للأمن القومي والاقتصاد العالمي.
أما إذا التزمت شركات التكنولوجيا باستراتيجيات النمو العالمي، ورفضت التوافق مع الحكومات وحافظت على الفجوة القائمة بين مجالات المنافسة المادية والرقمية، فسنرى عولمة جديدة يولد عنها نظام رقمي معولم. ستظل شركات التكنولوجيا صاحبة سيادة في الفضاء الرقمي، وتتنافس إلى حد كبير مع بعضها البعض من أجل الأرباح، ومع الحكومات على السلطة الجيوسياسية.
ولكن إذا أصبح الفضاء الرقمي ذاته الساحة الأكثر أهمية لمنافسة القوى العظمى، مع استمرار قوة الحكومات في التآكل مقارنة بقوة شركات التكنولوجيا، فإن النظام الرقمي نفسه سيصبح النظام العالمي المهيمن. إذا حدث ذلك، فسنصبح في عالمٍ “ما بعد ويستفالي“، حيث لن تتمتع كل دولة بالسيادة الحصرية على أراضيها، وستهيمن على النظام التكنولوجي القطبي شركات التكنولوجيا باعتبارها اللاعبين الرئيسيين في الجغرافيا السياسية في القرن الحادي والعشرين.
هذه السيناريوهات الثلاثة معقولة تماماً. ولا شيء منها حتمي في ظل تسارع التغيرات والحسابات العالمية. لكن سيعتمد أي من الاحتمالات على الكيفية التي تقود بها التحوّلات التقنية واتساع تأثيرها والحاجة البشرية لها التغييرات في هياكل السلطة الحالية، وما إذا كانت الحكومات قادرة وراغبة في تنظيم شركات التكنولوجيا، والأهم من ذلك، كيف يقرر قادة التكنولوجيا أنهم يريدون استخدام القوة التي وُهبت إليهم تدريجياً ولم تُستخدم كاملةً بعد.