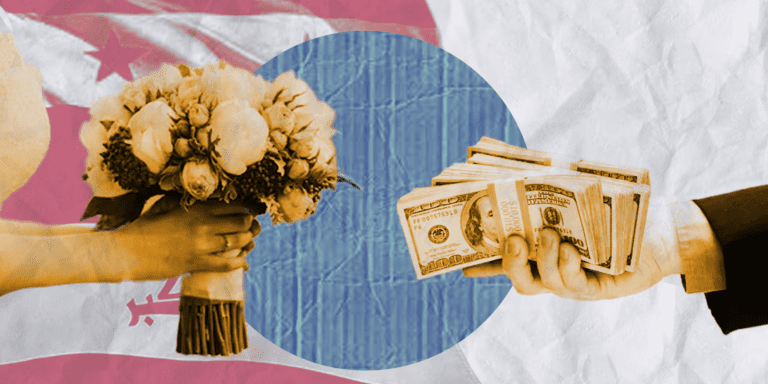“حين ترسلوننا إلى الحرب، فأنتم لا ترسلوننا إلى التفاوض، بل ترسلوننا إلى القتل…نحن نولد بفكرة أنه ينبغي ألا نقتل، والآن تقولون لي إذهب إلى الحرب واقتل جميع الأعداء، ومع الوقت تصبح فكرة أن لدي الحق في القتل طبيعية، ولا نعود نسأل لماذا؟ الأسئلة الوحيدة التي نسألها حين نذهب للحرب هي كيف نقتل؟”.
كان هذا جزءاً من جواب عامي أيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن العام في إسرائيل “شين بيت” (Shin Bet) في مقابلة مع قناة CNN مؤخراً، حيث سألته المقدمة المعروفة كريستيان أمانبور عن ارتكابات الجيش الإسرائيلي في غزة: “هل تشعر بأنهم (الجنود) يفقدون أخلاقيتهم وإنسانيتهم؟”، ليجيبها: “نحن نفقد هويتنا كأشخاص، كيهود وكبشر”…
النقاش أتى بعد انتشار مقاطع فيديو، يظهر فيها شاب جريح من سكان مدينة جنين في الضفة الغربية، مقيداً على غطاء مركبة عسكرية إسرائيلية تسير به، فيما فسّرته جهات فلسطينية، بأنه استخدام إسرائيلي للشاب المصاب كدرع بشري خلال اقتحام المدينة.
هذا الانتهاك ليس حادثاً فردياً، بل يتكرر من دون مساءلة، فخلال الأشهر الثمانية الماضية، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، امتلأ الفضاء الإلكتروني بفيديوهات توثق انتهاكات الجيش الإسرائيلي، مثل تعذيب المعتقلين وقتل المدنيين واقتحام المنازل وتدميرها.
كثير من هذه الصور والفيديوهات، نشرها الجنود الإسرائيليون أنفسهم، كنوع من التباهي، مما يمثل ظاهرة أخلاقية مقيتة، هناك أيضاً شهادات من جنود انشقوا أو رفضوا الخدمة العسكرية، تثبت الجرائم، وتُعد هذه المقاطع وثائق قانونية، يمكن استخدامها في المحاكم الدولية ضد إسرائيل، لانتهاكها القانون الدولي الجنائي.
هذا التوثيق لا يؤكد انهيار الحواجز والضوابط الأخلاقية والإنسانية، لدى أفراد “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم” فحسب، بل يدل على أن أولئك الجنود يشعرون بأنهم قادرون على فعل أي شيء، طالما أنهم يحظون بالحماية من قبل دولتهم، ومن قبل العواصم الكبرى، التي تدعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً في حربها، إسرائيل نفسها لا تنفك تنتقد وتهاجم، بل تعرقل سفر مسؤولين في هيئات حقوقية دولية، أو في الأمم المتحدة بشكل علني ومستمر، بسبب مواقفهم من ارتكابات الجيش الإسرائيلي.
الأمر وصل بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى إلغاء تأشيرة الإقامة لمنسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية لين هاستينغز، وبسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالتلويح بانسحاب إسرائيل من الأمم المتحدة، ومنع إعطاء التأشيرات لمسؤوليها “لتلقينهم درساً”، بل حتى أنه اتهم الأمم المتحدة بمعاداة السامية، ودعا إلى وقف تمويلها!
المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز تعرضت للتهديد، بسبب اتهامها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية، كما تجرّأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصياً، على الاستخفاف بالأمم المتحدة، معتبراً أنها “وضعت نفسها على اللائحة السوداء للتاريخ”، واللائحة تطول وتطول..

حكاية “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”
من بين المزاعم التي يتم تداولها في الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية، هو الادّعاء بأن الجيش الإسرائيلي هو “أكثر جيش أخلاقي في العالم”، هذا الوصف، الذي يُروَّج له بشكلٍ مكثّف من قبل القيادات الإسرائيلية والداعمين لهم على الساحة الدولية، من سياسيين وإعلاميين وضباط وجنرالات متقاعدين، يهدف إلى تقديم صورةٍ مثالية عن أداء الجيش الإسرائيلي في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر، خصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بقوانين الحرب وحماية حقوق الإنسان، ويستمر التمسك بهذه المقولة الفارغة، في ظل تراكم الأدلّة التي تشير إلى حصول إبادة جماعية في قطاع غزة، وانتهاكات جسيمة في القطاع والضفة الغربية على حدّ سواء، لقوانين الحرب تلك.
ولعل ظاهرة تصوير الجنود الإسرائيليين أنفسهم، وهم يرتبكون أعمالاً تصنّف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، هي من أبرز ما أفرزته الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي ظاهرة مستمرة من دون رادع.
لكن ما الذي يقود عدداً متزايداً من الجنود الإسرائيليين، إلى ارتكاب مثل هذه الفظاعات وتوثيقها بأنفسهم؟
وأية استراتيجيات تتبعها إسرائيل لتشكيل الذات الإنسانية الإسرائيلية وصوغها، لتنتج هذا النموذج للجندي الذي يرتكب أعمالاً مروعة؟
البحث عن الإجابة لا بد أن ينطلق من سياسة نزع الأنسنة عن الفلسطينيين، متى ما تم بناء عقل قادر على شيطنة الآخر، يمكن بسهولة استباحة جسده سواء بالقتل المباشر أو بالتعذيب، وممتلكاته سواء بالمصادرة أو الهدم أو التخريب.
فيديوهات عديدة انتشرت في الأشهر الأخيرة، لجنود إسرائيليين يُقدمون على هذا النوع من الممارسات، ووصلت استباحة ممتلكات الفلسطينيين، إلى مصادرة الجنود الإسرائيليين ثيابهم الرجالية والنسائية وحتى الملابس الداخلية، وكأنها مغانم حرب، ونشر الجنود بأنفسهم مقاطع وصوراً تثبت تلك الانتهاكات، على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بحسب أداما دينغ، وهو مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسجل السابق للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا: “الإبادة الجماعية ليست حادثاً عرضياً، ولا هي حتمية، الإبادة الجماعية هي عملية تتطور بمرور الوقت، وبغية التمكن من الانخراط بمستوى العنف المرتبط بالإبادة الجماعية، يحتاج الجناة إلى وقت لتطوير القدرة على القيام بذلك، وتعبئة الموارد واتخاذ خطوات ملموسة، سوف تساعدهم على تحقيق هدفهم”.
استراتيجية صهيونية لتجذير التطرّف والعنصرية
لا يمكن لأي فرد، مهما بلغت الأفكار التي يحملها من بؤس وتطرّف، أن يصير قادراً على ارتكاب أفظع الجرائم والممارسات من تلقاء نفسه، فارتكاب القتل الفردي ليس بالأمر السهل، فكيف إذا كان قتلاً جماعياً؟
وعملية تحوّل الأفكار المتطرّفة، صهيونية كانت أم إسلامية أم غيرها من الأفكار والأيديولوجيات، إلى ممارسات عملية تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا تحصل بشكل تلقائي، بل تتطلّب جهازاً ضخماً لنشر الدعاية والتجنيد والاستقطاب والتمويل والتخطيط والتنفيذ، وإلّا فإنها تبقى محصورة في إطار محدود مهما بلغت الجرائم المرتكبة من بشاعة.
جزء لا يتجزأ من هذه العملية، التي تمهّد لتحويل الأفكار المتطرفة إلى سلاحٍ للقتل الجماعي العشوائي، هو وضع استراتيجية نفسية واجتماعية، تزيل الشعور بالذنب والمسؤولية لدى الفرد المشارك في الإبادة، والإبادة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة من ضمن وسائل متعددة لتحقيق الغاية الكبرى، ومثل هذه الاستراتيجية تلقى نجاحاً لا مثيل له في إسرائيل اليوم.
في التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية، نجحت السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الإعلام، في تجريد أهالي غزة من إنسانيتهم بسرعة، بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، العملية التي نفذتها “حماس” وقتلت خلالها مئات الإسرائيليين، بينهم مدنيون، شكّلت قاعدة للحملة الدعائية الكبيرة ضد الفلسطينيين، وقد ساعد على ذلك، نشر كمٍ كبير من الأكاذيب التي ساهمت في تعبئة الإسرائيليين وتجنيدهم، وظهور تعاطف دولي مع ردة الفعل الإسرائيلية، مهما كانت مفرطة وهستيرية.
أبرز الأكاذيب كانت قطع رؤوس 40 طفلًا في كيبوتس كفار عزة، لدرجة أن الرئيس الأميركي جو بايدن شارك في نشر هذه الكذبة، على أوسع نطاق، قبل أن ينفي البيت الأبيض صحّة كلامه، وقد قام المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية بنفسه بنفي هذه الكذبة، لكن رغم إمكانية نفي هذه الأكاذيب، لا يمكن إلغاء الضرر الناتج عنها.
عملية تحويل الإنسان الإسرائيلي إلى مجرمٍ يشارك في إبادة جماعية، بشكل مباشر كجندي، أو بأشكال غير مباشرة كمبرِّرٍ لها وداعٍ إليها، لا تقتصر على ردود الأفعال العاطفية المباشرة، بل تمرّ بمراحل عديدة للتطبيع مع العنف، بدءاً من العيش في بيئات مغلقة يتطبّع فيها الأفراد بأنماطٍ متشابهة من السلوك الجمعي، وعادةً ما يكون فيها النقد لما يُعتبر من الثوابت الدينية و/أو القومية محرّماً، وصولاً إلى الفصل والتمييز بين أطفال العرب الفلسطينيين واليهود في نظام التعليم.
وتقول زاما نيف، المديرة التنفيذية لقسم حقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”: “هناك هوة شاسعة تفصل بين المدارس العربية واليهودية التي تديرها الحكومة؛ فالتعليم الذي يحصل عليه أطفال العرب الفلسطينيين يقل مستواه، من جميع النواحي تقريباً، عن مستوى التعليم الذي يتلقاه نظراؤهم من الأطفال اليهود، وهو أمر ينعكس في الأداء السيئ نسبياً للتلاميذ العرب”.
وجاء في تقرير أعدته “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “مواطنون من الدرجة الثانية: التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل” الآتي: “ينقسم نظام التعليم المدرسي الذي تديره الحكومة الإسرائيلية إلى شقين منفصلين، أحدهما للأطفال اليهود الإسرائيليين والآخر للأطفال العرب الفلسطينيين، ويتجلى التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في كل جانب من جوانب هذين النظامين”، وفي صلب التقرير حول انقسام النظام التعليمي أتى (الترجمة بشكل مباشر عن التقرير): “منذ يومهم الأول في روضة الأطفال وحتى وصولهم إلى الجامعة، يذهب الأطفال العرب الفلسطينيون واليهود دائماً إلى مدارس منفصلة، ويتم تعليم الأطفال العرب الفلسطينيين باللغة العربية، والأطفال اليهود باللغة العبرية، ومناهج النظامين متشابهة ولكنها ليست متطابقة، على سبيل المثال، يتم تدريس اللغة العبرية كلغة ثانية في المدارس العربية، في حين لا يُطلب من الطلاب اليهود دراسة اللغة العربية.”
من الواضح أن أولى خطوات تثبيت هذه الاستراتيجية النفسية والاجتماعية، الهادفة إلى تحويل الإسرائيلي إلى شخص ينظر بفوقية عنصرية إلى الفلسطيني، إلى درجة أن يمارس بحقه القتل من دون رحمة أو تردّد في مراحل متقدمة، هي تكريس الفصل العنصري في التعليم.
يُجبر الأطفال الفلسطينيون العرب على تعلم اللغتين العربية والعبرية، بينما يتعلم الأطفال اليهود العبرية فقط، ومن المعلوم أن الاندماج الثقافي لا يسير في اتجاه واحد، وعدم تعليم العربية للأطفال اليهود يعني تجريدهم من القدرة على رؤية المشهد بعيون العرب الفلسطينيين، ونقد الأيديولوجيا الصهيونية، وتبادل المشاعر والآراء والتواصل بشكل متساو وخالٍ من النظرة الدونية إلى “الآخر”.
وهذا يؤدي إلى إضعاف تعاطفهم الإنساني وإيجاد أرضية مشتركة ضد عدو مشترك، حيث يظل التناقض بين “فلسطيني” و”إسرائيلي” قائماً، بدل أن يتحول إلى تناقض بين صاحب أرض وآخر يمكن أن يدعمه ضد دولة الاحتلال والفصل العنصري، التي تسلب من الأول حياته وأرضه وكرامته الإنسانية، ومن الثاني إنسانيته وقدرته على نقد الأيديولوجيا الصهيونية العنصرية، التي تقول بأن اليهود يمتلكون سمات خاصة لا تمتلكها الشعوب الأخرى، وفي نهاية المطاف تحولّه إلى مشروع مجرم وقاتل.
بالإضافة إلى النظام التعليمي، فإن جزءاً كبيراً من أطفال اليهود، ومن أعمار مختلفة، يتعرضون لعمليات “غسل الدماغ” عبر وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة والمنشورات والإعلانات اليومية، لكن الأُسَر تلعب الدور الأهم في تماسك المجتمع الإسرائيلي الاستيطاني، وتُشكّل الخلية الأساسية للتجنيد، بخاصة في المجتمعات الضيقة والمحافظة (كما في العديد من المستوطنات المغلقة التي تسيطر فيها الأفكار الدينية والقومية المتطرفة، وغالباً ما يكون المستوطنون فيها أعضاء في أحزاب أقصى اليمين الإسرائيلي، ومدجّجون بالسلاح، ومستعدون لتوسيع نطاق استيطانهم عبر التعديات المستمرّة على الأراضي المحيطة) حيث يتم تعليم أطفال اليهود العداء للعرب الفلسطينيين وتجريدهم من الصفة الإنسانية، وضرورة الالتحاق بالجيش الإسرائيلي “للدفاع عن الوطن” ضدهم.
في حين تبرز فروقات في الآراء واختلافات أيديولوجية، في مناطق تتنوع فيها العلاقات الاجتماعية وأنماط الحياة و”يتعايش” فيها اليهود والعرب بشكل أو بآخر، ويقومون ببناء الصداقات وإنشاء العلاقات الاجتماعية، ولو “على مضض” في الكثير من الأحيان، بحُكم التشارك والتعاون في النشاط الاقتصادي والإنتاج، وفي هذه الحالة تدخل عوامل إضافية وتحتل المعتقدات الشخصية حيزاً ولو متواضعاً في التأثير على آراء الأُسَر اليهودية وأطفالها تجاه العرب الفلسطينيين، والعكس صحيح، وعلى الرغم من استمرار الكراهية العنصرية بأشكال مختلفة، لكنها تتمظهر بحدّة أقل في كثير من المستوطنات المغلقة والمنغلقة على ذاتها.
بمجرّد عدم الانصهار التام للفرد الإسرائيلي في الجماعة الواسعة المستعدة لإطاعة الأوامر العليا والامتثال للثقافة السائدة من دون ممارسة أي نقد، فإنه يحفظ هامشاً من القدرة على التعاطف والتواصل الإنسانيين مع العرب الفلسطينيين، هذا الهامش البسيط من الحريّة في التفكير في بعض المناطق، وبالأخص في المدن والمجمعات الصناعية، يسعى معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف اليوم إلى إلغائه، مستمراً في استغلال أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، هادفاً إلى تحقيق التكامل في عناصر الإبادة الجماعية، حتى ينفلت الوحش الصهيوني من عقاله، وتتجاوز أعمال الإبادة حدود قطاع غزّة.
يُجبَر الإسرائيليون عند بلوغهم 18 عاماً على الالتحاق بالجيش، إذ إن التجنيد إلزامي ويُعتبر ركناً أساسياً في استراتيجية التنشئة والتدريب، فلا يكون الفرد إسرائيلياً بحقّ في نظر الدولة، إذا لم يكن قادراً على استخدام السلاح والامتثال للأوامر، ويشمل التجنيد الإلزامي جميع اليهود، بمن فيهم الحريديم الرافضين للتجنيد لأسباب دينية (صدر مؤخراً قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية قضى بإنهاء إعفائهم من الخدمة العسكرية، وأمر بتجنيد 3 آلاف طالبٍ منهم بشكل فوري) إضافة إلى الدروز والشراكسة، لكن العرب الفلسطينيين يتم استثناؤهم بالكامل، ويُسمح لهم فقط بالتطوّع (معظم المتطوعين العرب من البدو).
يُظَهَّر الاستثناء كامتياز للعرب، لكنه في الحقيقة تجنّبٌ لتضارب الولاءات ولحالات التمرّد.
يخضع المجندون حديثاً إلى تدريبات مكثفة، و”برمجة نفسية”، ليصيروا مستعدين للمشاركة في القتل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخطاب اليميني المتطرف العنيف، من قبل السياسيين الإسرائيليين، بدءاً بكلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي شبّه فيه العرب الفلسطينيين بالعماليق (أعداء بني إسرائيل بحسب العهد القديم) مما يعني وجوب قتلهم وإبادتهم لأنهم يشكّلون خطراً وجودياً على اليهود، مروراً بدعوة قائد تيار “القيادة اليهودية” (أكثر التيارات تشدداً في حزب الليكود اليميني) موشيه فيغلين إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، إضافة إلى الدعوات إلى تهجير جميع سكان القطاع وتحويله إلى مجمع ضخم للمنتجعات السياحية (أوقحها على الإطلاق كانت لدانييلا فايس، الناشطة اليمينية المتطرفة في حركة الاستيطان الصهيونية الأرثوذكسية الإسرائيلية) أو الدعوات لاستخدام السلاح النووي في القطاع وجعله مكاناً “لا يمكن لأحد أن يعيش فيه”، وأبرز تلك الدعوات كانت لوزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي بن إلياهو (وقد تم منعه من حضور اجتماعات الحكومة الإسرائيلية بعد هذا التصريح) إضافة إلى دعوة السيناتور الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام إلى قصف غزة بقنبلة نووية، لإنهاء الحرب على طريقة إنهاء الولايات المتحدة الأميركية للحرب العالمية الثانية، بعد قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية، أو الدعوة بشكل علني وصريح إلى ارتكاب جرائم حرب ضد سكان القطاع وتشديد الحصار التمويني عليه، وكانت أبرز تلك الدعوات لنائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نسيم فاتوري، الذي لم يتردّد في تأكيد دعواته إلى “حرق غزة” و”قتل جميع من لا يغادر شمال غزة”، رغم موجة الاستنكار الكبيرة التي أحدثتها عالمياً.
بالترافق مع كل هذا التحريض، تؤمّن السلطات السياسية والعسكرية والقانونية الحماية للجنود والضباط، وتبرّئهم من المسؤولية مهما ارتكبوا من جرائم فردية وجماعية على أرض “المعركة”، حتى ولو تمادوا إلى درجة تصوير التعديات التي يرتكبونها على أملاك الفلسطينيين بأنفسهم، ونشرها على صفحاتهم الخاصة (أنظر: تقرير “عربي بوست” لمراد القوتلي).
لا يمكن لهذه الانتهاكات أن تصل إلى هذا المستوى من الصفاقة والسفاهة لولا سقوط الحواجز الأخلاقية كلها، بفعل التطبيع الممنهج للجيش الإسرائيلي مع ثقافة العنف تجاه العرب الفلسطينيين.
تقابل هذه الوقائع، صورة زاهية بألوان المساواة الجندرية والحرية الفردية والتفوق الأخلاقي للجنود، تحاول إسرائيل بيعها للغرب، فيما يردّد صحافيون وضباط غربيون بحماسة منقطعة النظير مقولة “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم” (ربما يكون القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان الكولونيل ريتشارد كيمب أكثرهم وقاحة وبلاهة في تكرار البروباغندا الحربية الإسرائيلية) مستندين إلى معلومات مغلوطة تتناقض بشكل كامل مع المعلومات، التي توفّرها المنظمات الحقوقية الدولية، حول ما يرتكبه هذا الجيش من أعمال “يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

المقارنة التي تفرض نفسها: النازية والحركة الصهيونية
تجاوزت إسرائيل تجاهل القوانين الدولية، وأعلنت الحرب صراحة على الأمم المتحدة، بدءاً بعدم الاعتراف بمقرّراتها (وليس فقط الاكتفاء بتجاهل تطبيقها) إلى تهديد موظفيها وإساءة معاملتهم واستهداف مراكزها بالقصف (أنظر: تقرير “وضع الأونروا” رقم 114، بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2024، ويشير التقرير إلى مقتل 193 من عمال الوكالة وموظفيها، وتعرّض 187 من منشآتها إلى التدمير الجزئي أو الكلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023)
تتشابه سلوكيات إسرائيل مع تصرفات النازيين في تجاهل المجتمع الدولي، وتتصرف بنرجسية وتلاعب لتحقيق مصالحها، مما يجعل انسحابها في المستقبل محتملاً، وللمفارقة، فإن أول إجراء متعلق بالسياسة الخارجية لألمانيا اتخذه أدولف هتلر، بعد 9 أشهر من وصول النازيين إلى الحكم، كان الانسحاب من عصبة الأمم بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 1933.
وللمفارقة أيضاً، فإن أول من أسّس مفهوم “الإبادة الجماعية”، هو المحامي البولندي اليهودي رفائيل لمكين، وكان قد بدأ بالكتابة حول الموضوع، انطلاقاً من اهتمامه بتوثيق الإبادة العثمانية للأرمن (عام 1915) والضغط من أجل إصدار قوانين دولية لمحاكمة مرتكبيها، ثم الإبادة العِراقية بحق الأقلية الآشورية في شمال العِراق (مجازر سميل عام 1933) قبل حصول الإبادة النازية لليهود بسنوات (1941).
قام النازيون بقتل عائلة لمكين، خلال أعمال الإبادة التي استهدفت اليهود، ليهرب إلى الولايات المتحدة الأميركية ويستكمل عمله ويقود حملات الضغط، من أجل إقرار قوانين لمحاكمة المتهمين بارتكاب الإبادات الجماعية كافة، وقد نجحت مساعيه في إصدار الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، ولو كان لمكين بالذات حياً اليوم، لاتهم إسرائيل بكل وضوح بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقاد حملات الضغط الدولية من أجل معاقبتها.
تطرّقت الفيلسوفة الأميركية اليهودية من أصول ألمانية حنة آرندت إلى أوجه التشابه بين الأعمال الوحشية التي ارتكبها النازيون، وبين تلك التي ارتكبها الصهاينة، بل حتى بين أوجه الشبه بين الفكرين النازي والصهيوني (حتى أطلق عليها بعض المفكرين الصهاينة لقب “اليهودية الكارهة لذاتها”) وذلك في كتابها الصادر عام 1963 “أيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشر”، متأثّرةً بمحاكمة أدولف أيخمان التي حضرتها بنفسها في القدس المحتلة.
وأيخمان هو أحد القادة النازيين المنظّمين للهولوكوست، الذي تمكنت مجموعة من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من خطفه في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بتاريخ 11 أيار/مايو 1960.
وقد ذكرت آرندت في كتابها، أن رئيس أيخمان في وحدة “شوتزشتافل” فون ميلدنشتاين، حينما كان أيخمان يدعي بأنه مهندس ميكانيك (في الحقيقة هو لم ينه دراسته وعمل في مجالات كثيرة لا تحتاج إلى خبرة أو معرفة، لكنه نجح لاحقاً في الحصول على لقب “مهندس الهولوكوست” أو أحد مهندسيه) طلب منه قراءة كتاب “الدولة اليهودية” لثيودور هرتزل، وكان أيخمان في حينها رجلاً بسيطاً وساذجاً، فأعجب بأفكار هرتزل إلى درجة أن الكتاب “حوّله على الفور وإلى الأبد إلى الصهيونية”، كما تقول آرندت (الفصل الثالث، الصفحة 23).
كما أن أيخمان عبّر عن احترامه الشديد لليهود الصهاينة حصراً، فهم بنظره اليهود “المثاليون”، المطابقون لمعاييره النازية حول الإنسان المثالي (الفصل الرابع، الصفحة 30)، أما باقي اليهود فكانوا في نظره “رعاعاً” أو Jewish mob (الفصل الثالث، الصفحة 25).
وتحاول آرندت أيضاً فضح ادعاءات الحركة الصهيونية، بأن المقاومة الوحيدة للنازية كانت المقاومة الصهيونية، بالرغم من تواضع المقاومة آنذاك أمام الجبروت النازي، وكيف أن هذه الادعاءات الكاذبة تمثل استحواذاً صهيونياً على التاريخ اليهودي، حيث “لعبت جميع المنظمات والأحزاب اليهودية دورها في المقاومة، وبالتالي فإن التمييز الحقيقي لم يكن بين الصهاينة وغير الصهاينة، بل بين الأشخاص المنظمين وغير المنظمين” (الفصل السابع، الصفحة 60).
وتعيد آرندت ذكر الطابع الخاص للعلاقة بين الحركة الصهيونية والسلطات النازية في أكثر من مكان، فتقول مثلًا (مترجم مباشرة عن الكتاب): “كما أصبح من الواضح أن الموظفين الصهاينة في هنغاريا حصلوا على امتيازات أكبر من الحصانة المؤقتة المعتادة للاعتقال والترحيل الممنوحة لأعضاء المجلس اليهودي، كان للصهاينة حرية القدوم والذهاب كما يحلو لهم، وتم إعفاؤهم من تعليق النجمة الصفراء على صدورهم، وحصلوا على تصاريح لزيارة معسكرات الاعتقال في هنغاريا، وبعد ذلك بقليل، استطاع الدكتور كاستنر، المؤسس الأصلي للجنة الإغاثة والإنقاذ من السفر حول ألمانيا النازية دون أي أوراق هوية تثبت أنه يهودي”. (الفصل الثاني عشر، الصفحة 94).
تجارب ستانلي ملغرام:
هل تقدم تفسيراً حول الخضوع المطلق للجنود الإسرائيليين لأوامر قادتهم، حتى في أكثر الظروف قسوة واختباراً للحدود الإنسانية؟
في عام 1961، أجرى عالم النفس الاجتماعي ستانلي ملغرام في جامعة ييل الأميركية، دراسة حول التأثير النفسي للسلطة والطاعة، باستخدام تجربة على 40 رجلاً بين أعمار 20 و50 عاماً، من خلفيات مهنية متنوعة، تضمنت التجربة إجبار المشاركين على تعذيب “شخص” في غرفة أخرى بصعقه بالكهرباء، مع زيادة الجهد الكهربائي لكل إجابة خاطئة حتى 450 فولت، وهو ضعف قوة التيار المنزلي، الضحية كان متواطئاً مع ملغرام ويمثل الألم، وأحياناً يتوقف عن التجاوب، مما يوهم المشاركين بفقدانه الوعي أو موته، ومع ذلك، كان يطلب منهم ملغرام الاستمرار، وإطلاق المزيد من الصعقات الكهربائية، وبالرغم من اعتراضهم للحظات، فإن معظمهم (الثلثين) وصلوا إلى الحد الأقصى 450 فولت، وقاموا بتكرار استخدامه مرات متتالية، بعد إبلاغهم بأنهم لن يتحملوا مسؤولية قانونية في حال مفارقة “الضحية” الحياة أو تعرضها لأي سوء، كان رفع المسؤولية القانونية عنهم كافياً لإعطاء أنفسهم “حق” ارتكاب جريمة، على الرغم من معارضتهم المبدئية وشعورهم بالأسى والذنب!
وتُظهِر ملاحظات ملغرام في الدراسة الآتي (الترجمة بشكل مباشر عن ورقة البحث): “أسفرت التجربة عن نتيجتين كانتا مفاجئتين، تتعلق النتيجة الأولى بالقوة المطلقة للميول المطيعة التي تتجلى في هذا الظرف، لقد تعلّم المشاركون منذ الطفولة أنه يعد انتهاكاً أساسياً للسلوك الأخلاقي إيذاء شخص آخر ضد إرادته، ومع ذلك، فقد تخلى 26 منهم عن هذا المبدأ، متبعين تعليمات شخصٍ لا يملك صلاحيات خاصة لفرض أوامره، فإن عصيان تلك الأوامر لم يكن ليجلب أي خسارة مادية لهم؛ لم يكن ليترتب على ذلك أية عقوبة، ويتضح من الملاحظات والسلوك الخارجي للعديد من المشاركين، أنهم بمعاقبة الضحية غالباً ما يتصرفون بما يتعارض مع قيمهم الخاصة، غالباً ما أعرب المشاركون عن رفضهم العميق لصعق الرجل بالكهرباء في مواجهة اعتراضاته، واستنكرها آخرون ووصفوها بأنها غبية ولا معنى لها، ومع ذلك فإن الأغلبية امتثلت لأوامر التجربة (…)”
ويُكمِل ملغرام: “(…) وكان التأثير الثاني غير المتوقع هو التوتر غير العادي الناتج عن الإجراءات، يمكن للمرء أن يفترض أن الفاعل سوف ينقطع ببساطة، أو يستمر كما يمليه عليه ضميره، ومع ذلك، فإن هذا بعيد جداً عما حدث، وكانت هناك ردود فعل مذهلة من التوتر والضغط العاطفي”.
وقد أجرى ملغرام هذه الدراسة بعد تأثره بمحاكمة أدولف أيخمان أيضاً، حيث كان أيخمان في طريقه إلى حبل المشنقة هادئاً ومقتنعاً بصحّة ما ارتكبه من جرائم، وقبل وفاته بلحظات قليلة، قال: “لقد حاولت الانصياع لقوانين الحرب وعلَم بلادي”، ونجد في أرشيف “يونايتد برس انترناشيونال”، بتاريخ الأول من حزيران/يونيو 1962، أي بعد يومٍ واحد من إعدامه شنقاً، أن أيخمان ادّعى في محاكمته “أنه كان مجرد ترس صغير في الآلة النازية”، وفي مناشدته الأخيرة للرحمة، ألقى باللوم في المذبحة على “قادة نازيين آخرين لم يذكر هوياتهم”.
كم أدولف أيخمان، من المقتنعين بأنهم “مجرد ترس صغير في الآلة الصهيونية”، يوجد بين القادة والضباط الإسرائيليين اليوم، وهم مقتنعون تمام الاقتناع بأنهم لا يتحملون مسؤولية القرارات والأوامر التي ينفذونها من دون مساءلة؟

تاريخ طويل من تجريد العرب والفلسطينيين من إنسانيتهم
في مقطعٍ من مقال لبونيابريا داسغوبتا عام 2006 بعنوان “أعداء إسرائيل كوحوشٍ وحشرات” (Israel’s Foes as Beasts and Insects)، كتب داسغوبتا التالي (المقطع مترجم بشكل مباشر عن المقال): “مباشرةً بعد حرب 1967، روى روبين ماكسويل هيسلوب في مجلس العموم البريطاني، وهو أحد الأعضاء المحافظين، محادثة أجراها مع ديفيد هاكوهين، الذي كان سفيراً لإسرائيل في بورما، وكما روى ماكسويل هيسلوب، فإن هاكوهين تحدث بتعصّبٍ شديد وبشكل مطوّل عن العرب، وعندما أخذ استراحة قصيرة، اضطررتُ إلى القول له: «دكتور هاكوهين، أنا مصدوم بشدّة لأنك تتحدث عن بشر آخرين بعبارات مشابهة لتلك التي استخدمها يوليوس شترايخر (أحد أشهر المروّجين للدعاية النازية عن اليهود)، ألم تتعلم شيئاً؟ سأتذكر إجابته إلى يوم وفاتي، إذ ضرب الطاولة بكلتا يديه”، وقال: “ولكنهم ليسوا بشراً، ليسوا بشراً، إنهم عرب. أحد الأشياء العديدة التي يبدو أن المتحدثين الإسرائيليين غير قادرين على إدراكها، هو أن الإساءة ليست بديلاً عن العقل، لقد راكمت إسرائيل قدراً كبيراً من القوة العسكرية، لكنها ما زالت فقيرة جداً في المنطق”.
وفي العام 2013، أدلى نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إيلي بن دهان بتصريحٍ مماثل في مقابلة إذاعية قال فيه بوقاحة: “إن الفلسطينيين، بالنسبة لي، مثل الحيوانات، وليسوا بشراً”، وهناك العديد من الأمثلة المشابهة بين عامي 1967 و2013، وما قبلهما وما بعدهما أيضاً.
لذا، فإن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تجرّد الفلسطينيين العرب من إنسانيتهم، وتهدف إلى تكريس “التنميط الحيواني” بحقّهم ليست بجديدة، وهي لم تأتِ في سياق رد الفعل التلقائي على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كما في حالة تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد يومين منها، الذي وصف فيه أهل غزة بـ “الحيوانات البشرية” وأعلن فيه الحصار الكلي للقطاع ومنع الكهرباء والماء ومواد الطاقة من الدخول إليه، بل هي خطاب ممنهج ومعتمد تاريخياً، وهي جزء من استراتيجية متكاملة، لا يشكل الفصل والتمييز العنصري إلا وجهاً واحداً من أوجهها فقط.
السردية السائدة بوجهيها الصهيوني والإسلامي الأصولي
السردية الإسرائيلية تجعل من الأطفال الفلسطينيين “إرهابيين”، فقط لأن ولادتهم في مكانٍ معيّن من هذا العالم، تحتّم عليهم أن يكبروا في ظروفٍ عنيفة وقاهرة، لا بد أن يتحوّل فيها جزء كبير منهم إلى متمرّدين على أسباب العنف والقهر، التي تلاحقهم من المهد إلى اللّحد، وبذلك تعزّز تلك السردية مسار قتل الأطفال واحتلال الممتلكات وتخريبها، من قبل الجنود والمستوطنين من دون عقاب، ومن دون حتى الحاجة إلى الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير، لأن أولئك الأطفال مشاريع “إرهابيين” و”وحوش بشرية”، إذ إن الإنسان الفلسطيني في الرواية الصهيونية “همجي” بطبيعته، بينما تمثّل إسرائيل جنّة للثقافة والديمقراطية والإنسانية. لكن هذه السردية التي تجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم، تُقابلها سردية إسلامية متطرّفة، متمايزة في الشكل، لكنها متماثلة إلى حد التطابق في الجوهر معها، إذ إنها تجعل من أي إسرائيلي قاتلاً ومجرماً وتُبيح الاقتصاص منه حتى ولو كان طفلاً لم يكوّن بعد مهارات اللغة والتواصل والإدراك، أو متضامناً مع القضية الفلسطينية، أو رافضاً للقتال ضد الفلسطينيين، أو داعياً إلى تفكيك الدولة الصهيونية من مواقع فكرية وسياسية وإنسانية متقدّمة.
وفي كلتا السرديتين يُغيَّب العقل الإنساني ويُستبدَل بمشاعر وأفكار همجية حقيقية، تشكل خطوة نحو حدوث إبادة جماعية، كما يحصل في هذه اللحظة بالذات، ومنذ أشهر مضت، وأحد شروط حصول مثل هذه الجريمة الكبرى هو تجريد “الآخر” من إنسانيته، واعتباره نوعاً مختلفاً من الكائنات التي لا تستحق العيش، لكن بالطبع، فإن الشرط الأساسي لحدوث الإبادة الجماعية، إلى جانب الشروط والعوامل المتبقية، هو امتلاك القدرات والموارد المادية والبشرية، والقدرة على التخطيط لممارسة القتل الجماعي والعشوائي للسكان، بالإضافة إلى الغطاء السياسي، وهذا بالضبط ما يمتلكه الصهاينة، ولا تمتلكه التيارات الإسلامية الأصولية.
إقرأوا أيضاً:
في إمكانية الفصل بين مستقبل “الإنسان الإسرائيلي” والحركة الصهيونية
تشير العديد من الآراء إلى أن الحركة الصهيونية والنظام النازي حققا أهدافاً متبادلة؛ الأولى باحتلال فلسطين والأخرى بالإبادة الجماعية لليهود الأوروبيين، هذه الجدلية تسير في سياق متزايد من التحريض في المجتمع الإسرائيلي وأعمال الإبادة في غزة، وفي ظل تفاقم التحريض في المجتمع الإسرائيلي، واستمرار أعمال الإبادة الجماعية، خصوصاً بعد التدمير الكامل لمعبر رفح المتنفّس الوحيد للقطاع، وتغلغل اليمين المتطرف أكثر في جسد الدولة الإسرائيلية التي تشهد عملية تحوّل عميقة باتجاه الفاشية، وما سينتج عن كل ذلك من تداعيات وتفجيرات أمنية في الضفة الغربية والقدس، سوف يجد “الإنسان الإسرائيلي” نفسه، عاجلاً أم آجلاً، أمام ثلاثة خيارات: الأول، هو الانخراط في دوامة العنف المفرغة من موقعٍ رجعي نَشِط، وتغذية المسار الفاشي المتصاعد، الذي لن ينتج عنه سوى المزيد من الفظائع والأعمال الوحشية، التي يمكن أن تطال شعوب المنطقة برمّتها، وليس فقط الفلسطينيين والإسرائيليين.
الثاني، وهو الحل الفردي وإيجاد ملاذٍ آمن بعيداً عن المنطقة المشتعلة، وهو الأضعف وسط هيمنة القوى اليمينية المتطرفة والأقل قيمة، بما أنه يعزّز من سيطرتها ومن التوجه الفاشي للدولة، التي لن تجد مقاومة داخلية تُذكَر.
أما الثالث والأخير، فهو اقتناع جموعٍ إسرائيلية أكبر، بفشل “التجربة الصهيونية”، وبضرورة النضال المشترك مع الفلسطينيين لتفكيك الدولة الصهيونية، والدوس على أيديولوجيتها العقيمة المشابهة في جوهرها الرافض لأي “آخر” بالنازية والإسلام الأصولي، والبناء على أنقاضها، بما يضمن للفلسطينيين العرب حقهم بالعودة إلى أرضهم وحقوقهم الإنسانية والتاريخية كافة، كما يبعد شبح “الهولوكوست” الجديد عن اليهود الذين يزدادون تطرفاً في الاتجاه الخاطئ، كلما استثمر أقصى اليمين الصهيوني في الجريمة التاريخية لإثارة الرعب في نفوسهم.
ليس ارتفاع الصوت اليهودي المعادي للصهيونية في الغرب إلى أقصاه، إلا بداية ملموسة لمسار حقيقي، طويل ومعقد، من شأنه أن يؤدّي في المستقبل، إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي إلى كتلتين متصارعتين حول جدوى استمرار النموذج الحالي، قريباً كان هذا المستقبل أم بعيداً، ولن يكون بعد ذلك ارتفاع الصوت الإسلامي والعربي المناهض للدولة الصهيونية ببعيد جداً، وهو في الآن ذاته سيكون صوتاً ناقماً على الإسلام الأصولي، الذي قام بتجويف القضية الفلسطينية من أساسها الإنساني وبُعدها الحقيقي، وحوّلها إلى مجرّد دفاع جامدٍ عن المقدسات الدينية من جهة، وتحريضٍ عشوائي وفارغ على “القوم الكافرين” من جهة أخرى.