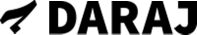يظهر جمهور أحزاب الطوائف اللبنانية متأهباً دائماً لتلبية حاجات الخطابات السائدة عبر تبنّي نسق الخطاب وتدليلاته بالرموز. انتشرت حملة “كل العيون على رفح” العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر بصورة معدّة بالذكاء الاصطناعي محاكاةً لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مليئةً بخيام النازحين، كدلالة على ترقّب الناس حول العالم مصير اللاجئين الفلسطينيين في المدينة.
ساهم ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل في نشر الحملة ودعمها، ما شجّع إطلاق حملة “كل العيون على بيروت”، للتركيز على ما تعرّض له لبنان من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى التذكير بتفجير مرفأ بيروت – الحوار العام عبّر عن الاصطفاف الحاد في البلاد، بخاصة في ظلّ فتح حزب الله جبهة الجنوب، أي “جبهة الإسناد”، ما طرح أسئلةً كيانيةً وجدّيةً في المجتمع اللبناني حول دور المجتمع والدولة والتنظيمات المهيمنة أثناء الإبادة في غزة.
على رغم قاعدة “الاصطفاف والاصطفاف المقابل”، أبرز المجتمع اللبناني عبر مراحل تاريخية أساسية تضامنه وتكاتفه على اختلاف تطلعات الجماعات الذاتية، وانحياز اللبنانيين الى قضايا التحرر الوطني ورفض الاضطهاد والفرض النظامي الحاد على الرأي العام وتحرك الشعوب. بناءً على هذه القراءة، نبحثُ عن “لبنان” بالمعنى الموضوعي والتاريخي، بعيداً من السرديات السائدة ما بين جماعة وأخرى. فنعم، لبنان قضيتنا، ولكن ما هو لبنان؟
لبنان كبلدٍ تمسّك باستقلاليته ورفض التسلّط، في ظلّ مراحل تاريخية حساسة شهدت تدخّلات مخابراتية وسياسية مباشرة من دول وأجهزة (أحداث 1958، اتفاقية القاهرة 1969، الحرب الأهلية، الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس الجيش لبنان الجنوبي، الوصاية السورية، الاغتيالات السياسية والسيارات المفخخة بعد 2005 و2011 و2019).
عبّرت شرائح واسعة من اللبنانيين عن رفضها “الهيمنة”، وتمسّكت بمفاهيم تمحورت حول “الاستقلالية” و”الحرية” و”التحرير”. اعتبر بعض هذه الفئات أنّ الحرب الأهلية اللبنانية هي حرب “الآخرين” في لبنان، وعلى رُغم الصبغة الشوفينية والانعزالية لتلك القراءة، فهي قائمة أولاً على رفض ما يسمّى “الارتهان” للخارج.
مع تنامي الحضور الفلسطيني المسلّح في لبنان أواخر الستينات، ومع “شرعنة” وجود منظمة التحرير الفلسطينية المسلّح في جنوب لبنان بعد توقيع “اتفاق القاهرة” 1969، أصبح جنوب لبنان تحت سيطرة منظمة التحرير بشكل فعلي.
وعلى رُغم تأييد فئات واسعة من المجتمع القضية الفلسطينية والاعتراف الشعبي الكبير بأهمية الكفاح المسلّح في تلك اللحظة الحساسة في تاريخ المنطقة، بدأت أصوات الجنوبيين تتعالى، رافضين تسلّط ياسر عرفات وقوّاته على حياتهم اليومية.
فالصوت الجنوبي، المؤيد للمقاومة والقضية الفلسطينية، أدرك، في تلك اللحظة بالذات، أنّ المقاومات لن تحقق أهدافها بحال جاءت على حساب كرامة المقيمين تحت سلطتها وحريتهم. فجهاز “التحرر الوطني” الذي يتمحور حول الحواجز وانتهاك خصوصية الناس والبطش اليومي، لا يستطيع أن يحقق تحرراً فعلياً ومستداماً متمحوراً حول الكرامة الإنسانية.
لذلك، الاستقلالية ليست فقط صفة تاريخية لدول بالمجمل، بل أيضاً هي صفة مجتمعية عابرة لتشخيص أفراد وفئات تدخُل الصراع السياسي كي تحقق أهدافاً خاصة وعامة. فرفض بعض اللبنانيين (والسوريين) التيار الناصري في أواخر الخمسينات، ليس نابعاً فقط من خلفيات هوياتية وهواجس ثقافوية، بل اعتبروا نظام عبد الناصر خطراً حقيقياً على استقلالية “المجتمع الشامي” بما يمثّله من أفرادٍ يملكون آراءً قد لا تتفق مع اعتبارات النخبة الأمنية والسياسية والثقافية.
ففي سياق سياسي تتقاطع فيه تلك الاعتبارات الثقافية والسياسية، يتحوّل “استقلال لبنان” إلى شعار داخلي اجتماعي، وليس فقط الى ردّ قومي على “الخارج”. الاستقلالية هنا ليست فقط استقلالية قومية شوفينية، بل أيضاً تتمثّل باستقلالية القلم والجسد والعقل، على رغم تناقضاتها الكثيرة، والتي هي ناتجة من تعددية ضرورية أصبحت معدومة في المنطق الشمولي المهيمن. فبين قومية عربية ناصرية “مقاومة” وقومية شامية أسدية “ممانعة”، اختار هذا البلد، في لحظات مفصلية معينة، نطاقاً “لبنانياً محلّياً” جعل من التعددية السياسية والاستقلالية الفكرية أولوية أمام طموحات “القوميين الكبار”.
لبنان كشعب رفض الاحتلالات
للبنانيين على انقساماتهم في مراحل متعددة، تاريخ قائم على مقاومة الاحتلالات بمختلف أشكالها. فحتى في المرحلة التأسيسية الأولى، وعلى رغم انقسام المجتمع اللبناني بين الراغبين في الوحدة مع سوريا والمطالبين بالحماية الفرنسية، اجتمع الطرفان أخيراً على نبذ الانتداب الفرنسي، بدعم وتأييد شعبيين كبيرين، أفضيا في نهايتهما إلى إجماع حول ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تبدأ بجلاء كامل للفرنسيين من لبنان.
ومع بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، تشكلت “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية” (جمول). وفي 12 أيلول/ سبتمبر من تلك السنة، نفّذت الجبهة العملية الأولى عند صيدلية بسترس في بيروت، وتوالت العمليات في الأعوام اللاحقة بقدرات عسكرية متواضعة. وبعدما أبدى المقاومون بسالة كبيرة في وجه الاحتلال بضربه في مختلف مناطق وجوده، تم تحرير بيروت عام 1985. كان مؤدى صمود الجنوبيين في أرضهم ورفضهم تركها، وعمليات حركات المقاومة الإسلامية والوطنية على مدار السنوات اللاحقة، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من دون شروط عام 2000. في أعقاب اتفاق الطائف، وفي إطار معاهدة “الأخوة والتعاون والتنسيق”، أضفيت الشرعية على الوجود العسكري السوري في لبنان.
شهد لبنان في تلك المرحلة سيطرة السلطة الأمنية اللبنانية-السورية، وكانت نتيجتها مطاردة الصحافيين وقمع حريات المواطنين وترهيبهم، وصولاً إلى اغتيال شخصيات شبابية سياسية وصحافية وثقافية. في عام 2005، بعد استمرار نهج القمع والتصفية في لبنان، وصولاً إلى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، اندلعت انتفاضة شعبية ضمت شخصيات سياسية من أطراف عدة اجتمعت حول ضرورة إنهاء الوجود العسكري في لبنان. فاضطرت سوريا إلى إعلان انسحابها الكامل من لبنان في 30 نيسان/ أبريل 2005.
لا ننكر حصول تعامل مع الانتداب الفرنسي وبحث عن مكاسب وامتيازات أثناء الفترة التأسيسية للبلاد، وهناك من أنشأ وانضم الى جيش لبنان الجنوبي أثناء احتلال الجنوب، وثمّة من شكر سوريا الأسد قبل إنهاء الوصاية السورية – ولكن هذا كله لا يمحي تاريخ تلك المقاومات غير المثالية، والتي على رُغم تناقضاتها عبّرت عن هوية لبنانية تاريخية صلبة: هوية رافضة للاحتلالات ومتمسّكة بصنع واقعها الخاص.
بيروت كملجأ للأحرار والمضطهدين
يبقى لبنان ناقصاً من دون بيروت، أي بيروت الأزمات الاقتصادية والحروب الدائمة؛ وبيروت المدينة المعدومة من أبسط التطبيقات الأمنية الضرورية لتحقيق العيش الكريم والآمن. هي بيروت، مدينة العنف السياسي والمجتمعي الفاقع على مستويات عدة.
على رُغم نكسات بيروت، لا تزال هذه المدينة تجذب الصحافيين والناشطين والكتّاب والمنظمات الحقوقية من كلّ أنحاء العالم العربي، ولذلك حافظت على حيوية “المساحة الثالثة” التي لا تتصل فقط باعتبارات المحاور المُسيطرة، على رغم الحدود المفروضة عليها محلياً وإقليمياً. تشكل بيروت أيضاً “بيتاً اجتماعياً مرغوباً” لفئات عرقية ودينية وسياسية “مضطهدة وغير مرغوبة” من كلّ أنحاء المنطقة، من اللاجئين السوريين، إلى كتّاب العراق، إلى نسويات الخليج، إلى الصحافيين المصريين. فترافقت رغبة الأسديين والناصريين في السيطرة على لبنان وفضائه العام، مع رغبة معارضي سوريا ومصر في الهروب نحو مدينة، على رُغم أزماتها المتكررة، شكّلت مصدر راحة وحرية وابتكار.
المحلل أو الناشط الذي يردّ على التضامن بتسليط الضوء على بيروت ومعاناتها، هل حقّاً يعرف مدينة بيروت؟ هل من أراد تنظيم حلقة منافسة بين إبادة غزة وتفجير بيروت في 4 آب/ أغسطس، يعرف حقيقة بيروت في كلّ الحقبات التاريخية السابقة؟ فهل نتحدث عن المدينة ذاتها؟ هل بيروت هي بيروت من دون “فلسطين” كعنوان ثقافي واجتماعي وفنّي؟ هل بيروت هي بيروت من دون صحيفتيّ النهار والسفير، اللتين رحبتا بالسوريين والفلسطينيين كأصوات حرة تتحدى الاحتلال والاستبداد؟ هل تستطيع بيروت، عاصمة لبنان، أن تحافظ على دورها السياسي من دون الحفاظ على وظيفتها كعاصمة ثقافية للعالم العربي ككل؟ وعاصمة متمرّدة في وجه كلّ من حاول السيطرة عليها؟
إقرأوا أيضاً: