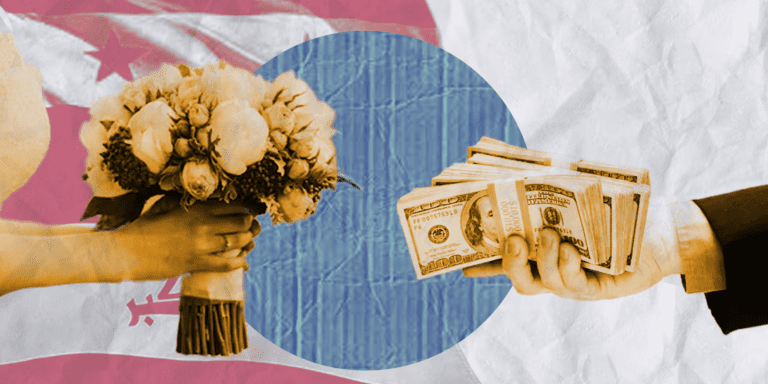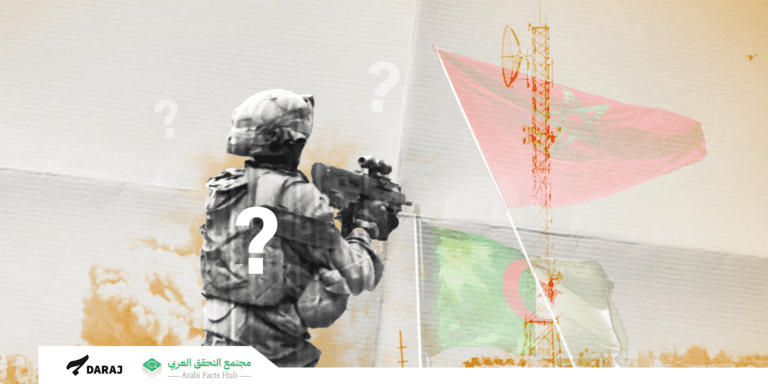لا أبالغ حين أقول إن أكثر من ثلاثين طائرة حربية اسرائيلية تحوم فوق شمال قطاع غزة، نراها بالعين المجردة، تحلّق على ارتفاعٍ منخفضٍ جداً، ولك أن تتخيل مدى الضجيج والتلوث السمعي، والصداع الذي نشعر به، والدوار الذي نختبره، وآلام الأذن بفعل الضغط على طبلة الأذن إثر اختراق الطائرات حاجز الصوت، ناهيك بقنابل الغاز الفوسفورية والدخانية التي تأكل أنوفنا، وتكاد تحرق أجسادنا.
الأمَرُّ من ذلك كله هو مئات الغارات في الليلة الواحدة، ومئات القتلى أيضاً. وفي ما يبدو، فإن الذاكرة تطرد المآسي وتظنّها لا تتكرر، إذ كنا نعتقد أن أصعب ليلة مرّت علينا هي ليلة “الحزام الناري”، التي جرت في منطقة “بير النعجة” في جباليا ليلة العيد عام 2021.
لكن المصائب التي نكرهها تُعاد بشكلٍ أعنف وأضخم، وأكثر ضراوة، وكأنهم يستحدثون طرقاً جديدة لقتلنا نفسياً وجسدياً، فمشهد “الحزام الناري” يتكرر في الليل والنهار، في أكثر من موضعٍ ومكان، والقصف المجنون في هذه الحرب فاق الوصف حدّ ملامسة المخيّلة.
لا تقتصر أساليب القتل الجماعية على صواريخ الطائرات المزعجة تلك، وإنما تتعدد صنوف الإبادة، وتتنوع أشكالها، منها: المدفعية العمياء التي تقف على التخوم، والبوارج البحرية التي تطلق قذائفها من دون وعي أو هدف، ومع الاجتياح البري، دخل الرصاص المعركة، ورصاص الاشتباكات القريبة يصلنا ونحن داخل البيوت.
نحن هنا في غزة، المخيم الذي يأبى أن تتكرر مأساة تهجيره، نرى الموت كل يومٍ ألف مرةٍ. هذا الضيف الثقيل السمجُ الذي حلّ علينا منذ أكثر من شهر، لينتقيَ أفضلنا وأنقانا وأجملنا وأطهرنا.
أكذب لو قلت إنّ وجودي لا يتآكل كل ليلة، فمقوّمات صمودي بدأت تتلاشى، مع قصف بيوت جيراننا الآمنين، الذين رفضوا تغريبتهم إلى الجنوب، بعدما حاول الاحتلال دفع سكان الشمال نحو الانتقال إلى جنوب وادي غزة.
أذكر يومها، أننا كنا واقفين جميعاً على شبابيكنا، واضعين أيدينا على خدودنا، نشاهد مشهد التغريبة الفلسطينية الجديدة، حملت ملامح وجوهنا كثيراً من الحسرة، وقليلاً من الكلام، فاكتفينا بالإيماء؛ كانت الحيرة واضحةً، والسؤال واحداً: أي مصيبة حلت على هذا الشعب؟ وأي كارثة ستنزل به؟ وماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة؟
الكل يسير على وجهه لا على رجليه، محاولين التقاط شيءٍ من الأمان في الجنوب (لا ألوم باحثاً عن النجاة) لكنه المشهد الذي يجب أن نرويه للعالم.
عسى ألا يصبح جيراني أرقاماً
كانت العائلات تمشي جماعات، الرجال يجرّون أبناءهم، والنساء يهمن بلا وعي، يحملن حقائب صغيرة فيها أشياء كثيرة، والأطفال يحملون حقائب مدارسهم مستعيضين عن الكتب بالقليل من الملابس، أما الشباب فيحملون حقائب اللابتوب، وأوراقاً لا قيمة لها في هذه المصيبة.
الكل يسير على وجهه لا على رجليه، محاولين التقاط شيءٍ من الأمان في الجنوب (لا ألوم باحثاً عن النجاة) لكنه المشهد الذي يجب أن نرويه للعالم.
كنتُ يومها آنسُ بوجود جيراني الباقين معي، المتفرجين بذهول على المشهد ذاته، أترك شباكي مفتوحاً لأؤكد لهم أني باقيةٌ معهم، وألوّح لهم كل صباحٍ بأني مثلهم، لن أرحل، لكنهم رحلوا قبلي. في البداية، رحل أصحاب المخبز بعد قصف منزلهم ومخبزهم، خروجوا حينها جرحى من تحت الركام، ثمّ رحل أصحاب المحلات التجارية، بعد مقتل خمسة منهم، وانتشال جرحى وناجين من الحفرة العميقة إثر قصف المحالّ في السوق المقابل لمنزلنا.
ثمّ كانت الليلة الماضية قاضية حين قصف الجيش الإسرائيليّ منزل جارنا المقابل لنا، وقُتل أبناء وبنات ونساء وأطفال ورجال، هؤلاء رحلوا قبلي إلى السماء. أما المصابون فلن يعودوا، لم يعد هناك مأوىً في المكان، فمن لي بأنيسٍ بعدكم؟ ومن لي بجارٍ بعدكم يحفظ سرّي، ولا يكشف ستري؟.
لا أدري كيف يمكن أن تغمض لي عينٌ بعدما سمعت أصواتكم الأخيرة؟ وكيف سيطلعُ عليّ صباحٌ أستقبل شمسه في غرفتي المطلّة عليكم؟ أنا التي رأيتكم مُضرجين بدمائكم، ملفوفين بستائر الشبابيك البيضاء الناصعة. هذه قصتكم أيها الأبطال، سطّرتم مجدكم بالدم، واخترتُ أن أنقلها للعالم بكثير من الحزن، وبشيء من المَهابة في الموقف الجَلل؛ علّني لا أكون عبداً للصمت والانبطاح، وعلّكم لا تكونون أرقاماً في الإحصاءات الرسمية وخبراً في البيانات الصحافية.
في الصباح، كانت النجاة من حظّنا، واستمرت الحياة بدورتها العادية نفسها، لم يتوقف القصف، وكان المخيم مثل حلقة النار كل من في داخلها مستهدفٌ، والخروج منها مغامرة لا تُحمد عقباها، وقد آثرنا البقاء، مع الدعاء بالسلامة.
“إنكِ لن تجدي الشمس في غرفة مغلقة”، مقولة لغسان كنفاني في قصة قصيرة للأطفال، كتبتها كثيراً في حكمة اليوم على سبورة المدرسة، وحكيتها مراراً لطالباتي ترافقها نصيحة دائمة لهنّ: “افتحنَ شبابيككنّ أيتها الفتيات، واستقبلن الحياة، وعشن الحرية”.
فتحت شباكي لاستقبال شمس الصباح التي تطلع وسط الغبار في وطنٍ مقيّد، ندفع فواتيره بالدم، ألقيت تحية الصباح على البيت المقصوف أمامي، وجدت سيدة من الناجيات تبحث عن بقايا تنفعها من تحت الركام، لا أثر لأي شيء. أستغرب كيف تذيب هذه الأسلحة كلّ شيء، لا وجود لخزانات الأطفال، ولا لغرف الأولاد، ولا لأدوات مطبخ، ولا لملابس نساء، لا معلمَ من معالم الحياة سوى مجموعة من الحجارة المتراكمة التي سيضطر أهلها لهدمها بأيديهم مرة أخرى للبحث عن مفقودين، أو لاستخدامها في البناء مرة أخرى.
إقرأوا أيضاً:
مولود جديد تحت القصف
كنا على موعد مع استقبال فرد جديد ينضم إلى العائلة، في ظروف هي الأصعب على المستوى الشخصي والأقسى على المستوى الوطني. وشاءت الأقدار أن تنقطع الاتصالات والإنترنت في تلك الليلة، وفي الصباح أيضاً، لم نستطع الاتصال بأحد وسط الحصار المطبق على شمال غزة.
خرج أخي وسط النار للبحث عن سيارة إسعاف تمر بالمصادفة في الشارع، علّ زوجته التي جاءها المخاض وحان موعد ولادتها تجد طريقاً لمستشفى أو عيادة. لا مجال لركوب سيارة مدنية، فقد تكسرت شبابيك سيارة عمي بعد قصف البيت المقابل في الليلة الفائتة، كما أن مستشفيَي العودة والإندونيسي في مخيم جباليا يتعرضان للقصف بشكل مكثف في محاولة للضغط عليهما للإخلاء. لكن لحسن الحظ، لدينا طبيبة نساء وولادة في بيت النازحين، وقد استطاعت توليد زوجة أخي في البيت.
استقبلنا مولودة جميلة، لكنهم حرمونا المسرّات، فما عدنا نعرف كيف نفرح بطفلة تخرج من رحم الألم؟ وماذا عسانا نفعل مع طفلة تضجّ بالحياة في بلدٍ يصرخ أطفاله فزعاً من غيلان الموت ووحوش تحمل المتفجرات. استبشرنا خيراً بولادة الفتاة، ودعونا أن تكون سنة نبات وبنات، ففي الموروث الشعبي الفلسطيني مثلٌ شهير: “سنة البنات نبات، وسنة الفحول محول”، السنة المنصرمة سنة غلب فيها إنجاب الذكور، أما سنة البنات فهي سنة الخير، دعوتُ لها في سري أن ترى أياماً أجمل من أيامنا، وألّا تفتح عينيها على بلدٍ محتل تُسلب فيه كل حقوق الطفولة، وأن يكتب لنا الله النجاة ببركة وجودها، وأن تحمينا الملائكة بحمايتها.
وعلى استحياء من دم القتلى النازف كل ثانية في غزة، فتحت علبة شوكولاتة تأخرتُ في توزيعها على طالباتي، وكانت من نصيب الأطفال الصغار الذين لا يدركون ماذا يفعل بهم أعداء الإنسانية. ولأنّ الحزن قد تملّك قلوبنا، لم نتحلقْ بدهشة حول الطفلة، ولم نطلق زغاريد الفرح في استقبالها، ولم تذبح لها العقيقة، ولم تطبخ لها الولائم، وحده الألم وليد اللحظات.
مع عودة الاتصال والإنترنت، أخبرتُ صديقي البحريني الذي يطمئن على حالي كل يوم عن هذا الميلاد الجديد، فحدثني عن صديق سوداني له، شعرت زوجته بآلام الولادة في ظل حظر التجول الذي فرضه الجيش السوداني إثر انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 1964، فخاطب الجنود المتمركزين قرب منزله، ووافقوا ببقية من مروءة على نقله وزوجته بالدبابة إلى المستشفى. فقلت: “يا ليت شعوبنا العربية تحمل شيئاً من شهامة العرب، أو بقية من حميّة الجاهلية، أو قليلاً من مروءة الإسلام، تشعل فيهم ثورة؛ علّها تطفئ لهيب النار المستعرة في غزة، وليتهم ينهضون لينهوا الإبادة الجماعية لأهلهم في القطاع، ويقفون وقفة رجل واحد؛ ليرفعوا هذه الغمّة عنهم، التي اشتدت، وضاقت، واستحكمت حلقاتها”، لكن هذه الحكاية لن تنتهي، ما دامت في العمر بقية، وفي الروح نَفَس.