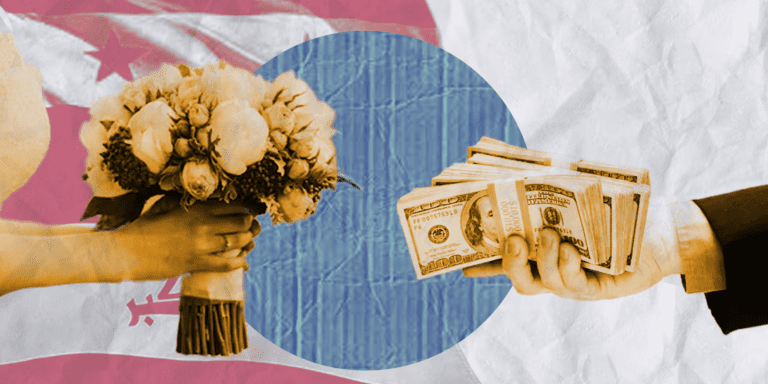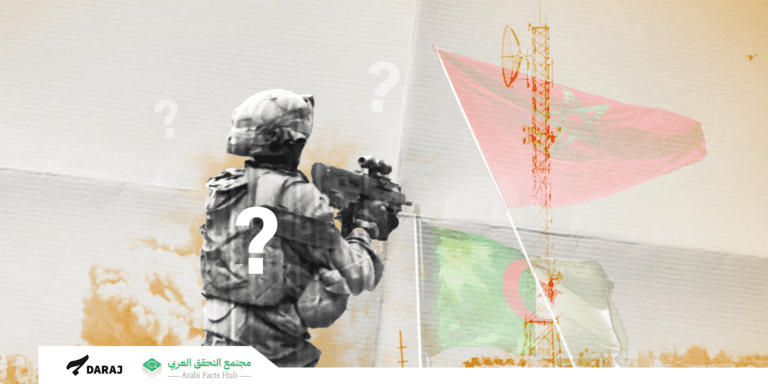المقاربة التي قرأنا بها الواقع السياسي في تونس (في كتاب فرانكشتاين تونس) والذهنية التي أنشأته وتديره، تستمد مرجعياتها من فكرة أن الشر ليس مقولة خارجة عن البشر، بل شيء نابع منهم، وأن الشعوب ليست مسؤولة فقط عن مصيرها، بل هي متورطة غالباً في إنتاج واقعها، وأحياناً شريكة أساسية في إنتاج تلك الفظاعات التي تشتكي منها، سواء كانت اجتماعيّة أو سياسيّة أو حقوقيّة أو ثقافيّة.
الدوستوبيات مهما بدت غريبة، فإن عنصراً واقعياً متآمراً من داخل ضحاياها ساهم في ظهورها. فلا تنشأ الديكتاتوريات إلا بشيء من التجسير لها عبر النخب ومؤسسات المجتمع المدنيّ والإعلام والشعب، الذين يتورطون في لحظة تاريخيّة ما، في تبني قناعات عجلى كالانتخاب الانتقاميّ والتهليل للقضاء على العدو الأيديولوجيّ بأي طريقة، لكنها تكشف في آخر المطاف أنها ربّت الوحش الذي سيلتهمها، وأنها قد أطعمته من لحمها من دون أن تعلم.
وبالعودة الى أصل شخصية وحش فرانكشتاين في أدبيات العالم، فإن هذه الشخصية المفاهيميّة، لم تتمرد على صانعها فقط، بل التهمت حتى اسمه.
فما فرانكشتاين في الحقيقة إلا لقب المهندس الشاب، لكن الاسم صار إحالة على الوحش، هكذا استولى قيس سعيد على إرادة الشعب، والشعب نفسه، ليحاول التماهي معه عبر تقنيات البؤس.
الاستيلاء على إرادة الشعب
تلك الآلية التي يتحرك بها الرئيس ويتكلّم، تجعل من الاستعارة واقعاً، فالماكينة المتوحشة قائمة كواقعة في شخصية الرئيس الذي لا يقوى على مخاطبة شعبه إلا من وراء لغة متحشرجة آلية، خالية تماماً من أي عنصر بشريّ.
لم يكن الأدب يوماً بريئاً كما ذهب إلى ذلك الفيلسوف والروائي جورج باتاي، لذلك بالإمكان أن نقرأ به كل شيء، فالنص الأدبي آلة لمقاربة الواقع وفهمه أحداثاً ومناخاً وطموحاً واستعداداً.
تتقاطع النوايا الطيبة في صناع الوحوش بين الرواية الإنكليزية والواقع التونسي في الأمل، فقد حلم كل من فيكتور فرانكشتاين، والشعب التونسي، بتغيير الواقع ومقاومة الشرّ، لكنهما سقطا معاً في مأزق صناعة الوحش بدل المنقذ.
أما المختلف بين شخصية وحش فرانكشتاين لفيكتور فرانكشتاين وفرانكشتاين تونس الذي صنعه الشعب، فهو أن الأول كان صنيعة العلم، والثاني صنيعة الجهل. وهنا تأتي الخطورة، فالأول مجال وجوده وتأثيره هو التخييل، بينما مجال وجود الثاني وتأثيره هو الواقع.
لم يأتِ ذلك الاهتمام برواية فرانكشتاين لماري شيللي من عدم، ولا تلك المقاربات السينمائيّة التي تجاوزت الـ150 مقاربة منذ ظهور الرواية سنة 1818. لقد خلقت ماري شيللي شخصية مفاهيمية (التعبير لجيل دولوز وفيلكس غوتاري في كتابهما “ما الفلسفة ؟”) عظيمة، عبرت من خلال رمزيتها مجالها الأدبي الضيق، لتصبح مفهوماً نقرأ به الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، تماماً كما فعل ميغيل دي سيرفنتس مع شخصية دون كيشوت.
لم يكن التفات الكاتب العراقي أحمد سعداوي في روايته “فرانكشتاين في بغداد” إلى تلك الشخصية وإلى تلك الرواية في لعبة تناص نصي وتخييلي واضح، إلا من باب الاعتراف بأن فرانكشتاين صار مفهوماً يمكن به قراءة الواقع السياسي العربيّ.
لا يخفي قيس سعيد في ظهوره سلوك الوحش، بل عكس قادة الأنظمة الشمولية الذين يختفون عادةً وراء خطاب لطيف وتمظهرات للديمقراطيّة. ينتصب قيس سعيد في عالمه السياسي الخاص ككائن عدوانيّ، لا يتوقف عن الشتم والسب، وخلافاً لأي ديكتاتور وانقلابي.
يتفاخر قيس سعيد بأنه محمي من العسكر والشرطة، لذلك يحرص يومياً على إخبار الشعب عبر صفحة رئاسة الجمهورية، بأنه التقى بالجنرال الفلاني ووزير الداخلية ووزيرة العدل التي يعتبرها وزيرة السجون. وكلما اشتدت الأزمات بسعيّد، يركض إلى مقر وزارة الداخلية ليخطب في الشعب من هناك في ساعة متأخرة من الليل، أو إلى ثكنة عسكريّة ليحرّض الجيش على المعارضين وعلى الشعب، ويذكّره بأنه تحت السيطرة.
ليس لهذه السلوكيات الفيتشيّة مثيل في تاريخ الأنظمة الشموليّة، لأنها تمثل انقلاباً تاريخياً فاشلاً يتآكل كل يوم، وليس أمام مدبّره إلا استعراض قوّته التي يستمدها من مؤسستين، مؤسسة الجيش ومؤسسة الشرطة.
صارت كلمة المعارضة وبجميع أشكالها المدنيّة والسياسيّة والثقافيّة، تعني بالنسبة إلى قيس سعيّد خيانة عظمى، كما لا يعني العدل بالنسبة إليه إلا اعتقال الجميع، جميع من يقول “لا” لبرنامجه المشوّش حتى في ذهنه.
هناك شبق ما يحرّك الديكتاتور الصغير لارتكاب المجازر وتحريض المؤسسات الأمنية والعسكريّة على التدخل، ويشي بأنها لا تخضع لنزواته كل الخضوع، وأنها تورّطت معه غالباً في ما حصل في 25 تموز/ يوليو، والكثير منها نادم ولا يريد أن يذهب أكثر في هذا الغلو، لأنه ليس مستعداً لخسارة شرفه وتاريخه كما المؤسسة العسكريّة، ولا أن يعود إلى الخطأ المرتكب ذاته في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وما انجرّ عنه من إذلال وطلب للعفو بالنسبة إلى المؤسسة الأمنيّة.
إقرأوا أيضاً:
رئيس معلّق بين اثنين
هذه الوضعية التراجيديّة للرئيس قيس سعيد تكشف أنه معلّق، لا هو في صف الشعب الذي كشف تعلّقه المرضي بالسلطة، ولا يمكنه العودة إليه بأي خطابات مطمئنة، ولا هو ممسك بالمؤسستين العسكرية والأمنية كل المسك، وأي انتفاضة شعبية ستسقطه، وستتبرأ منه المؤسستان بذريعة أنهما حاولتا منع حصول حمام من الدم، وأنهما انتظرتا تحركاً شعبياً حقيقياً لحسم أمر المُنقلب.
الخطورة التي يعيشها الشعب التونسي اليوم، تكمن في تحوّل فرانكشتاين تونس من وضعه كوحش إلى وضعه كمخلوق يمكن أن يكتسب شيئاً من الإنسانية المضلّلة، كما هي الحال مع فيلم “عروس فرانكشتاين”، ويصبح الوحش أليفاً ويتعامل معه التونسيون كشيء عادي ومقبول، والأفظع أن يظهر الدكتور بريتوريوس، صديق الدكتور فيكتور صانع الوحش، والذي سعى الى إطلاق نسخة نسائية بشرية منه لينطلق في الوجود نسل الوحش المخبول الآلي المحمول.
نتساءل كصاحب كتاب “الطاغية” إمام عبد الفتاح إمام، متى يتوقف الشعب عن البحث عن منقذ؟ فـ”الطغيان ما زال يطل برأسه هنا وهناك كلما سنحت الظروف، وهي كثيراً ما تسنح في عالم متخلف ترتفع فيه نسبة الأمية ويغيب الوعي، فلا يستطيع الشعب أن يعتمد على نفسه، فينتظر من يخلصه مما هو فيه، فتكون بارقة الأمل عنده معقودة على المخلص والزعيم الأوحد والمنقذ والقائد الملهم ومبعوث العناية الإلهية والرئيس الذي نفتديه بالروح وبالدم! ولأننا ألفنا الطاغية لآلاف السنين، لم نعد نجد حرجاً ولا غضاضة في الحديث عن إيجابياته وما فعله من أجلنا من جليل الأعمال”.
لقد عرف المشهد السياسي التونسي عبر تاريخه الكثير من المستذئبين، لكنه لم يشهد مثل هذا الكائن الخرافي الذي جمع في نفسه كل صفات الوحوش الأسطورية والخرافية التي تخيف الأطفال والكبار، من صوت البعابع إلى سلوك مصاصي الدماء إلى خطوات الزومبي.
مشهد مرعب
يقول جون لوك في مؤلفه “في الحكم المدني”: “الشرطي الذي يجاوز حدود سلطاته يتحول إلى لص أو قاطع طريق… كذلك كل من يتجاوز حدود السلطة المشروعة سواء كان موظفاً رفيعاً أم صغيراً ملكاً أم شرطياً. بل إن جرمه يكون أعظم إذا صدر عن عظمة الأمانة التي عهد بها إليه”.
لم يكن أحد يتصور، قبل نتائج الدور الأول من الانتخابات، أن قيس سعيد سيكون أكبر المرشحين، إذ فاجأت النتائج العالم كله، وهي الصدمة ذاتها التي أحدثها ظهور وحش فرانكشتاين الذي رُكِّبَ في السر بعيداً من الأعين . لقد رُكّب في الغرف المظلمة والمقفلة، جزء منها افتراضيّ (في المجموعات المغلقة)، وجزء آخر واقعي (في الجحور الواقعية هنا وهناك). وكانت الطلعة الثانيّة له أثناء إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسيّة في بيته في “المنيهلة”، ضمن المشهد السوريالي المرعب الذي تناقله الإعلام الدولي، أثناء إعلان فوز سعيد بالانتخابات الرئاسية في بيته بالمنيهلة.
لم تكن إمارات الفرح أو الأمل بادية على ملامحه، ولا حتى الامتنان، بل الصدمة المختلطة بالوعيد. وكان مشهد تقبيله العلم غريباً على التونسيين الذين عرفوا مشهد قبلة أخرى راقية للعلم من رئيسهم الأول الحبيب بورقيبة. ومنذ تلك اللحظة التي حاول فيها قيس سعيد النزول من شقته والخروج على العالم، بدأت خطوات الوحش. لا شيء إنساني نزل من شقة المنيهلة، لقد كان وحش فرانكشتاين يجس الدرج تحت هتاف تلك الأفواه الجائعة للانتقام.
لذلك، لا يمكن فهم شخصية قيس سعيد إلا في ضوء استعادة كرونولوجية لطلعاته وصوره وخطاباته لرصد تحولات تلك الشخصية الحاكمة التي لم تبدأ إلى الآن ممارسة السياسة، بل انشغلت طوال سنوات حكمها بالهدم وتمديد حالة الطوارئ. ويبدو أن الوقت حان لبومة مينيرفا أن تظهر، ولعلماء النفس والاجتماع والفلاسفة أن يخرجوا من كهوفهم ليقاربوا هذه الشخصية، فقد راكمت من ردود الفعل والسلوك والخطابات ما يسمح الآن بتحليلها ومحاولة فهمها.