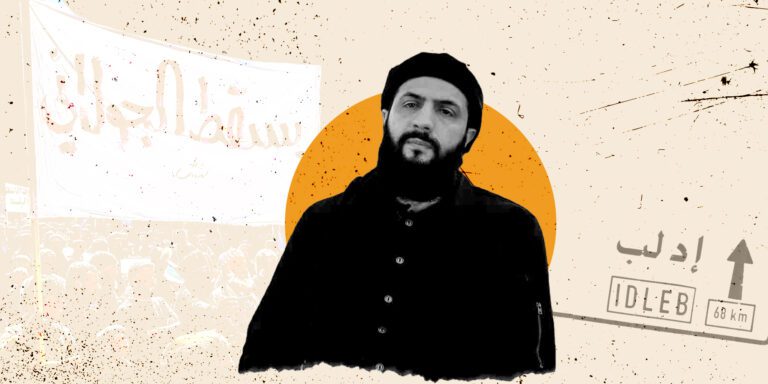كملايين الفلسطينيين، أغار على مدينتي رام الله وأخشى من فقدانها، فأتشبثّ بكل زقاق ضيق وأكلة شعبية ووردة برية وذكرى آفلة وحجر قديم فيها.
أضفي طابعاً رومانسياً على كل ما يخصّ بلادي.
يعتريني قلق من أن تصبح كائناً مشوهاً مجرداً من التفاصيل، لتصبح شبيهة بكل المدن التي أمست ضحايا للعولمة.
ما عليّ إلا أن أستمتع بما تبقى من المدينة من شوارع ضيقة وبيوت عتيقة وبساتين، وأشم رائحة الياسمين بشوق أكبر، وأبحث عن حبات التين غير الناضجة على الأشجار المعمرة قبل فوات الأوان. لست أبحث عن إعادة صياغة كليشيهات مبتذلة عن فلسطين، إلا أني أخاف مما سيحل بمدينتي رام الله في المستقبل.
لكن، لماذا أخاف على مدينتي؟
رام الله مدينة تنضح بالتناقضات الصارخة، فتجمع ما بين الموروث الثقافي الذي تركه أهل البلدة، وما أضافه اللاجئون إليها، حتى تحولت من بلدة صغيرة الى مجمّع للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في يومنا هذا.
رام الله قديماً
منذ بداية القرن العشرين، شهدت رام الله نقاط تحول عدة نجمت عنها مفارقات اقتصادية واجتماعية مهمة، ما أدى الى حدوث تغيرات واضحة في ملامح المدينة ومشهدها الحضري. ففي مطلع القرن، هاجر ميسورو الحال من أهل رام الله الى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول، لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأرسلوا مساعدات مالية لأهاليهم في البلدة، ما انعكس إيجاباً على وضعها ومكانتها. وعلى أثر النكبة عام 1948، استقبلت رام الله العدد الأكبر من اللاجئين في الضفة الغربية، فلعب السكان الجدد دوراً مهماً في عملية تحوّل المدينة وتطوّرها. ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994، أصبحت رام الله المركز الإداري للسلطة، ما زاد من الهجرة الداخلية للمدينة وأدى الى تغيرات هيكلية في بنيتها الفوقية والتحتية.
وعلى غرار غيرها من المدن الكبيرة التي التهمتها زوبعة العولمة، تبلورت في رام الله أساليب حياة جديدة تعتمد على ثقافة الاستهلاك. ففي رام الله التحتا، أي البلدة القديمة، على سبيل المثال، نجد بيوتاً اسودّت حجارتها من القدم والفقر، وعلى بعد أمتار، مطاعم ومخابز تنافس العواصم الأوروبية بغلاء أسعار منتجاتها. أما في مخيلتي، فرام الله هي عبق زهر الياسمين وأشجار التين وتضارب الساحات الضيقة والبنايات الشاهقة. في الحقيقة، يفقد هذا التصور لمدينتي الجميلة جزءاً من الواقعية يوماً بعد يوم.
كملايين الفلسطينيين، أغار على مدينتي رام الله وأخشى من فقدانها، فأتشبثّ بكل زقاق ضيق وأكلة شعبية ووردة برية وذكرى آفلة وحجر قديم فيها.
في مشهد يتراوح بين التواؤم والشذوذ، وفي إحدى أحياء المدينة، تختبئ بعض البيوت القديمة بين مبان تجارية وشوارع مكتظة، لتطل سوياً على مستوطنة “إسرائيلية” تبعد دقائق من الحدود الوهمية للمدينة. وأمام مرأى عيني، شاهدت أحد هذه البيوت يتعرض للهدم، في مشهد يجسّد التعدّي على حرمة المكان، رأيت المنزل بصورة خماسية الأبعاد: الحائط الخارجي نصف المهدوم، وغرف النوم، والحمامات، و”علاقات” الملابس في إحدى الغرف.
هي خمس مراحل للحزن، للتحول من الشيء الى اللاشيء، مررت بها على مدار أسبوع. ومن وراء الشباك، شاهدت المنزل يتحوّل الى حطام.
أولاً، الإنكار:
علل: لماذا يحوم التراكتور حول البيت؟
في البداية، تنتابك شكوك حول سبب وجود “التراكتور” بالقرب من المنطقة المهدّدة. تتساءل عن الأسباب التي قد تبرّر وجوده، وتفشل في إيجاد إجابة مقنعة. من المستحيل أن يمسي مصير هذا البيت كغيره من البيوت التي دُمرت في السنوات الأخيرة، لتُستبدل بعمارات أو كراجات أو مجمعات تجارية. لو كان البيت معرضاً للهدم، لكانت هناك ضجة إعلامية أو حتى مجتمعية حتى لا يحل به ما حل بغيره.
ثانياً، الغضب:
للحجارة معان عدة في القاموس الفلسطيني، لكن في هذا السيناريو، كان معناها الخذلان. تدرك مصير البيت حين تُهدم أول جدرانه. ترفض تصويره أو حتى النظر إليه لما يسبب لك هذا المنظر من حزن. تشتم الرأسمالية والطمع والبلد. تصرخ اعتراضاً على ما آلت إليه البلاد. تخوض النقاش نفسه عشرات المرات، ولا تفوّت على نفسك فرصة للتذمّر من الموضوع.
ثالثاً، المساومة:
“ممكن صار معهم ظرف، ممكن لزمهم مصاري، بتعرفي قديش قطعة هاي الأرض بتسوى؟”. تحاول أن تتفهّم الظروف والتبريرات، وتفشل في إقناع نفسك بأي منها. في الواقع، تعلم أن البدائل محدودة، فيعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بين الحدود التي رسمها الاستعمار، في أراض قسمها لـ “أ” و”ب” و”ج” ليفرض سلطته عليها، لتُسلب مجدداً تحت هذه المسميات. وبينما تتذمر بسبب منزل هُدم ليُستبدل بعمارة، يعاني سكان مسافر يطا، المكونة من 12 قرية فلسطينية، من خطر التهجير القسري، ليحوّل المستعمر قراهم الى مناطق إطلاق نار، ويقتلع المستعمر ذاته عائلة ابراهيم محمد ناجي من بيتها في كفر الديك ليدمّره أمام عيون أصحابه.
رابعاً وخامساً، الاكتئاب والتقبل:
كل شيء فانٍ، من الضروري أن تكون على يقين بذلك. ستلتهم الحداثة البيوت المتبقّية في الحي، وإن لم يحصل ذلك اليوم، ففي الأيام المقبلة. وإن لم تُهدم، “ستنقذها” البرجزة “gentrification” فتتحوّل الى فندق أو مطعم أو مقهى لتواكب طبيعة التغيرات التي حلّت بالبلاد، فأمسى هذا الملاذ الوحيد والبقاء للأقوى. تؤازرني حالة من العجز أمام هيمنة الحداثة وجبروت الاحتلال.