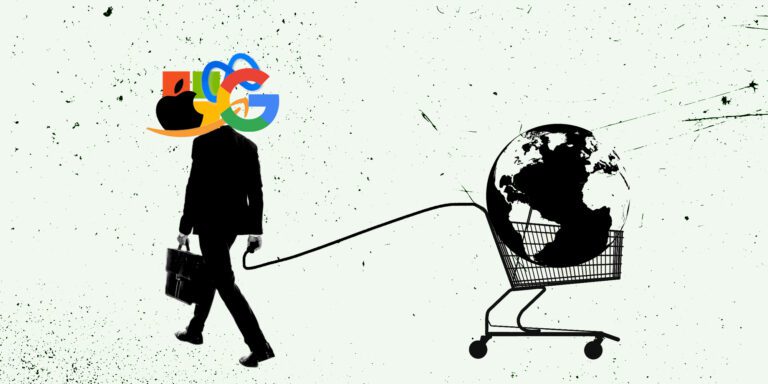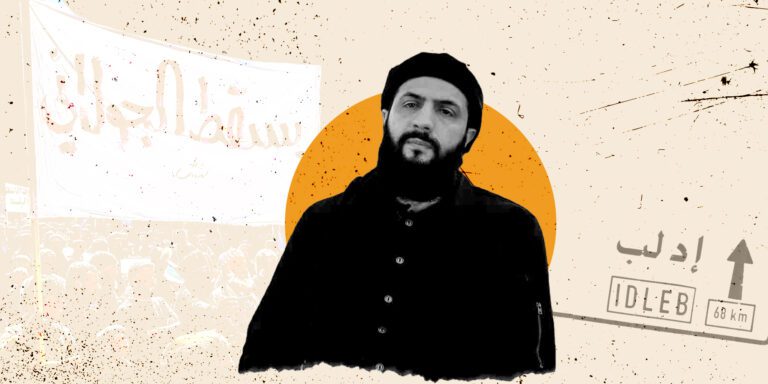في بداية شهر آب/ أغسطس الحالي، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة التقطها لدمشق من الجو، وأرفقها بتعليق على حسابه على “تويتر”: “قلب العروبة النابض. إليكم منظر التقطتُه لدمشق، أقدم عاصمة مأهولة بتاريخ البشرية بأبوابها السبعة وموطن الجامع الأموي ونهر بردى وجبل قاسيون”.
لن تظهرْ في صورة دمشق من الفضاء مشاعرنا أو ذكرياتنا، والأيام التي خفنا فيها من الموت وخبأنا رؤوسنا تحت أيدينا، صور المدن من الفضاء تشير إلى أماكنها لكنها لا تتحدث عنها، إنها الصور التي تتهرب من الحقيقة والألم، صورٌ مأخوذة من أبعد نقطة ممكنة، تبقى أقل من حقيقة أن تكون أنت داخل هذه الصورة.
بعد خروجي من سوريا، وقعت في معضلة دمشق الجميلة، وفي فخ الحنين، الذي اعتقدت أني محمية منه. ففي العام الأول، لم يراودني الحنين الى دمشق، مع بداية العام الثاني وجدت نفسي أمام الصور والذكريات والأماكن كوحش ضعيف، أريد اصطياد ما يسدُّ رمقي من دون أن أقدر على ذلك. دمشق مدينة التناقضات الكبيرة والحادة والمؤذية، دمشق مؤذية حتى بجمالها، هي مدينة الهدوء والفوضى والأمان والخوف والجوع والفقر والاكتفاء والسلام، هي أقدم مدينة مأهولة في العالم، لكنك لو تمشيت فيها عند الفجر ستشعر كما لو أن سكانها تركوها منذ آلاف السنين، البيوت المعتمة والهدوء الذي لا يخترقه سوى صوت العصافير والغربان والحمام الذي يستيقظ مع بداية اللون الأزرق ليومٍ جديد.
في دمشق، حتى الغربان سترافقك في مشاويرك وصباحاتك، المدينة مليئة بالغربان التي تتمشى في حدائقها قرب العشاق، تقف على أعمدة الإنارة وتراقب الناس المتعبة، لا أحد يذكر الغربان حين يتحدث عن ذكرياته.
في باب توما كنت أستيقظ صباحاً على صوت الغربان، لكني لم أكرهها ولم أتنذر شؤماً بها، لذلك كانت هذه المدينة متناقضة ومدهشة لي، إني أشتاق الى غربان دمشق وحمامها.
تخدعك دمشق، تتركك تكتب القصائد عنها، ثم تثبت لك أنك لم تفهمها حتى. كتبت قبل سنوات قصيدة بعنوان “عندما سأترك دمشق”، قلت فيها إني سأغادرها بكل أقدامي، وقد عنيت الكلمة فعلاً، إذ كنت أتوق الى تركها، الى بداية جديدة والى مدينة أقل حزناً. دمشق تمنحك أقداماً كثيرة، بالمعنيين الإيجابي والسلبي، ستحتاج الى كثير من المشاوير لتستوعب كمَّ الجمال فيها، حتى في الأماكن الأكثر بؤساً. إذ تمكن الناس من بناء علاقة مع المكان، وأصبح هناك رابط خفي بين التعب والشوارع والألوان الباهتة في الأحياء الفقيرة، جمالٌ تلعنه لكنه يتسلل الى داخلك ويترك خلفه عاطفة ستؤرقك لزمن طويل. ستؤلمك الأقدام التي تركتها في دمشق إلى الأبد، للأقدام أيضاً ذاكرة، للمشاوير في الشام القديمة وجرمانا ودويلعة والحميدية والمزة ذاكرة.
والفرق، أن العلاقة التي تبنيها مع دمشق لا يتدخل فيها الأشخاص، فهي علاقة مباشرة، لا تلوثها القسوة أو الظلم الذي يمارس عليك، فأنت تحب الأماكن لا لأنك عشت ذكرى جميلة فيها وحسب، بل أيضاً لأنك مررت فيها بتجارب قاسية. ومع الوقت، “تعالج” هذه الأماكن علاقتها بك وتجعلك تسامحها أو هي تسامحك، لا فرق.
في باب توما كنت أستيقظ صباحاً على صوت الغربان، لكني لم أكرهها ولم أتنذر شؤماً بها، لذلك كانت هذه المدينة متناقضة ومدهشة لي، إني أشتاق الى غربان دمشق وحمامها.
الغريب في حنيني إلى دمشق، أني لا أرغب في العودة حقاً الآن، ولا أريد زيارتها في المستقبل، لكني أتمنى لو أني مشيت فيها أكثر، لو أني تعرفت عليها بشكل أعمق، كانت تنقصني آلاف الخطوات فيها.
حين احترق قصر اليوسف في ساروجا، أدركت أني لم أعرف هذه المنطقة كما يجب، ولم أزرها إلا مرات معدودة، وفي إحداها تناولت الفول في أحد المطاعم الشعبية، وفي إحدى المرات، ذهبنا أنا وصديقاتي في الجامعة إلى أحد المقاهي التراثية، وفي أخرى ذهبت إلى منزل الفنان التشكيلي يوسف عبدلكي لإجراء مقابلة معه.
على رغم أني لم أولد في دمشق ولم أكبر فيها، لكني أمضيت فيها السنوات العشر الأخيرة لي في سوريا. وقد انتقلت إليها في بداية تعليمي الجامعي، وكانت مدينة التجارب والفرح والألم، عشت فيها الاكتفاء والخوف والحاجة والفرح والحب. وأول حبّ وأول قبلة لي كانا في دمشق، أول موعد عاطفي كان في دمشق القديمة، ذعر البدايات واللقاءات الأولى والحب النقي كان في دمشق. فكيف أخرج منها وما زالت مشاعري تتمشى في زواريبها وبيوتها التي سكنتها في المزة والدويلعة وباب توما وباب شرقي وجرمانا وحي الأمين! مشاعري ما زالت هناك، في كل البيوت التي تنقلت بينها، في أصغر منزل سكنته في جرمانا وصولاً إلى البيت الشامي الواسع في باب شرقي، قرب “البحرة” وصوت المياه الذي يجري بخفّة ويجعلني أشعر بهذه المدينة بأعمق نقطة داخلي.
في دمشق، جرّبت لحظات الاقتراب من الموت، المشي قربه والضحك بسببه، ففي عام 2018، كانت دمشق ترزح تحت وابل القذائف القادمة من الفصائل المسلحة في الغوطة. وقد كان من الطبيعي أن تشهد وقوع قذيفة قبل مرورك بدقائق، ففي إحدى المرات وبينما كنا ننتظر وسط ساحة باب توما انطلاق سرفيس جرمانا، سقطت قذيفة بالقرب منا فصرخت بصوت عال، نظر شاب كان بجانبي إليّ من دون أن يقول شيئاً، ثم أشاح وجهه عني مراقباً الطريق، وهذا لم يكن مستغرباً في بلد تآلف سكانه مع الموت.
بعد ثوانٍ من انطلاق السرفيس الذي وجد أنه من الآمن الرحيل على الفور، إذ كانت باب توما من أكثر المناطق استهدافاً، صدر صوتٌ أقوى فصرخت مجدداً ونظرتُ نحو الشاب مستفسرة عن نوع الانفجار، فقال: “ردوا عليهن”. كان الناس يميزون بين أصوات القذائف، فالأصوات القوية هي ضربات من الجيش نحو الغوطة، وكان لقذائف الهاون صوت مميز، لا أستطيع شرحه، لكني أعرفه بسهولة. بعد برهة من انطلاق السرفيس، صدر صوت أقوى، وكانت ردة فعلي كما السابق، فنظر الشاب نحوي مبتسماً وقال: “شو رأيك تاخدي سماعاتي!”، وفتح حقيبته ليخرجها، فنظرتُ باستهجان وقلت كمن أخذ أحدٌ حقّه بالخوف: “يعني هيك بموت بدون ما أسمع صوت القذائف!”، وضحكت من قلبي لسبب لا أعرفه، لم أستطع التوقف عن الضحك. كانت فكرة أن أضع سماعات الأذن كي لا أسمع صوت القذائف سريالية تماماً، بينما صمت الشاب وهو ينظر نحوي مستغرباً، ثم انفجر ضاحكاً معي وسط صمت الركاب وصوت القذائف في الخارج.
أسأل نفسي بعد هذا كله، ما الفرق بين مدينة وأخرى؟ ليس الموقع أو تاريخها أو لغة سكانها، بل النظام الذي يحكمها، إذ إننا في عصر نميز فيه المدن والناس والأماكن تبعاً لأنظمتهم، فهناك مدن ديكتاتورية وأخرى ليبرالية وبعضها ذات عدالة مزيفة!
في دمشق، اختلط الشعر مع الحب والموت بكل ما للكلمة من معنى، وقد كتبت مجموعة شعرية عن الحرب والحب، ليس بالمعنى المجازي، بل الحقيقي، إذ كنت أخلطُ الموت بالحب وأتفنن في إيجاد الحب في أكثر الأماكن خطورة.
في عام 2016، كنتُ على موعد مع إحدى المحطات الفضائية لتصوير تقرير عن الشّعر، وحددنا مكاناً في باب توما، عندما وصلت “حمام البكري”، كانت قذيفتان قد نزلتا قبل وصولي بدقائق، وقفت مصدومة أراقب الوجوه المدماة والنادل الذي يتفاخر بالدم على قميصه بعد إسعافه مصاباً، وحدها الفتاة التي نظرت نحوي بوجهها المغطى بالدم ورأسها المائل كانت تود الصراخ. لكن الدم يجعلنا نصمت بينما يصرخ الآخرون علينا، كنتُ وحيدة تماماً، تسمّرت في مكاني، ثم هوت قذيفة قريبة، وكانت المرة الأولى التي أصرخ فيها وأركض للاختباء في أي مكان. وللمصادفة، كان المحل الذي دخلته محل أحذية رجالية! يومها، عرفت أن الصراخ خوفاً لتجدي نفسكِ في محل أحذية رجالية هو التراجيديا بعينها!
اختبأ يومها طاقم التصوير في مطعم قريب، وبعد عودة الهدوء ذهبنا إلى المكان المحدد، وتابعنا التصوير كما أن شيئاً لم يحدث. وفي طريق العودة مساءً، مشيت بهدوء، وكأن خوف الصباح اختفى مع غروب الشمس، كان الجميع يتحدث عن القذائف، إلا شاباً واحداً عاكسني قائلاً: “حلوة بس بتخوفي!”
لا أعلم كيف جمع الصفتين معاً، وكيف كنتُ أبدو بعد يوم طويل من الموت والشعر والحب، حتى الطفلة المشردة التي افترشت الطريق مع أخيها، كانت تخبره عمّا حدث، وأن مروحة السقف سقطت إثر القذيفة. نظرتُ إلى المكان الذي أشارت إليه على أنه السقف، فكانت السماء، ابتسمتُ لها وقلت: “حلوة هذه المدينة لكنها مخيفة!”.