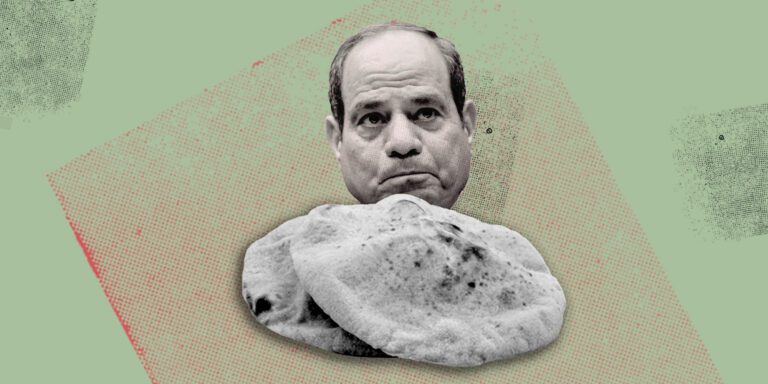مضى على حدث النصيرات أربعة أيام حتى الآن، هذا ليس الحدث الأول لمجزرة تحرير إسرائيل رهائنها في غزة، جاء هذا الحدث بعد أربعة أشهر من حدث مماثل في رفح، في شباط/ فبراير 2024 قتلت إسرائيل أكثر من مائة فلسطيني، كي تحرر اثنين من رهائنها لدى “حماس”.
لم يكن لدي حيلة سوى أن أمتلك ذراعين أكبر من ذراعي، أو أن أصير أخطبوطاً فجأة، كي أحمي عائلتي بين أذرعي، أبي السبعيني وأبناء أخي الذين سألوا ليلتها عن صوت لم يجربوه سابقاً، هو صوت طائرة “كواد كابتر”.
أسميها “قاتل يتسلى” إذ عرفتها في خانيونس فترة نزوحي هناك، على مدار ثلاثة أيام قبل نزوحي إلى رفح بعد خانيونس، كانت الطائرة تتسلى بقتل المارين على الطريق من مستشفى ناصر حتى البحر غرباً، وهو أسلوب إسرائيل بالترهيب، كي تُخلي المنطقة من سكانها ونازحيها، إذ تسمع صوت إطلاق نار فجأة، وما إن تنظر حتى ترى الناس في الطريق جثثاً، أو يحاولون النجاة بالاختباء تحت أي سقف، فلا أحد يعرف مصدر الرصاص أو وجهته، الجميع يهرب فقط.
النصيحة الثابتة في مواجهة ذلك، هي عدم الخروج إلى الشارع، فإسرائيل تقتل كل هدف متحرك.
ليلة حدث رفح، كانت حيلتي أن أستعير أقدام الطبيبة أميرة العسولي، المرأة الطبيبة التي جازفت بحياتها لتنقذ حياة مصاب، فترة حصار الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس، كي أحاول إنقاذ أخي وعائلته وأختي وأبنائها المقيمين في الجهة المقابلة لنا، لأنهم كانوا أكثر قرباً من الخطر.
تجاوزت تحذيراتي ونصائحي للجميع، بألا يخرجوا وإلا سيصبحون هدفاً للطائرة القاتلة، الساعة الآن الثانية بعد منتصف الليل، مضى على الحدث الذي استمر ثلاث ساعات، ربع ساعة فقط، لكنني لم أفكر إلا بأن يتمكن الجميع من النجاة، كي لا أقول بعد قليل: يا ليت! أو كي لا أقف منهزمة أمام خسارة أرواح لا ذنب لها إلا أنها وقفت في طريق الوحش! استطعت أن أساعد في إخلاء العائلتين، نحو مكان توسمنا فيه الأمان حتى الصباح.
بعدها بأيام قليلة، تعرفت إلى السيدة سمر، وهي أم ترعى طفلها قصي البالغ من العمر سنة ونصف، وهو مصاب بمرض “القدم الحنفاء” منذ ولادته، وهو عبارة عن عيب خلقي، لكنها بعد فترة نزوحها من شرق المحافظة الوسطى إلى رفح، اكتشفت أعراض مرض جديد على ابنها، وهو “أكل الأصابع”، في البداية ظننت أن ذلك عارض لمرض نفسي مصاحب لحالة الطفل وإعاقته، فسألتها عنه، فأجابتني بأنه “مرض عضوي، اكتشفته بعد أن نبتت أسنانه هنا في رفح، وهو يبدأ بشعور “تنميل” تحت جلد المفصل، لا يقوى الطفل على حكه، أو تجاوزه بالحد الطبيعي والمعقول، فيلجأ إلى عض الأصابع والمفاصل، حتى يسيل الدم ويقضم طرف الأصبع!”.
أصابني شعور لم أعرف وصفه لحظتها، لكنه تمثل إلي قول “أكل أصابعه ندماً”، لم يخطر ببالي صورة المجاملة بعد طبق مفضل حين تدعوك أمك مثلاً فتقول: “ستأكل أصابعك وراه”، لم يخطر لي هذا الأمر، فقط الصورة الآن أمامي طفل يأكل أصابعه ندماً، لكن أي ندم يصيب طفلاً بعمر السنة ونصف؟!
حيلة سمر الأم، كانت إخفاء أصابع قصي الابن، عبر لفها بشاش طبي، لكن ذلك لم ينهِ وجعه أو يخفف حالته، وهو تجاوز للوجع بوجع آخر أشد صعوبة.
كل مرة تصادفني الأحداث، خلال هذه الأيام؛ أيام الحرب، تقفز إلى ذهني مشاعر لا أعرف كيف أفسرها أو أترجمها، لكنني أحاول تجاوزها بالإسقاط على حدث سابق أو تجربة شعور ما، مع لوحة فنية أو معزوفة موسيقية.
حيلة قد تبدو باذخة، لكنني بحاجة إلى وسيلة تحل محل الشعور المبهم.
مضى على حدث النصيرات أربعة أيام، وأنا أحاول الكتابة عن مشاعري لحظتها، لكني أفشل في كل مرة، لجأت إلى صديق قال لي إن هذا يُسمى “تخمة المشاعر”، وفسرها بأننا ممتلئون بالمشاعر، ولكننا لا نعرف من أين نبدأ…
كان ذلك أفضل ما يمكن لوصف حالتي هذه، وأشد التوجهات صواباً.
اليوم التالي لحدث رفح، عرفت أننا خسرنا في ليلة واحدة بعد ثلاث ساعات فقط، مائة شخص، مائة روح في لحظة، سألت نفسي بعد ما حدث وخروجنا إلى الشارع لنتفقد الحي ونتفقد بعضنا بعضاً: “كيف حدثت النجاة؟ وهل ستستمر؟!” لم أكن أعي أنها ستستمر حتى بعد أربعة أشهر، من حيث أقف الآن، أراقب حركة هروب الناس من شرق المحافظة الوسطى بأكملها؛ والنصيرات خاصة، باتجاه مكان نزوحي في دير البلح، متجمدة المشاعر، لا أعرف هل هو بكاء قد يحدث؟ أم هل هي حسرة؟.
ضجيج كامل يصعد ويلتهم اللحظة كلها دفعة واحدة، ويصعد أكثر نحو رأسي وجسدي!
كنت حين أغضب، أشبّه رأسي بالقطار البخاري قديماً، حين يعلو صوته، كنت أشعر أن بخاراً يخرج من رأسي ودخاناً كثيفاً يعلو أمام عيني، أسمع صوت لهاث الهاربين، أسمع صراخاً وفوضى، انقلبت فيها صورة يوم يبدو طبيعياً في الحرب.
الناس خرجوا إلى السوق، إلى مراكز توزيع المساعدات، إلى العيادات والمستشفيات، ليداووا جرحاً ينزف إثر إصابة سابقة، كل شيء مكتظ أمامي الآن في السوق، الشارع، مراكز المساعدات والإيواء، السيارات والعربات والكارات، كل شيء كل شيء، حتى رأسي وشعوري يفور ويغلي مكتظاً بصوت واحد “اللهاث”.
تذكرت تجربة شعوري الأول وأنا أسمع معزوفة “حدث في العامرية” للعراقي نصير شمة، وهي معزوفة أرشيف تاريخي، لما حدث في ملجأ العامرية في العراق في شباط/ فبراير 1991، حين قصفت القوات الأميركية الملجأ، أعاد شمة المشهد كفيلم صوتي، معتمداً على آلة العود فقط، كجسر يدخلك نحو الحدث ويصور المجرم والضحية، أول مرة سمعتها منذ سنوات، كنت أخشى صوت الإسعاف، الذي يظهر بوضوح، بطريقة تجعلك تصدق أن سيارة إسعاف قادمة نحوك، وأن ضوءها أمامك، وصراخ هاربين دالين على الضحايا ولهاثهم ورائحة دم وغبار، لكنك تسمع فقط، صوت الإسعاف.
تُرى أية معزوفة ستنجح بعد حين، بعزف صوت اللهاث الذي يعلو أمامي الآن؟ هاجمني شعور آخر، تُرى لماذا سيكون شكل الموسيقى موتاً؟ ولم لا تكون المعزوفة على شكل القلب الذي توقف فجأة، في جسد طفل، كان يمضغ لقمته الأخيرة قبل أن يموت وفي فمه اللقمة؟ ماذا غنى طفل في شارع في بلوك 5 في مخيم النصيرات قبل الحدث بدقيقة؟ وفجأة صار صوت قلبه “لهاثاً” ونفساً خائفاً!
أية موسيقى ستُعزف الآن، صوت صراخ صديقي، وهو يشد زوجته كي يهربا، لكنها تقف جامدة لا تتحرك، وترد بأنها ها هي تمشي معه، لكنها جامدة حد الثقل، الذي لم يستطع فيه أن يحملها ويركض بها، وكل ما فعله أنه ألقى بأكياس الخضار، وشدها بيديه الاثنتين نحوه وهربا نحو الغرب!
أي عود يا نصير يعزف هذا الصوت؟
عادت تخمة الشعور مرة أخرى ماثلة أمامي بعد انتهاء الحدث، وأُعلن عن عدد الضحايا: 276 ضحية من أجل تحرير أربع رهائن، تبادلت المواقع صورهم، بل تنافست صور مبتسمة؛ كأنها تغيظ الشعور بداخلي أكثر، حررهم القاتل من بين الضحية، وقتل معهم ما يزيد عمن قتلهم في رفح، مائة مقابل اثنين، ومائتان وأكثر مقابل أربعة، أي شعور يطلع الآن؟
لقد اختبرنا مشاعر لأول مرة تفلت خارج حدود الخيال!!
أذكر لوحة “زحل يلتهم أبناءه” أو “ساتورن يلتهم ابنه” للفنان التشكيلي الإسباني غويا، التي تصور الأسطورة اليونانية، التي تحكي عن الأب الذي خشي أن يطيح به أبناؤه، فقام بأكلهم كلهم عند ولادتهم، تقول بعض الروايات على قلتها، أنه كنعاني الأصل، وبمرور الوقت تم تأليهه، وهو مؤسس مدينة بيليوس أو جبيل اللبنانية.
الأسطورة تمثلت بلوحة فنية، تصور الشكل الآدمي لإنسان، وهي النموذج المحاكي لأب كوكبي بمزاج مجنون، يلتهم ابنه بين يديه، في تخلٍ صادم عن كينونة الأب، حد السطوة التي منحته أن يحمي نفسه، ويلتهم ابنه في أشد المشاهد الخيالية بشاعةَ، فإذا تأملت اللوحة ستغيظك عينا الأب الآكل، كيف تبدو جاحظة أمامك، وفمه ممتلئا بلون الدم، وجسد الابن مقضوم الرأس، وآخر يداه بين يدي الأب الآكل، هي رمزية التعطش السلطوي للقتل من أجل وهم النصر والفوز.
ماثلة أمامي بشعورها هذا، بينما أرى 276 ضحية، يلتهمهم الوحش من أجل أربعة، تخرج صورهم أمامي مبتسمين، بينما الضحايا تخرج صورهم مبتسمة، من زمن سابق لهذه اللحظة، قبل أن يصيروا أمواتاً وأشلاء.
ينتابني شعور قصي الآن، تحت جلد مفاصلي، أريد أن أعض مفاصل أصابعي كلها، بل جسدي كله، كي أحظى بتفسير لحظة الحسرة هذه، حين مر أمامي مقطع فيديو لأب يحمل ابنه الجثة، ويصرخ “لموا ولادنا، ادفنوا ولادنا” بينما ينادي عليه رجل آخر كي يكفنه، فيرد: “بديش أكفنه”.
أريد الآن أن أتحرر من شاش أصابعي الملفوف على يدي وأعضها أكثر، ليس ندماً، بل حسرة، أو لنعتبرها ندماً
لقد تعددت أسباب الندم الآن، لكننا لا نجرؤ كغزيين أن نعض الأصابع خشية انهيار صورة الخارق!
لكن، لنتوقف قليلاً أمام لوحة الموت واللهاث هذه، ونسأل: هل نحن أبناء زحل الذين أكلنا آباؤنا؟ وماذا لو كان معي عود نصير شمة؟ بعد حين ما هو الصوت الذي سيؤرشف معزوفة اسمها: حدث في النصيرات؟.