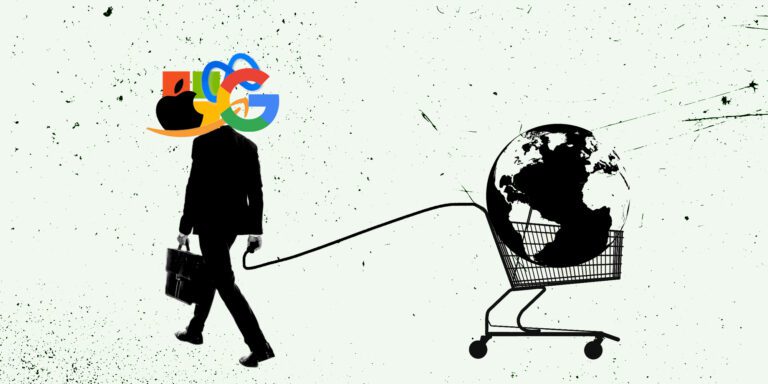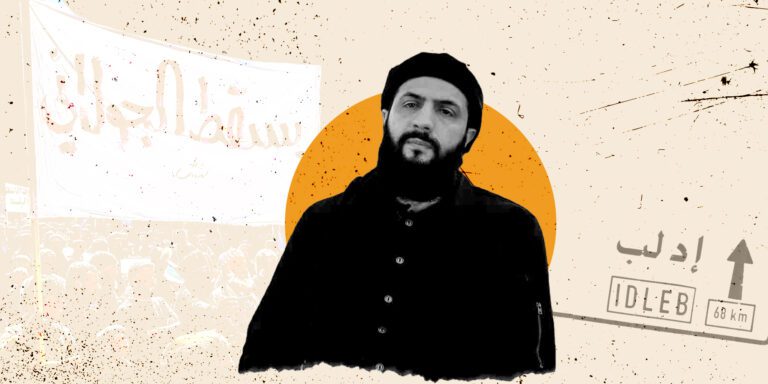قالت لي: كلما سمعت بامرأة قتلت زوجها، أشعر بأن الحياة قد سدّدت لي بعضاً من ديوني المستحقّة عليها، فثمّة امرأة لا داعي لمعرفة اسمها ولا دوافعها، انتقمت لي شخصياً، وحقّقت على الأرض قليلاً من العدالة، منعني جُبني من أن أسعى إليها. لكن، عليّ أن أتردد بالإفصاح عن مشاعري، ذاك أنني أمام جريمة موصوفة، تبدلت فيها الأدوار، فالقاتل امرأة وقتيلها رجل. والجريمة على بشاعتها استدرجتني إلى التأمل بنفسي.
للأسف يا صديقتي، لقد جبنت عن قتله، كبتّ رغبتي في الانتقام، لأني كمعظم النساء، في هذا الجزء المعتم من الكرة الأرضية، رصيدي من استخدام العنف تجاه الآخر، يلامس الصفر، حتى إن كان استخدامه بغرض الدفاع عن النفس.
نشأت على مفهوم تقبّل عنف الآخرين، كل الآخرين، ضدي، والتصالح معه، لأن هناك من يعتبره اعتراضاً، يحمل بداخله بذور رفض لتعاليم الدين ومنظومة القيم والأخلاق والتربية، ولأني امرأة، كان عليّ أن أتقبّل عنفهم المقدّس، وإلا أصبح الاعتراض صنو الكفر.
تخبرني بينما تتبدل ملامحي: هوّني عليك، فصديقتك ليست ذات طبيعة إجرامية، أحياناً لقلّة حيلتي أجد في أخبار كهذه نوعاً من التطبيب النفسي لمعالجة نوبات الغضب والصداع والاكتئاب التي تلازمني بسبب الظلم الذي سكتّ عنه، فكلما كان إحساس الواحدة منا بالظلم عميقاً، كلما كان عدم تعاطفها مع رجل مقتول عميقاً أيضاً.

أتعلمين؟! حين قرأت الخبر (امرأة دسّت السمّ لزوجها في طبق الملوخية وقتلته) مسحت براحة يدي، لا شعورياً، على فروة رأسي، الشاهدة على أيام السحل، على أذني التي عطبها في إحدى ثورات غضبه، على كتفي الأيمن المصاب بإعاقة دائمة، ثم وضعتها على قلبي لتطمئن جرحاً غائراً لم يلتئم إلى الآن.
أتذكرين يوم جُنّ جنونه لأني طلبت الطلاق؟ مخلوق استثنائي مثله، ترفضه حشرة غير مرئية مثلي! كان يجب أن أظلّ راكعة أصلّي عند قدميه، أقدّم العطايا والقرابين والذبائح حتى يرضى، ولا أدري كيف ومتى يرضى!
أتذكرين أنني لم أنجُ منه حتى بعد طلاقي؟ ظلّ يلاحقني حيثما أذهب، يتبعني إلى مكان عملي، وبيوت أصدقائي، يشتمني، يبصق عليّ، يرميني بالقاذورات، يضع الحجارة أمام سيارتي، ويهددني بممارسة المزيد من العنف الجسدي واللفظي، وبأن يحوّل حياتي إلى جحيم.
أتذكرين أوّل إنجازاته التي تفاخر بها وما زال بعد الطلاق؟ عدا إجباري على التخلّي عن كامل حقوقي، بمساعدة الشيخ الوقور في المحكمة الدينية، حرمني من حضانة بناتي الثلاث ورؤيتهن، كنّ جميعهن في سن الحضانة، لكنه والشيخ الوقور والعائلة والبيئة الحاضنة، يعني الله والوطن والعائلة، أقرّوا عدم أهليتي لتربيتهن تربية صالحة، لأني كافرة، لا أصلّي ولا أصوم ولا أذهب إلى الحسينية، ولا ألبس الأسود في عاشوراء، ولأني سافرة، غير محجبة، أي مجرّد قطعة حلوى يغطيها الذباب، ولأني امرأة عاملة، أي فاسقة، أمارس الاختلاط، ولأني قبل هذا كله، رضيت بالعنف، سكتّ منذ اليوم الأوّل، لأني اعتبرت الزواج وإن كان جريمة يومية، ستراً، والطلاق وإن كان نجاة، فضيحة.
أتعلمين؟ أنا لست ضحيته وحده، أنا ضحية نفسي أولاً، وضحية منظومة دينية واجتماعية وسياسية وثقافية، لا يمكن خرقها، حتى من السماء.
لم أكن وحدي الضحية، بناتي أيضاً، عشنا سبعة عشر عاماً من دون لقاء، ثم التقينا بعدما حوّلنا البعد والعرف والشرع الحكيم إلى مجرد أربع نساء غريبات، هنّ لا يعرفنني إلا بما تلقّنه من مساوئ عني، وأنا لا أعرف عن عالمهن شيئاً، لا يربطني بهنّ سوى شبه يدل على القربى، لا على الأمومة، صلة الرحم بيننا مقطوعة بالكامل، حاولت وصلها، وهنّ حاولن، لكننا لم نصل الى نتيجة.
فتّشن عني بعدما تجاوزن سنّ الرشد، أتين بعدما كبرن بعيداً عن عينيّ وذراعيّ ويديّ وحضني، بعدما تشظّى رحمي، بعدما انتهت حاجتهن العاطفية الى وجود أمّ.
حالياً، نعيش معاً في منزل فشلنا في جعله بيتاً، أحاديثنا القليلة قائمة على الأسئلة والإجابات كأننا نجري مقابلات، ما زلنا نستكشف عوالمنا المختلفة، مثل شخصين تعارفا للتو، وينويان أن يكملا حياتهما معاً، علاقتنا فيها مسايرة وتكلّف، ولا واحدة منا على سجيّتها، نستخدم في تخاطبنا اليومي الكثير من عبارات المجاملة، تمرّ أيّام ينسين فيها وجودي، اعتدن على عدمه، أنا أيضاً أنسى، لا غرابة في ذلك، فالأمومة والبنوّة مسارا عشرة طويلان، يراكمان توازياً، كماً من المشاعر والأحداث والمواقف والأوقات السعيدة والتعيسة والروائح والأصوات والمشاهدات والحميميات، وليسا صندوق مفاجآت.
أتظنين يا صديقتي بأن الأيام كفيلة بترميم هذه الفجوة العاطفية بيني وبينهن؟ لا أريد إجابة، فأنا أسأل سؤال العارف، الأيام لن تعيدهن صغيرات، حتى يكبرن على يديّ كما أشاء، لكن كلّ يوم يمرّ، ونحن بعيدات عن هذا المجتمع، الذي لم يقدّم لنا سوى الحرمان والظلم والعنف، هو بمثابة بناء وليس ترميماً لعواطفنا، هو انتصار لإنسانيتنا لكوننا نساء.
سعيدات بحياتنا الجديدة المتأخرة، التي بدأناها في بلاد الغرب الكافر، حيث الناس سواسية كأسنان المشط، كما قال نبيّكم، هنا نتمتّع بقانون إنساني يحمي النساء والأطفال، بالطبابة المجانية، بالتعليم المجاني، بالشيخوخة المضمونة، نستمتع بالطبيعة المحمية بالقانون أيضاً، بأنظمة السير والبناء والبيع والشراء، والغذاء والماء والهواء النقي، ونمارس بحريتنا المكفولة من الدولة، العمل والتنزّه والرياضة والسباحة والرقص والغناء والحبّ.
إقرأوا أيضاً:
يا صديقتي، هنيئاً لهنّ ولك، بنجاتكنّ من الحرب المفتوحة على النساء، في بلادنا، لكن، رغم تعاطفي معك، ما زلت أعدّ الانتقام بالقتل عملاً خسيساً، والتعاطف مع القاتل، بناء على هويته، هفوة حضارية، كما القتل.
الانتقام تصرّف صحي، هكذا تراودني مخيلتي المعذّبة، ولو أنه يُشفي ولا يُجدي، أما أن يعالج قتل رجل في آخر الدنيا، بطريقة بشعة، جرحاً نفسياً لامرأة لا تعرفه ولا يعرفها، فهذا دائرة عنف خطرة للغاية، إذا بدأت، لن تنتهي إلا بانهيار إضافي في بناء الإنسانية.
ثمة نساء ينفّذن كل ليلة جرائم في خيالهن، وأنا واحدة منهم، لكنهن في اليوم التالي، يخرجن إلى الطريق بكامل براءتهن.
الأقنعة انتقام أيضاً، تعلّمي كيف تضعين كل يوم قناعاً جديداً، بكلمة أخرى تعلّمي الكذب، أكذبي أكذبي، إذا أتقنت هذه المهارة، ستنتقمين منهم بوقاحة، سيكون الكذب نجاة لك، وسجناً لهم.
أرجوك يا صديقتي، لست بحاجة إلى من يذكّرني بأن هذه الأحاسيس غير إنسانية، هي كذلك، لكنها ليست خارج نطاق الطبيعة البشرية، فأيّ إنسان يتعرّض لمعاملة غير عادلة، بشكل دائم وطويل، تتحرّك في داخله طبيعة الانتقام، الرغبة في تحصيل العدل بالقوّة، في تلقين الآخر درساً في احترام إنسانيته، فيحصل ما يحصل، على هذه الأرض، لا ينجو من الظلم والقهر إلا القاتل، أما المقتول فمثواه الجنة، فوق.