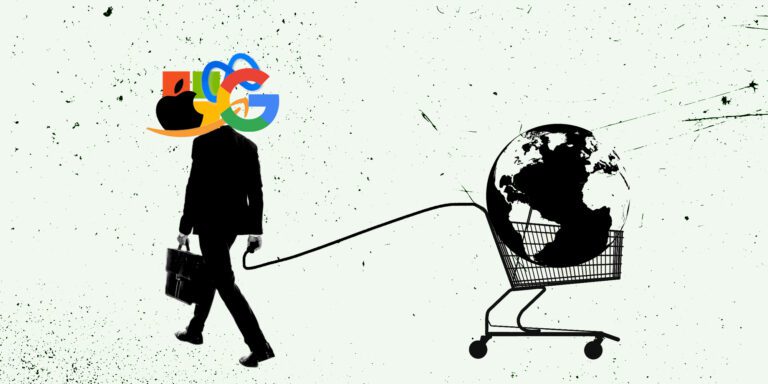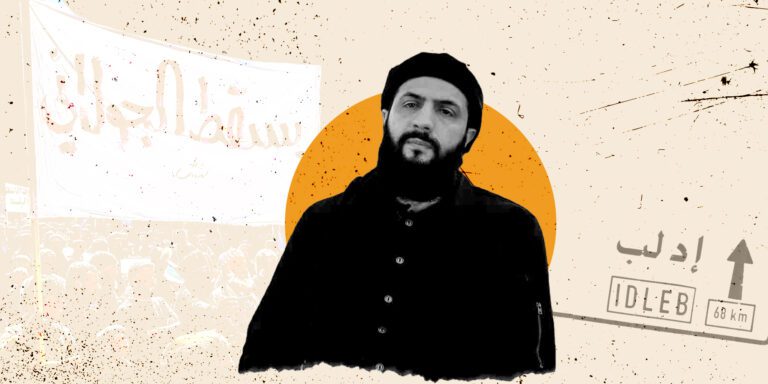خلّفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 16 ألف قتيل وأكثر من ضعفهم من الجرحى، وما يزيد عن 7000 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة، ولا يني جنرالات إسرائيل يتحدثون عن تجنّب قتل المدنيين كمؤشر الى أخلاقية جيشهم. هذا ادعاء يستدعي سؤالاً افتراضياً عن حصيلة تلك الحرب في ما لو خاضتها إسرائيل مجرّدة من الأخلاق؟
سيكون الفلسطينيون، والحال هذه، ضحية معيار إسرائيلي يتأرجح بين المجزرة بوجودها، وبين الإبادة في انعدامها.
الهدنة القصيرة للحرب الراهنة على قطاع غزة، أفضت أيضاً إلى حرب أخرى يخوضها طرفاها، إسرائيل و”حركة حماس”، بأثر كل تلك الوقائع الدموية. إنها الحرب الأخلاقية، وقد استدعى سياقها مشهديات يحاول الطرفان تسييلها في الوجدان العالمي كمآل من مآلات تلك الحرب.
إسرائيلياً، ومع أن الادعاء الأخلاقي يتبدى كوقاحة موصوفة، لا يني سياسيو الدولة العبرية، كما جنرالات حربها، يكثفون ادعاءً مبستراً عن حقيقة جيشهم أنه الجيش الأكثر أخلاقاً.
تهافت الادعاء المذكور لم تفضِ إليه حرب غزة الراهنة، لكنه يتأتى من مسار إجرامي يمتد إلى ما قبل إعلان دولة إسرائيل في العام 1948. لكن وقائع حرب غزة كثّفته إلى معنى صار معه هذا الادعاء جريمة بحد ذاتها، وأن محاسبة إسرائيل، لو قيض أمر محاسبتها، يُفترض أن تباشر من ادعاء كهذا.
في إسرائيل إذاً، من لا يزال يراكم بعداً أخلاقياً لحرب بدت منذ لحظتها الأولى أنها تُخاض ضد الشعب الفلسطيني أكثر مما هي ضد “حركة حماس”، وأن إخضاع الأخيرة يتأتى بالضرورة من “المثابرة” على القتل الأعمى، والذي تبدت عدمية مآله مع حركة قطعت أصلاً ضريبة الدم مع “شعبها” منذ مباشرة الحرب.
في الهدنة المحدودة التي وقعت قبل أن تُستأنف الحرب الشرسة، انساقت “حماس” إلى “الحرب الأخلاقية”، وأتاح لها تبادل الأسرى والرهائن الاندفاع إلى تلك الحرب في محاولة لاستلاب وجدان عالمي مؤطر أصلاً لصالح إسرائيل. فكيف وأن وجداناً كهذا تكثفت فيه مشاهد ارتكابات يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (عملية طوفان الأقصى)، بوقائعه حيناً، وبالدعاية الإسرائيلية المضلِّلة عنه أحياناً.
فباستثناء موقعها الإيجابي في الوعي الممانع، كانت “حماس” تندرج سلباً في وعي عالمي غالب. وعملية “طوفان الأقصى” كثفت هذه السلبية إلى الحد الذي بدا فيه استئصالها مطلباً لم تعد تتفرد فيه الدولة العبرية وحدها.
أتت عملية تبادل الأسرى والرهائن، وتبدل المزاج العالمي من حرب اتخذت طابعاً دموياً هائلاً، لتسعف “حماس” في مراودة الوجدان العالمي، والتخفف أقله من تداعيات ذلك “الطوفان”.
كان الأسرى من الأطفال والنساء يخضعون لمعاملة حسنة. هذا ما وشىت به مشاهد الإفراج عنهم ووقائعه. وافتراض العكس يفنده على الأرجح أنهم امتلكوا حريتهم راهناً، وأن باستطاعتهم تهفيت ادعاء آسريهم، ولم يفعلوا.
عموماً، تقصّي الأثر الأخلاقي لمشهدية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، في غير وعي الممانعين، يبدو ضئيلاً، ثم إن إدراجه في قياس تبدل مزاج الرأي العام العالمي من الحرب على غزة، يبدو أكثر ضآلة. والحال، نحن أمام مزاج تبدّل على وقع مشاهد القتل والدمار الذي تنكبته إسرائيل.
لكن تسييل مشهدية “حماس” أخلاقياً عند الممانعين أفضى إلى تفاعل سريع مع وقائعها. تفاعل تبدى بأنماط مختلفة التقت على تكثيف البعد الإنساني فيها، مرةً بمقاربة أريد لها أن تُثمَّر في “الحرب الأخلاقية”ْ ، وأخرى ذهبت بالمخيلة إلى حدود الخرافة.
والأخف مشقة على النفس أن يباشر المرء المقاربتين من الثانية وقد أفضت إلى صنع مناخ نفسي تواطأت فيه الأخلاق مع عبث المشاعر. وهذه عموماً كانت حال جمهور الممانعة.
المشهد الذي أرادته “حماس” أخلاقياً معلناً، أضفى على مخيلة الجمهور الممانع ما هو أبعد من الأخلاق، واتسع لصناعة حبكة “عاطفية” بين الآسر والرهينة. إنها مخيلة المثقلين بصورة “الفارس” الذي أُريد لمقاتل “حماس” أن يكونه في موازاة الجندي الإسرائيلي “المفعم” بالقتل.
غالب الظن أن جمهوراً كهذا لم يقرأ ديوان “حالة حصار” للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وتحديداً قصيدة “إلى قاتل آخر”، لكنهم اقتربوا منه في تأويل فوضوي للحواس بين حدثي حصار “رام الله” في العام 2002 (تاريخ كتابة الديوان)، و مشهد المقاتل “الحمساوي” والفتاة الإسرائيلية الأسيرة راهناً.
اختلقت مخيلة محمود درويش عاطفة مقتولة كان يفترض أن تسيل في جيل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كان الشاعر مثقلاً بالسياسة لا شك، ومتماهياً حتى في الحصار مع خيار السلام الذي ذهب إليه الرئيس الفلسطيني (المحاصر) ياسر عرفات.
مخيلة الممانعين تقاطعت مع الصورة الشعرية لدرويش، لكن التباين بين المخيلتين هو في المناخ العام للصورة المختلقة في الحالتين، أي بين “حب” مفترض هو نتاج السلم، وبين “حب” متوهم هو نتاج مخيلة استدعت عبث العاطفة إلى “الحرب الأخلاقية”.
المقاربة الأخرى ابتعدت عن “يوتوبيا” المشاعر، وانحصر مدلولها في مقارعة الادعاء الأخلاقي الإسرائيلي، والذي سهل انعدامه على “حركة حماس” أن تصنع مشهدية أخلاقية بدت في وقائعها وطقوسها مُنتجها الوحيد للتخفف من آثار المقتلة الإسرائيلية أمام العالم، وأمام الشعب الفلسطيني.
مشهدية “حماس” الأخلاقية لم تنطوِ بلا أثر رجعي عن موقع الحركة الإسلامية في فلسطين نفسها. “ليت حماس تتعامل معنا كما تعاملت مع الأسرى الإسرائيليين”. هذه “تغريدة” تفاعل معها فلسطينيون كثر، وكانت على الأرجح مؤشراً الى الانقسام الفلسطيني وخياراته، والأهم أنها مؤشر الى الفضاء المغلق الذي تفرضه “حماس” على شعب فلسطين ممن لا يشاطرونها موقعها السياسي.
إقرأوا أيضاً: