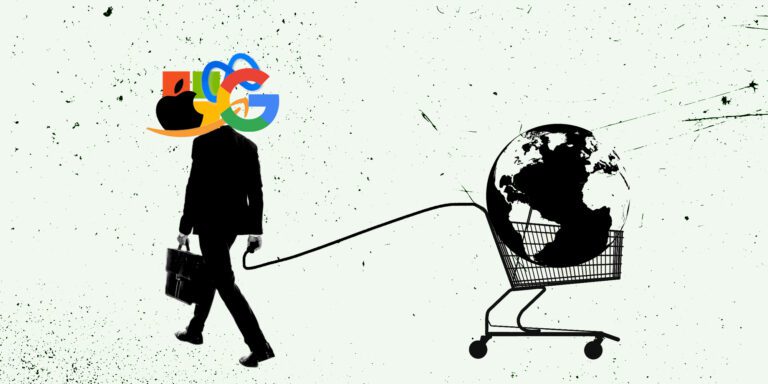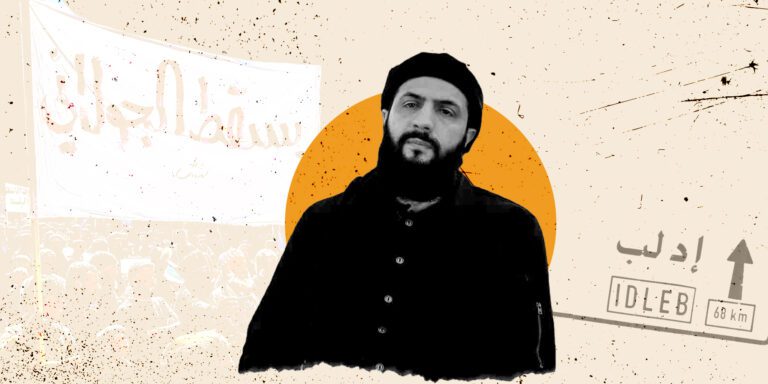قبل ثلاثة أعوام، نشرت مقالاً هنا في “درج”، عنوانه: “هذه ليست لوحة فنية…” (11/10/2021)، تحدثت فيه عن صورة مزدوجة لغزّة. الأولى، تمثلت بحشد كبير من الشباب يتدافعون أمام كوة مكتب لتقديم طلبات العمل في إسرائيل (قبل الحرب كان ثمة 200 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، منهم 20 ألفاً من غزة)، وكان مرجحاً أن يزداد العدد، بل وأن يتضاعف، بسبب ضآلة فرص العمل، وارتفاع نسبة البطالة، وتالياً الفقر، بين الشباب في الأراضي المحتلة، بخاصة في قطاع غزة، قليل الموارد والمحاصر منذ 17 عاماً.
بالطبع، لا يدرك هؤلاء أنهم يعملون في إسرائيل، العدو الذي استولى على أراضيهم ويحاصرهم ويعتدي عليهم، هم يدركون فقط أن العمل لتحصيل قوت يومهم هو شرط حياتي لبقائهم في أرضهم، وأنه أحد أهم أشكال مقاومة إسرائيل، التي تريد سلبهم أرضهم وإخراجهم منها.
ويفيد التنويه هنا بأن المكتب المذكور كان يعمل بمعرفة سلطة “حماس”، وأن تلك الحركة تحصل على موارد مالية مباشرة من قطر، بمعرفة إسرائيل وبتنسيق معها أيضاً.
أما الصورة الثانية، فتتمثل بـ “مسيرات الاستعراض العسكري، وصور الصواريخ المنطلقة من غزة، وإطلالات “أبو عبيدة” إبان كل حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على غزة، متوعداً إياها بزلزلة الأرض من تحت أقدامها، وواعداً الفلسطينيين بفرض شروط المقاومة (ميناء في غزة وفتح المعابر ورفع الحصار وإعادة الإعمار)، من دون أن يحصل أي شيء من هذا أو ذاك، لا في الحرب الأولى (2008) ولا في الرابعة (أيار/ مايو 2021)”.
في ذاك المقال، طرحت إشكالية التناقض بين الصورتين، وبين اعتماد فلسطينيي غزة في كل شيء تقريباً على إسرائيل (ماء وكهرباء ووقود ومواد تموينية وطبّية)، والدخول في الوقت نفسه في حرب صاروخية معها، علماً أن ثمة خيارات أخرى للمقاومة، سواء كانت شعبية ومدنية أو مسلحة، وهو ما يجري في الضفة مثلاً.
أخيراً، وطوال خمسة أشهر تقريباً من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، برز ذلك التناقض بشكل حاد ومأساوي، بين ما تفعله إسرائيل في غزة، في البشر والشجر والحجر، مع قطع الماء والكهرباء والوقود والدواء، عن الفلسطينيين، وتجريف طرق غزة، وتدمير بيوتها وعمرانها، وتشريد مليوني فلسطيني، مع ضحايا يزيد عددهم عن مئة ألف، كقتلى وجرحى ومعتقلين (8000 معتقل جديد من الضفة لوحدها خلال الحرب) ومفقودين تحت الركام، وبين فيديوات وصور عمليات المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
في الغضون، كان صوت المقاومة مسموعاً، وفيديوات كتائب القسام رائجة في نشرات محطات فضائية واسعة الانتشار، في حين أن صوت الفلسطيني البسيط، الذي خسر كل شيء، لا أحد يسمعه، تقريباً، سوى في وسائل التواصل الاجتماعي، على رغم أنه هو الذي دفع الثمن الأكبر لحرب الإبادة الإسرائيلية أساساً، التي حصلت بعد العملية الهجومية الكبيرة لحماس.
ومن خلال متابعتي المباشرة مع أصدقاء في غزة، وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، بدا لي أن ثمة وجهة نظر تستحق الحضور، لا سيما مع مقولات لبعض مسؤولي حماس، ضارة وخاطئة وتقوض صدقية المقاومة ذاتها، كالقول إن المقاومة بخير، وإن إسرائيل لم تحقق أهدافها وستضرب وتدمّر لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبعدها لن تستطيع القضاء على المقاومة، وأن الفلسطينيين ليس لديهم ما يخسرونه، كأن حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل لا تؤثر على “حماس”، أو كأن استهداف الشعب الفلسطيني أمر عادي وبسيط، لكأنه يجري في بلد آخر، ولشعب آخر، وكأن خسارة أب أو ابن أو أم أو إبنة، أو خسارة شخص يده أو رجله، أو خسارة بيته وأملاكه ومصادر رزقه، لا يعد شيئاً، أو لا يفترض حسابه من أجل “القضيةّ”!
ولئن أتت خطابات بعض مسؤولي “حماس” على هذا النحو، فقد جاءت كتابات فلسطينيين في غزة مشحونة بالألم والقهر والغضب، وكانت قاسية ومحبطة وساخرة أيضاً، من إسرائيل ومن العالم العربي، ومن دول العالم، ومن الحركة الوطنية الفلسطينية ومن “حماس” أيضاً.
كان الهاجس الأساسي أو القاسم المشترك بين معظم تلك الكتابات، الألم الذي لا يمكن وصفه بالكلمات، والسؤال المحير عن وضع غزة في مرمى حرب الإبادة الإسرائيلية، وقد شمل ذلك التساؤل عن الخذلان العربي والدولي.
في هذا الإطار، لخّص عبد الكريم الأشقر (24/2) الوضع بكلمات قليلة: “كنا بدنا نضم الغلاف لغزة – قام الغلاف ضم غزة للغلاف… كنا بدنا نحرر فلسطين – احتلوا هم غزة… كنا رايحين على القدس – صرنا في رفح … كنا نريد الدولة والتنمية – أصبح أسمى الأماني الخيمة… كنا نريد رفع الحصار عن غزة – هدمت غزة ولم تعد صالحة للعيش… نحن لا نهزم ولكن يمكن أن نندثر… إحنا يتامى مغامرات متراكمة وفشل سياسي”.
وكتب نضال أبو شريعة (20/2): “أمس، ذهبت أبحث عن كيس طحين مثل عشرات الآلاف… في جو ممطر ورياح شديدة وبرد شديد وطبعاً شوارع لا توصف… الحمير والبغال لا تستطيع المشي فيها والزنانات (نوع طائرات تصدر ضجيجاً شديداً) وقصف الدبابات وإطلاق النار فوق رؤوسنا، لكن الجوع دفع الجموع الزاحفة نحو الطحين… وصلت الشاحنات الى النقطة التي تسيطر عليها دبابات الاحتلال، وفي هذه اللحظة انهمرت الرشاشات… وسقط العشرات… وفي نهاية المطاف اقتربت الشاحنات، وعلى بعد فقط 100 متر من نقطة الجيش كانت 6 شاحنات فقط محمّلة بالطحين، وفي أقل من 10 دقائق كانت فارغة بالكامل. وبتقديري، كانت تحمل 10 آلاف كيس، لكن عدد الناس كان لا يقل عن 120 الى 140 ألف شخص”.
أما الشاعر والكاتب الساخر أكرم الصوراني(15/2)، فقال: “لا وقت لدينا الآن لوصف حالتنا التي لا توصف، نُجهّز الحطب والنار، ونغلي الماء، ثم لا نجد ما نطبخه، نطبخ كل شيء إلا الطبيخ، نأكل كل شيء عدا الأكل، ما زلنا بحاجه لخبرة في الطبخ وفي التعرّف من جديد على طعم اللحم، رغم اللحم المسفوح في الطرقات، لا وقت الآن، جداً نحن مشغولون، وفارغون، ‘فاضيين أعمال’ أو كما أُحب أن أُردّد ‘وإحنا شو ورانا.. ورانا حرب’، الوقت من دم، سندفن جثة مجهولة الهوية، تحت شجرة مجهولة الهوية، لا وقت الآن، لا ماء، لا كهرباء، ولا سكر في المدينة، صواني المجدّرة والمعكرونة تجتاح خيم النازحين، وسط معركة أَشبَه بــ ‘معركة ذات الصواني’، ولا صوت يعلو فوق صوت المعلقة… بعد أربع ساعات من الانتظار، تذكرت أنّي نسيت هويتي في الخيمة، ويبدو أن جيراني المشرّدين هم الآخرون نسيوا هويتهم أيضاً في الخيمة… خيمة تخيّبنا!”.
وعن الضياع والتنقل من منطقة إلى أخرى، كتبت كوثر أبو هاني (12/2): “كلمت أهلي بعد القيامة في رفح، لقيتهم عاملين قيامة ثانية… مشاكل وهستيريا وضياع. أختي وزوجها وأهله وكل الأبناء بدهم يفكّوا الخيم ويحملوها وينزحوا، ما حدا بيعرف لوين! أمي بدها تنزح معهم، قالت بانكسار ‘يما لخّة الوضع (أي معقد). أبوك بطل يمشي عشان المرض تطور وما في أدوية وبدنا نلحق الشباب يحملوه مع الخيم’. أختي الثانية، تتهاوى وتتآكل، تشاجرت مع أمي بغضب شديد وتريد إجبارها على البقاء. أمي ليست في وضع تفهّم مشاعر ابنتها الخائفة، جميعهم مضطربون. أختي خائفة من البقاء وحيدة مع أطفالها في الخيمة في رفح التي لم تعد آمنة. كلهم تائهون ومنكسرون. أكبر انكسار هو حمل الخيمة والأب معاً والنزوح إلى المجهول.
“كنا بدنا نضم الغلاف لغزة – قام الغلاف ضم غزة للغلاف… كنا بدنا نحرر فلسطين – احتلوا هم غزة… كنا رايحين على القدس – صرنا في رفح …”
المحامية فاطمة عاشور، حاولت تلخيص الخيارات الصعبة أو الاضطرارية لفلسطينيي غزة، فكتبت (2/12): “الخيارات الصعبة التي وضعتنا إسرائيل فيها مرعبة ومحرجة ومربكة، الخيار الأول واقعة فيه مصر للأسف يا ترى تقفل المعبر عشان القضية ولا تخليهم يموتوا جوا من سكات واديني بنديهم شويه أكل وأسمنا فاتحين المعبر! الخيار الثاني إنه مش قادرين نحكي رأينا الحقيقي في حماس عشان المنسق الإسرائيلي بياخد كلامنا ويحطه في صفحته وبنطلع كأنه متفقين وده طبعاً مش حقيقي، بس سكوتنا مش معناه إننا موافقين أو عاجبنا. الخيار الثالث تسافر وتنفد بروحك ولا تضل وتنقصف ده في أحسن الأحوال بس الإشي إلي ما بنحكي عنه إنك بتعيش علي مدار الثانية، مش الساعة، على مدار الثانية، جعان وبردان وحزين وخايف ولا حول و لا قوة لك ولا تضلك مع أهلك وصحابك… وإذا طلعت هتتلام وهتزعل وهتندم وهتطلع وحش في عين كتار وفي عين نفسك كمان، في رحلة من جلد الذات ما بتخلص هادي خيارات بشعة بشعة جدا… تختار تعيش ألف ألف ألف موتة ويمكن تضل عايش بكمية وجع الله وحده الي ممكن يداويه ولا تغادر بلدك الي بتحبها مهما واجهت فيها”.
وذهب مروان أبو ثريا إلى طرح أسئلة تبعث على المرارة والألم، (5/2) بدأها بمقدمة قال فيها: “ليس هناك أكثر جهلاً وغباءً ممن يقول بأن إسرائيل خسرت الحرب لأنها لم تقضِ على حركة حماس. أيهما أهم بالنسبة الى إسرائيل: تدمير شعب أم تدمير تنظيم؟ هل تعلمون ماذا فعلت بنا إسرائيل؟ إسرائيل دمرت الشعب ونكبته في كل تفاصيل حياته. وجعلت الموت هو الخيار الأرحم بالنسبة إليه. إن اسرائيل لم تدمر البيوت فقط ولم تدمر البنى التحتية فقط، ولم تقتل وتجرح أكثر من 100 ألف فقط… ولم تهجر الشعب فقط. بحيث جعلت ثلاثة أرباعه مهجرين. إنها دمرت البنية الأخلاقية في المجتمع. حولت النظام الاجتماعي الحضاري إلى نظام حيواني غرائزي ليس له علاقة بالإنسانية. تحكمه شريعة الغاب ويلتهم القوي فيه الضعيف. ماذا يعني أن تُسرق المساعدات الإنسانية والإغاثات ويتم بيعها في الأسواق؟ ماذا عن السطو والاستغلال؟ وماذا يعني أن تشتري طبق البيض بمائة شيكل وكيلوغرام البصل بـ 40 شيكل والخيمة بـ 2000 شيكل لناس معدمين”.
في الوقت ذاته، سأل حسن الداوودي (27/2): “ما الذي لا نراه ويرونه يرفع المعنويات في مشهد عناصره: إعادة احتلال قطاع غزة، فقدان ثلاثة أرباع المباني، تشريد ثمانية أعشار السكان، ظروف لا آدمية لكل السكان (طوابير دورات مياه حتى طوابير الخبز وأمراض وجوع وبرد)، كل ساعة خيار الهجرة الطوعية ينفرد بكل فرد إن لم يسبقه تهجير قسري، إبادة عائلات وتخريج أفواج أرامل ويتامى، في النكبة أيضاً كان هناك رصاص يصيب الجنود، لكن النتيجة جعلتها نكبة وإلا لو كنتم أونلاين آنذاك لسميتموها طوفاناً”.
كذلك، عرض سعيد الكحلوت حالته، كعينة لحال معظم أهل غزة، فكتب (14/12/2023): “إسمي سعيد محمد الكحلوت متزوج ولدي أربعة أطفال. أحمل درجة الدكتواره في الصحة النفسية، وأحب عملي جداً، بل أمارسه كهواية. أنا أيضا كاتب وقاص أكتب المقالات والقصص القصيرة ولي كتب منشورة… لي بيت جميل تبلغ مساحته ٢٢٠٠ متر مربع، اعتنيت جداً في تفاصيل بنائه، في داخله مكتبة تحتوي على 878 كتاباً، أحفظ أسماءها كما أحفظ أسماء أطفالي. في العاشر من أكتوبر الماضي، أي ثالث يوم الحرب، انقلبت حياتي رأساً على عقب. دمرت الطائرات المقاتلة البيت وحوّلته إلى ركام وضاعت كتبي بين الحجر والحديد. وأمسيت أنا وأسرتي مُشردين نبحث عن مأوى نحمي به أجسادنا وأحلامنا من شظايا القصف. الآن وبعد أكثر من ستين يوماً من الحرب، أعيش مرة أخرى تجربة اللجوء التي عاشها أجدادي قبل 76 سنة، وقد سجلتُ في مدرسة للنازحين. أصلي الفجر ثم أسير في الظلام، تنبح علينا الكلاب الضالة، ويعضنا البرد القارس، أحمل في يدي عبوات كبيرة وأتوجه لمحطة المياه، أصطف في طابور طويل جداً، يقول الرجل الأول فيه إنه أتى هنا منذ منتصف ليل الأمس. بعد ساعتين، أحصل على 32 ليتراً تقريباً من المياه، أحمل عبواتها بيدين مُجردتين وأعود لاهثاً لمكان لجوئي بعد قطع مسافة تصل إلى كيلومتر. أغسل وجهي بكوب صغيرة من الماء وأعطي تعليمات مُشددة لأسرتي بأن يحافظوا على كل قطرة ماء ليكفي الماء للشرب والطبيخ والنظافة لليوم التالي… أقف في طوابير للحصول على قليل من (الملح، السُكر، الخميرة، الدقيق، الأرز… وأشياء بسيطة وسخيفة جداً يمكن لأي رب بيت القيام بها في العالم ابن القحبة). أعكف هذه الأيام على كتابة رواية جديدة، وأنتظر صدور مجموعتي الجديدة “رُبع رغيف” و \التي وثقتُ فيها صعوبة حصول المواطن العربي على سُبل الحياة، كما يحدث معنا الآن. أقضي الليل تحت القصف في الكتابة على الورق والقراءة من الجوال”.
سميح القاسم كتب بدوره: “لا أحب الموت لكني لا أخاف منه، وأخشى يوماً ما أن أضطر لاستخدام الورق الذي أسجل عليه روايتي الجديدة في إشعال النار لإعداد الطعام لأطفالي، فالحياة أولويات والضرورة أحياناً لها أحكام كافرة”.
ثمة حكاية لناجية من تحت الأنقاض كتبتها صاحبتها عايدة أبو لاشين (5/11/2023): لم أنج بعد من الموت… لم أكن أتوقع أن أعيش بعد هذا اليوم !! العاشر من أكتوبر، الساعة الثانية من منتصف الليل. صوت الانفجارات يبدو بعيداً. بلحظة كل شي تغير، تزلزلت الأرض من تحتي وتساقطت الأشياء فوقي. بعد ساعة تجمعوا الناس والدفاع المدني لإنقاذنا، ولكن تم إعلان موتنا جميعاً، لأنهم وجدوا محمد أخ زوجي (جمال)، جثة واقعة على الأرض. كنت أسمعهم وأنا تحت الأنقاض، الإسعاف والدفاع المدني وأصوات الجيران. من بين الأنقاض حاولت الصراخ عليهم بكل قوة: نحن هنا أحياء، لم نمت. نحن أحياء تحت الأنقاض، لكن رائحة البارود والغبار التي تدخل في نفسي، أقوى من ذلك الصراخ الذي لم يسمعه أحد… ذهب الجميع للبحث عن أحياء عند سماع غارة جوية جديدة في مكان آخر… استيقظت من النوم، لا أدري، كان المكان معتماً جداً، شعرت بشيء ثقيل فوقي. المساحة ضيقة جداً وجسم متخشب لا شي يتحرك مني، لا شي، بالكاد أستطيع التنفس، بالكاد يصلني الأوكسجين المختلط برائحة الغاز. ناديت على زوجي: جمال، جمال، فلم يرد، المكان معتم جداً، حاولت تحرير نفسي ورفع الأثقال، ولكن كان سقف المنزل الإسمنتي أقوى بكثير من محاولاتي… وبكل هذا الوقت أنزف الدم من يدي ورأسي ورجلي محشورة بين الحجارة، مر الوقت: صباح، ظهر، مساء. وأنا أرتجف من البرد وأشعر بالعطش الشديد. وفي صباح اليوم التالي، سمعت خطوات شخص يمشي فوق الأنقاض، مسكت حجر وحاولت أن أضربه بالسقف من فوق رأسي حتى سمعوا الصوت وسألوا: هل من أحد حي هنا. قلت لهم نعم أنا عايدة. أخيراً، بعد 48 ساعة خرجت من تحت الركام، سألتهم عن زوجي (جمال) قال لي أبي إنه بخير، ذهبت إلى المستشفى لمعالجة إصابتي، لم يكن لي سرير، الأموات والمصابون في كل مكان، انتقلت إلى منزل والدي سألتهم مجدداً أين زوجي جمال؟ فكانت الإجابة في أعينهم، مات جمال ومات أخوه محمد وزوجته سلامه وطفلاهما هادي وشام… أنا الناجية الوحيدة من هذه المجزرة. أنا عايدة أبو لا شين من مدينة غزة، لم أنج بعد من الموت… حياتي ممكن أن تنتهي في ثانية، ربما الليلة ربما لا. أوقفوا هذه الحرب”.
هناء عليوة طالبت بالنظر إلى فلسطينيي غزة، في مآسيهم المهولة، كبشر عاديين، يتألمون ويجوعون ويخافون، من دون أسطرة متخيّلة، قد ترضي ذات البعض، لكنها لا تفيد الناس في غزة، خاطبت هذا البعض قائلة:
“جربت تنام بخيمة؟ جربت تفقد كل شي بحياتك!؟
نفسي أحكي لأي حد بيقول لي حاسين فيكم؛ أقول له تعال حسّ عالمزبوط: إنك تنام بخيمة أو بغرفة صغيرة برفقة 10 أشخاص نصهم أطفال، هي غرفة الأكل والنوم والمعيشة والمطبخ، وأحياناً بنحمم الولاد بنفس الغرفة. تعال وقف في طابور الحمّام خصوصاً الصبح قدامك عشرة عشرين وراك عشرة عشرين. إجا دورك تفوت يلا تلحق تعمل شي واحد فقط. شي واحد. تقضي حاجتك أو تغسل وجهك. وصدقني ممكن تكسب وقت أكتر لو فات معك حد تاني وتتبادلوا الأدوار، مهو مفيش خصوصية! اه والله. استنى… الحمام غالباً ما فيه مي، دبر حالك وتعال قلي قديه حاسس فينا. جرب شعور يطلبوا ولادك أكلة بسيطة خبزة ولا بيضة ولا تفاحة، وما تقدر تجيب، ما معك مصاري، وأصلاً ما في شي تجيبه. حاسس فينا… جرب تنام بنفس اللبس وتصحى بنفس اللبس وتطلع بنفس اللبس وتعمل كل شي بنفس اللبس… جرب تموت من البرد ومش لاقي لبس شتوي وتعال قلي قديه حاسس فينا. جربت تكون مرتك حامل في شهرها بالحرب! عارف إنه انقطع حليب الأمهات من صدورهن بسبب الخوف وقلة الأكل! جربت تحتاج دوا وما تلاقيه !! جرب عيش هاد القلق وتعال قلي قديه حسيت فينا!! بشو حاسين بالضبط!! جرب ما تروح على شغلك وتمارس حياتك كإنسان، جرب تفقد مصدر رزقك، جرب تنسى إنه عندك حياة، جرب تنحرم من إنسانيتك، جرب تنذل، اه تنذل، اه والله… وتعال قلي قديه حاسس فينا. هَنا عليوة، نازحة ومتنيلة بستين نيلة…”.