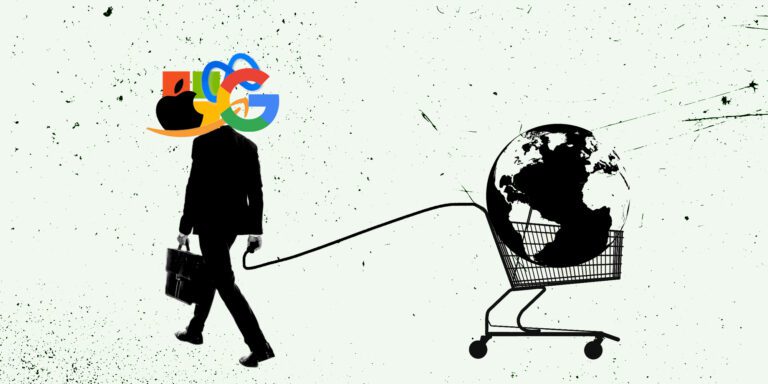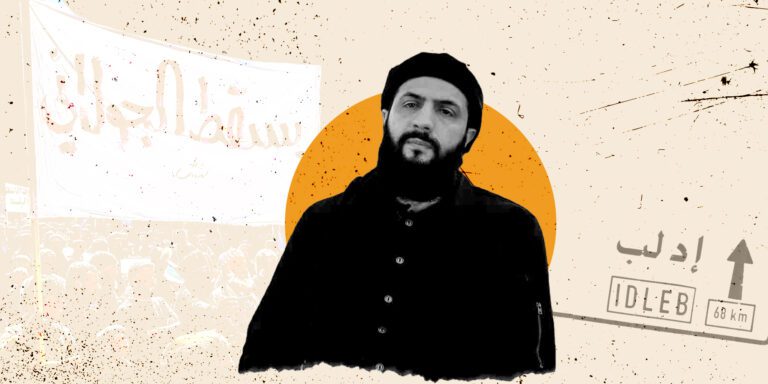الأسبوع الماضي، في محافظة المنيا التي تبعد نحو مائتي كيلومتر جنوب القاهرة أو أكثر قليلًا، وقعت في قريتين مختلفتين، وبفارق أيام قليلة، حادثتان طائفيتان مألوفتان ضد الأقباط، وضد حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
بدأ الأمر إثر تداول أنباء عن بناء كنيستين، واحدة أرثوذكسية وأخرى إنجيلية، فتجمهر عدد من مُسلمي القريتين، الفواخر والكوم الأحمر، مُرددين هتافات معادية للأقباط، مُسلحين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء وحجارة وعصي.
اعتدى “المتجمهرون” على رجال ونساء أقباط، ونهبوا ممتلكاتهم، وحبسوهم في بيوتهم، كما أحرقوا منازلهم وأملاكهم، وهدموا مقدساتهم، وأهانوا عقائدهم، باثّين الرعب والهلع في نفوسهم ونفوس أطفالهم.
مئات الحوادث الطائفيّة
منذ عام 2010 وحتى الآن، وقعت أكثر من 300 حادثة عنف طائفي ضد الأقباط، رصدتهم بنفسي أثناء عملي على هذا الملف. تتنوع هذه الحوادث بين قتل وتفجير وجرح واعتداء وإرهاب وقمع وتمييز، وحرق وهدم ونهب واقتحام وحصار لكنائس وبيوت ومحال ومخازن ومنقولات مملوكة للأقباط.
أكثر من ثُلث هذا العدد من الحوادث، وقع داخل محافظة المنيا، ونحو 80 في المئة من هذا الثُلث، يتبنى النموذج المتكرر ذاته، الذي وقع أخيراً في الفواخر والكوم الأحمر.
يتطابق سيناريو الأحداث في معظم الحالات، تماماً كمن ينقل من كتاب، ويحدث بالترتيب التالي نفسه تقريباً: تداول أنباء عن بناء كنيسة، ثم التحريض، ثم استغاثة من الأقباط، فتجاهل من المسؤولين المعنيين، فتجمهر واعتداء وإرهاب وهدم وحرق، ثم إلقاء القبض على بعض الأشخاص.
تُنظّم لاحقاً جلسة عرفية برعاية مؤسسات الدولة، يليها إذلال الأقباط وتهجيرهم قسرياً أحياناً إذا اقتضى الأمر، بعدها يتم التراجع عن بناء الكنيسة أو الصلاة في مكان معين، وأخيراً إفراج عن الجميع، والتأكيد على اللُحمة الوطنية بين عُنصري الأمة.
لماذا المنيا؟
أكثر من 25 في المئة من الحوادث ضد الأقباط في مصر، تحدث في مكان واحد، ونمط واحد. الأمر الذي يتركنا أمام سؤال تردد كثيراً خلال الأيام الماضية: “لماذا المنيا؟”، والإجابة عنه تشكّل مبحثاً مهماً لكل العاملين والمُهتمين بالملف القبطي في مصر.
هناك نظريات عدة للإجابة عن هذا السؤال، البعض يعتقد أن السبب هو كثافة الأقباط المرتفعة في المحافظة، وبالتالي حاجتهم الى بناء كنائس تستوعب أعدادهم، الأمر الذي يُوجهه الأهالي بالاعتداءات والعنف بهدف إحباط أية محاولة لبناء كنيسة جديدة.
البعض الآخر يعتقد أن السبب هو ارتفاع نسبة الفقر، فالمنيا واحدة من أفقر محافظات مصر، بنسبة تتجاوز 54 في المئة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة، ما يؤثر على سلوك الأفراد وأخلاقهم ويدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
تُعتبر المنيا أيضاً مركزاً رئيسياً لنشاط الجماعات المتطرفة، الذين يلعبون دوراً في التحريض على الأقباط ورعاية مثل هذه الحوادث. ناهيك بسلوك الأجهزة الأمنية داخل محافظة المنيا تحديداً، والمتهمة بالتواطؤ في مثل هذه الأحداث ورعايتها.
هناك من يرى أن الأمر يعود إلى التركيبة الديموغرافية النادرة داخل محافظة المنيا، إذ يحدث أحيانًا أن توجد قرى بكاملها من المسيحيين، وقرى مجاورة لها بكاملها من المسلمين، وقرى تحوي غالبية ساحقة من أحد الدينين.
التركيبة السابقة هي على عكس ديموغرافيا باقي المحافظات التي يسكنها المسلمون والمسيحيون في نسيج أكثر تداخلًا وتشابكًا، ما يجعل من المنيا حقلاً لنمو الطائفية والتنافسية المشحونة بالعداء بين المسلمين والمسيحيين.
والبعض يتوقع أنها سياسات تأديبية لأسقف المنيا الأنبا مكاريوس المعروف بتصريحاته ومواقفه الصلبة والجافة تجاه الأحداث الطائفية المتكررة، والكثير من النظريات الأخرى التي تحاول الإجابة عن السؤال نفسه “لماذا المنيا؟” .
تدعم كل واحدة من هذه الفرضيات الكثير من الحجج والاستدلالات التي يسوقها أصحابها، ولكن للأسف، لا يُتاح للعاملين في هذا الملف من الباحثين والحقوقيين، اختبار تلك الفرضيات عن قرب، للتأكد من مدى دقتها وسلامتها.
منذ عام 2010 وحتى الآن، وقعت أكثر من 300 حادثة عنف طائفي ضد الأقباط
“السياسة العامة” وثقافة الإفلات من العقاب
السؤال الذي يحتاج الى المزيد من البحث، لا يتعلق بالمكان بقدر ما يرتبط بإمكانية ارتكاب العنف، بصورة أخرى، لماذا يعتقد الجناة أنه من الممكن الاعتداء على الأقباط والتضييق عليهم واستباحتهم؟ هل من طبيعة الناس هناك أنهم إذا أرادوا شيئاً بشدة حصلوا عليه بأيديهم؟ كم عدد الاحتجاجات التي اجتاحت المنيا ضد الضغوط السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية خلال الأشهر الماضية مثلًا؟
لست بحاجة إلى البحث لأعرف أن عدد الاحتجاجات يقترب من الصفر، فليس سرّاً ألا أحد في مصر الآن يجرؤ على أن يحتج بكلمة من دون المخاطرة بإلقاء القبض عليه، وتوجيه واحدة من تهم الإرهاب وأخواتها إليه، لا في المنيا ولا في غيرها من المحافظات! فكيف الحال بسكان القرى المغلوبين على أمرهم؟
إذا كان الأقباط هم الضحية، فيتوقع الجناة إنفراجة أمنية تسمح لهم بالتجمهر وترديد الهتافات المعادية وممارسة الإرهاب والبلطجة والنهب والتحرش وهدم دور العبادة، بل والإفلات من العقاب في هذا كله، فكيف ساد هذا الاعتقاد وتسرب إلى وجدان الجناة؟
هذا النوع من التفاهم الضمني الذي يسمح بحدوث مثل هذه الاعتداءات باستمرار وبشكل تلقائي، يُسمَّى “سياسة عامة” Public Policy، حسب عالم السياسة والأستاذ الجامعي توماس أ. بيركلاند، الذي يعرف المفهوم بـ”منهجية المؤسسات الحكومية المتمثلة في الفعل أو اللافعل، بهدف تناول مسائل اجتماعية، وتعيين الموارد، وتنظيم السلوك في سياق سياسي معين”.
في ظل التعريف السابق، نسأل: ما هي السياسة العامة تجاه الأقباط؟ ما الذي تفعله أو لا تفعله المؤسسات الحكومية ويؤدي في النهاية إلى مثل هذه الجرائم؟
أحد أهم أوجه السياسة العامة بخصوص الأقباط، هو سلوك الأجهزة الأمنية المتمثل في التجاهل والتراخي ورعاية الجلسات العرفية لتسوية هذا النوع من الحوادث، والتي ينتج منها إفلات المتورطين من العقاب، وبالتالي إقرار مسلكهم وتشجيع الآخرين على القيام بهذا الفعل مجدداً.
تناول تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تعليقه على الحادثتين الأخيرتين هذا الوجه بالتفصيل والتذكير والتحذير والتأكيد والإلحاح على ضرورة توقف هذه السياسات الخطيرة ،التي تقود بشكل مباشر إلى تكرار هذه الحوادث.
ليس هناك ما يمكن إضافته في هذا الصدد، لكن ما يعنيني هنا هو شكل آخر من أشكال السياسة العامة القريبة والمحيطة بهاتين الحادثتين، ألا وهو “الخطاب السياسي”، ولا أقصد ما هو واضح ومباشر كتأكيد الرئيس مثلًا في خطاباته على عدم التفرقة بين المواطنين على أساس الدين، أو كزيارته الكنيسة في الأعياد وما تحمله من رسائل إيجابية.
نموذج الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن الحكومة الذي يتجاوز شخص الرئيس، نتلمسه خلال الأيام التي سبقت وتلت الاعتداء على قرية الفراخر، خلال حدثين اثنين، الأول، يرتبط بيوم عيد القيامة، والثاني تجنّب إدانة الاعتداءات.
تفادي عيد القيامة
يوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل الماضي، وقبل يوم واحد من اندلاع الأحداث الطائفية في قرية الفواخر، أصدر مجلس الوزراء القرارين رقم 1354 و1355 لسنة 2024 بمنح إجازة رسمية يومي 5 و6 أيار/ مايو، وهما اليومان الموافقان لعيد القيامة الذي يحتفل به الأقباط، والعيد المصري القديم شم النسيم.
لكن قرار منح الإجازة لم يصدر بهذا الشكل، بل ذكر أن الأجازة الرسمية لمناسبة عيدي العمال وشم النسيم! ولأن عيد العمال يوافق يوم 1 أيار وليس 5 أيار، فقد تم ترحيل يوم إجازته أربعة أيام ليوافق يوم عيد القيامة، وبالتالي يتمكن الأقباط من الحصول على إجازة في عيدهم الكبير ولكن من دون الحاجة إلى ذكر اسم القيامة!
لم يُفوِّت رواد السوشيال ميديا هذا الخبر، فانهالت آلاف المنشورات والمشاركات الساخرة التي يتبارى أصحابها من المسلمين والمسيحيين في إبداع وابتكار النكات الناتجة والمفارقات وأوجه الشبه بين عيدي العمال والقيامة، ليتصدر الخبر قائمة الترندات على منصات التواصل الاجتماعي لأكثر من أسبوع.
أثار التصريح استياء ملايين الأقباط الذين شعروا بالإهانة من تجنب حكومتهم ذكر اسم عيد القيامة المجيد، عيدهم الأكبر وفرحتهم الكبرى. ولكن هذا ليس الأثر الجانبي الأكبر لهذا التصريح.
الكارثة الحقيقية تكمن في الخطاب السياسي الذي تم تمريره من خلال هذا الاستخدام الخطير للغة التي تتواصل بها الحكومة مع مواطنيها الأقباط والمسلمين، فالرسالة التي يحملها هذا التصريح هي أن الحكومة تترفع أو تشعر بالإحراج أو تتردد في ذكر اسم عيد القيامة أو منح إجازة رسمية بسببه، ما يعني أن الحكومة لا تنظر إلى الأقباط باعتبارهم مواطنين لهم الحقوق المقررة للمسلمين نفسها.
وسواء كان السبب هو عقيدة أصحاب السلطة أنفسهم، أو خوفهم أو مجاملتهم لأصحاب التيارات المتشددة، التي لا تعترف بحقوق المواطنة للأقباط، فالنتيجة واحدة، وهي صياغة العلاقات السلطوية، بحيث يظن المواطن المسلم أنه متقدم على المواطن المسيحي، وبالتالي يمكنه استباحته وممارسة سلطته الممنوحة له من الحكومة عليه. أو ليس بالضرورة استباحته، يكفي أن يعطف المواطن المسلم على المواطن المسيحي حتى يتغذى لديه الإحساس نفسه بالفوقية على حساب حقوق الأقباط وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.
من المؤسف أن الحكومة المنوط بها اتخاذ التدابير الخاصة لحماية حقوق الأقليات الأكثر هشاشة وعرضة للخطر، هي نفسها من تتخذ التدابير لإضعافهم وتسليمهم فريسة للطرف الأقوى داخل المجتمع.
الأزهر لا يدين العنف
التجلي الثاني للخطاب السياسي، ما أعاد نشره -بعد أحداث قرية الفواخر- الصحافي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، على صفحته، من تصريحات سابقة لشيخ الأزهر، أحمد الطيب.
جاء في تصريح الطيب: “ما يحدث في بعض القرى والنجوع من مضايقات عند بناء أي كنيسة هو ميراث وليد عادات وتقاليد، والناس تناقلته وليس له أصل في الإسلام”.
هذا التصريح لاقى احتفاءً وقبولًا من الأقباط قبل المسلمين، لكن لم ينتبه أحد الى لغة التصريح، والتي تتجنب توجيه أية إدانة صريحة ومباشرة لهذه الأفعال.
كلام شيخ الأزهر مجرد تبرئة لتعاليم الدين الإسلامي من هذا السلوك، ولكن بدلاً من وصف هذه الأفعال كجرائم إرهابية أو حتى كذنوب ومعاصٍ، وُصفت باعتبارها “عادات وتقاليد”!
مرة أخرى تؤدي اللغة المستخدمة من مؤسسات الدولة إلى الاستهانة بهذه الحوادث والاستخفاف بما يتعرض له الأقباط، إلى حد وصف الجناة بأنهم “يمارسون العادات والتقاليد”.
لا أقول إن قرار مجلس الوزراء قاد إلى أحداث قرية الفواخر، أو إن تصريحات شيخ الأزهر قادت إلى أحداث الكوم الأحمر، ولكن اللافت هو التزامن الذي يؤكد المعنى الواضح: السياسة العامة تستخف بالأقباط وتقلل منهم، والناس يصدقون ويتبعون.
حل المشكلة الطائفية يبدأ بتغيير السياسة العامة في مصر تجاه الأقباط، ما يعني إصلاح الخطاب السياسي والانتباه الى اللغة المستخدمة، وإصلاح التشريعات التي تتعارض مع حقوق المواطنة، وتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة التي تضمن تحقيق المواطنة، وتخصيص ميزانية لحل هذه المشكلة.
لاب د أيضاً من الإيفاء بالاستحقاق الدستوري المتأخر عشر سنوات بإنشاء مفوضية التمييز الديني، والتعاون مع المجتمع المدني بالبحث والدراسة والتحليل والتقرير وتقديم المساعدة.
الأهم هو قيام الجهات المتخصصة بضبط أداء المؤسسات والأفراد تجاه هذه المسألة، والقيام بردود الفعل المناسبة والكافية لردع الناس عن العنف وارتكاب الجرائم بحق الأقباط، لا الاكتفاء بالمصالحات والجلسات العرفيّة.