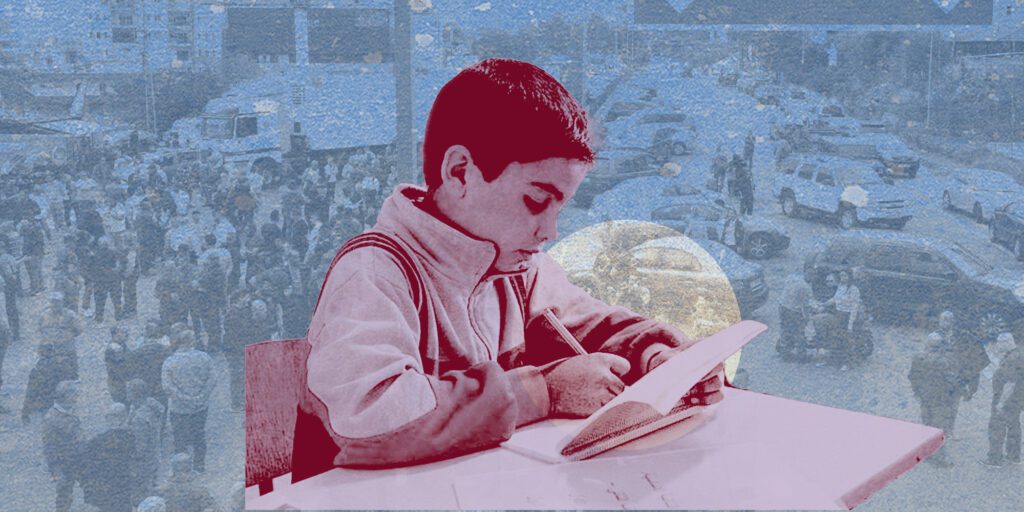في سنةٍ ما من سنوات المراهقة ينعطف واحدنا، غالباً مع شلّة من أصحابه، إلى محلّ يبيع السندويش: “واحد فلافل من فضلك” أو “واحد شاورما”.
طالب السندويش لا يكون يعرف، في تلك اللحظة، أيّة فعلة يفعل. لا يكون يعرف أنّه يتمرّد، وأنّه، في حدودٍ ما، يمارس تحرّره الأوّل من سلطة العائلة ونظامها الأبويّ. هناك، في هذه السُلطة البيتيّة، يضيق الخيار: الوجبة المطبوخة معروفة وجاهزة، وما عليك سوى أن تأكل. وهي مطبوخة بالطريقة المألوفة في بيتٍ ما، بحيث تقتصر الحرّيّة على رشّة ملح إضافيّة أو رشّة بهار.
هنا، في حضرة السندويش، سندويشِنا المشرقيّ ما قبل الصناعيّ على الأقلّ، أنت السيّد المطاع. الصحون عديدة بقدر ما هي مختلفة. فوق هذا، يستطيع طالبه أن يُحدِث فيه تحويلات نوعيّة تُنقص بعض الموادّ أو تزيد موادّ أخرى: “بلا مَيّونيز من فضلك” أو “زدْ لي البندورة والزيتون إذا سمحت”.
وزبائن المحلّ لا يعرفون بعضهم بالضرورة، كما أنّ لقاءهم هناك لم يأت نتيجة موعد. فالمؤاكلة التي يتشاركون فيها لا تفترض صلة قربى، ولا حتّى صلة معرفة، وإن كانت هي نفسها قابلة لأن تتسبّب بتعارُف عابر بين الزبائن. وهذا عكس البيت تماماً، حيث “زبائن” الطاولة معروفون سلفاً. إنّهم أفراد العائلة الذين ينضمّ إليهم أحياناً ضيوفٌ هم، بدورهم، معروفون. وفي هذا رابطة وولاء “حزبيّان” عبّر عنهما قول قديم: “مَن أكل على مائدتين اختنق”، إذ “الخبز والملح” على الطاولة يجمعان ويوحّدان، وقد يفرزان آخرين “منشقّين” عن جماعة صغرى مؤتلفة القلوب.
فمن دون الطاولة لا توجد العائلة ولا يكون الاجتماع العائليّ الذي حظي ويحظى بنعوت ورديّة ومتعالية لا حصر لها. ذاك أنّ الطاولة البيتيّة إنّما تشدّنا، بين ما تشدّ، إلى المشترك بيننا، وهو روح الماضي الذي يُصوَّر واحداً مشبعاً بالذكريات الجامعة، فيما يشدّنا السندويش إلى الانتقال والتحوّل والجديد، وإلى التخفّف من كلّ إرث معطى أو مُتوهّم. هكذا يستطيع واحدنا، في مقابل حصريّة البيت، أن يحمل سندويشه إلى العمل أو النزهة أو أيّ مكان آخر، تاركاً وراءه الصحن والملعقة والشوكة والسكّين. فلم يكن من الصدف بالتالي أنّ إنكلترا الصناعيّة في القرن الثامن عشر هي التي أنجبت السندويش في شكله الحديث، أنجبته كائناً سهل الحمل ورخيص الثمن، يلبّي احتياجات مجتمع بدأت الصناعة تفصله عن أمكنة السكن والقرابة الأصليّين.
فمن دون الطاولة لا توجد العائلة ولا يكون الاجتماع العائليّ الذي حظي ويحظى بنعوت ورديّة ومتعالية لا حصر لها. ذاك أنّ الطاولة البيتيّة إنّما تشدّنا، بين ما تشدّ، إلى المشترك بيننا، وهو روح الماضي الذي يُصوَّر واحداً مشبعاً بالذكريات الجامعة، فيما يشدّنا السندويش إلى الانتقال والتحوّل والجديد، وإلى التخفّف من كلّ إرث معطى أو مُتوهّم.
ثمّ إنّ طالبي السندويش يأكلون واقفين، وأحياناً ينقّلون أقدامهم في خطى صغيرة داخل المحلّ فيما هم ينتظرون سندويشهم، أو يتفقّدون بأعين فضوليّة تلك الصحون الصغيرة للكبيس والحَرّ ويضيفون منها إليه. وهم، في مرّات، يفعلون هذا بقدر من التفنّن أو التراقص المضغوط أو التأمّل والتفكّر. بهذا تراهم يعاكسون مبدأ الجلوس المُلزِم حول المائدة، بما لها من هيبة ونفوذ وبما تستدعيه من نظام لا بدّ من الإذعان له. وربّما للسبب هذا نرى النساء، وهنّ الأكثر امتثالاً في المجتمعات الذكريّة، أقلّ ارتياداً لمحلاّت السندويش وأشدّ رضوخاً لمعايير المائدة، علماً أنهنّ هنّ ضحاياها.
والنظام والتراتُب تحصيلٌ حاصلٌ في هذا كلّه: فالمائدة، التي كرّمها القرآن بأن أطلقها اسماً لإحدى سُوَره، هي الطاولة وما عليها من طعام. ونعرف، في المفاوضات بين الدول المتنازعة، أيّ جهد يُبذل للاتّفاق على شكل الطاولة بوصفه من تعابير توازن القوى القائم. أمّا المأدبة، وهي أعلى مراتب الموائد وأغزرها مادّةً وأوسعها مَدعوّين، فتجمعها بـ “الأدب” و”التأدّب”، وهما نظامان، قرابة لغويّة لا لبس فيها.
وإذ يجافي الأكل السندويشيّ النظام والطقس، فإنّ الطقس الأبرز الذي يتحدّاه هو المائدة نفسها، تلك التي تملك، أقلّه في اليهوديّة والمسيحيّة، رمزيّة دينيّة معروفة. وأعياد الفصح والقيامة وأوّل قربانة، وكذلك العشاء الأخير، شواهد على ذلك. لقد رأى أستاذ “العهد الجديد” إن تي رايت مثلاً أنّ “المسيح حين أراد أن يشرح لتلاميذه ما الذي يعنيه موتُه الوشيك لم يقدّم لهم نظريّة، بل قدّم وجبة طعام”. ويزخر إنجيل لوقا خصوصاً بأخبار الطاولات والموائد، بحيث لا يكاد المسيح يظهر إلاّ ذاهباً إلى وجبة طعام أو عائداً من وجبة أو يتناول وجبة.
وبالفعل ثمّة عائلات مؤمنة لا تباشر الأكل على المائدة إلاّ بعد صلاة، وعائلاتٌ محافظة لا تباشره إلاّ بعد أن يفعل البطريرك، ربُّ الأسرة، الذي غالباً ما يجلس على رأس الطاولة تقابله الأمّ على الرأس الآخر. بل هناك عائلات أشدّ محافظة، وإن قلّ عددها اليوم، تتوقّف عن الأكل حين يتوقّف البطريرك حتّى لو لم تفرغ منه، أو تطيل الجلوس على المائدة، حتّى لو امتلأت بطونها، إلى أن ينتهي هو من أكله. وفي ثقافات الإسلام، تقول العبارة الشائعة، التي يُظَنّ خطأً أنّها حديث نبويّ، “لا سلام على طعام”، فتفترض نوعاً من الانكباب، بل التفرّغ، لتلك المهمّة.
الأكل في البيت يطفّل الآكلَ، فيُشعره بـ “دفء العائلة” ويعرّضه لمبالغات الأمّ وتعويضها الكلاميّ عن قهرها عبر استعراضها التضحيات التي تكبّدتها كي تطبخ هذه الطبخة بعينها “لأنّكم تحبّونها”. لكنّ السندويش، في المقابل، ينضّج آكله إذ يُحلّه من هذه الالتزامات والتبعات جميعاً ولا يقيّده بشيء.
ثمّ إنّ الوجبة البيتيّة محكومة بمواعيد تناول الطعام التي تسود النهار وتؤطّره. فالفطور يسبق بدء العمل، والغداء يسبق القيلولة، والعشاء يسبق النوم. أمّا السندويش الذي لا يسبق شيئاً ولا يلي شيئاً، فالجوع وحده ما يقود إليه. لكنّه، مع هذا، بل رغم هذا، يكسر مبدأ “الأكل للأكل” فلا يزعم لنفسه أيّة مركزيّة وأيّ تقديس تُمليهما أولويّة الجوع على سائر الاعتبارات. ففي محلّات السندويش يتكرّر مشهد الخبز وهو يُنقل ملفوفاً بالأكياس والأوراق والنايلون، من الخارج إلى داخل المحلّ، ثمّ يُكوَّم بكميّات هائلة على الأرض، تماماً كما تُنقل أيّة سلعة “عاديّة” أخرى وتُكوّم. وكثيراً ما يُسمع بعض طالبي السندويش وهم يطلبون “نصف رغيف فقط”، غير عابئين بالإهمال والنبذ اللذين قد يعانيهما النصف الآخر. فهنا إذاً تنكسر علويّة الخبز الذي “هو جسدي”، بحسب المسيح، والذي طويلاً ما تعاون الدين والفقر والعائلة على رفعه إلى سويّة “العيش”، كما يسمّيه المصريّون، أو الصلاة عليه، أو تقبيله إذا سقط أرضاً ورفعه إلى الجبين.
والنظام إيّاه يداخل الوجبة البيتيّة بأشكال عديدة أخرى، فيبوّب الطعام وينظّم تناوله، كأنْ يثبّت السَلَطة “الحتميّة”، قبل الصحن الرئيسيّ أو بعده، أو أن يختم الوجبة بالحلوى أو الفاكهة أو الأجبان، قبل تناول القهوة. وهذا لا يعني، في المقابل، أنّ السندويش آحاديّ يُخلّ بالتعدّد، فهو شديد الحرص على تمثيل البندورة والخيار والكبيس، إلاّ أنّه أشبه بقِرص أكلٍ مُدمّج يتعدّى العناصر المبعثرة إلى تركيبها، ويختصر العمليّات الكثيرة والتفصيليّة في خلاصتها العمليّة. وهذا فضلاً عن أنّ الوجبة عموماً موزّعة على أطباق فيها الرئيسيّ وفيها الثانويّ، حيث ترفع اللغة الإنكليزيّة كلّ طبق إلى سويّة الـcourse – تلك المفردة التي تنضح بحمولة مهيبة. لكنْ رغم هذا التنظيم الدقيق، فهي وجبة مجانيّة لا يُدفع ثمنها. إنّها علامة حبّ عائليّ، أو علامة كرم حيال صديق أو ضيف، وهي بالتالي تجبّ التسعير والتثمين. وهذا مع أنّ طبخ النساء، كما تقول النسويّات بحقّ، إنّما يُستَهلك من دون أن يُسوَّق، بحيث تدفع النساء – الأمّهات، اللواتي لا يتقاضين ما يقابل جهدهنّ، ثمن هذا الحبّ وتلك الضيافة!
أمّا السندويش فيُعفي صاحبه من ذاك الحبّ، إذ هو تعريفاً سلعة يُدفَع ثمنها قبل تناوله أو بعده. وفي هذا المعنى، فإنّ الأكل في البيت يطفّل الآكلَ، فيُشعره بـ “دفء العائلة” ويعرّضه لمبالغات الأمّ وتعويضها الكلاميّ عن قهرها عبر استعراضها التضحيات التي تكبّدتها كي تطبخ هذه الطبخة بعينها “لأنّكم تحبّونها”. لكنّ السندويش، في المقابل، ينضّج آكله إذ يُحلّه من هذه الالتزامات والتبعات جميعاً ولا يقيّده بشيء.
وهذه معانٍ ودلالات تطاولَ على بعضها السندويش الجديد الذي تبيعه “السوبرماركت” والمقاهي الأميركيّة كـ “ستاربكس”، والتي تقدّمه جاهزاً وملفوفاً لا يقبل التعديل وإعادة النظر. مع ذلك، فالتبادل لا يسلك خطّاً واحداً بل خطّين، إذ نجد بعض المآكل كـ “الهمبرغر” وقد كيّفت نفسها مبكراً مع السندويش، فيما تزعم سَلَطات موسّعة كـ “الكلوب سندويش” أنّها تنتسب إليه اسماً ومضموناً. وما لا شكّ فيه أنّ النسب الجامع بين “البيتزا” والسندويش سبب قويّ وراء ذيوعها وانتشارها الكونيّين، إن لم يكن هو السبب الأقوى.
وهذا جميعاً لا يلغي أنّ ثورة السندويش إصلاحيّة وليست راديكاليّة. فهو، حتّى لو تحوّل إلى صناعة كبرى، لا يستطيع، لألف سبب وسبب، الحلول محلّ العائلة وبيتها. أمّا نصير السندويش، إذا كان معتدلاً في حماسته، فيعرف أنّ طرحه بديلاً كاملاً عن الطاولة انقلابٌ سخيف على واحد من نتاجات التمدّن، انقلابٌ كفيل بأن يجعل المعلّم نوربرت إلياس يتململ في قبره. لكنّ انكماش البيت وضمور العائلة وتعاظم التمديُن والانسلاخ لا بدّ أن يوسّع ذاك الهامش الذي يقيم فيه السندويش، والذي يوفّر للمراهقة فرصتها كي تنجز ثورة لا يخالطها الدم.