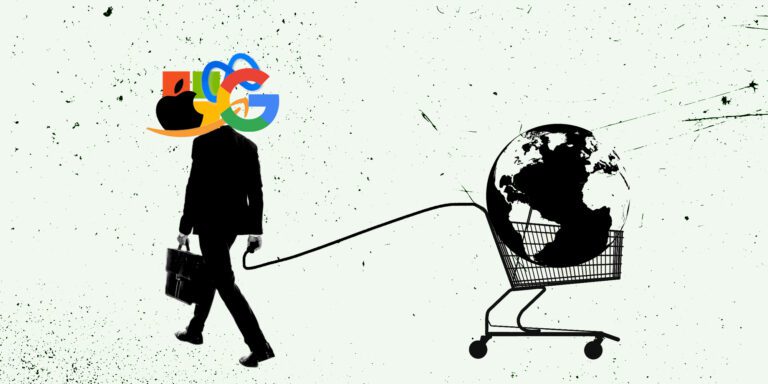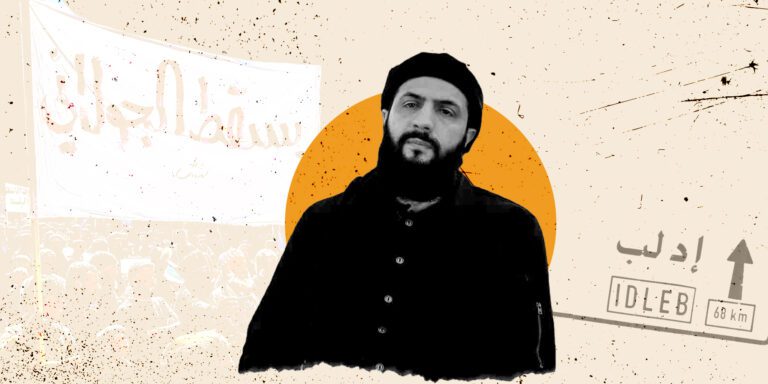عام 2019، عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل أحد السجون، وبعد يومين من صدور تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون من المعارضين للنظام المصري داخل السجون، نظمت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، زيارة ميدانية للمراسلين الأجانب إلى “مجمع سجون طرة”، بالتزامن مع وصول وفد من النيابة العامة.
ظهرت السجون المصرية في الزيارة “المسرحيّة”، بأبهى صورة، بل وتضمن الفيديو الذي بثته الهيئة، شهادات من معتقلين كحازم عبد العظيم وصفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، عن حسن المعاملة، بما في ذلك استعانة وزارة الداخلية المصرية بأحد الطهاة (شيف) من فندق “سميراميس” المطل على النيل في القاهرة، للإشراف على عملية تحضير الطعام في منطقة سجون طرة.
أثار الفيديو سخرية قطاع كبير من المصريين، الذين ربطوه بمشهد من فيلم “البريء”، إخراج الراحل عاطف الطيب، وتأليف وحيد حامد، فبعد مقتل أحد المثقفين داخل السجن، تأتي هيئة نيابية للتحقيق، فلا يرون سوى مشهد معدّ سلفاً عن وضع السجن كمكان للرفاهية، حيث تُطلى واجهاته، ويعامَل فيه المساجين بإنسانية كبيرة، يأكلون لحوماً مطهوة بشكل جيد وخبزاً من أفخر أنواع الخبز، يعيشون في عنابر نظيفة، يتريضون ويقرأون بحرية، والكثير غيرها من الامتيازات التي تُسحب فور رحيل اللجنة.

حصار السينما
صوّر عاطف الطيب فيلمه في عام 1985، رصداً لواقع متناقض مع الكذبة الفجة للإعلام المصري وهيئات الاستعلامات، لكن في عام 2019، لم يكن هناك بين السينمائيين، من يرصد هذا الواقع، لا لأن مصر قد عدمت من بينها من هو قادر على رصده، لكن لأن السينما والتلفزيون ووسائل الإعلام، صارت في قبضة جهة واحدة، لن تسمح إلا بتعميم الكذبة الموحّدة.
السينما المصرية منذ منتصف الألفية الجديدة، تحاصر بدأب المخرجين أصحاب الرؤى، الذين قامت على أكتافهم في بداية الثمانينات، سينما مصرية لها لغتها الخاصة، والتي تميزها عن السينما الهوليوودية، لينتهي هذا العصر تدريجياً لصالح صعود سينما المخرج المنفذ، وهو المخرج الذي تطور فقط في جانب التكنيك أو ما استنسخوه من تقنيات سينمائية أميركية.
مخرج كداود عبد السيد، أحد أعمدة جيل الثمانينات، أعلن اعتزاله السينما، هو الذي لا يعمل في الأساس منذ فترة طويلة، لكنه رأى أن حتى لو قدّر له العودة، فمن الصعب العمل وسط الشروط السينمائية الحالية، في ظل القبضة الحديدية للرقابة الخانقة للإبداع، كما أن ثمن تذكرة السينما المرتفع، يعني أن أفلامه المهمومة بالطبقات الكادحة والمتوسطة لن تصل إليهم، بعدما أصبحت تجربة دخول السينما مكلفة مادياً، ما يعني أن شرطها الوحيد هو التسلية.
ما سبق، يدفعنا إلى طرح سؤال: ماذا لو مد الله في عمر عاطف الطيب الذي توفي في سن صغيرة عام 1995 بعدما ترك 21 فيلماً، هل كان سيجد الفرصة لمواصلة مشروعه السينمائي؟
الإجابة المؤسفة غالباً هي لا. والدليل هو ما حدث مع جيله كله، كداود ومحمد خان، ورأفت الميهي وخيري بشارة، فلا مكان للواقع أو الفلسفة أو الهم اليومي في السينما.

تقنيّة عالية وتغييب “الواقع”
من بين مخرجي الجيل الحالي، يبرز اسمان، مروان حامد وبيتر ميمي، الأول موهوب والثاني يتطوّر عبر الاجتهاد من فيلم إلى آخر، لكن المشترك بينهما أن تطورهما يقتصر على مستوى التقنية لا الرؤية، لا فارق هنا بين الموهوب والمجتهد، بل إن أفلامهما تعمل بحرص على إلغاء هذا الواقع وتحريفه، فنجد مثلا في فيلم “كيرة والجن” لمروان حامد فيلماً ممتعاً ومسلياً، لكنه يقدم الثورة المصرية في عام 1919، على الطريقة الأميركية، بخاصة في تنفيذ المعارك، حتى إن بعض حركات القتال تنتمي إلى مدارس قتال آسيوية، فضلاً عن مشاهد المطاردات، واقع لا يمكن حدوثه في تلك الفترة، ولا حتى في لحظتنا الحالية.
أما بيتر ميمي، الذي أخرج أجزاء مسلسل “الاختيار” تحت إشراف أمني، يحكي فقط الجانب الذي تراه الجهات السيادية للأحداث، فأفلامه أيضاً تحرص على عدم الاهتمام بالواقع حد التنكر للمنطق الدرامي نفسه، سواء في رسم الشخصيات أو في الحوارات بينها، وكذلك تقديم الفقر بوصفه كرنفالاً وفلكلوراً، مع إصرار على تزييف البيئة التي يعيش فيها الفقراء وتجميلها.
فمثلاً في فيلم “شلبي”، يعيش الأبطال الفقراء في بنسيون شديد الجمال والأناقة بأجرة لا تزيد عن 40 جنيهاً شهرياً، يصفّق الأطفال الهاربون من ساعات التعليم الحكومي البائس لمونولوج مسرحي بالفصحى، في حين أنهم في الواقع سيسخرون من صاحبه، تلفق الأسباب التحولات الدرامية التي تساهم في اتخاذ الشخصيات قراراتها.
لا يمكن إغفال أن السينما تعمل تحت تلك الظروف التي لم تعد ترغب في رؤية الواقع، سواء لأسباب إنتاجية بحتة، أو لأن الواقع من الأساس حبيس وجهة نظر واحدة.
رأس الدولة نفسه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصاً على انتقاد فيلم الإرهاب والكباب الذي أُنتج قبل أكثر من عقدين من وصوله إلى الحكم، والذي ناقش مسؤولية الدولة عن الظروف القاهرة التي يعيشها المواطن، وأشار إلى أن مثل هذا النوع من الفن قد جعل من الدولة خصماً، في إشارة الى نوع الفن الذي تفكر فيه القيادة السياسية، سينما دعائية أو لا تقول شيئاً على الإطلاق.

سلطة قول الحقيقة
مرّ أكثر من ربع قرن على ذكرى وفاة المخرج المصري عاطف الطيب، الذي يعد رائد ” الواقعية الجديدة” في السينما المصرية ومطوّرها بعد خلفه صلاح أبو سيف، وقد ترك قبل رحيله المبكر عام 1995، 21 فيلماً، اشتبكت كلها مع الواقع بجدية أكبر.
يقول عاطف الطيب في لقاء تلفزيوني قديم، “أنا بعتبر إن المخرج مهواش تكنيك المخرج أساساً مفكر، ولو فكره مش بيظهر من خلال فيلمه فالتكنيك مش هيبقى هو اللي بيقدمله العذر عن ركاكة الموضوع، مهم المخرج يبقاله رؤية واضحة للمجتمع ورؤية واضحة لنفسه هو عايز ايه من دنيته؟ وبعد كدا حتى لو هو سينمائي عادي، الشخصيات هتكون صادقة وهتعيش”.
المفارقة أن الواقع الذي رصده عاطف الطيب، لم يتغير، ما تغير هو الاتفاق الضمني على عدم رصده.
على رغم أنه لم يلفت نظر أساتذته أثناء دراسته في معهد السينما، ومن بينهم صلاح أبو سيف، بسبب هدوئه وانطوائيته، ودرجاته المتوسطة ومشروع تخرجه الذي لم يكن يشي بمخرج فارق، وعلى رغم أن فيلمه الروائي الأول “الغيرة القاتلة” تعرض لهجوم شرس، حتى أن الناقد السينمائي سمير فريد كتب أن عليه أن يعود إلى معهد السينما ليتعلم الإخراج من جديد، إلا أنه نال اعتراف الجميع وأولهم صلاح أبو سيف وسمير فريد، عندما عرض فيلمه الأيقوني “سواق الأتوبيس”، والذي لم يكتف بالنجاح النقدي، بل حقق نجاحاً تجارياً لافتاً.
كان فيلم “الغيرة القاتلة” مجرد محطة لتجريب أسلوبه، لكن موضوعه لم يكن منتمياً الى مشروعه الكبير، الذي يرصد فيه من خلال تجربته وانكسار جيله، بعد نكسة 67، هموم المواطن المصري وواقعه، فبعد تخرجه من معهد السينما عام 1970، أمضى عاطف الطيب خمس سنوات مجنداً في الحرب في الشؤون المعنوية، ضمن آلاف المجندين في الصحراء، بعد فشل التجربة الناصرية وانكسارها، ليخرج من الحرب ويجد مثل أبطال أفلامه، عالماً قد تغيرت قواعده بالكامل ولا تصب في صالح من ضحوا بأرواحهم لإزالة آثار العدوان، بل تشهد صعود نماذج طفيلية، وتحولات تسحق المواطنين من دون حماية من الدولة.
يقول الطيب: “كان سؤالنا ـ المر ـ كيف استطاع السادات في عشر سنوات أن “يشخبط” إنجازات عبد الناصر، رغم الجماهيرية الواسعة التي كانت تحيط بناصر وإنجازاته، رغم انحيازه الى الناس والفقراء، كيف تمكن السادات من كل هذه “الردة”، والرجل لم تمر ذكراه الخامسة بعد!! كان يعني ذلك ـ لدينا وقتها ـ أمران: الأول، أن خطأً ما شاب تجربة ناصر، علينا أن نعرفه وندركه. والثاني، أنه لا بد من مواجهة ما يحدث ـ فناً بالطبع ـ وطرح حل واضح كحد أدنى وهو بث الهمة”.
خلال سنوات تجنيده، سيقدم فيلمه التسجيلي الأول “جريدة الصباح” عن التناقض بين عناوين الصحف اليومية والواقع المعاش، وهو ما يعاكس وفق ملاحظة الناقد حسام الدين السيد في مقاله: سينما المحارب المهزوم، كل توجيهات وحدة الشؤون المعنوية التي كان مجنداً فيها، المنوط بها دوماً بث الأخبار التي تؤيد السلطة وتوحّد الصف.
وُلدت من رحم ذلك الفيلم الذي لم يتخطّ الـ 4 دقائق، رؤية ستطبع مسيرة عاطف الطيب، قول الحقيقة حتى لو كانت تلك الحقيقة هي اكتشاف المرء أنه كان مخدوعاً ومساءلة السلطة، أي سلطة، بأسئلة لا تكتفي فقط بمعارضتها، بل بإثارة الشكوك حول جدارتها، من خلال حكايات أبطاله الذين بحسب نور الشريف يعيشون رحلة من الضغط العصبي المتواصل توصلهم إلى لحظة انفجار.
على عكس شاعرية خان وفلسفة داود عبد السيد وفانتازيا رأفت الميهي، يبدو الواقع هنا، واقعاً صرفاً، الكاميرا غير معنية سوى بتسجيله، الجمال والشاعرية ينبعان مما يعانيه أبطاله، من اللحظات الصغيرة التي يحتفظون بها بإنسانيتهم وسط هذا السيل من التحولات الساحقة.
إقرأوا أيضاً:
ثنائية القهر والتمرد
كانت التيمة الأساسية في مشروع عاطف الطيب الأساسي هي ثنائية قهر السلطة والتمرد عليها، بحسب تعريف الناقد حسن حداد في كتابه “ثنائية القهر والتمرد في سينما عاطف الطيب“.
تتجاوز السلطة عنده، السلطة السياسية لتمتد الى سلطة المجتمع والدين والقانون، وكذلك مفهوم القهر. فـ”سواق الأتوبيس” و”الحب فوق هضبة الهرم”، يحملان أسئلة عن القهر الاجتماعي، وفي فيلمي “كشف المستور” و”البريء”، قهر السلطة السياسية واستغلالها جهل مواطنيها أو تشويهها معنى الوطنية، وفي “التخشيبة” و”ملف في الآداب”، هناك سؤال وضح ضد سلطة القانون والإجراءات الحكومية التي تهين مواطنيها.
ذروة تلك الأسئلة كلها هي في فيلمين: “الهروب” و”ليلة ساخنة”، حيث تتواطأ كل أنواع السلطة ضد الأبطال، سلطة المجتمع المتغير والسلطة السياسية والدينية والقانون.
كانت انحيازاته الأخلاقية هي ما تقود بوصلته، وعلى عكس مخرجين ظهروا في أفلامهم بشكل لافت، حرص عاطف الطيب على أن يظهر في أفلامه كعابر أو مهمش ضمن أبطاله، لأنه واحد منهم، وكانت العلامة المميزة لأفلامه، أن تمنح الكاميرا للكومبارس لحظات بطولة، تركز على ملامحهم، وتجعلهم في متن المشهد لا هامشه.
ونقلاً عن صديقه المصور الكبير سعيد الشيمي في كتابه “ أفلامي مع عاطف الطيب“، يقول الطيب: “إننا نعيش واقعاً تغمره الأحزان اليومية، والسينما مؤثرة بشكل كبير فى سلوكيات الناس، ولا بُد أن نناقش هذا الواقع ونسجل أحزان الناس، ونحاول بقدر المستطاع أن نغوص فى أعماقهم ونطرق بـود على أسباب متاعبنا… هذا هو هدفي”.
سينما تشعر بالناس، حتى لو وُجد مخرج مثل عاطف الطيب في زمننا، أو امتد العمر به ليعيش ذلك الزمن، فربما لم يكن ليسمح به رصد الواقع كما رآه.
إقرأوا أيضاً: