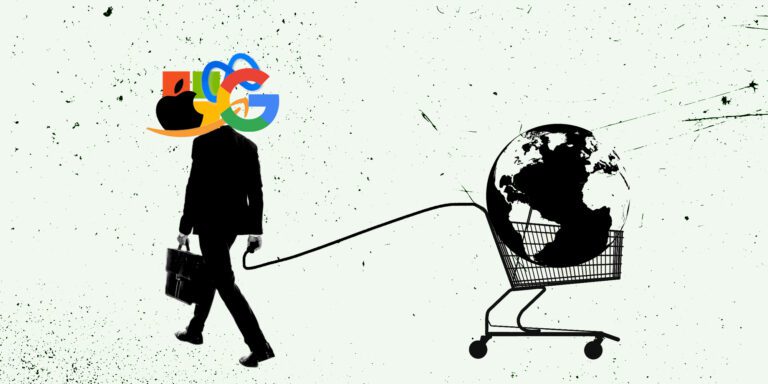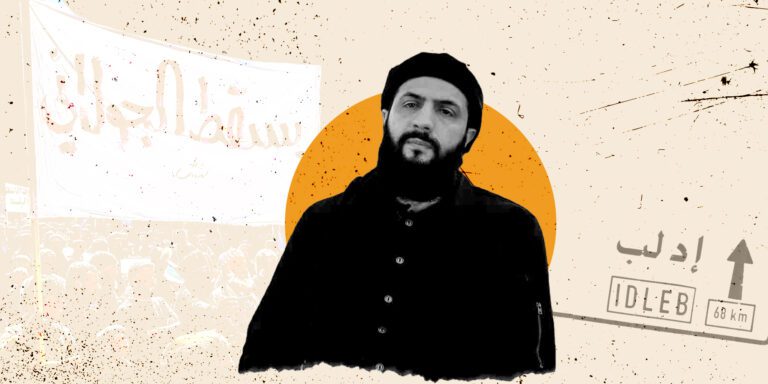لطالما اعتبرت شقائي اليومي في العمل منبعاً لتقديري لذاتي، بدونه ”لا أساوي شيئًا“. أناجي به إيجاد المعنى لقضاء ساعات النهار بأكثر إنتاجيّة ممكنة. التعب لا مكان له. الراحة سيأتي وقتها ليلًا. “سأنهي ما علي فعله أولًا” بكلّ ما أوتيت من قوة. نهار تحوم حوله الانتاجيّة فقط. ثلاث دوامات جزئية. عليّ بذلك أكسب من المردود ما يكفيني لتجنب قلق تكاليف العيش حتى آخر الشهر في بلد الأزمات. الكثير من القلق. لا يزال طنينه في أذني حتى وأنا أكتب الآن: ”لا تقومين بالقدر الكافي، بإمكانك القيام بأكثر من هذا“.
شعور الذنب يلاحقني إذا ما تأففت من كثرة العمل. إذ أسمع كثيرًا: ”اشكري ربك عم تشتغلي“. كل هذا الاجتهاد طيلة الوقت لماذا؟ ما الفضيلة في الكدح المتواصل رغم كلّ الصراعات حولي؟ لكن لا. ليس ما سبق إلا عيّنة من جنون يبدو أعظم.
“لا لأن العمل شيء حسن، بل لأن الفراغ شيء حسن”!
في مقال قيّم نشره برتراند راسل، الفيلسوف وعالم المنطق والرياضي والمؤرخ والناقد الاجتماعي البريطاني، عام 1935 بعنوان: في مدح الكسل (In Praise of Idleness) يقول فيه: ”الفراغ اليوم تشوبه البطالة التامة التي تصيب نصف العاملين، بينما يرزح كاهل النصف الآخر تحت ثقل العمل المرهق. وباتباع هذا الأسلوب سيسبب الفراغ الذي لا محيص عنه شقاءً في كل مكان، بدلًا من أن يكون مصدرًا للسعادة، فهل من الممكن أن نتصوّر جنونًا أكثر من هذا؟“
ربما يغيب عن ذهننا كم أن ساعات من القراءة أو “الصفنة” في فكرة لطالما راودتنا ولم نجد لها الوقت لتقديرها أو ربما نبذها أو فَلتَرَتِها قد تغني عن البؤس وقتًا. أو حتى إعطاء شعور البؤس حقّه على متاريس الكدّ والاجتهاد اليومي في ظروف اقتصاديّة، أقلّ ما يُقال عنها أنها كارثيّة، يستدعي القليل من التثاؤب على هذا الحال وأن نُمهل أنفسنا رويدًا.
في عصر رقميّ متسارع. تطبيقات السوشيل ميديا التي لا تعد ولا تحصى. ساعات من التصفّح في هذه المتع السلبيّة. التضخّم الاقتصادي عالميّا. الهشاشة. الحروب. الهجرة المتسارعة. تسلّق اليمين في بلدان “العالم الأول” على ظهر المهاجرين، في كتاب سياسات الهوية لفرانسيس فوكوياما 2019 يتحدّث فيه عن سبب من أسباب صعود اليمين: استغلال العنصرية والكره المحيطين باللاجئين والمهاجرين.

يَغرَقُ الانترنت بالكتب والمقالات المتعلقة بالكسل، إنِ العلمية أو السيكولوجية أو مقالات الرأي وغيرها. نبذًا أو تأييدًا. لكن ماذا يحوم تحت مظلته؟ ولماذا “الإيد البطّالة نجسة”؟ وهل حصيلة كل جنون ما سبق هيّن ولا يستدعي برهة لإعادة تعريف “بطّالة”؟ ولم لصقها بـ”نجسة”؟ وهل تستدعي فضيلة العمل أن يشقى جزء من البشر بينما حقيقةً يعيث جزء آخر بحثًا عن عمل ليكفيه مردوده دون جدوى؟ فكيف يمكننا تعريف الكسل إذا ما كان العمل لصيقًا به إذن؟ يمكن تأمل المعنى اللغويّ، الكَسَل: التَّثَاقُل عمَّا لا يَنْبَغِي أن يُتَثاقل عنه. والضدّ هو الاجتهاد والكدّ والعمل.
العمل و”أخلاق العبيد”
ليس ببعيد عن ذلك، يقول برنارد راسل في مقالته عام 1935، بأن “الخضوع للسلطة يعود من جديد .. وسائل الإعلام الحديثة من شأنها ألا تجعل الفراغ حكرًا تنفرد فيه طبقات ضئيلة العدد وتنعم بالامتيازات، بل تجعل منه حقًا يعطى بالتساوي لأفراد المجتمع.” ويضيف أن أخلاقيات العمل في الدولة هي “أخلاقيات العبيد، ولا حاجة في العالم الحديث إلى نظام العبيد.”
يرى راسل في مقالته، أن أخلاقيات العمل هي “أخلاق دولة العبيد مطبقة في ظروف تختلف تمامًا عن ظروف نشأتها”. “أصبح المطلوبون للعمل يعملون ساعات طويلة متصلة ويُترك الباقون ليتضوّروا جوعًا بسبب تعطّلهم عن العمل. لماذا؟ لأن العمل واجب ولأن الإنسان لا ينبغي له أن يحصل على أجر يتناسب مع ما ينتجه، بل يتناسب مع فضيلته المتمثّلة في جدّه واجتهاده”، أي ما لا ينبغي أن يُتثاقل عنه.
المفهوم أوسع من أن يكون تفسيرًا مجتمعيًّا وحيدًا لا شريك له!
اعتبر عالم النفس والأستاذ في كلية الدراسات المستمرة والمهنية بجامعة لويولا في شيكاغو، ديفون برايس في كتابه: ”الكسل لا وجود له” الذي نشره عام 2021، أن الكسل “كذبة”، واصفًا إياها بـ”مصدر الشعور بالذنب لعدم قيامنا ”بما يكفي“. إنها أيضًا قوّةٌ تجبرنا على العمل إلى حدّ الإيصال بأنفسنا إلى المرض”. حدد برايس “٣ من المبادئ الأساسية لكذبة الكسل: ١- قيمتك هي إنتاجيّتك، ٢- لا يمكنك الوثوق بمشاعرك وحدودك، ٣- هنالك دائمًا المزيد الذي يمكنك القيام به.”
يصف برايس الكسل الذي يرمي المجتمعُ به الأشخاصَ جزافًا بأنه يتعدّى كونه وصفًا فقط، بل يرونه “نتيجة” للكسل. وهنا نضع خطين تحت “نتيجة”. فيصبح كلّ ما يمنع الفرد عن نجاحه في دراسته أو عدم استطاعته إيجاد عملٍ ما أو إيقاف نفسه عن تعاطي المخدرات هو “نتيجة” لكسله. يعترض هنا برايس بأن “الحياة ليست بتلك البساطة”.
وذهب أبعد من ذلك في إعادة وصمة الأشخاص “الكسالى” بالعار إلى أن من العوامل الأساسية المسببة في انتشار هذه الكذبة كانت من قرونٍ مضت. ففي الولايات المتحدة، حسب بحثه، وقبيل وصول “البيوريتانيين” أو “التطهيريين”، هؤلاء جماعة متشددون دينيًا لطالما اعتقدوا بأن الفرد إذا ما عمل بجدّ فهذه علامة على أن الله قد اختارهم للخلاص.
يشير برايس أن البيوريتانيين، من جهةٍ مقابلة، اعتقدوا بأن الفرد الذي لا يستطيع التركيز على المهمة التي يقوم بها أو لا يستطيع تحفيز نفسه لفعلها فقد وصم بإنه خطيّ. أولئك الذين فشلوا في أداء مسؤولياتهم لم يخترهم الله. يذكر برايس أنّ هؤلاء التطهيريين عندما وصلوا واستعمروا أميركا، انتشرت أفكارهم بين المستعمرين الآخرين الأقل تقىً، وأنه لأسباب عديدة أصبح هذا الاعتقاد الذي يحكم على “الكسالى” ويعاقبهم سائدًا وشائعًا ومفيدًا سياسيًا أيضًا.
يرى برايس أنه وبسبب اعتماد أميركا المستعمِرة على عمل العبيد والخدم لعقود كثيرة، كان من المهم جدّا لطبقة الأثرياء أن تجد طريقة لتحفيز العبيد على العمل الجاد بالرغم من أنه لا شيء من العمل بهذا الشكل يأتي عليهم بالربح، إلا أنه تمت السيطرة عليهم فكريًّا خوفًا من تمرّدهم أو “شغبهم” إذا ما تم إعطاؤهم وقت فراغ ما. هذا باقتضاب. ثم ما لبث أن أصبحت هذه النظرة للعالم أساس الرأسمالية الأميركية. لكن حقيقة يطول الشرح لا شكّ.
نحن نعيش في عالم يُكافأ فيه من يعمل بجدّ، في حين يلتصق العار بمن يكون لديه احتياجات وقيود تمنعه عن إتمام عمله. ويُسهِبُ متعجّبًا كم أننا نرزح في إجهاد أنفسنا بشكل مستمر خوفًا من أن يتم وصمنا بالعار وقلّة الحيلة، لكن بالعودة إلى المعنى اللغويّة لكلمة مهنة، التي أصبحت اليوم معادلاً لـ career، نلاحظ أنها مشتقّة من المهانة، وكانت العرب تكره المهنة لما فيها من مهانة وذلّ، ربما الكسل، يحمينا من “ذلّ” العمل، وما فيه من “عبوديّة” إن صح التعبير.

الحق بالكسل
هنالك تفتيش دائم عن شيء ما لملء الوقت. هنالك الكثير منه. وبشكل موازٍ، القليل منه. الكثير من الوقت للتفكير، والقليل منه اذا ما انهمكنا بالقلق اليومي والعمل الإنتاجي الذي أصبح مع الرأسمالية عالميًا سببًا في الاغتراب. لا سيما في بلدان تملؤها الفوضى. دعونا نأخذ برهة للتفكير، للتلحيل، للاسترخاء، لل”صفنة”. سرعة العصر، الكثير من البيانات و البيانات المناقضة. أيديولوجيات متناحرة. تفاهة هنا ولهاثٌ وراء شيء هناك. كيف السبيل لإعادة صياغة مفهوم الفراغ. الاسترخاء لقراءة كتاب. في عصر يملؤه القلق والخضوع لشيء “أكبر مني ومنك”. ماذا لو أردت الاستمتاع برسم لوحة ما؟ ماذا لو أخذت وقتك لكتابة كتاب خاصٍ بك عن تجربة عالم تراها مثيرة للاهتمام؟ الاستجمام حتى.
في دراسة للدكتور سرير أحمد بن موسى، بعنوان “من الحق في الكسل إلى نهاية العمل: قراءة نقدية لمفهوم العمل الإنتاجي”، يقول بن موسى أن الدفاع عن حضارة الكسل أو الترفيه جاء “بداية برفض ما يقابلها من مصطلح. أي العمل.” ويضيف “إذا ما أخذنا مقاربة بول لافارغ، زوج ابنة كارل ماركس في كتابه “الحق في الكسل”، الصادر في بداية 1880، حيث يعترض فيه على تأثير أخلاق العمل على البروليتاريا. فالطبقة العاملة في نظره تركت نفسها عُرضة للاستمالة بواسطة تقييم للعمل يتعارض مع مصالحها. حجج لافارغ تشير من جهة، إلى قانون العمل كأداة أيديولوجية للسيطرة الاجتماعية والسياسية، ومن جهة أخرى إلى نتائجه الفيزيولوجية الوخيمة.”
ويتابع بن موسى عن حجج لافارغ أن “دليل الخداع والمراوغة الخاص بأخالق العمل يظهر من خلال تصرفات الطبقات المالكة، فالأغنياء، والحكام، والطبقات البعيدة عن عملية إنتاج المنافع، كلهم حسب لافارغ يتنعمون في الرفاهية ومتعة الكسل.”
إقرأوا أيضاً:
بين الكسل الفعلي والكسل القسري
في حين أن الكسل كمفهوم هو ذاتي التعريف يرتبط بثقافة محددة، وقد يختلف تعريفه بناءً على وجهات نظر مجتمعيّة أو فرديّة كخلاصة. لكن إذا ما أخذنا على سبيل المثال حال لبنان، في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي انعكست انهيارًا وتفكُّكًا اجتماعيًّا أيضًا، تصبح مقاربة مفهوم الكسل أوسع وأعمّ إذا ما أضفنا في الحسبان الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم، بحيث يرتبط حكمًا العدد المتزايد للعاطلين عن العمل ونسب البطالة المقنّعة بهذا الواقع. التساؤل هنا عن مدى كسل البعض وجهوزيّة البعض الآخر أمام شراهة الواقع وتدميريّته يصبح مبتذلًا. ويصبح مبتذلًا أيضًا التعقيب بوصم هذا المصطلح بالأشخاص المثقلين من هذا الواقع المؤلم المعقّد.
منذ بداية الانهيار الاقتصادي إلى اليوم، ينحدر حال الأفراد بشكل مخيف، رعبٌ متجسّد بحال اقتصادي ميؤوس منه وانهزام يوميّ وشرخٌ ما بين الطبقات الاجتماعية. في وقت كهذا لا حرج في أن تعجُّ صالات الأطباء النفسيين بالطالبين لجلسة استماع فقط. يترنّح البعض خلف أدوية “الأعصاب”، فهم لا يتمالكون أنفسهم، والآخر خلف جلسات استماع مرتبطة بالأزمات التي لا مكان للهروب منها. أو الاثنتين معًا، فتكثُرُ “الحالات النفسية” وتفقّس معها مفاهيم جديدة.
ربما إذا ما اطلعنا على اللاعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي يتصف بها حال أغلب من يعيش في البلد، يصبح التساؤل عن “رفاهية الكسل” أكثر من مجرّد تساؤل. ففي هذه الأزمة الاقتصادية النادرة التي تجتاح لبنان، يصبح التعريف أكثر تعقيداً وأهمية.
هناك تحوّل في وجهة نظر الكثيرين حول الكسل، ففي السابق ربما كان يُفهم بأنه نتيجة للكسل الفردي أو العزوف عن العمل، لكن اليوم يبدو أن البعض يشعر بأنه نتيجة واقع مرير يجبر الكثيرين على عدم القدرة على العمل والتحرّك لتحسين أوضاعهم.
في ظل هذه الأزمة، يصبح من الصعب الفرز ما بين الكسل الفعلي والكسل القسري. هناك من يجد نفسه عاجزاً عن البحث عن فرص عمل أو طرق للنجاح في ظل الواقع الاقتصادي المتردي، مما يجعل الكسل يبدو كواحد من نتائج الظروف الصعبة التي يعيشها الناس.
انهيار الاقتصاد وتفاقم البطالة يضع الكثيرين في مواجهة تحديات باهظة الثمن، وبالتالي يصبح تعريف الكسل ضمن هذا السياق يحتاج إلى تفكير عميق وتقدير للواقع الصعب الذي يواجهه الناس يومياً.
التساؤل عن الكسل في زمن الأزمة الاقتصادية في لبنان يجب أن يتضمن التفكير بالاعتبار الواقع الصعب والمتلازمات الاجتماعية المعقدة التي يعيشها الناس. قد يكون هناك العديد من الأشخاص الذين يتخبطون بين شعور بالعجز والإحباط بسبب الأوضاع الصعبة، وقد يجد البعض نفسه محاصراً في دوامة من اليأس وعدم القدرة على الخروج منها. لذلك من المهم أن نعترف بأن الكسل قد يكون نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة وتراكم المشاكل الاجتماعية التي يشهدها البلد.