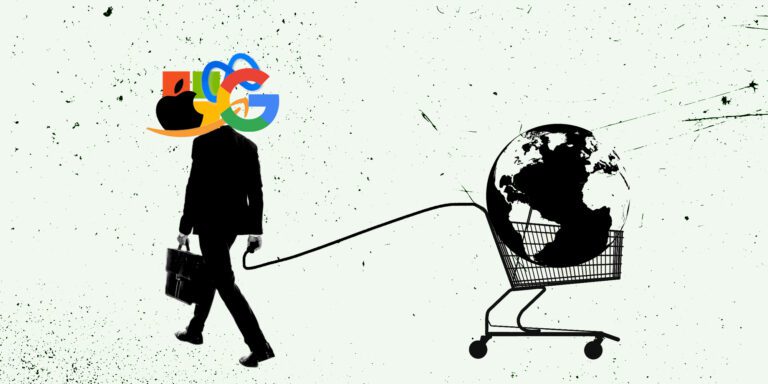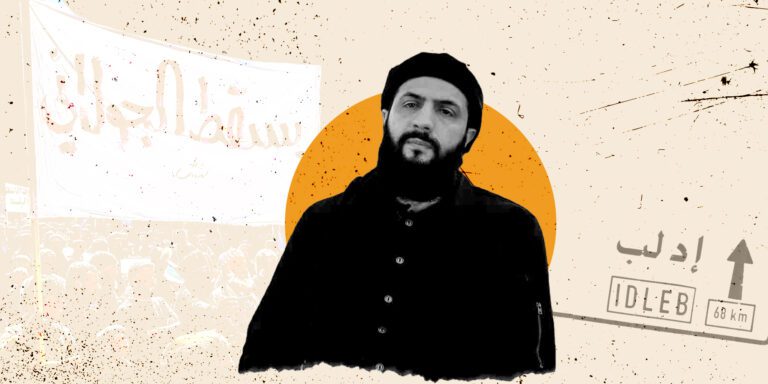يستطيع أي فلسطيني زيارة بلده إذا بات لديه جواز سفر أجنبي، وهو ما فعلته، للمرة الأولى في العام 2017، بعد حصولي على الجنسية الأميركية (2016)، وكان ذلك، في ما مضى، حلما مستحيلاً، إذ توفي والداي وهما يحلمان بالعودة إلى مكانهما الأول، حيث والدي من اللد، ووالدتي من حيفا.
هكذا ظلّت فلسطين بالنسبة الى جيلي والأجيال التالية، من الذين وُلدوا بعد النكبة، لوالدين لاجئين، مجرد بقية ذكريات أو حكايات من الأهل، أو مجرد مخيلة تتغذّى من قصائد الشعراء وروايات الروائيين، من أمثال عبد الكريم الكرمي وتوفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش وعز الدين المناصرة وإميل حبيبي وغسان كنفاني، وكذلك المنشورات والشعارات والأغنيات السياسية، وخطابات قيادات الفصائل الحماسية التي انبثقت أواسط الستينات.
انحسار فلسطين المتخيّلة
لكن تلك الصورة المتخيّلة عن فلسطين لم تبقَ على حالها، ففكرة التحرير، والتي تتضمن العودة وراودت خيال رواد الحركة الوطنية الفلسطينية، تهمّشت، أو تهشّمت، إذ إن إسرائيل هزمت تلك الحركة، كظاهرة اعتمدت الكفاح المسلّح في الخارج، بعدما هزمها الواقع العربي، الذي ظلت أنظمته التسلطية تروج نظرياً، فقط، لاعتبارها فلسطين قضيتها المركزية، للمخاتلة والمزايدة والتلاعب، في حين أن تلك الحركة ذهبت إلى عقد اتفاق مجحف مع إسرائيل (1993)، تضمّن تحوّلها إلى سلطة على شعبها، من دون انتهاء الاحتلال، ومن دون سلطة لها على الأرض والموارد.كما تضمن عودة مناضلي التحرير، مع بنادقهم، إلى جزء من أرضهم احتُّل عام 1967، علماً أن حركتهم كانت قامت قبل ذلك لتحرير فلسطين، أي ليس لإقامة دولة، أو سلطة، في ذلك الجزء (الضفة والقطاع)، الذي لم يكن محتلاً آنذاك.
إذاً، فقد كُسرت الصورة والإطار والسردية الأساسية، لقضية الفلسطينيين وحركتهم الوطنية، بعودة المناضلين، مع عائلاتهم، من حركة “فتح” والجبهات الشعبية والديمقراطية والنضال وغيرها، ليتحولوا إلى موظفين، في السلكين المدني والأمني، في إطار الكيان السياسي الذي خُلق في الضفة وغزة، باسم فلسطين، مع سلطة، أصبحت سلطتان، تحت سلطة الاحتلال، بحيث بات لنا بدل الدولة دولتان، بانتظار “تفريخات” أخرى، ربما.
قبل كل تلك التطورات، لم تكن العودة أو الزيارة الفردية متاحة، عدا استثناءات قليلة، بل إنها كانت موضع شبهة، أو تساؤل، لا سيما مع الدعوات الساذجة، أو المزايدة، أو ضيق الأفق لما يسمى مناهضة التطبيع، التي لم توفر شخصيات مثل إدوارد سعيد ومحمود درويش وعزمي بشارة والياس خوري ونوري الجراح، في واقع عربي مثقل أصلاً بالتطبيع، من الناحية العملية، مع إسرائيل، أي مع وجودها، في ظل أنظمة حصرت همّها، نظرياً فقط، باستعادة الأراضي التي احتلت عام 1967، وعملياً بمجرد بقائها كنظام تسلّطي على شعبها، في إقليمها.
في العام 2017، وصلتني رسالة من الصديق أسعد غانم (أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا) يسألني فيها عن إمكان المشاركة في مؤتمر في القدس، عنوانه: “خمسون عاماً على احتلال القدس”، بتنظيم من “جامعة القدس” ومن “لجنة المتابعة العربية العليا”. للوهلة الأولى، انتابتني مشاعر متضاربة، من الدهشة والحيرة والامتنان واللهفة، الدهشة من تلك المفاجأة غير المتوقعة، والحيرة لما قد يثيره ذلك من قبل البعض، ثم الامتنان لهذه الفرصة، واللهفة لحدوثها، وهكذا كانت تلك زيارتي الأولى لأرض الآباء والأجداد، ثم تكررت ثانية وثالثة في العام 2018، والرابعة التي حصلت في الأيام الماضية.
الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (1967)، فهم يعيشون في حال من الحيرة والقلق، فلا هم في واقع احتلال، ولا هم في واقع دولة مستقلة، إذ إن إسرائيل تصارعهم على كل شبر
في زيارتي الأولى تسنّت لي معرفة البلاد، وهو مصطلح محبب لدى الفلسطينيين، يطلقونه على فلسطين، رغم مساحتها الصغيرة (27 ألف كلم مربع)، إذ إنها عندهم كبيرة جداً، بوديانها وسهولها وجبالها وبحرها وصحرائها، وبإطلالتها على بلدان عدة، وبتاريخها السحيق الذي شهد معظم ملاحم المشرق العربي، بين بلاد الشام ومصر، ولاتصالها بالحضارة الآشورية والفارسية والرومانية، وبأرضها التي ولدت، أو احتضنت، الأديان السماوية الثلاث.
كان اللقاء الأول مشوباً بالحماسة واللهفة، ومأخوذاً بجمال تلك البلاد، ومسكوناً بالحنين لمعرفة الجزء الآخر المنسي من الشعب الفلسطيني، الذي نسيته الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بتعاملها معه بدلالة مواطنيته الإسرائيلية (الاضطرارية)، بدل التعامل معها بدلالة أنه ذلك الجزء الصامد من الفلسطينيين، الذي بقي في أرضه، عصياً على محاولات الاقتلاع والإخضاع والأسرلة.
هكذا ظلت كل تلك الخلطة ساكنة في قلبي وعقلي، وملازمة لمشاعري، في زياراتي كلها، التي شملت أكبر عدد من المدن والبلدات والمناطق، وتضمنت الالتقاء بأكبر عدد من الشخصيات المعروفة، في الوسطين السياسي والأكاديمي.
فلسطينيات متعدّدة
في البلاد، شهدتُ عن قرب كم أن فلسطين مقسّمة، وكم أن الفلسطينيين مقسمون في المكان، وفي السياسة، وفي الحقوق، في المعنى والمبنى، كل شيء مقسم أو تُجرى هندسته وفق العقلية الإسرائيلية التي تتوخّى إزاحة الفلسطينيين من المكان والزمان، أو جعلهم يختفون خلف جدران أو أسوار عالية، كأن البلاد من النهر إلى البحر فيها طوابق عدة، الذين فوق لا يعرفون، أو لا يريدون أن يعرفوا، الذين تحت، خارج الأسوار، والذين يعيشون بحرية، لا يريدون أن يعرفوا الذين داخل الأسوار التي تتناسل في البلاد وتتنوع أشكالها وأحوالها وتوظيفاتها.
ليس الحديث هنا عن مستوطنات في الضفة فقط، ففي مناطق 48 (أي في إسرائيل)، ثمة فصل بين اليهود والفلسطينيين، في معظم الأمكنة، صحيح أن الطرق وأماكن التسوق والجامعات واحدة، لكن الفصل يكمن في الحيز الضيق المتاح للمناطق العربية، بالقياس حتى لمستوطنة صغيرة أقيمت قبل سنوات؛ وهذا ما لاحظته بشكل مكثف وفظّ في مدينتي اللد، إبان زيارة اصطحبني فيها غسان منيّر، إذ ثمة تدمير لمعظم أحياء تلك المدينة، وحجز من تبقى فيها من فلسطينيين في أماكن محددة، لا يسمح لهم بالتوسع فيها لا أفقياً ولا عمودياً، في حين تشمل الأبنية الحديثة للسكان اليهود حدائق واسعة وملاعب، وتتمتع بخدمات راقية جداً، بالقياس الى الخراب الذي حل بالأحياء العربية المتبقية، مع ركام الأوساخ والأتربة. الأخطر من ذلك، أن الأحياء العربية المتبقية مهددة من جماعات يهودية من المتطرفين المتدينين الذين أتوا خصيصاً للإقامة في تلك المدينة لإشاعة الهلع فيها، وحمل سكانها على تركها، إلى درجة أن غالبية بيوت الفلسطينيين فيها باتت محاطة بأسوار عالية، سجن أصحابها أنفسهم فيها، تحاشياً لهجمات اليهود المتطرفين المسلّحين، والتي تحصل غالباً تحت أنظار وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.
أيضاً، يحصل الفصل في إقامة أحياء يهودية خالصة تمنع سكن الفلسطينيين، أهل الأرض الأصليين، فيها، ويحصل ذلك مع تدني مستوى الخدمات، أو الموازنات، لذا فإن تشريع قانون أساس في الكنيست (2018) باعتبار إسرائيل دولة قومية لليهود لم يأت عبثاً، إذ عبّر عن واقع قائم، منذ إقامة إسرائيل (1948)، وهو الأمر الذي جعل منظمات حقوق إنسان عالمية، وضمنها بتسيليم الإسرائيلية، توصف إسرائيل باعتبارها دولة “أبارثايد”، من النهر إلى البحر، أي أن ذلك يشمل تعاملها بشكل عنصري مع الفلسطينيين من مواطنيها، هذا علاوة على كونها دولة استعمارية.
في كل الأحوال، فإن الفلسطيني في 48 يشعر أنه مهدد في أي لحظة، لأي سبب في امتلاكه مكاناً، أو في حرية الحركة، أو في مكانته القانونية في الدولة، إنهم الأغيار أو الفائضون عن الحاجة، أو إنهم بمثابة الضاحية للمدينة، أو الهامشيون في المتن، أو العمال عند أرباب العمل، لهم حقوق طبعاً، وربما هي أفضل من حقوق أي “مواطن” عربي في دولته، علماً أن هذا المفهوم غائب تماماً في معظم البلدان العربية.
أما ما يميّز الفلسطيني في 48، قياساً بالفلسطينيين في بلدان اللجوء، وفي الأراضي المحتلة عام 1967، فهو أولاً، قوة المستوى الأكاديمي، تبعاً لقوة منظومة التعليم في كل المراحل الدراسية في إسرائيل. ثانياً، التقديمات الاجتماعية (التأمين الصحي والنظام التقاعدي)، ونمو الطبقة الوسطى. ثالثاً، حرية الرأي والتعبير، وضمن ذلك الحق في إقامة كيانات سياسية، والحق في المشاركة السياسية (وضمن ذلك في انتخابات الكنيست)، شرط عدم الخروج عن السقف، وعدم استخدام العنف، وهي كلها حقوق طبيعية، ونتاج لطبيعة الدولة الإسرائيلية، كدولة ديمقراطية لليهود الإسرائيليين، أي أن الفلسطينيين يستفيدون من ذلك الهامش، رغم أنهم على هامش المجتمع والدولة الإسرائيليين.
في القدس المقسّمة، تجد نفسك في مدينة ممزّقة، ثمة قدس شرقية (احتلت في 67) وغربية (كانت احتُلت في 48)، وثمة في القدس الشرقية أحياء عربية وأحياء إسرائيلية، وفي القدس القديمة (العتيقة) حيث الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ثمة أحياء وبنايات وحوانيت استولى عليها المستوطنون المتدينون، المتطرفون، إلى درجة يبدو الصراع فيها على أشدّه على كل سنتيمتر فيها. ويخيّل إليك في القدس داخل الأسوار كأنك وسط قاعدة عسكرية، فالجنود في كل مكان، حتى في الأزقة، في البوابات، وفي باحات المسجد الأقصى، في مشهد حربي بامتياز، فالمدينة في حالة احتلال معلن منذ 56 عاماً، كأن ذلك بدأ للتو، مع ذلك فإن الفلسطينيين يمضون في حياتهم، كأن هؤلاء المجندين طارئون على المكان والزمان، ووجودهم يبعث على الاستفزاز والغضب، مشوّهاً جمال المدينة، الآتي من التاريخ ومن الأسطورة.
ثمة أيضاً، غزة خلف الأسوار العالية، والأسلاك والخنادق، التي لم تسنح لي الظروف الراهنة بدخولها، وثمة الضفة الغربية، التي دخلتها، مرة عن طريق القدس – رام الله، ومرة عن طريق الناصرة – جنين، في الدخول والخروج يُطرح عليك السؤال من جندي أو جندية، “من وين أنت؟ أو لوين رايح؟ أو أيش راح تعمل؟”، بالعربي أو بالعبري أو بالإنكليزي أو بالروسي، أشخاص لا تعرف من أن جاؤوا، سمر وصفر وبيض، أشخاص لا علاقة لهم بالمكان البتة، ربما جاؤوا قبل سنة أو قبل عشر سنوات، أو قبل عشرين سنة، لا يعرفون الأماكن التي يعيشون فيها، ولا يعرفون تاريخها، لكنهم وجدوا أنفسهم مع بندقية وخوذة، كسلطة على أهل البلاد.
في الضفة الغربية، كل شيء يحتمل الانفجار، وكل شيء يبعث على اللامبالاة، في تناقض مخيف، هو سمة الوضع الفلسطيني، لشعب بات يعيش تحت السلطة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، وسلطة المستوطنين الذين ينازعون السلطتين على ما نشهد هذه الأيام.
مشهد الضفة الغربية بات بالغ التشوّه، فالجدار الفاصل يتلوّى كالأفعى لإخفاء الفلسطينيين ولحماية المستوطنين، في حين تنتشر المستوطنات والطرق الالتفافية والأنفاق والجسور، كي تعزز الانفصال بين القرية الواحدة وبين القرية والقرية، وبين المدينة والقرية، كل شيء خاضع للفصل والضبط والهندسة الاستعمارية، التي تثبت سيطرة إسرائيل ومستوطنيها، بما في ذلك انتهاجها سياسة هدم البيوت والاعتقال التعسفي والقتل.
الفلسطينيون في مناطق السلطة حيرى بين الغضب والإحباط واللامبالاة، بين حدي الوطنية والخلاص الفردي، ثمة طبقة وسطى واسعة، وطبقة فقيرة، ثمة سلطة على الشعب لكن لا حيلة لها إزاء المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وبين هذا وذاك ثمة عملية فدائية هنا، أو هناك، بين فترة وأخرى، وردة فعل إسرائيلية هوجاء، تتمنى محو الفلسطينيين، أو طردهم، على ما بات يصرّح بعض وزراء حكومة نتنياهو، مثل بن غفير وسموتريتش.
إلى أين من هنا؟
لا مجال للاختصار في هذه اللوحة عن فسيفساء الوضع الفلسطيني، المكان، والناس، الممكن والمستحيل، الألم والأمل، الطموحات والإمكانات، لكن الاستنتاج الأساس يتمثل في أن الفلسطينيين قبل إقامة السلطة كانوا أكثر وحدة وتحرراً وجرأة في مواجهة إسرائيل وسياساتها، وأن إسرائيل استطاعت استيعاب الحركة الوطنية الفلسطينية، وإزاحة سرديتها المؤسسة على النكبة، وقضية اللاجئين وإقامة إسرائيل (1948) إلى سردية تقوم على إقامة كيان سياسي للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل في الأراضي التي احتلت عام 1967.
أيضاً، فإن الحركة الوطنية الفلسطينية في المحصلة أخفقت في استراتيجية التحرير بواسطة المقاومة، كما أخفقت في استراتيجية إقامة دولة في الضفة والقطاع بواسطة المفاوضات. إذ بات الفلسطينيون في غيتوات، أو حيزات مغلقة، تم استيعابها،وهندستها،لتغدو أكثر طواعية أو أكثر تكيفاً، بحسب طبيعة الحال، مع دولة إسرائيل اليهودية.
والحال، فإن الفارق الأساسي الذي يمكن أن يكسر تلك الهندسة أو تلك المعادلة، مع سكون المعادلات، أو المعطيات، العربية والدولية الراهنة، ومع افتقاد الفلسطينيين حركة وطنية فلسطينية جديدة وفاعلة، إنما يكمن في ارتداد المشروع الصهيوني على ذاته، وهو ما يحصل اليوم بشكل أو بآخر، مع صعود تناقضات إسرائيل الذاتية، بين المتدينين والعلمانيين، والشرقيين والغربيين، بين إسرائيل الديمقراطية الليبرالية وإسرائيل اليهودية الاستبدادية، وهي التناقضات التي باتت تفلت مع شعور إسرائيل بأنها باتت في واقع احتلال مريح ومربح؛ الى حد أن إيلان بابيه (لدى لقاء جمعني والصديق أسعد به) اعتبر ذلك بمثابة صراع بين دولة إسرائيل ودولة يهوذا، للمستوطنين المتدينين، التي تريد أخذ الدولة الأولى، كدلالة على عمق الأزمة او الانشقاق الحاصل بين الإسرائيليين.
طبعاً، الفلسطينيون، أيضاً، يعيشون مع تناقضاتهم، أو خلافاتهم، التي تتناسل، فثمة جزء من الشعب الفلسطيني يتعايش مع إسرائيل، ويكافح ضد سياساتها بالأشكال السياسية والمدنية المتاحة، في الصراع على شكل الوجود، وجزء آخر يؤسس فكرته على الصراع على الوجود، متوسلاً الكفاح المسلح، والعمليات التفجيرية، والقصف الصاروخي. وبينما تقصف فصائل فلسطينية إسرائيل بالصواريخ من غزة، مثلاً، فإن تلك الفصائل تطالبها بفتح المعابر، وتسهيل إمدادها بالمياه والكهرباء والمحروقات، ناهيك بأن مئتي ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، بما في ذلك في المستوطنات. فوق ذلك، ثمة التناقض المقيم بين إقامة سلطة فلسطينية، وواقع الاحتلال والتمييز العنصري، وبين الإمكانات والطموحات، وبين الواقع والحلم.
القصد أن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بالغ التعقيد، ولا سابقة له، فإذا كان العدو واحداً، وطبيعته هي ذاتها، والنظرة إليه لا تختلف من وضع إلى آخر، وطالما أن الشعب الفلسطيني واحد، وسرديته واحدة، فما الذي يوجب هذا الاضطراب أو الاختلاف، في رؤية الفلسطينيين لذاتهم ولمشروعهم الوطني؟ أو ما الذي يجعلهم لا يتفقون على استراتيجية واحدة، ممكنة، ومستدامة، ويمكن الاستثمار بها، واستنزاف عدوهم عبرها، بدل استنزافه لهم، استراتيجية توحدهم كشعب، وتمكنهم من الصمود وصوغ إجماعاتهم وبناء بيتهم الوطني، وتعزز من إمكان تخليق مشتركات وإطارات عمل بينهم وبين الشخصيات والقوى اليهودية المناهضة للسياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية؟
في زيارتي إلى فلسطين، ظلت تسكن مخيلتي فلسطين التي اضطر والداي لمغادرتها، إذ هي تكاد تختفي أو تذوب، في الهندسة الإسرائيلية للأمكنة، وللسكان، وهو ما يحصل على الضفة الأخرى، حيث مجتمعات اللاجئين في سوريا ولبنان والأردن والعراق، إذ تكاد تلك المجتمعات تختفي بدورها، إن بسبب اختفاء اللاجئين، بعد مرور 75 عاماً، وبسبب تحلّل أو تفكك قضية فلسطين، وبسبب الاضطرابات وتغير أحوال تلك المجتمعات، مع التغير الحاصل في بلدان اللجوء. أما الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (1967)، فهم يعيشون في حال من الحيرة والقلق، فلا هم في واقع احتلال، ولا هم في واقع دولة مستقلة، إذ إن إسرائيل تصارعهم على كل شبر.
رغم تلك الصور كلها، ترى في فلسطين من البحر الى النهر بلاداً يغار الجمال من جمالها، مع شعب مليء بالحكايات، يعيش ماضيه كأنه حاضره ويعيش مستقبله بروح التحدي، شعب ضعيف وقوي، ممزق وموحد، صلب ورقيق، يختلف على كل شيء، وعلى أي شيء، لكن روحه تبقى واحدة، في التحدي والعناد، في الصبر والمكابرة.