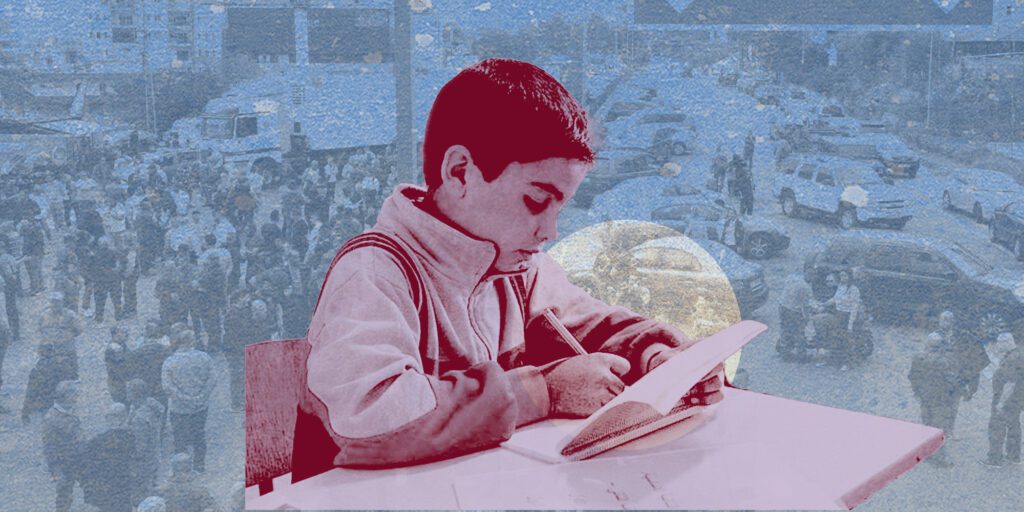في صيف عام 2017، حدثت أكبر عملية بيع للاعب كرة قدم في التاريخ حينها، إذ حصل نادي باريس سان جيرمان على البرازيلي نيمار مقابل مبلغ وصل إلى 227 مليون يورو؛ وبعد ذلك حدث انقلاب في الاقتصاد الرياضي، ووضعت معايير جديدة لبيع اللاعبين، والمسؤول الأول عن ذلك كان هيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك النادي. اليوم تزلزل السعودية مجدداً اقتصاد كرة القدم بعمليات شراء ورواتب تاريخية، وهذه المرة على الأراضي السعودية وليس في أوروبا. فماذا تريد السعودية من ذلك كله؟
نسخ ثقافية جاهزة قابلة للشراء
تنسخ السعودية تجربة الدوري الإنكليزي على أراضيها، ليضخ صندوق الاستثمار السعودي – الذي يعد من أكبر أربعة صناديق استثمارية في العالم بميزانية تصل إلى 650 مليار يورو- ما يصل إلى أربعة مليارات لصالح أكبر أربعة أندية سعودية، لمحاكاة الدوري الإنكليزي بأندية الأربعة الكبار. والإنفاق السعودي هذا الموسم يعتبر ثاني أكبر إنفاق لموسم انتقالات في العالم بعد الدوري الإنكليزي بأنديته العشرين، علماً أن تصنيف الدوري السعودي هو السادس والخمسين عالمياً.
يصرّح الدوري السعودي عبر موقعه، بأنه يريد أن يكون من أفضل عشرة دوريات في العالم، إضافة إلى أن الاستثمار في كرة القدم ذو هدف صحي، لأن 70 بالمئة من الشعب السعودي يعاني من السمنة! هذه الإجابات التي تبدو سطحية وإعلانية جداً، يقف خلفها مشروع يهدف إلى خلق تحولات كبيرة على مستويات لا تخص الرياضة فقط.
عينت السعودية بالفعل كلاً من سعد اللذيذ وعبد العزيز الفالق وكارلو نوهرا، لإدارة مشروعها الرياضي، والذين فجروا بدايته بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو براتب يصل إلى 224 مليون يورو. ظن الجميع وقتها أن الصفقة ليست خطوة في بناء صرح رياضي على المستوى البعيد، بل تتعلق برونالدو نفسه الذي طُرد تقريباً من نادي مانشستر يونايتد، ومهد ذلك الطريق أمام السعودية للتعاقد معه ليكون واجهة تسويقية سياحية للملكة، بعدما امتنعت أندية أوروبية عدة عن ضمّه.
لكن، تتالت الصفقات بعدها كما حال بنزيما الذي يتلقى 103 ملايين جنيه استرليني، وكانتي الذي يصل راتبه إلى 67 مليون جنيه، وروبن نيفيز، وساديو ماني، ونيمار، وغيرهم الكثير. عمّ الهلع في أوروبا نتيجة هذه المبالغ التاريخية، لينبري بعض المحللين والمسؤولين في الفيفا بالقول إن ذلك لا يدعو الى القلق، إذ إن معظم اللاعبين المنتقلين الى الدوري السعودي هم في مرحلة الشيخوخة الرياضية، لترد السعودية على ذلك بعقد صفقات للاعبين في ذروة عطائهم الرياضي، وتنفي بالكامل تهمة “دوري المتقاعدين” عنها. والمضحك، أنه قبل ثلاث سنوات فقط كانت الفيفا قد حذرت بأن الأندية السعودية لا تدفع مرتبات لاعبيها الأجانب، والتي لم تتجاوز مئات الآلاف حينها.
“نستثمر في شعبية اللعبة وليس في اللعبة”
الجزم بأن السعودية تريد تطوير كرة القدم في البلاد -بخاصة بعد نجاح المنتخب السعودي في الفوز على الأرجنتين في المونديال الأخير- هو أمر مستبعد كلياً، إذ إن قواعد التجربة الناجحة لتطوير اللعبة واضحة تماماً؛ وهي الاستثمار في البنى التحتية، مع خطط طويلة الأجل تبدأ بمنتخبات الناشئين، ولكن ذلك كله لا يعني المملكة بقدر شيء آخر: وهو التسويق.
معظم اللاعبين الذين انتقلوا الى الدوري السعودي هم بالدرجة الأولى الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. رونالدو لم يجلب لأجل البطولات، وهو لم يفز باللقب السعودي حينما انتقل الى نادي النصر، بل هو موجود لمشروع تسويقي بالكامل لا تنافسي.
نجحت خطة التسويق! إذ تصدرت أخبار الانتقالات في الدوري السعودي العالم بأسره، وهذا تماماً ما أرادته المملكة. إنها محاولة لتجميع المشاهير في قاعة واحدة أكثر من كونها عملية لخلق رياضة تنافسية. أصبح اللعب والتنافس شكلاً أدائياً استعراضياً أقرب الى المصارعة الحرة من كونه منافسة رياضية. اللاعبون هنالك للنزهة والتصوير، ويتناغم ذلك مع الرؤية التسويقية الجديدة للعبة، والتي تعنى بمقاطع “الريلز” بعد المباراة، وبأخبار الانتقالات أكثر من المباريات نفسها.
السؤال الأهم: هل التسويق الذي تريده المملكة هدفه اقتصادي بالضرورة؟ والإجابة الى حد الآن هي استحالة تحقيق ربح اقتصادي من هذا الاستثمار، وضآلة أرباحه حتى في الأندية الأوروبية. الفكرة السعودية هي خلق خطة تمتد من خمس إلى سبع سنوات تتكون بموجبها أربعة فرق على المستوى العالمي يتم بيعها في ما بعد للقطاع الخاص.
لكن خطة صنع “فرق النجوم ” ثم بيعها، وعبر مقارنة بسيطة للأرقام، لا تبدو مربحة، خصوصاً إن أخذنا بالاعتبار مشاهدات الدوري وانتشاره عالمياً. صحيح أن السعودية باعت حقوق بثها إلى شبكة (أي أم جي) لكي تبثه إلى ما يقارب 54 دولة، إلا أن المبلغ يكاد يكون مضحكاً مقارنة بالدوريات الأوروبية. إثر ذلك، قامت شبكة (أس أس سي) السعودية الحكومية بشراء البث المحلي بعشرة أضعاف الرقم، فالأمر أشبه بمن يبيع ويشتري مع نفسه.
المفارقة أيضاً، أن قيمة رواتب اللاعبين والعقود الموقعة معهم، لا تقترب مع إيرادات المشاهدات، كما الحال في كرة القدم الأوروبية، والخطة السعودية لتسويق الدوري ستخفض الخسائر بنحو عشرين بالمئة بالحد الأقصى ولن تعوض الإنفاق. باختصار، المشروع السعودي لا يهدف الى الربح بل الى الاستعراض.
هذا الكلام ينسجم تماماً مع الخطة السعودية في هذا القطاع منذ عام 2018، حين استضافت بطولة “دبليو دبليو اي” للمصارعة الحرة في الدرعية، بتكلفة مئة مليون دولار سنوياً، إضافة الى استضافة بطولات للتنس، ونهائي بطولة الملاكمة للوزن الثقيل بجائزة تساوي 60 مليون دولار سنوياً، وهي الأكبر في التاريخ. كذلك وضعت السعوديّة جائزة عشرين مليون دولار لنهائي سباق الخيل كالأعلى في التاريخ أيضاً، ومن ثم اشترت حصصاً في سباقات الفورمولا، إضافة الى شراء حصص سيادية في بطولة الغولف الأميركيّة وجلب معظم المشاهير والسياسيين الى اللعبة، بجوائز خرافية، وتحولها كذلك إلى شكل استعراضي أدائي متلفز.
تضاف الى هذه الأرقام الاتفاقيات الموقعة مع بعض اللاعبين مثل ميسي بعقد يبلغ 25 مليون يورو، ليكون الوجه الترويجي للمملكة. باختصار، حجم الاستثمارات خلال سنتين فقط بلغ ستة مليارات، وهو رقم يفوق ميزانيات بعض دول أوروبا الشرقية.
أمثولة الهزيمة الصينية في كرة القدم
هناك من يراهن على فشل تجربة الدوري السعودي بالاستشهاد بالتجارب التاريخية المشابهة، بخاصة الصين والولايات المتحدة. ففي عام 2016، التُقطت صورة تاريخية جمعت كلاً من الرئيس الصيني جين بينغ، والرئيس البريطاني ديفيد كاميرون، واللاعب سيرجيو أغويرو في إحدى حانات إنكلترا.
مهدت هذه الصورة لمشروع اقتصادي صيني ينسجم مع أسطورة الصين الاقتصادية ذلك الوقت. وبدأ الإعصار الصيني بخطف لاعبين مثل نيكولاس أنيلكا، وديديه دروغبا، ولم يقف الأمر على جلب مشاهير في آخر مسيرتهم، بل تم شراء كل من هالك وأوسكار -ذي الخامسة والعشرين من العمر حينها- بمبالغ قياسية، كونهم من نجوم تلك المرحلة.
اعتمد المشروع الصيني على مجموعة من رجالات الأعمال مع شراكات حكومية، والهدف الأساسي كان رفع شعبية الرياضة في الصين، والترويج للدولة بغية استضافة كأس عالم، وتطوير منتخب البلاد؛ ولكن بعد عامين فقط سقطت التجربة بالكامل مع فشل اقتصادي مريع، لتتدخل الدولة وتضع حداً للأندية، عبر سن قانون يسمح لكل نادٍ بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب فقط، ومع حلول وباء كورونا انتهت التجربة الصينية، لتعلن الأندية إفلاسها.
اكتشف العالم حينها أن البنية التحتية لها الأولوية إن أردت تطوير لعبة ما، وهذه التجربه تتشابه أيضاً مع ما فعله رجال الأعمال في الولايات المتحدة خلال سبعينات القرن المنصرم بجلب لاعبين كما بيليه وبيكنباور، لخلق سوق للعبة في الداخل، ورغم ذلك فشل المشروع.
تختلف التجربة ضمن هذا الإطار ليس على مستوى الشكل، ولكن بالهدف. إذ تدرك المملكة جيداً أن المشروع خاسر على المستوى الاقتصادي، والربح مستبعد تماماً، وهذا هو جوهر الاختلاف عن الصين والولايات المتحدة. فالسعودية لن تنتظر الجمهور ليمول لها مشروعها.
أوروبا الرابح الأكبر والضحية الكبرى أيضاً
شن بعض المدربين مثل يورغن كلوب وبيب غوارديولا ولاعبون مثل توني كروس، هجوماً بدرجات متفاوتة على الاستثمار السعودي، معربين عن خوفهم على اللعبة نفسها. وفي المقابل، صرح ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “المشروع غير مجدٍ، ولن يغير شيئاً في كرة القدم التي نعرفها” معللاً ذلك بأن أوروبا لا تزال منجماً للأموال، والهوة مع السعودية ليست بذاك الاتساع، كما أن اللاعبين أنفسهم يريدون البطولات وليس فقط المال.
هناك مفارقة غريبة في هذا الإطار، إذ إن اتحادات كرة القدم في أوروبا تضع قوانين اللعب المالي النظيف في رأس أولوياتها، وتحاول فرض سقف رواتب على الأندية، رغم اختلاف الضرائب بين الدول. وقد ارتفعت حدة القوانين هذه بعد جائحة كورونا في محاولة لإنقاذ الأندية الرياضية، والإبقاء على حدة المنافسة بين جميع الأندية.
يأتي ما سبق مع ثورة بعض الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد، لخلق دوري يضم كبار اللعبة بما يشبه نظام دوري السلة الأميركي، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالكرة الأوروبية. وعلى رغم هذه الثورة، ظلت الفيفا على موقفها بفرض قوانين اللعب المالي النظيف لكسب معركتها مع الأندية الكبرى، وانقسم جمهور اللعبة بين مؤيد للفيفا وللمستضعفين، وبين مؤيد للحل الإنقاذي الذي وضعته كبرى الأندية، معتقدين أن القوانين ستضعف الكبار وتشل اللعبة وجماهيريتها.
ضمن النزاع بين “المستضعفين” و”الأغنياء”، يبدو الاستثمار السعودي كطوق نجاة لكرة القدم الأوروبية، فالفكرة الأوروبية برأيي واضحة هنا، وهي أن السعودية لا تعطل الكرة الأوروبية، بل تحييها، وستكون المصدر المالي الضخم الوحيد لأوروبا بعد كوارث جائحة كورونا الاقتصادية، وانخفاض شعبية اللعبة على مستوى التلفزة مقارنة بمقاطع “الريلز” والملخصات.
ترى الفيفا الهجمة السعودية كحل إنقاذي مثالي، وتراهن على عدم قدرة الدوري السعودي نهش وتفتيت الصرح الأوروبي الكروي التاريخي، فالسعودية تريد شراء صورة كرة القدم الأوروبية، ولن ترفض أوروبا بيعها نسخة، مقابل أن تستمر في العيش. يتشابه الأمر مع رفض بعض أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الاستثمار السعودي في لعبة الغولف، لكنهم تخلوا عن موقفهم لاحقاً عندما علموا أن المال فقط هو من يستطيع الحفاظ على هويتهم الثقافية.
في المقابل، تبدو المملكة واعية لجشع أوروبا المالي، ومدركة لكمية الخسائر التي ستتكبدها، ولكن الهدف الأساسي يرتقي فوق ذلك كله. الهدف الأساس للمشروع السعودي هو تغيير الصورة الثقافية المكرسة عن المملكة، وإيجاد بديل معاصر آخر. ببساطة، يمكن القول إن السعودية ليست آبار النفط أو دولة الإسلام، بل هي كريستيانو رونالدو وميسي. إنها محاولة لخلق شهرة عبر “أشياء” غير النفط، وتعزيز الصورة الدولية عبر المنتجات الثقافية، وتبدو الرياضة هنا أداة ثقافية متينة وقوة ناعمة مدمرة في الصراع مع الأقوياء، ما يجعل الهوية السعودية الجديدة كهرمون النمو الأساس في قلب النظام العالمي.
السباق الخليجي نحو المعاصرة
هنالك مستوى أقليمي لا يمكن إغفاله، متمثل بالسباق الخليجي نحو مغازلة النيوليبرالية العالمية. هذا السباق افتتحته مجموعة أبو ظبي، والتي تمتلك تسعة أندية حالياً في أوروبا: أهمها مانشستر سيتي. وقد اعتمدت تجربتها على النجاح الرياضي ضمن جدول هادئ زمنياً، وبناء قواعد رياضية متينة للأندية.
دخلت إلى جانب أبو ظبي، هيئة الاستثمار القطرية كمتسابق في هذا المجال، واستثمرت في كرة السلة للمحترفين، وأسست أهم مشاريعها وهو نادي باريس سان جيرمان الذي كان يفجر سوق الانتقالات على مدى السنوات السابقة. وبسبب هذه الاستثمارت، خلق ما يسمى بأندية الدول، أي الممولة من حكومات، والقادرة على تجاوز الخسائر عبر تسجيل إيرادات مزيفة، أي أن الرعاة الأساسيين للنادي هم شركات مملوكة للجهة المستثمرة ذاتها. يقومون بضخ الأندية بعقود ذات أرقام فلكية. وأخيراً، دخلت السعودية السباق الخليجي في أوروبا عبر نادي نيوكاسل، ولم تكتف بذلك لتنقل السباق نحو مستوى آخر متمثل بصنع دوري عالمي داخل أراضيها وليس بالوكالة.
هذه الغايات تحاول بعض المنظمات الإنسانية تفكيكها والقول إنها غسيل رياضي، أي غسل سمعة الدولة عبر الرياضة والمنتجات الثقافية، وهذه المحاولات موجهة الى الداخل بالدرجة الأولى. فالسعودية تحاول ترسيخ نمط حياتي جديد داخل المملكة مقابل صمت المواطنين. إنها تحرق الثروة مقابل السلام الاجتماعي، وترسخ حكمها السياسي عبر الإبهار. وللغسيل الرياضي دلائل تاريخية واضحة أبرزها ما حدث في الصين إبان أولمبياد بكين، والتي أنست العالم مجازر الإبادة الجماعية، ويتشابه الأمر مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم بعد أسابيع من استضافة الأولمبياد. وحديثاً، شاهدنا كيف نسي الجميع مسألة حقوق العمال بعد انتهاء مونديال قطر 2022.
يعقب بيتر هيلتون، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة قنوات “يورو سبورت” وأيضاً “اي اس بي ان”: “لقد عملت في مجال الرياضة 40 عاماً ولم أر مثل هذا الإصرار”، فالمال السعودي مجهز لسنوات لاحقة، وليس لعاصفة إعلامية وحيدة، وهو محاولة حقيقية لتغيير كرة القدم جغرافياً وفنياً.
وفي ظل القوة المالية المدمرة إضافة إلى استكانة الفيفا والاتحادات الأوروبية وتواطئها، لا يبقى سوى المراهنة على فكر اللاعبين أنفسهم، وأولوياتهم في عالم كرة القدم. فبينما رحل كثر إلى السعودية بهدف المال، هنالك أيضاً من اتخذ قراره على أساس ديني، كما حال بنزيما وكانتي، وتبرير قرارهم بأن السعودية دولة إسلامية. وفي المقابل، فإن بعض اللاعبين رفضوا العرض السعودي دفاعاً عن رغبات عائلاتهم كما حال ميسي ودي ماريا، أو من رفض بسبب شغف التنافس كما راموس وسون، لكن الأدلة التاريخية تثبت دوماً أن المال هو المنتصر بالنهاية، وهو العامل الأساس لقرار اللاعبين، وفي تغيير اللعبة. ليس فقط الآن، بل ومنذ السبعينات، إذ يحكى أن مدرب نادي أياكس أمستردام (نادي الكرة الشاملة) وفي غرف تبديل الملابس، بادر الى وضع قطعة نقدية على ركبة لاعب النادي يوهان كرويف عندما أخبره بأنه يعاني من إصابة في ركبته. وقال له “ستتحسن”.
إقرأوا أيضاً: