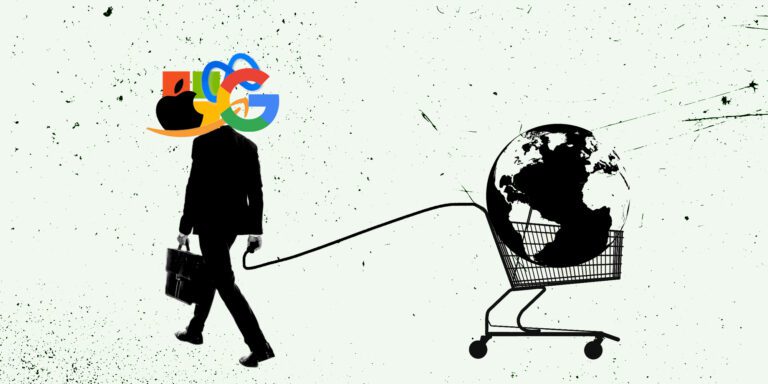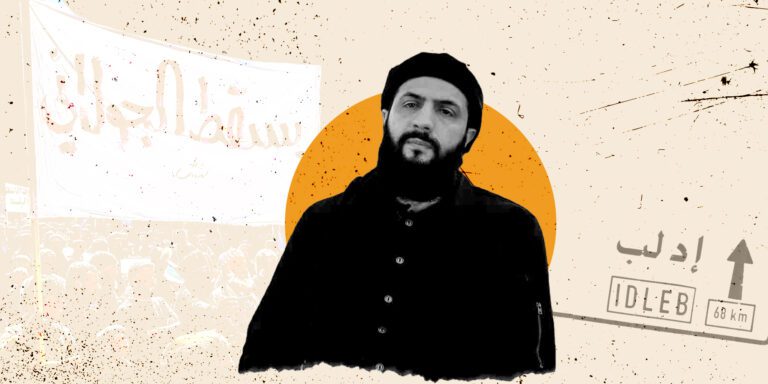كان يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر حدثاً غير مسبوق لخّصه الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنياع في “يديعوت أحرونوت” بقوله: “حدثت إهانة عظمى لم يشهد الجيش الإسرائيلي مثيلاً لها، إهانة استخبارية، إهانة في سهولة دخول “حماس”، وإهانة في سهولة العودة بصحبة أسرى ورهائن، وإهانة في البطء الذي رد به الجيش على التوغلات”.
يضاف الى ذلك فشل القبة الحديدية ومنظومات التجسس الأحدث والأغلى عالمياً، واختراق الجدار الضخم شديد التكلفة من تحت وفوق الأرض، وظهور قدرات فلسطينية رفيعة في التخطيط والتنفيذ والتنسيق بين مختلف الوحدات كما يحدث في الجيوش الحديثة.
الجيش الذي لا يقهر يُقهر، والاستخبارات التي تستشرف الخطر من كل الجهات والمزودة بأحدث أجهزة التجسس، لم تستشرف شيئاً. والجدار الحامي من فوق الأرض وتحتها والمزود بمجسات إلكترونية وكاميرات وأبراج حراسة، لا يحمي. القبة الحديدية التي تدمر الصواريخ قبل وصولها الى أهدافها، تركت الصواريخ تعبر الغلاف وما بعده وصولاً الى العمق الإسرائيلي. وأسْر الجنود والضباط تحقق بالجملة، بما في ذلك أسر رتب عسكرية رفيعة خلافاً لـ “بروتوكل هانيبال”. هذا التغير الصادم والمفاجئ الذي أنزل إسرائيل من عليائها، حدث لساعات، ليوم أو لبضعة أيام، ثم خرج المارد الجريح من القمقم، واستيقظت المؤسستان الأمنية والسياسية الإسرائيلية من سباتهما لتشرعا في أبشع مقتلة في قطاع غزة.
ما حدث يوم 7 تشرين الأول له معانٍ رمزية ومعنوية تفوق بكثير ما تحقق عملياً ضد مؤسسة فخورة بفائض قوة ردع هائلة وحاسمة. فما جعل تنظيماً عسكرياً – حماس- يتحدى الردع الإسرائيلي من داخل حصار محكم، ويخترق المنظومة الأمنية ويلحق خسائر كبيرة بها، يمكن أن يحمل الدول التي سلمت بالتفوق وقوة الردع الإسرائيلية المطلقة الى أن تعيد حساباتها، فَلِمَ لا يطرح بلد بوزن مصر إعادة النظر ببنود معاهدات السلام الجائرة على أقل تقدير، وتعود لتتنافس على دور إقليمي!
كان أخطر معاني “الطوفان” هو التشكيك في مقولة أن اسرائيل “أكثر مكان آمن لليهود في جميع أرجاء العالم”. ومن شأن المس بهذه المقولة إحداث تحول في مكون أساسي من الاستراتيجية الصهيونية، عنوانه رجحان كفة الهجرة المغادرة على كفة الهجرة الوافدة في المدى القريب وربما المتوسط، والمؤشر على ذلك أن معظم اللاجئين الأوكرانيين الذين هربوا من الحرب في بلادهم الى إسرائيل عادوا إلى أوكرانيا.
للطوفان معان أخرى يسردها إيهود باراك قائلاً: “في 7 تشرين الأول، انهار عقد الدولة مع مواطنيها، والذي في مركزه واجب الدولة في ضمان أمنهم. وانهارت فرضية أن حماس ذخر جرى دعمه بـ 1.5 مليار دولار، وأن السلطة عبء. وانهارت فرضية أن طريق السلام مفتوح مع العالم العربي ومغلق مع الفلسطينيين”.
ما حدث يوم 7 تشرين الأول واقعياً ورمزياً لا يشكل تهديداً وجودياً لدولة متفوقة عسكرياً وتمتلك ترسانة نووية، ومحمية بالأساطيل الأميركية. التهديد الوجودي المفتعل والمضخم له صلة باهتزاز ثقة الجمهور الإسرائيلي بأدوار المؤسسة السائدة في السيكولوجية الإسرائيلية. وربما اهتزاز الثقة الأميركية والأوروبية بالدور الوظيفي الإسرائيلي. يأتي تضخيم التهديد الوجودي لتبرير حرب الإبادة التي يتعرض لها 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتهديد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه.
رداً على اهتزاز عقيدة التفوق والردع، كشرت المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية عن أنيابها، واستحضرت كل عناصر القوة والغضب والعقاب والانتقام والثأر والتدمير لإعادة بناء قوة الردع وغطرسة القوة. منذ اليوم الأول، أعلن نتانياهو وأركان جيشه حالة الطوارئ والحرب، وبدأت آلة الحرب الجهنمية بغزو قطاع غزة، ولم تتوقف الطائرات الحربية منذ 7 تشرين الأول عن إسقاط القنابل والصواريخ بمئات الأطنان من المتفجرات لتهدم الأبراج والمنازل والأسواق، مخلِّفةً
ما يزيد عن 16 ألف قتيل قبل انتهاء الهدنة. تم تدمير أكثر من 45 في المئة من المناطق الحضرية في قطاع غزة وتهجير 1.7 مليون مواطن من شمال القطاع الى جنوبه، ولم تسلم المستشفيات وأبنية الهلال الأحمر وسياراته، ومعدات الدفاع المدني وكذلك مدارس الحكومة والأونروا والاتصالات والنظام المصرفي. وقد أخرجت آلة الحرب كل البنية التحتية عن الخدمة وأصبحت عاجزة عن أداء مهامها الإنسانية والخدمية، ما يهدد بانهيار بنية المجتمع.
استحضر نتانياهو كل ما في ترسانته ضد الشعب الفلسطيني، بدءاً بدعوته 2.3 مليون مواطن لمغادرة بيوتهم، في دعوة صريحة للتهجير. مروراً بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن عقوبات جماعية بحق المواطنين، حين قال: نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا وقود،كل شي مغلق، ووصف الفلسطينيين بأنهم “وحوش بشرية” ونتصرف بناءً على ذلك”. هكذا يتحلل أرفع مسؤول عسكري من قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقات جنيف الرابعة وبروتوكولاتها. ودعا آخرون إلى “إعادة قطاع غزة إلى العصر الحجري”.

خطاب خطر وجودي
صوّرت حكومة نتانياهو حركة حماس بأنها خطر وجودي يهدد إسرائيل عبر سياساتها وأيديولوجيتها وممارستها في 7 تشرين الأول، وشبّهتها بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ومرات أخرى شبهتها بالنازيين، وجاء ذلك مترافقاً مع شن أكثر الحروب وحشية ودماراً. اللافت، أن حكومة نتانياهو دمجت الشعب في قطاع غزة بالخطر الوجودي الذي يهدد إسرائيل واعتبرته مسؤولاً عن أفعال حماس.
عضو الكنيست ريفتال غوتليف، دعا الى استخدام قنبلة نووية على غزة. وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي للقناة 13، “إن غزة ستُسوّى بالأرض وتتحول الى مدينة من الخيام”. وقال ألون بن دافيد في معاريف، إننا في حرب على الوجود، إذا لم ننتصر ونحسم فيها فلن نتمكن من الوجود في هذا المكان”.
إزالة التهديد الوجودي تعني حسم المعركة، وذلك بإبادة البنية التحتية، أي تدمير معظم المنطقة المبنية في شمال القطاع – الشجاعية وكل مدينة غزة وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا وطرد حماس الى جانب الكثيرين. ويوضح بن دافيد، أنه عندما تدخل القوات لن تكون هناك مبان ولا مدنيون على الأرض.
كرر وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الدعوة الى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أما الجنرال السابق جيورا ايلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، فشدد على تهجير جميع سكان غزة الى مصر أو الى الخليج. وكي يحدث ذلك، يجب اعتبار كل مبنى، بما في ذلك المدارس والمستشفيات التي يقبع في أسفلها مقر لحماس، هدفاً عسكرياً، واعتبار كل مركبة في القطاع مركبة عسكرية لنقل المقاتلين ولا يهم إذا كانت المركبات لنقل المياه أو الإمدادات الحيوية الأخرى.
ما سبق، غيض من فيض التهديد والوعيد المحمّل بالكراهية والحض على تطهير عرقي لـ 2.3 مليون مواطن أولاً ولاحقاً لمعظم الفلسطينيين، وممارسة العقاب الجماعي على شكل إبادة تصنّف كجرائم ضد الإنسانية. وقد بدأ التهديد يُترجم على نحو مريع. حرب إبادة تقوض وجود شعب على أرض وطنه، تشن تحت بند “حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها”، حق رددته دول أميركا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وغيرها، وعلى رغم أنها تربط هذا الحق باحترام القانون الدولي، لكنها تتغاضى عن الترجمة الإسرائيلية العملية لذلك الحق بالضد من القانون الدولي، وتستمر في تأمين الغطاء السياسي “لحق إسرائيل” في تحويل قطاع غزة الى خرابة فوق رؤوس مواطنيه.

لماذا حدث الانفجار؟
تفاجأت إسرائيل وإدارة بايدن ودوائر الغرب وكل المعنيين بملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بما حدث يوم 7 تشرين الأول، والذي أتى تتويجاً لتحولات في الموقف الشعبي الفلسطيني، وللتبدل المتعاظم في الاستقطاب السياسي، بفعل إصرار إسرائيل على استبعاد حل هذا الصراع من كل الاتفاقات والمعاهدات العربية – الإسرائيلية القائمة والمحتملة. وكان نتانياهو يتفاخر بتعميم الاتفاقات مع دول عربية وإسلامية أخرى، فيما يرفض مع سبق الإصرار حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي باعتباره جوهر الصراع في الشرق الأوسط. لذا خلت التفاهمات الإقليمية الأخرى بين إسرائيل وتركيا، والتفاوض حول النووي الإيراني، وأيضاً اتفاقية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، من الإشارة إلى حل هذ الصراع.
روجت الحكومات الإسرائيلية، وبخاصة حكومة نتانياهو، منذ عام 2009، لمقولة إن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي غير قابل للحل وأقصى ما يمكن فعله هو خفض التوتر وتحسين شروط الحياة الاقتصادية للسكان، بتأييد أو تواطؤ من الإدارات الأميركية والاتحاد الأوروبي الذين توقفوا عن طرح عملية سياسية، وتركوا نتانياهو لاعباً وحيداً لنتانياهو، فيما يتواصل فيه الفعل الإسرائيلي المنهجي لتقويض مقومات الكيان السياسي الفلسطيني من خلال شطب أي حل سياسي للصراع وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتغول الاستيطاني، وممارسة “التطهير العرقي” في القدس والأغوار ومحافظة الخليل، وقرصنة أموال المقاصة وممارسة حصار مالي تشارك فيه الدول العربية، واستباحة المقدسات، وبخاصة المسجد الأقصى، فضلاً عن المحاولات المحمومة لكسر إرادة الأسرى. ونزع كل صلاحيات السلطة الفلسطينية، ما عدا “التنسيق الأمني”.
ذلك كله أحدث أزمة ثقة وانفضاضاً شعبياً متزايداً عن السلطة والمنظمة وحركة فتح، انفضاضاً أدى إلى مزيد من التفكك السياسي والتمثيلي، وفتح الأبواب أمام التدخلات الدولية والإقليمية في الشأن والمصير الفلسطينيين. في المحصلة، أرادت إسرائيل وإدارة بايدن تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني وتقرير مصير إلى “تأمين ظروف حياة أفضل للفلسطينيين” بالأقوال فقط. وفي ظل غياب حركة وطنية ديمقراطية -في إطار الشرعية الفلسطينية، فمنظمة التحرير الفلسطينية- تملك زمام المبادرة، وتجيب عن الأسئلة الشائكة في الحقل السياسي والاقتصادي والنضالي، حدث فراغ سياسي متعاظم، فسارعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الى ملئه من خلال تقديم خيار “المقاومة” في الضفة الغربية، بدعم سياسي ومالي من المحور الإقليمي الإيراني الذي التقط مظلومية الشعب الفلسطيني، بمعزل عن دعم تحرر الشعب الفلسطيني وخلاصه من الاحتلال، مكتفياً بادعاء القدرة على “تدمير إسرائيل”، المتقاطع مع حتمية زوال إسرائيل بحسب الإسلام السياسي، وكلاهما يعلمان أن التدمير والزوال ينتميان الى عالم الخيال.
الهدف الإيراني غير المعلن هو استخدام الورقة الفلسطينية الثمينة جيوسياسياً، للضغط ولتحسين مواقع النظام الإيراني وحصصه في الإقليم على المدى المباشر والمتوسط بمعزل عن إنجازات فلسطينية تقود الى الخلاص من الاحتلال وتقرير المصير.
استخدام إيران المقاومة الفلسطينية لدواعي تعزيز نفوذها وموقعها الإقليمي، يتقاطع مع الرغبة الفلسطينية الشعبية الجامحة في البحث عن منقذ -أي منقذ- في شروط القهر والإذلال والاضطهاد الإسرائيلي للسواد الأعظم من الشعب الفلسطيني.
وفي المفاضلة بين خيار المقاومة برمزيتها وسحرها – رغم عشوائيتها وبدائيتها وتحويلها الجمهور الفلسطيني الى مشجع بدلاً من مشارك في أشكال مقاومة أخرى، وبين خيار السلطة والمنظمة السياسي الذي لم يعد يقنع أحداً، والمترافق مع عجز اقتصادي فاقع، انحازت النخب المجتمعية والمزاج العام الى المقاومة، وفاز خيارها في الضفة بعد القطاع بدعم إيراني، مقاومة من دون الحد الأدنى من المقومات، ومن دون مشروع تحرري قابل للتطبيق في مدى زمني قريب ومتوسط ويحظى بدعم معسكر الأصدقاء دولاً وشعوباً.
طُرح خيار المقاومة في الضفة بطريقة مرتجلة عائمة في أهدافها ومغلفة بأيديولوجيا دينية متناغمة مع المزاج الشعبوي. ولم يبق أمام حركة حماس غير انتزاع السلطة والتمثيل والقرار الرسمي، كان ذلك هدفاً رئيسياً للحركة ولمحور الممانعة، واعتقدت حماس أنها تستطيع ذلك من خلال عملية الطوفان التي ستحظى بتأييد شعبي حاسم، وقد حدث ذلك في الأسبوعين الأوّلين،كما اعتقدت أن نجاحها في تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين عبر عملية تبادل سيعزز شعبيتها أكثر فأكثر، وسيدفع حركة فتح ومنظمة التحرير وسلطتهما الى الهامش.
إقرأوا أيضاً:
كعب أخيل 7 تشرين الأول
ما حدث يوم 7 تشرين الأول، اختصرته الدعاية الإسرائيلية الغربية باستهداف مقاتلي حماس المدنيين الإسرائيليين بأسلوب استفزازي، ورغم أن بعض الدعاية كان مفبركاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن الأثر السلبي بقي يفعل فعله ويدفع الى انحياز دول وقوى ومؤسسات حقوقية مع إسرائيل والتعامل معها كضحية ومنحها “حق الدفاع عن النفس”.
لا شك في أن قتل أطفال ومدنيين غير مسلحين ومسنين، أو أخذهم كرهائن، وإطلاق النار على أهداف مدنية مباشرة، و”التمثيل بالجثث” يحتاج الى تدقيق محايد، والى تخليصة من الإضافات والمبالغات. يحتاج إلى وقفة مسؤولة تعترف بالارتكابات وتعمل على تداركها في أسرع وقت.
مبدئياً، المسّ بالمدنيين المعرفين بالقانون الدولي، يخالف ما دعا إليه القائد العسكري محمد الضيف في كلمة إعلان الهجوم: “لا تقتلوا شيخاً ولا امراة ولا طفلاً”… ويخالف أساساً القانون الدولي الذي يعتبر قتل المدنيين عمداً جريمة حرب. الجدير بالذكر أن انتهاكات حماس وارتكاباتها استُخدمت ولا تزال تستخدم في تأمين غطاء سياسي دولي لاستباحة وتهديد مصير 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وبالمحصلة تهديد وجود كل الفلسطينيين داخل وطنهم. لكن ذلك بدأ يتعارض مع الموقف الدولي ولا يحظى بغطاء سياسي حتى بغطاء أميركي. وعلى رغم وجود غطاء أميركي تاريخي وضع إسرائيل فوق القانون وخارج المساءلة والعقاب، لكن الغطاء لم يشمل جرائم مفتوحة وتهديد وجود شعب بحرب إبادة تمارسها إسرائيل كما يحدث الآن.
لم تتوقف قيادة حماس عند مبدأ يقول إن العمل المقاوم لا يرد على الجرائم التي يرتكبها المستعمرون بجرائم شبيهة. فالتفوق الأخلاقي هو العنصر الأهم في عملية التحرر الوطني، وهو الذي يجعل الرأي العام من دول وشعوب وقوى سياسية ومنظمات حقوقية، يصطفّ مع المقاومين ومع شعوبهم المناضلة. انضباط حماس بقواعد الحرب المحددة في اتفاقيات جنيف الرابعة وبروتوكولاتها وباتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان، عدا عن كونه يشكل تفوقاً إنسانياً وأخلاقياً، فإنه يشكل أحد أهم العناصر التي تساعد في تأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة غطرسة القوة . للأسف، كان لأعمال القتل التي بُثت في وسائل الإعلام العالمية، مفعول عكسي وخطير هدد أمن الشعب الفلسطيني وأمانه. لذا كان ينبغي نقد كل خطأ وانتهاك ارتُكب أثناء العملية والاعتذار عنه للرأي العام الذي كان دائماً مع فلسطين. واعتبار الانتهاكات عملاً فردياً يتم التحقيق فيه والمحاسبة عليه.
لم تتوقف قيادة حماس عند فرضية أن أي حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي كحل الدولتين أو دولة علمانية واحدة أو دولة ثنائية القومية، كل الحلول المفترضة للصراع غير ممكنة من دون شريك إسرائيلي يهودي يتقاطع مع التحرر الفلسطيني. وهذا يستدعي وجود حساسيات وحقوق معترف بها تتناغم مع القانون الدولي. فالخطاب المعادي لليهود كيهود، وإنكار الوجود الموضوعي للإسرائيليين، والرد على الانتهاكات الإسرائيلية على خلفية دينية وعنصرية، بانتهاكات مشابهة، يؤدي إلى نتائج مأساوية. دائماً الطرف الأضعف – الفلسطيني – يدفع ثمناً باهظاً، وبخاصة مع إسرائيليين يهود ما زالوا مسكونين بعقدة الهولوكوست، ومدعومين بنظام دولي يضع إسرائيل فوق القانون، ومسلّحين بأيديولوجيا أرض الميعاد التي تحجب حقيقتهم الاستعمارية.
أكدت حروب المواجهات الأربع السابقة على قطاع غزة وحرب اجتياح الضفة الغربية عام 2002، طغيان الخسائر الفلسطينية على الخسائر الإسرائيلية وبما لا يقاس. نتيجة منطقية لميزان القوى بين شعب محاصر وداخل قبضة أمنية إسرائيلية تتحكم في الموارد والاستيراد والطاقة والماء والدواء والغذاء والاتصالات وحرية الحركة وكل شيء، دولة مستعمرة تملك ترسانة عسكرية ضخمة وحديثة واقتصاد متطور، ودعم خارجي بلا حدود.
أي قراءة موضوعية متعاطفة مع الشعب الفلسطيني، ستقول إن أي حرب مواجهة بين جيش حديث يملك قوة تدميرية هائلة وتتحكم بكل سبل الحياة والعيش الفلسطيني بحدوده الدنيا، مقابل قوة مقاومة محاصرة ومحدودة التسليح ستكون مغامرة غير محسوبة وستكون وبالاً على الشعب المحاصر. لا يمكن أي مقاومة بالمواصفات السابقة أن تبادر الى حرب مواجهة مع آلة حرب جهنمية، كان من المفترض أن تأخذ المقاومة بقانون الخصائص المتناقضة، التي يؤدي الالتزام بها إلى وضع عناصر قوة المقاومة وشعبها على عناصر ضعف آلة الحرب الباطشة كما حدث في الانتفاضة الوطنية الكبرى عام 1987، وليس استدعاء عناصر قوة العدو.
مبادرة حماس الى حرب مواجهة بإطلاق آلاف الصواريخ على كل أرجاء إسرائيل المترافق مع اقتحام عشرات مواقع جيش إسرائيل والكيبوتسات في غلاف غزة، لم تكن مدروسة، ولم تضع في الحسبان رد الفعل الإسرائيلي الجنوني الذي شرع بتهديد 2.3 مليون فلسطيني، وربما كل الشعب في الضفة والقطاع ومناطق الـ 48 ووضعهم جميعاً تحت رحمة آلة حرب مجنونة ومصير مجهول.
الرد على الغطرسة والتنكر والاستباحة الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، من المفترض أن تكون له أهداف سياسية واضحة وملموسة جوهرها تراجع سياسات الاحتلال على طريق إنهائه. ولا يكون الرد بالانتقام وإيقاع الخسائر فقط. كان ينبغي طرح أهداف كفك الحصار عن قطاع غزة، ووقف الاستيطان وعمليات التطهير العرقي وإزالة البؤر الاستيطانية، والاعتقال الإداري، ووقف عمليات تهويد القدس واقتحامات المسجد الأقصى، ودفع أموال المقاصة، وتغيير اتفاق باريس الاقتصادي وتغيير التنسيق الأمني، وذلك كله توطئة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية لإنهاء الاحتلال.
لم يكن هذا واضحاً في خطاب حركة حماس.

مقاربات للمستقبل
مخيال معسكر الممانعة والمقاومة الداعي الى تعميم لحظة 7 تشرين الأول والمضي بها الى انتصار، هذا المخيال بعيد من الواقع وله ثمن فادح يدفعه الشعب الفلسطيني، وبخاصة بعد فشل وحدة الساحات. مقابل مخيال إسرائيل القائل: “ليست هناك حاجة الى السلام، يستطيع جيش إسرائيل حماية دولة إسرائيل من دونه، وإلى الأبد يمكن السيطرة على الشعب الفلسطيني واضطهاده بينما تزدهر إسرائيل إلى جانبه…كما أن المستوطنات تحرس إسرائيل وتحميها”. موازين القوى لا تسمح بتحويل الرمزية الى واقع، بالعكس فإن الدولة المستعمرة وحلفاءها يسعون الى محو وإزالة تلك اللحظة وأدواتها كما فعل الأميركان بعد بيرل هاربر وبعد ضرب أبراج التجارة.
غطرسة القوة لا تستطيع السيطرة على شعب وإخضاعه إلى ما لا نهاية.
مصلحة الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة تستدعي وقف الحرب والتدمير والتهجير فوراً، والبحث الجدي عن حل سياسي عادل. فهذه القضية تفاقم الصراع في المنطقة وبارتدادات عالمية. ويهدد عدم حلها كل التقدم المحرز لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فلم تنس الشعوب أبداً أن القضية الفلسطينية والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني كانا مصدراً مهماً للتعبئة وسط ملياري مسلم، كما يقول دومنيك دي فيلبان، رئيس وزراء فرنسا السابق. عندما يزول الاحتلال يزول التهديد المزدوج للشعب الفلسطيني، وللأمن والاستقرار الإسرائيليين. لا بديل عن الحل السياسي، وليس من مصلحة الشعب الفلسطيني طرح الخيار العسكري في ظل أقصى استنفار لغطرسة القوة.
ما يهم الآن تجاوز وصمة الإرهاب، التي يتم استخدامها لتصفية “حركة حماس” و”الجهاد الإسلامي” وسائر تنظيمات المقاومة ودمج التحرر الوطني بالإرهاب وتشويه القضية الفلسطينية، وذلك باعتماد جميع المكونات السياسية الفلسطينية القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقات جنيف وبروتوكولاتها وشرعة حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.
يستطيع الشعب الفلسطيني أن يكون موحداً وفاعلاً ببرنامج وطني وأهداف سياسية تستند الى الشرعية الدولية وقابلة للتحقيق وتحظى بدعم وتأييد عربيين وعالميين. ولقد ثبتت بالتجربة صعوبة الجمع بين قوى فلسطينية ترفض الشرعية الدولية وقوى تقبل بها في إطار سياسي واحد، والانتماء الى مشروع سياسي وطني قابل للتحقيق في الوقت نفسه.
إذا توحد الشعب الفلسطيني وطنياً وسياسياً على قاعدة الشرعية الدولية، سيكون أقرب الى تحرره رغم مرارة التجربة السابقة التي تحولت فيها الشرعية الدولية إلى ملهاة دولية. وإذا توحد الشعب الفلسطيني على قاعدة رفض الشرعية، سيدمج بالإرهاب ويعطي مبررات إضافية لتصفية قضيته الوطنية. الآن وأكثر من أي وقت مضى، ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني انقسام حركته السياسية.
لابد أن نشير إلى أن الاصطفاف الدولي الراهن شديد الخطورة والتعامل معه بحاجة الى حكمة وعقلانية وذكاء، بعيداً من الخطاب الشعبوي التهييجي الداعي إلى توسيع الحرب، والانتقال الى خندق حماس ومغامرتها العسكرية، فهذا يساعد في مفاقمة حرب التدمير والتهجير، ويساعد في تحقيق العدوان أهدافه الإجرامية.
المقاومة وُجدت لانتشال شعبها من براثن الاحتلال، وللدفاع عن شعبها وحمايته ورفع معاناته والتقليل من خسائره. ولا يمكن قلب المعادلة كالقول إن الشعب يفتدي المقاومة بكل شيء. لا يمكن الفصل بين سلامة الشعب وسلامة المقاومة، بل إن سلامة الشعب هي الأساس، والتي تحتل مركز الاهتمام. مسؤولية حماية الشعب مسؤولية مشتركة للمنظمة والسلطة والمقاومة والمعارضة. مسؤولية تبدأ بفتح أفق سياسي وقطع الطريق على الإبادة والتهجير والكوارث التي صنعتها سياسات الاحتلال.
تكرس إسرائيل عبر “حرب الابادة” التي تشنّها، خيار إسبرطة معزولة ومحاطة بشعوب معادية. ولن تُقابل إسرائيل الخارجة من حرب إبادة وتهجير إلا بالازدراء والعزل، ولن تكون عضواً “طبيعياً” في مجتمع دولي. ولن تستطيع مكوناتها التعايش في ما بينها بعد ارتكاب جرائم وفظائع حرب.